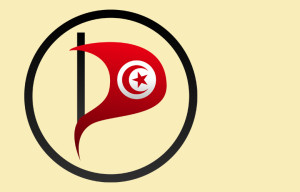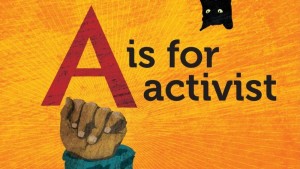نضال عبدالغني
جيش الإحتلال الصهيوني يقصف غزة والردود العربية قاسية جداً ، فهي تشتم وتلعن وتتوعد وتردد كلمات أغاني وأشعار مشهورة وقديمة وهناك الكثير الكثير من الأشعار والشعارات والتصاميم الجديدة التي نظمت خصيصاً للحدث. الجميع مواظبون على إحصاء عدد القتلى والجرحى وعلى ترديد الشعارات الثورية “القاسية” أيضاً! ولكن، أريد أن أسأل الجميع، لمن “يكتبون” تلك الكلمات؟ من المستهدف لأن يقرأها؟ وما الأهداف من قراءتها؟ أهي لحشد النفوس وتحميس الهمم لمواجهة العدو؟ أهي دعوات لخوض حرب رادعة تعيد الحقوق لأصحابها وتحاسب الظالمين المعتدين وتعاقبهم؟
جميل جداً، هذا حلمي أنا أيضاً وطالما تأملت لحظة النصر ورفع الهوان. ولكن، مَن سيحارب مَن؟ جيش العدو مُعَدّ ومُجهَّز بشكل كبير ومتقن، وموحَّد القيادة العليا والقرارات والتوجيهات. فأين نحن وقدراتنا ووحدتنا من كل هذا؟ ولنفرض أن الحماس الشعبي تفاقم وعلت الصرخات الى السماء وكسرت كل الحواجز والحدود ودخلنا فلسطين بغضبنا وشعاراتنا “القاسية”. ماذا بعد ذلك؟ دخلنا الحدود – بغض النظر عنوة أو بالتراضي- الى أين سنذهب؟ ما هي خطتنا المرسومة للإطاحة بجيش ودولة الإحتلال؟ ما الذي سنفعله وقد عجزالملايين في فلسطين عن فعله خلال عناء وحاجة أعوام طويلة ؟ هل هناك معجزة في انتظار عبورنا الحدود لتحدث؟
لنعتبر أن هدف تلك الشعارات ليس حشد عواطف العرب لدخول فلسطين ولتحريرها، بل “لفضح الممارسات العنصرية الهمجية” التي يقوم بها أفراد “العصابة” الصهيونية ضد الفلسطينيين في فلسطين. مع أنني أرى في التقليل من شأنهم إهانة لنا نحن، حيث أن تلك الأقلية هي ما يتحكم بمصائر ما يقارب 350,000,000 عربي في الشرق الأوس. فهل حدث أن استجاب العالم يوماً لمعلوماتنا أو لاستغاثاتنا أو لتظلماتنا – الدائمة – للمجتمع الدولي؟ على فرض أنهم “يفهمون لغة ومضموناً” ما نكتب من شعارات قاصفة و”قاسية” طبعاً!
إذن لا بد من أن هناك خلل ما. إما أن يكون هذا الخلل في خطاباتنا ومحتوياتها أو أن يكون في موقف المجتمع الدولي المسبق من قضيتنا -الذي يتبع نظرته إلينا بطبيعة الحال- فنحن لا نفعل شيء غير البكاء والشكوى والدعاء ومطالبة الغير بإزالة الأذى عنا. كأن نستجدي بهتلر مثلاً، أو أن ننادي على صلاح الدين ليعود إلينا من الموت ليفتح القدس ويحررها من جديد. أهو اعترافنا بالعجز؟ أهو فقداننا لكل الآمال في أن ننتج أبطالنا الجدد؟ هل أصبحنا يائسين الى هذا الحد؟ ولماذا؟
فكرت وأفكر دائماً في مشكلتنا القديمة مع الكيان الصهيوني الدخيل المزروع في أهم مفصل جغرافي للعالم العربي. كما وأفكر في ما يؤمن له غطاء الوقاية الدولية ليعطيه صلاحيات لكل ما يرغب في فعله على أرض فلسطين. وكل مرة كنت أفكر في هذه “المعضلة”، كنت أنتهي الى مثل شعبي أو مقولة تاريخية ،وكلها تصب في نفس الوعاء. فمرّة انتهى بي المطاف الى المقولة الشهيرة “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”. مرة أخرى الى المثل الشعبي الشهير أيضاً “قالو يا فرعون مين فرعنك؟ قال ما حدا ردني” وكثيراً مما يشابه تلك الأمثال والمقولات.
كل هذا يوجهنا الى التفكير الذاتي والبحث عن الحل لمشاكلنا في داخلنا نحن ويدعونا لأن نواجه أنفسنا بأغلاطنا قبل أن نلعن أغلاط العالم. وكلنا نعلم أن الشجاعة الحقيقية هي في مواجهة النفس وليست في مواجهة الخطر. كثيراً ما نرفض فكرة أننا “ضعفاء” وما سبب رفضنا إلا هروباً من “الواقع” الأليم ومرارة الإعتراف به! ولكن هذا الهروب لن يغير في المشكلة إلا أن يزيدها سوءاً –بالنسبة لنا نحن طبعاً- وأن يزيد من تعقيدات تفصيلاتها المتزايدة باستمرار مرور الوقت.
فلنفكر في ضعفنا ونعرّفه. أوّلاً، هو “عجزنا” عن رد الأذى عن أنفسنا و”عجزنا” عن التصدي لأي عدوان خارجي على أرضنا وعلى خيراتها. هذا ما يحصل لنا على أرض الواقع منذ مدة لا بأس بها. فنحن عاجزون –منذ زمن- عن إنقاذ فلسطين من الإحتلال. كما و عجزنا عن الوقوف بجانب العراق -مثلاً- في محنته واكتفينا “بالبكاء” والعويل على صدام حسين. لم نضيع أي فرصة في أن ننوّه الى “موعد إعدامه” الذي كان في أول أيام عيد الأضحى المباركة وما فيه من امتهان لكرامة المسلمين وأن هذه حرب دينية وأن الإسلام مستهدف… إلخ.
نحن دائماً نكتفي “بذكر” المصائب التي تصيبنا ولا “نفعل” شيء حيالها سوى “التعبير” بشعارات ساخنة و “قاسية” لا توجع إلا قلوبنا ولا تساهم إلا في زيادة “إحباط” نفسياتنا لأن عقلنا الباطن قد تعود على مثل تلك المسلسلات من أفعال “إجرامية” وما يتبعها من ردود أفعال “خطابية” بمدة صلاحية أقصر من مدة صلاحية الحليب “الغير مبستر طبعاً.” وللأسف، فقد انتبه أعداؤنا الى هذه الصفة فينا منذ زمن بعيد، وهي ما يعوّل عليها في اتخاذ أي قرار ضدّنا. فردّة فعلنا صارت محفوظة لديهم (سيثورون قليلاً ثم ينسون ويعودون الى مشاكلهم اليومية). وبلا أي تأثير نعاود الغضب المنفوخ بالهواء كل مر. وبعد انتهاء كل عاصفة تعصف بنا، نخرج منها “بحناجر” مرهقة ونفسيات محطمة، لكثرة مشاهدة دماء ذوينا تسيل مجاناً. دائما يخرج “المعتدون” منها بإحراز خطوة جديدة متقدمة لصالح “خطتهم طويلة الأمد“. إذن، هل مرور الوقت لصالحنا؟
كل مرة كنت أفكر في حل لمشكلتنا كنت أصطدم بحائطين متتاليين، الأول هو “تفاصيلها المهولة” والآخر هو اليأس العام
الحائط الأول، كثرة تفاصيل المشكلة. حتى الآن لم نتعلم معنى “التعددية” وقبول الغير كجزء آخر من نفس المجتمع العربي الواحد -حتى لو كان هذا الغير لا يعتقد بمعتقداتنا- وللأسف كل منا هو عدو لكل مَن هو غيره -مَن يختلف معه فيما يعتقد- يحاول إلغائه والظهور عنه و حتى إبادته إن استطاع ولو كان أخوه. لم نتعلم من كل ما حدث ويحدث وسيحدث -إن لم نغير نظرتنا للغير منا-
أن ضعفنا هو “تفرقنا” وتشرد أهدافنا وسيطرة “عواطفنا” على عقولنا في إنتاج “ردود أفعال آنيّة” دائماً ليس لها أي يد في تغيير أي مجرى للأحداث من حولنا -مع أننا دائماً من يتأثر بهذه الأحداث- هذا التفرُّق والتشرذم والإلتهاء بالخلافات الداخلية عن المواجهات الخارجية التي تحدد مصيرنا هي أسباب عجزنا عن تشكيل قوة سياسية “مؤثرة” في المجتمع الدولي، تساهم في رسم مستقبل وجودنا ضمن العالم المتحضر وعجزنا عن إعداد قوة ردع عسكرية لمنع أيّ كان من أن “يتبلطج علينا”، أو أن يمتلك كرامتنا وحريّة التصرف بها بما يتماشى مع “مصالحه الخاصة”. وهو أيضاً سبب لعجزنا عن تكوين “قوة إقتصادية عالمية” يحسب لها حساب -علماً بأننا “العرب” نملك كل مقومات الإقتصاد المتكامل.
لنتذكرالإتحاد الأوروبي -مع كثرة تفاصيله وتعدد خلفيات خيوط نسيج مجتمعه- وولادته في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على عرش القوة العظمى في العالم. أن هذا الإتحاد قد” تحقق” ضد مصلحة العملاق الأمريكي ورغماً عن أنفه، وهاهو “الإتحاد” الأوروبي اليوم يؤثر سلباً وبشكل مباشر على الإقتصاد الأمريكي. نستطيع أن نرى وبوضوح أن “القوة العظمى تقف عاجزة أمام الإرادة” الأوروبية. ألا يكشف لنا هذا أن “المارد الأمريكي الذي لا يعجز عن تدمير أي شيء” -كما أقنعونا في أفلام هوليوود– ما هو إلا “وهم” كبير؟
هذا نوع من الحرب النفسية التي تهزم النفوس قبل أن تهزم الجيوش. ألا نفكر في هذا “الوحش القادر” وهو يتآمر على إضعاف العراق لمدة 12 عاماً لكي “يستطيع” بعدها أن يسقط نظام البعثيين فيه وبعد أن نقل هذا النظام العراق الى مركز قوة بدأت تهدد الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط؟ الى متى سنظل ننسى الأحداث حتى قبل حدوثها؟ الى متى ستظل مصالح الطامعين فينا تحدد مصائرنا؟
الحائط الثاني، وهو “اليأس الوهمي العام” من الحل الوحيد لمشكلتنا في العالم ومع العالم بأجمعه، سأقولها مُهمِلاً كل الضحكات التي ستعلو لحظة سماع أصحابها بالحل المطروح والوحيد. الحل هو “الوحدة العربية”. هذا الحلم الذي أصبح مستحيلاً لدى الأغلبية الساحقة من العرب. ما أن تذكره إلا أن يذكر أمامه فكاهات واعتراضات وسخريات من أي شخص ينادي به. حالة من اليأس لا أدري كيف تعممت وشملت الجميع! ليس المقصود بالوحدة أن نصير كلنا نوع واحد، بل أن نندمج بكل خلفياتنا الإجتماعية والثقافية والعقائدية لنشكل وحدة تعددية وأن نستفيد من هذا التعدد وأن نتقبله وأن نستثمر فيه.
أريد الإشارة هنا الى شكلين من أشكال التعددية هما “التعددية المتناحرة” و”التعددية التكاملية”! نحن “العرب” متعددون متناحرون، بينما الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على التعددية التكاملية، وكذلك الأمر بالنسبة للإتحاد الأوروبي. والأهم من ذلك أن الدولة الصهيونية مبنية على التعددية، لأتهم بدأو بالهجرة من كل بقاع الأرض الى فلسطين منذ أقل من مئة عام ،هذا ما يعلمه الجميع.
هذه مؤشرات واقعية مثبَتة لأمكانية طرح قرار ناتج عن “الإتحاد العربي” على طاولة الإجتماع الدولية في المستقبل. فهل ستكون نظرة العالم لهذا القرار مشابهة لنظرته لأي “طلب استرحام” تقدمه أي دولة عربية اليوم ليس لها أي تأثير على أي شيء يخص مصالح دول العالم “الأول”؟ أشك في ذلك! الدول العربية “كلها” اليوم تنتظر قرارات مجلس الأمن. وهذه القرارات هي التي ترسم مجرى الأحداث السياسية وليس نحن من يرسمها الآن. وإن كان القليل القليل من هذه القرارات لصالحنا، فأن معظمها لا ينفذ ويتم تجاوزه وإهماله من قبل الطرف الصهيوني والأمريكي، لا يجرؤ مجلس الأمن أن يحاسبهما أو أن يلزمهما بتنفيذ أي قرار. لكن هذا التضامن القوي في المواقف الأمريكية الصهيونية تجاه العرب ما هو إلا “صفقة تبادل مصالح” بينهما، ونحن هنا من “يملك” تلك المصالح لكن لا نتحكم بها.
وبالمناسبة، عندما نتذكر مشروع قيام ما يسمونه “دولة إسرائيل” نتذكر معها أن الدولة العظمى في ذلك الوقت كانت بريطانيا وليست أمريكا. ونتذكر أيضاً أن بريطانيا هي من مهّد الطريق لتنفيذ المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. وهذا يدلنا الى حاجة الكيان الصهيوني “الدائمة” لدعم الدولة العظمى – أياً كانت تلك القوة العضمى – من هنا أطلب من الجميع أن يفقدو الأمل من زوال “إسرائيل” التلقائي بعد نزول أمريكا عن منصة “المركز الأول على العالم. فالكيان الصهيوني أدرى منا بحاجته للتحالف مع “أي” قوة عظمى محتملة. وهذا ما حصل فعلاً حين انتقلت مفاتيح قيادة العالم من بريطانيا الى أمريكا- بغض النظر عن المؤامرات التي ساهمت في إسقاط الإتحاد السوفييتي المتزامن مع ظهور أمريكا كقوة عظمى (تلك المؤامرات أيضاً كانت مبنية على “مصالح مشتركة” بين بريطانيا وأمريكا ونحن كنا أحد هذه المصالح ولكن ليس أهمها) – إذن الكيان الصهيوني باق حتى بعد سقوط أمريكا، لأن من الطبيعي أن يكون الشرق الأوسط “مطمعاً دسماً” لأي قوة عظمى في العالم. ونظراً لتفرّق العرب وبالتالي “ضعفهم” فإن الكيان الصهيوني سيبقى هو الحارس الأمثل لهذا “الكنز” العربي لصالح أي دولة عظمى جديدة مقابل الضغط على المجتمع الدولي لأن يغض النظر عن أي ممارسات يقوم بها الصهاينة في طريق “تنفيذ خططهم بعيدة المدى”.
الطريقة الوحيدة لأن نكون مؤثرين في لعبة المصالح العالمية تلك، هي أن نشكل قوة أكبر من القوة التي شكلها الجسد الصهيوني في فلسطين، لكي يصبح لنا قرار يفرض مصالحه، و يكون لديه القدرة على تحقيق أهدافه على كل طاولات الإجتماعات العالمية. بالإضافة الى التفاهم مع العالم من منطلق قوة ،تغنيه عن حاجته للقوة الصهيونية في المنطقة. وفجأة سيتحول خلافنا مع الكيان الصهيوني الى “مسائل شرق أوسطية داخلية لا داعي للتدخل الخارجي فيها. بعبارة أخرى “فليحلو مشاكلهم بنفسهم و يحلو عنا. المهم مصالحنا ماشية مع الأكبر والأقوى”. ولكن لكي نصبح فعلاً الأكبر والأقوى (من الصهاينة) يجب أن ننظر الى العالم من عين واحدة وأن نتحاور معه بلسان واحد كما يرانا العالم بعين واحدة ويتحاور معنا بلسان واحد.
ومن زاوية أخرى، أرى أن الوحدة العربية هي فعلاً “حلم واقعي” وليس هذياناً أو أسطورة مستحيل. فعندما ننظر الى “الشعوب العربية” نراها فعلاً موحَّدة في عواطفها وهمومها ومشاكلها اليومية وأحلامها وحتى في أعدائها. لا ينقصها إلا “قيادة واحدة” أو “قيادات متفقة متناسقة”. هذا نتركه كخيار لقادة دولنا العربية، إما أن ينسّقو فيما بينهم لتكون لنا قيادة متعددة المواقع متوحدة في “الهدف والخطة”، أو أن تعلو إرادة شعوبهم على إراداتهم، وأن تفرض عليهم حلولاً على الأغلب لن ترضيهم. فهذا مبني على أن نتعايش مع إختلافاتنا وتعدداتنا على كل الأصعدة، وأن نخلص كلنا لوطن واحد قدير وهدف مشترك واضح. وأن نتعلم كيف نرتب عواطفنا الكبيرة كما نرتب أفكارنا الكثيرة و أن نقتل اليأس فينا وأن نرجع لنحيي كل تلك الكلمات الي ماتت في آذاننا وفقدت طريقها الى عقولنا وقلوبنا ولنستحضر أمجاد ماضينا ونصحح بها التخطيط لما هو آتينا.