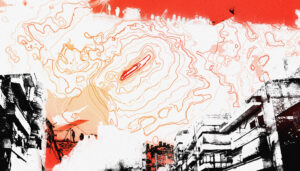(نشر هذا المقال بالانجليزية على موقع TomDispatch بتاريخ ٢١ آب ٢٠١٤)
بقلم باتريك كوكبيرن (ترجمة تقوى مساعدة ودعاء علي)
[هذا المقال مقتطف من الفصل الأول من كتاب باتريك كوكبيرن الجديد، “عودة الجهاديين: داعش والنهوض السني الجديد”، مع شكر خاص لدار نشر الكتاب، OR Books. الجزء الأول من المقال هو مقدمة جديدة كتبت خصيصًا لموقع TomDispatch].
هنالك الكثير من العناصر الاستثنائية في السياسة الحالية للولايات المتحدة في العراق وسوريا، والتي لسبب أو لآخر لا تجذب الكثير من الاهتمام. ففي العراق تشن الولايات المتحدة غارات جوية وترسل المستشارين والمدربين ليساعدوا في إيقاف تقدم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة باسم “داعش”) نحو العاصمة الكردية “إربيل”، ولو أن داعش حاصرت بغداد لكانت الولايات المتحدة لتقوم بالشيء ذاته.
أما في سوريا فإن واشنطن تتبنى سياسة معاكسة تماماً: فالخصم الرئيسي لداعش هو النظام السوري والأكراد السوريون في مناطقهم المحاصرة في الشمال، وكلاهما يتعرضان لهجوم داعش التي سيطرت على ثلث البلاد تقريباً، بما في ذلك منشآت النفط والغاز.
لكن سياسة الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا والسعودية ودول الخليج تهدف إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وهو ما تسعى إليه داعش والجماعات الجهادية الأخرى في سوريا. وفي حال رحيل الأسد فإن داعش هي المستفيدة نظراً إلى أنها تحتوي أو تتفوق على بقية جماعات المعارضة السورية المسلحة. وتزعم واشنطن وعواصم أخرى أن هنالك وجوداً لمعارضة سورية “معتدلة” تتلقى دعماً من الولايات المتحدة وقطر وتركيا ومن آل سعود، إلا أنها معارضة ضعيفة وتتهاوى يوماً بعد يوم، وقد تمتد الخلافة الجديدة قريباً من حدود إيران إلى البحر المتوسط، والقوة الوحيدة التي قد تتمكن من كبحهم هي الجيش السوري.
تتجه السياسة الأمريكية فعلياً إلى دعم الحكومة في العراق ضد داعش أما في سوريا فلا، ولكن أحد الأسباب التي مكنت داعش من تثبيت نفسها بقوة في العراق هو قدرتها على الاعتماد على مصادرها ومقاتليها في سوريا. ورغم الإجماع السياسي الإعلامي في الغرب على إلقاء اللائمة عليه، إلا أن الأخطاء التي حدثت في العراق لم تكن كلها ذنب رئيس الوزراء نوري المالكي. لقد حدثني السياسيون العراقيون خلال السنتين الأخيرتين أن الدعم الأجنبي لثورة السنة في سوريا حتماً سيزعزع استقرار بلادهم كذلك، وها قد حصل هذا الآن.
وبالاستمرار في هذه السياسات المتناقضة في البلدين، فقد ضمنت الولايات المتحدة أن داعش قادرة على تعزيز مقاتليها في العراق من سوريا وبالعكس. وحتى الآن فقد تمّلصت الولايات المتحدة من المسؤولية على بروز داعش، وذلك بإنحاء اللائمة كلها على الحكومة العراقية. ويبدو في الواقع أنها أوجدت حالة يمكن فيها لداعش أن تستمر، لا بل وأن تزدهر أيضاً.
استخدام وسم “القاعدة”
لم يلتفت السياسيون ووسائل الإعلام في الغرب إلا مؤخراً للزيادة الحادة في قوة وسطوة التنظيمات الجهادية في كلٍّ من سوريا والعراق، والسبب الأساسي هو أن الحكومات الغربية وقواها الأمنية تختصر تعريف الخطر الجهادي بأنه يقتصر على القوى المرتبطة بشكل مباشر بتنظيم “القاعدة” أو بالـ “قاعدة” نفسها، وهذا ما يمكنهم من تقديم صورة أكثر تفاؤلاً حول نجاحاتهم في ما يسمى الحرب على الإرهاب مما يسمح به الوضع على الأرض.
وفي الحقيقة فإن الاعتقاد بأن الجهاديين الوحيدين الذين يجب أن يُحذر منهم هم أولئك المنضوون تحت جناح القاعدة ما هي إلا فكرة ساذجة وخادعة للذات، فهي تتجاهل حقيقة أن أيمن الظواهري قائد القاعدة قد انتقد داعش مثلاً لإفراطها في العنف والطائفية.
وبعد الحديث في أوائل هذا العام إلى العديد من المجاهدين السوريين من غير المنتمين بشكل مباشر إلى القاعدة في جنوب تركيا، فقد أخبرني أحد مصادري “أنهم وبلا استثناء أبدوا حماسهم لهجمات الحادي عشر من سبتمبر وتمنّوا أن يحدث الامر ذاته في أوروبا كما حدث في الولايات المتحدة”.
الجماعات الجهادية القريبة أيديولوجياً من القاعدة أعيد تصنيفها كمعتدلة في حال اعتُبرت أفعالها داعمةً لأهداف السياسة الأمريكية.
الجماعات الجهادية القريبة أيديولوجياً من القاعدة أعيد تصنيفها كمعتدلة في حال اعتُبرت أفعالها داعمةً لأهداف السياسة الأمريكية. ففي سوريا دعم الأمريكيون خطة اقترحتها السعودية لتأسيس “جبهة جنوبية” في الأردن التي يُفترض منها أن تكون عدائية مع نظام الأسد في دمشق، وعدائية في الوقت ذاته حيال الثوار القريبين من فكر القاعدة في الشمال والشرق.
وبحسب تقارير، فإن لواء اليرموك القوي والذي يعدّ معتدلاً، كان المستقبل المفترض لصواريخ مضادة للطائرات من السعودية، وكان ينبغي أن يكون قائد عنصر في هذا التنظيم الجديد، إلا ان الكثير من مقاطع الفيديو أظهرت أن لواء اليرموك حارب بالتعاون مع جبهة النصرة وهي الحليف الرسمي للقاعدة، وبما أنه كان من المتوقع أن تقوم هاتان المجموعتان أثناء المعارك بالاشتراك في الذخائر، فقد قامت واشنطن بالسماح بتسليم أسلحة متقدمة ليستخدمها ألدّ أعدائها، كما أكد مسؤولون عراقيون أنهم ضبطوا أسلحة متطورة من مقاتلي داعش في العراق تم تزويدهم بها من قوى خارجية ليتم تسليمها لقوات تعتبر مناهضة للقاعدة في سوريا.
دائماً كان اسم “القاعدة” يُستخدم بشكل مرنٍ عند التعريف عن عدو، فعندما تصاعدت هجمات المعارضة العراقية المسلحة ضد قوى الاحتلال الأمريكي البريطاني في سنتي 2003 و2004، عزا المسؤولون الأمريكيون أغلب الهجمات لتنظيم القاعدة رغم أن منفذي الكثر من الهجمات كانوا من الوطنيين ومن المجموعات البعثية.
ساعدت مثل هذه الدعايات الإعلامية بإقناع قرابة 60 بالمئة من الناخبين الأمريكيين قبل غزو العراق، بأن هنالك صلة بين صدام حسين وبين المسؤولين عن تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر بالرغم من عدم وجود أي دليل على ذلك. وفي العراق نفسها، كما في باقي العالم الإسلامي، استفادت القاعدة من هذه الاتهامات حيث ضخّمت دورها في مقاومة الاحتلال الأمريكي والبريطاني.
وظفت الحكومات الغربية تكتيكات العلاقات العامة المعاكسة تماماً في ليبيا في سنة 2011، إذ قللوا من أهمية أي تشابه بين القاعدة وبين الثوار المدعومين من الناتو الذين كانوا يحاربون للإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي، باستثناء الجهاديين المرتبطين بالقيادة العليا لتنظيم القاعدة المتمثلة بأسامة بن لادن، حيث اعُتبرَ هؤلاء جهاديين خطرين.
ولقد انكشف زيف الادعاء بأن المجاهدين ضد القذافي في ليبيا كانوا أقل خطورة من اولئك المرتبطين بشكل مباشر بتنظيم القاعدة، بشكل واضح وحتى تراجيدي عندما قتل جهاديون السفير الأمريكي كريس ستيفنز في بنغازي في سبتمبر 2010، هؤلاء هم نفس المقاتلين الذي احتفت بهم الحكومات الغربية ووسائل الإعلام لدورهم في الثورة على القذافي.
تخيُّلوا القاعدة على أنها مافيا
القاعدة فكرة أكثر من كونها منظمة، وهذا ما كان عليه الأمر منذ وقت طويل. ولفترة امتدت لخمس سنوات بعد العام 1996 كان للقاعدة كوادر ومصادر ومعسكرات في أفغانستان، إلا أنها قد أزيلت بعد الإطاحة بطالبان في سنة 2011.
وكنتيجة لذلك صار اسم “القاعدة” دعوة للحشد، تمثّل مجموعة من المعتقدات الإسلامية التي تركز على إنشاء دولة إسلامية وفرض الشريعة والعودة إلى العادات الإسلامية وإخضاع النساء وإعلان الجهاد على غير المسلمين، وبالأخص على الشيعة إذ يعدونهم مهرطقين ويستحقون القتل. ويكمن في عمق عقيدة صناعة الحرب هذه التأكيد على التضحية بالذات والشهادة كرمز على الإخلاص الديني والالتزام، وأدى هذا إلى استخدام مؤمنين غير مدربين إلا أنهم متطرفون كمفجرّين انتحاريين لإحداث أثر مدمّر.
لطالما اهتمت الولايات المتحدة وحكومات اخرى بإظهار القاعدة وكأنها تضمّ بنية قيادة وسيطرة شبيهة ببنتاغون مصغّر، أو شبيه بالمافيا في أميركا، فهذه صورة مريحة للعامّة. فالجماعات المنظمة بغض النظر عن مدى شيطانيتها، يظل من الممكن تتبعها وإنهاؤها إما بالسجن أو بالقتل، وما يثير الفزع أكثر هو حركة يقوم اتباعها بتعيين أنفسهم ويمكن لهم أن يظهروا فجأة في أي مكان.
جماعة المقاتلين التابعين لأسامة بن لادن، والتي لم يطلق عليها اسم “القاعدة” إلا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كانت واحدة من عدة جماعات جهادية قبل اثني عشر عاماً، إلا أن أفكارها ومنهجها اليوم سائدة بين الجهاديين بسبب الهيبة والترويج التي حصلت عليه بعد تدمير البرجين والحرب على العراق وحملة الشيطنة التي شنتها ضدها واشنطن لتجعل منها مصدر كل الشر المعادي لأمريكا، وفي هذه الأيام هنالك حصر للاختلافات بين معتقدات الجهاديين بغض النظر عن علاقتهم بتنظيم القاعدة المركزي.
الحكومات تفضل الصورة الفنتازية للــ”قاعدة” لأنها تمكنهم من ادّعاء الانتصارات عندما ينجحون في قتل أفضل أعضائها أو حلفائها
وبالطبع، فإن الحكومات تفضل الصورة الفنتازية للــ”قاعدة” لأنها تمكنهم من ادّعاء الانتصارات عندما ينجحون في قتل أفضل أعضائها أو حلفائها، وعادة ما يُمنح هؤلاء المقتولون رتباً شبيهة بالرتب العسكرية، مثل “قائد العمليات” لإضفاء معنى أكبر على موتهم.
لحظة تكثيف هذا الجانب المضخّم إعلاميًا من “الحرب على الإرهاب” كانت مقتل بن لادن في أبوت أباد في باكستان عام 2011. سمح هذا الحدث للرئيس باراك أوباما بالاستعراض أمام الجمهور الأمريكي على أنه الرجل الذي ترأس على مطاردة وقتل زعيم القاعدة. لكن على المستوى العملي، لم يكن لمقتله تأثير كبير على الجماعات الجهادية الشبيهة بالقاعدة، والتي تحقق انتشارها الأوسع في مرحلة لاحقة.
تجاهل أدوار السعودية وباكستان
اتخذت القرارات الأساسية التي سمحت للقاعدة بالاستمرار ثم التوسع خلال الساعات القليلة التي تلت أحداث 9/11 مباشرة. كانت كل العناصر الهامة تقريبًا في مشروع تحطيم الطائرات في البرجين التوأم ومعالم أمريكية بارزة أخرى تؤشر إلى ارتباط المملكة العربية السعودية به. كان بن لادن أحد أفراد النخبة السعودية، وكان والده مقربًا من العائلة المالكة. وبحسب اقتباس في التقرير الرسمي حول أحداث 9/11 من تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) صدر عام 2002، فإن القاعدة اعتمدت في تمويلها على “مانحين وممولين عدة، جلّهم في الخليج، وبشكل خاص في السعودية”.
اصطدم محققو التقرير بشكل متكرر بمنع أو تقييد الوصول إلى معلومات في السعودية. لكن الرئيس جورج بوش على ما يبدو لم يفكر حتى في تحميل السعوديين المسؤولية عمّا حدث. بل سّهلت الحكومة الأمريكية خروج سعوديين رفيعي المستوى، من بينهم أقارب بن لادن، من الولايات المتحدة عقب أحداث 9/11 بأيام. الأهم من ذلك هو أن 28 صفحة من تقرير اللجنة الرسمية النهائي حول 9/11 تتحدث عن علاقة المهاجمين بالسعودية حذفت ولم تنشر مطلقًا بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، رغم وعد الرئيس أوباما بنشرها لاحقًا.
استمرت لامبالاة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تجاه الشيوخ السعوديين الذين تدعو رسالتهم المنشورة للملايين في الفضائيات واليوتيوب وتويتر إلى قتل الشيعة المهرطقين بنظرهم
عام 2009، بعد 9/11 بثمان سنوات، اشتكت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في برقية كشفتها ويكيليكس من أن المانحين في السعودية يشكّلون أهم مصدر لتمويل الإرهابيين السنة حول العالم. لكن رغم هذا الاعتراف السري، استمرت لامبالاة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تجاه الشيوخ السعوديين الذين تدعو رسالتهم المنشورة للملايين في الفضائيات واليوتيوب وتويتر إلى قتل الشيعة المهرطقين بنظرهم. هذه الدعوات ظهرت فيما كانت تفجيرات القاعدة تذبح الناس في أحياء شيعية في العراق. في برقية أخرى من وزارة الخارجية في العام نفسه، ظهر عنوان فرعي يقول: “المملكة العربية السعودية: معاداة الشيعة كسياسة خارجية؟”. اليوم، وبعد خمس سنوات، أصبح لدى الجماعات المدعومة سعوديًا سجل حافل بالأعمال المتطرفة طائفيًا ضد المسلمين غير السنة.
باكستان -أو بالأحرى وكالة الاستخبارات الباكستانية (ISI)- كانت الحاضن الآخر للقاعدة وطالبان والمجموعات الجهادية إجمالًا. حين كانت طالبان في طور التفكك تحت وطأة القصف الأمريكي في 2001، حوصرت مجموعة من قواتها في شمال أفغانستان. قبل أن تستسلم هذه المجموعة، تم بسرعة إخلاء المئات من عناصر الوكالة ومدربيها العسكريين ومستشاريها جويًا. ورغم هذا الدليل الواضح على رعاية وكالة الاستخبارات الباكستانية لطالبان وللجهادين بعامة، رفضت واشنطن مواجهة باكستان، وبالتالي فتحت الباب لعودة طالبان بعد 2003، وهو ما لم تستطع لا الولايات المتحدة ولا الناتو منعه.
لقد فشلت “الحرب على الإرهاب” لأنها لم تستهدف الحركة الجهادية ككل، وفوق ذلك لم تستهدف السعودية أو باكستان، وهما الدولتان اللتان ربّتا الجهادية كعقيدة وكحركة. لم تفعل الولايات المتحدة ذلك لأن الدولتين كانتا حليفتين هامتين لم تشأ إهانتهما. فالسعودية سوق هائل للأسلحة الأمريكية، كما استقطب السعوديون -وأحيانًا اشتروا- أعضاء مؤثرين في المؤسسة السياسية الأمريكية. أما باكستان، فهي قوة نووية خلفها 180 مليون نسمة، ذات جيش تربطه صلات وثيقة بالبنتاغون.
العودة المدهشة للقاعدة وما تفرع عنها تحققت رغم التضخم الهائل لوكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية ولميزانياتها بعد 9/11. منذ ذلك الحين، خاضت الولايات المتحدة تتبعها بريطانيا حروبًا في أفغانستان والعراق، وتبّنت إجراءات عادة ما تُربط بالدول البوليسية، كالسجن دون محاكمة وتسليم المعتقلين والتعذيب والتجسس الداخلي. فالحكومات تشن “الحرب على الإرهاب” زاعمة أنه يجب التضحية بحقوق المواطنين الأفراد في سبيل تأمين السلامة للجميع.
مقابل هذه الإجراءات الأمنية المثيرة للجدل، لم تهزم الحركات التي كانت المستهدفة منها، بل على العكس من ذلك ازدادت قوة. حين حدثت هجمات 9/11، كانت القاعدة منظمة صغيرة وغير فعالة بوجه عام. وبحلول 2014، باتت الجماعات على شاكلة القاعدة عديدة وقوية.
بكلمات أخرى، فإن “الحرب على الإرهاب”، تلك الحرب التي رسمت المشهد السياسي في الكثير من دول العالم منذ 2001، فشلت بشكل كارثي. وحتى سقوط الموصل، لم يكن أحد يعير ذلك اهتمامًا.
* باتريك كوكبيرن هو مراسل صحيفة الإندبندنت في الشرق الأوسط، وعمل سابقًا مع صحيفة الفاينانشال تايمز. كتب كوكبيرن ثلاثة كتب عن تاريخ العراق الحديث، إلى جانب كتاب مذكرات بعنوان “الفتى المكسور”، وكتاب عن الشيزوفرينيا بعنوان “شياطين هنري”، شاركه فيه ابنه. عام 2005 فاز بجائزة مارثا غيلهورن، وبجائزة جيمز كاميرون عام 2006، وبجائزة أورويل للصحافة عام 2009. كتابه الأخير، “عودة الجهاديين: داعش والنهوض السني الجديد” متوفر حصرًا عبر دار النشر OR Books.