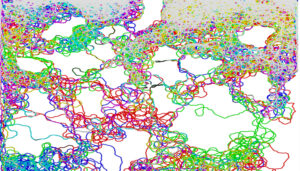«لم أعد أعرف ماذا جئت أفعل في هذه العزلة التي تذكر بالمعبد وبالصالون، بالمقبرة وبالمدرسة. (..) أجئت لأتعلم أم لأبحث عمّا يسحرني أم لأقوم بواجبي تجاه الأعراف؟»،[1] يتساءل بول فاليري عام 1923، معبرًا عن عداوته للمتاحف، تلك «الأكداس من المخلوقات المجمدة» التي تستمر اليوم بتقديم ذاتها كمسلّمات ثقافية، وكمؤسسات تقوم بحراسة التاريخ وإتاحته للجميع بكل حياد وموضوعية، وهو أبعد ما يكون عن الواقع. فقد تكون المتاحف إحدى أكثر الفضاءات العامة أدلجةً وانحيازًا في عالمنا المعاصر.
يشكل المتحف، خصوصًا الفني والأثري، مكانًا سياسيًا بشكل مزدوج، فهو ينتشل، من جهة، الأغراض من سياقها ويعطل وظائفها الأصلية وسردياتها مقابل سردية وحيدة، هي سردية المتحف ذاته، والتي تعمل، من جهة أخرى، كوعاء لتلقي سردية السلطة القائمة عليه، والتي تمرر أجنداتها عبر عملية اختيار القطع، وطريقتي عرضها وتقديمها.
بعزل المقتنيات عن سياقها الأصلي، يعيد المتحف فرزها في سلاسل وتجميعات خيالية، وفق منطق غالبًا ما يتناقض مع منطق الأعمال ذاتها. كما في سوبرماركت، نجد كل القطع الفخارية في هذه الصالة، وكل اللوحات التي تمثل المسيح في تلك، كل الأغراض منحشرة على رفوفها بالأرقام والتواريخ كأنها صُنعت لتكون جزءًا من هذه المجموعة، لا من سياق معماري وطقسي خاص بها. فقط في المتحف يمكن لعشر مومياءات أو لخمس لوحات دافينشي أن تتكدس في بضعة أمتار، «أغراض نادرة أراد لها صانعوها أن تبقى فريدة من نوعها»، حسب فاليري، كانت كل منها أعجوبة زمانها ومكانها قبل أن تتحول إلى مجرد قطعة إضافية: «أحيانًا نقول أن هذه اللوحة تقتل كل اللوحات الأخرى حولها».
إضافة إلى ذلك، يفرض المتحف زوايا نظر محددة بوساطة أقفاص زجاجية وقواعد وغيرها من الحواجز التي تعزز الدور الجديد لتلك الأغراض كصمديات للتأمل، بعد أن كان لها غايات أخرى، بل أن بعضها صُمم أساسًا ليتفادى النظر، كالأقنعة الجنائزية المصرية التي دُفنت مع الميت أو المنحوتات القوطية التي وُضعت عاليًا في الكنائس لتبقى غير مرئية. لإرضاء ضميره، يرفق المتحف الأغراض المتيتمة بنصوص تفسيرية جافة، تعمل كبيان نعي أكثر منها كتحفيز لخيال الزائر.
ينجح المتحف بإخراس أيديولوجيات القطع ووظائفها على حساب قيمتها كغرض للفرجة، تتساوى السياقات، ويصبح من السهل القيام بمقارنات مجانية، فالإله الذي سينقذ المدينة، والكتاب الأثمن لذلك الدير، والبورتريه التي كانت هدية عرس جرى توارثها في صالون العائلة، تتحول جميعها إلى أغراض متماثلة، يتنقل الزائر أمامها كما ينقل بين قنوات التلفاز، بشيء من الخدر.
بدلًا من الاستمرار بلوم الزوار على لامبالاتهم أمام عظمة التاريخ، يجدر بنا النظر إلى طريقة العرض في ظل ما يسميه الفيلسوف جان بودريار بالـ«النموذج الدعائي»،[2] والذي يغزو برأيه كل أشكال التعبير الثقافي، وهو نوع التواصل القائم على التنميط وتسطيح الفروقات بين الرسائل المختلفة مقابل الأثر الظاهري لوسيلة التواصل ذاتها، بحيث يصبح ما يبيعه الإعلان أقل أهمية من الإعلان، تمامًا مثل ما تصبح قيمة القطعة كغرض متحفي للفرجة أهم من قيمتها الأصلية كأداة نفعية أو دينية أو رمزية. تجري مصالحة التناقضات الصارخة للحضارة الإنسانية في «لغة بلا تناقضات، مثل الحلم، ذات كثافة سطحية».
انتشر هوس الاقتناء والتجميع في أوروبا مع عصر النهضة، وبحدود القرن السابع عشر صار من المتعارف عليه أن يتملك الملوك والنبلاء مجموعات فنية وأثرية هائلة، بدأ بعضهم بإتاحتها للعموم مثل لويس الخامس عشر في فرنسا أو كاثرين الثانية في روسيا. لكن الولادة الحقيقية للمتاحف تأتي، بحسب المفكر بيرنارد ديلوش،[3] بالتزامن مع فكر الأنوار وولادة مفاهيم الإنسان والكرامة الإنسانية. فمع افتتاح المتحف البريطاني عام 1753 كأول متحف مستقل، ومن ثم قيام الثورة الفرنسية بتأميم الممتلكات الملكية والكنسية، تحولت المقتنيات تلك من ملكية شخصية أو إلهية إلى ملكية عامة، أي أنها صارت تخص الإنسانية، وبالتالي كلًا منا.
يشكل ذلك التحول صميم أيديولوجية المتحف، الذي يحول الزائر إلى وريث شرعي لمقتنياته، مطالبًا إياه بتشكيل ذاته بطريقة أو بأخرى كاستمرار لها، بعدما حولها من تعبير عن نزوات أرستقراطية وأذواق شخصية إلى مراجع لقيم كونية ومطلقة، إلى أمثلة معيارية تحكي قصة «الحضارة» و«التاريخ» و«الإبداع الإنساني»، وغيرها من المفاهيم التي تصفى من تعقيداتها لتُقدم كصبّات أزلية «مبسّطة، فيها شيء من الإغراء، وشيء من الإجماع»، حسب بودريار، حقائق جوهرية لا تفنى ولا تشيخ، ولا حتى فيزيائيًا، حيث يعمل المرممون على نفي الزمن عن تلك الأغراض بحيث تبقى أبدية، كالثوابت التي صارت تمثلها بالرغم عنها.
يفسر ذلك الخشوع والصمت الذي يسود المتحف، فبطبيعته شبه الدينية كمعبد للتاريخ والإنسانية، يقوم المتحف بتطمين من يدخله بأن كل ما فعلته وستفعله البشرية سيصب بعفوية وهدوء في القصة الكبيرة الي تحكي عظمة الإنسان. ولذلك، من غير المألوف أن نحب قطعة ما في المتحف بشكل شخصي حميم أو أن نكرهها ونرغب بالتخلص منها كما نفعل مع أغراض أخرى في الحياة، فعلاقتنا معها محصورة بارتباط أحادي الاتجاه: الاحترام.
إن كانت أيديولويجة المتحف تقوم على تسطيح الفروقات بين الأعمال لإدخالها في سردية أحادية حول قيم مطلقة وخالدة، فإن ذلك النقص في العمق التاريخي للأعمال ذاتها ينتهي بالعمل كوعاء تملأه أيديولوجية جديدة، هي أيديولوجية السلطة.
يظهر ذلك خصوصًا في كبريات المتاحف الوطنية التي جرت مأسستها في القرن التاسع عشر بهدف تقديم أفضل ما أنتجته الحضارة الإنسانية، شعار غالبًا ما يموه غرورًا قوميًا وطبقيًا، يظهر في المسار المفروض على الزائر وفي عمارة المتحف ذاتها. ففي القسم المركزي لمتحف اللوفر مثلًا، والذي يعود تنظيمه لأيام نابوليون الأول، يعبر الزائر بهوًا مسكونًا بالتماثيل اليونانية والرومانية يقوده نحو «الجاليري الكبير»، قلب المتحف ومركز ثقله المحجوز للفن النهضوي الإيطالي حصرًا، والذي يقود بدوره إلى مساحة توازيه هندسيًا ومعنويًا، محجوزة هذه المرة للفن الفرنسي للقرنين 18 و19. لا يعود ذلك التنظيم إلى غياب فن إيطالي بعد القرن السابع عشر أو فرنسي قبل الثامن عشر أو افتقاد اللوفر لتلك المقتنيات، بل إلى الرغبة بتعزيز سردية يرى فيها الزائر بعينيه انتقال الحضارة من الشرق (القسم المصري) نحو الغرب، عبر أثينا أولًا، ومنها إلى روما القديمة ومن ثم الحديثة ومنها إلى باريس. سردية حاضرة سلفًا في كل مضامين الحياة الفرنسية منذ تأسيس لويس الرابع عشر للأكاديمية الفرنسية في روما لنقل واستملاك تلك المعارف، وحتى قيام نابوليون بغزو مصر وإيطاليا ونهب مئات القطع الأثرية والفنية، سردية إذًا لا يخلقها المتحف بقدر ما يستعرض البراهين المادية على صحتها.
مقابل هوس الدول اللاتينية بتعزيز ارتباطها بالحضارات الكلاسيكية عبر روما، قامت الدول الجرمانية والأنكلوساكسونية بفبركة علاقة موازية تمر عبر أثينا، فقام ملك بافاريا بإنشاء متحف الجليبتوتيك على صورة معبد يوناني، تمامًا مثل المتحف البريطاني، كجزء من حملات لتحويل كل من ميونخ ولندن إلى أثينا جديدة، بجامعاتها وبنوكها ومبانيها الحكومية، كطريقة لتعليب الماضي والحاضر بذات الغلاف اليوناني.
أما متحف البرادو في مدريد، فقد جرى تجهيزه بالتزامن مع اللوفر بعمارة وسردية مشابهة: جاليري كبير مخصص هذه المرة للفنون الإيطالية والفلمنكية، وآخر موازٍ مخصص للفن الإسباني. بينما اتبعت المتاحف الشمالية تنظيمًا مختلفًا، فنرى متحف المعلمين القدماء في بروكسل يخصص غرفًا جانبية للفنين الفرنسي والإيطالي بينما يحتفي في أكبر مساحاته بالفن الفلمنكي والهولندي، الفن ذاته الذي يقصيه اللوفر إلى الغرف الصغيرة للطابق الأخير.
وحتى بعيدًا عن المسائل الهوياتية، تطال السياسة المعايير التي تحدد ما هو «فن» وما هو «ثمين» أساسًا، معايير تبقى وريثة الأعراف الأرستقراطية والبرجوازية، التي تبرر تكريس اللوفر لقاعاتٍ واسعة من صحون الخزف المريعة هذه، بينما لا يزال الجاليري الوطني في لندن، كمعظم المتاحف الغربية، يعتبر أن البورتريهات الشخصية لنبلاء المملكة تشكل شأنًا فنيًا عامًا، على العامة الاستمرار بالتطلع نحوهم والانبهار بملابسهم وحليهم وتحضرهم.
حتى بلا ملابس ولا حلي، يشكل الجسد العاري فضاءً سياسيًا بحد ذاته. فبعد أن قام هتلر مثلًا بنقل تمثاله المفضل، رامي القرص يوناني الأصل، إلى متحف ميونخ، صرح بأنه «يمكننا الحديث عن التقدم، ليس فقط عندما نصل إلى جمال مماثل، بل عندما نتفوق عليه». في نفس العام، قام فيلم البروباجندا النازي أوليمبيا بترجمة الفكرة حرفيًا، حيث تفتتح الفيلم مجموعة تماثيل يونانية آخرها رامي القرص، الذي يتحول إلى رياضي ألماني معاصر يجسد تفوق العرق الآري، وريث الحضارة اليونانية. حتى الجمال يمكن أن يكون مسألة سياسية.
تعيش المتاحف الأوروبية محاولات للتعامل مع تلك الأعباء التاريخية، حيث ظهرت في لندن جولات سياحية بعنوان «الفن غير المريح»، كمحاولة لتطوير علاقة نقدية ببعض الأعمال، تتجاوز الاحترام الأعمى، وتفضح أيديولوجياتها الإمبريالية أو العنصرية أو الذكورية، بينما حاول اللوفر التخفيف من عجرفة التركة النابوليونية بافتتاح أقسام جديدة للفنون الإسلامية والإفريقية وغيرهما، بقيت هزيلة أمام المجموعة الأصلية نظرًا لغياب المساحة وافتقاد القدرة على اقتناء مجموعات ضخمة لطالما جرى الحصول عليها باستخدام الجيوش والأساطيل.
يقوم المتحف بانتشال الأغراض عن سياقها وتكريسها للفرجة، مسبغًا عليها وهم قيمٍ مطلقة ومقدسة تعمل في الحقيقة كمرآة لأجندات السلطة.
إن كانت المتاحف الأوروبية تنجح في تمويه أجنداتها السياسية في اختيار القطع وتصفيفها، فإن متحفًا عربيًا مثل متحف الأردن لا يبالي باستعراض أجندته بشكل صريح. فبين قاعتي العصر الحجري والعصر البرونزي يتعثر الزائر بقاعة البداوة والترحال، حيث يمكنه الاستراحة على وسائد معاصرة ومشاهدة صور الرمال والجِمال، حركة تُغلّف بنبرة أنثروبولوجية، زائفة طبعًا، بدليل تقديمها للبدو بصورة نمطية وأزلية بدلًا من تتبع تحولاتهم التاريخية عبر الزمن (حتى المسار يشير ضمنًا إلى عدم تغيرهم منذ العصور الحجرية)، وبدليل عدم تضمن تلك «المواقع تفاعلية» حسب تسمية المتحف، لا للمدن ولا للأرياف، فتنتهي بالتالي كتسلية فولكلورية للأجانب، وكتذكير هوياتي للمحليين بفوقية بعض المكونات على حساب أخرى.
مثل باقي المتاحف، تتلاشى الصراعات الإيديولوجية بين إله هيلينستي عار، ومخطوطات البحر الميت اليهودية، والمضافة البدوية لتظهر جميعها كما في كتاب مدرسي، كمجرد شواهد، لا عن ذاتها، بل عن «قصة أرض وإنسان الأردن»، قصة لا تعنيها أساسًا، كون وجودها بحد ذاته هو تذكير بهشاشة الدول وقصصها وحدودها الجغرافية والثقافية.
بالمقارنة مع متاحف وطنية أخرى في المنطقة، نرى متحف فلسطين في بيرزيت يقدم نفسه كـ«مؤسسة عابرة للحدود السياسية والجغرافية» من أهدافها «إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين» (بالجمع، مقابل «قصة أرض وإنسان الأردن»، بالمفرد)، أمّا متحف دمشق، الأقدم في بلاد الشام (1919)، والذي لا يمتلك موقعًا لتقديم ذاته أساسًا، فتتولى السلطة التقديم عنه، خصوصًا منذ إعادة افتتاحه مؤخرًا واستخدامه إعلاميًا كمناسبة إضافية لتمجيد الجيش وتأكيد تفوق الإنسان السوري. تعكس تلك الدرجات اختلاف تبعية المتحف، بين أداة مباشرة بيد سلطة عسكرية (دمشق)، ومؤسسة مستقلة اسمًا بدعم حكومي فعلًا (عمان) ومؤسسة غير ربحية في بلد بلا حكومة ولا حدود واضحة أساسًا (بيرزيت).
يقوم المتحف إذًا بانتشال الأغراض عن سياقها وتكريسها للفرجة، مسبغًا عليها وهم قيمٍ مطلقة ومقدسة تعمل في الحقيقة كمرآة لأجندات السلطة. قد يكون المقال قد تطرق إلى تلك السلطة بوصفها دولة، وبالتالي إلى المتاحف الوطنية الكبيرة المعنية غالباً بالفنون والآثار والتاريخ السياسي، لكن السلطة بمعناها الواسع قد تكون اجتماعية أو علمية، وتمس بالتالي المتاحف الأنثروبولوجية والبيئية وغيرها بدرجات وأشكال مختلفة. فامتلاك القدرة على افتتاح متحف وتملك مقتنيات كبيرة هو بحد ذاته دليل سلطة، ودليل رغبة تلك السلطة بالحديث عن ذاتها وعن رؤيتها للأمور، ولو ادّعت غير ذلك.
قد يكون ذلك أحد أسباب النفور الذي يثيره المتحف لدى البعض ممن يرون أنفسهم مجبرين على أن يكونوا معنيين بمقتنيات لا يستطيعون أساسًا التواصل معها، دون الحديث عن تقديرها والقبول بها كمسلمات «طبيعية». فالمتحف «يحول التاريخ إلى طبيعة»، كما يكتب الفنان دانييل بورين،[4] والذي اشتهر مثل غيره من فناني القرن العشرين، بنقده لمتاحف الفن. مع ذلك، انتهت معظم أعماله في المتاحف (وللسخرية، قام أحد الزوار قبل أسابيع بمهاجمة وتمزيق أحد أعماله في متحف الفن الحديث في باريس، واحدة من ردات الفعل المتكررة التي يجب قراءتها كانعكاس لإحباط الزوار وغربتهم في فضاء عنيف وغير صحي).
من السهل أن يبدو مقالٌ عربيٌ عن نقد المتاحف والعقلية المتحفية كصيد في الماء العكر، كون المتاحف العربية لا تحتاج إلى أسباب إضافية لإهمالها أكثر مما هي مهملة أصلًا، حكوميًا وشعبيًا. لكن الخلاصة ليست الدعوة إلى هجر المتاحف أو نبذها، بل بالعكس، الدعوة بإلحاح إلى زيارتها أكثر وأكثر ومحاولة غزوها فكريًا ورؤية مقتنياتها كأغراض مضحكة ومزعجة وجميلة ومذهلة. أما الحل الأذكى لمواجهة تسلط المتاحف، فقد يكون بقلبها على ذاتها: بمتحفة المتحف، أي بتقديمه لا كمؤسسة حيادية تحمي التاريخ وتصونه من موقع فوقية دون الخضوع لقواعده، بل كغرض تاريخي مثله مثل ما يحتويه، أي بوعينا أن اللوفر لا يحكي قصة الحضارة الإنسانية بل قصة فرنسا الإمبريالية، وأن متحف الأردن لا يحكي تاريخ إنسان الأردن، بل التاريخ الذي تتمناه المنظومة الحالية لرعايها على حساب تواريخهم الفردية الأكثر تعقيدًا. خلف الواجهة الخرساء لأعمال مسلوبة الإرادة تقبع علاقات قوى حية ومزدهرة، تتحدث بلسانها وتحركها، مثل الدمى، بخيوط في الفراغ الذي تصممه هي كمسرح، سياسي بالدرجة الأولى.
-
الهوامش
[1]Paul Valéry, « Le problème des musées » (1923), in Œuvres, tome II, Pièces sur l’art, Nrf, Gallimard.
[2]Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994.
[3]Bernard Deloche, Mythologie du musée, Paris, Le Cavalier bleu, 2010.
[4]Daniel Buren, «Function of the Museum,» in Artforum, September 1973.