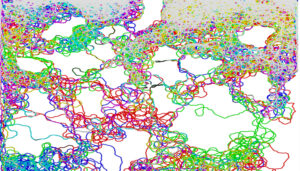تنتمي الفنانة المعاصرة منى حاطوم إلى مجموعة نجوم يحرّك حضورهم في العواصم الغربية كثيرًا من الأقلام النقدية، بينما لا تكاد تولد معارضها في عمّان أو الدوحة أكثر من بضعة أسطر إخبارية في قسم المنوعات.
نشأت منى حاطوم في بيروت في عائلة حيفاوية لجأت مع النكبة، ووجدت ذاتها عالقة في لندن بعمر الثلاثة وعشرين عامًا عند تفجر الحرب الأهلية اللبنانية، لتراكم منفىً على آخر، ولتنتج باكورة أعمالها في بريطانيا الثاتشرية، متأثرةً بتكاثر الحروب والحدود التي حالت بينها وبين حياتها الأولى.
يواجه بعض النقاد الغربيون صعوبة في هضم تلك الخلفية، خصوصًا منذ أن وصلت شهرة حاطوم إلى حد إقامة معارض منفردة في محافل مثل مركز بومبيدو في باريس وتايت مودرن في لندن، وفي مدن مثل برشلونة وهيلسينكي وبوسطن. في مقدمة كاتالوج معرضها الأخير في بومبيدو[1] نقرأ مثلًا: «منى حاطوم لا تنتج أعمالها كفلسطينية منفية في لندن (…) فهي فنانة من الحاضر، في توافق مع حداثتنا». كأن الفلسطينيين المنفيين ليسوا من الحاضر ولا من «حداثتنا» (الـ«نا» عائدة طبعًا على الغرب)، بل ترسبات أجنبية وبدائية قد تعكّر صفو عالمية حاطوم إذا ما تدخلت أكثر من اللازم في قراءتنا لأعمالها، وهو تمامًا ما سيقوم به هذا المقال، أولًا من باب الاستفزاز، وثانيًا من باب مجابهة الخطاب الذي يهدد بكتابة أعمال حاطوم كمنتج غربي بحت مع رشة بهارات.
لن يغير ذلك من قائمة الإنجازات التي سيذكر بها الفن الغربي حاطوم: النجاح بالخروج من «اختزالية»[2] السبعينيات إلى «ما بعد-الاختزالية» أو المزج بين الالتزام السياسي ومكتسبات الفن التجريدي للقرن العشرين، وما إلى ذلك من المسائل التي لن تعني الكثير للمشاهد العربي، كونه سينبهر مباشرة وبلا مقدمات بسحر أعمالها الذي لا يقاوم، وبقدرتها على مخاطبته بلغة يفهمها جيدًا.
بالمقابل، تحمل محاولة إعادة توطين فن حاطوم أخطارها. فمقياس أعمالها وغناها يتجاوزان أي محاولة لحصرها في سياق مناطقي أو هوياتي، كما أن أعمالها تستمد سحرها من غربتها، ومن حضور خاص لما يعنيه الوطن، حضور مموه وحالم قد تهدد محاولة الإصرار على تحديده وتعريفه بسحقه.
في عملها «كوفية»، خاطت حاطوم قصائص من شَعرها لتخرج من أطراف كوفية فلسطينية في لفاليف عشوائية، كأعشاب ضارّة. النتيجة مقلقة، والكثير يمكن أن يقال عنها: ربما هي طريقة للحديث عن أنوثة خطرة تولد من صميم رمز وطني، أليست الكوفية في النهاية غرضًا ذكوريًا لطالما قامت النساء بحياكته للرجال على حساب وقتهن وأجسادهن؟ أليست كذلك رمزًا لمقاومة يمكن القول إن الرجال احتكروا كتابة تاريخها، بينما يمكن بالاقتراب منه رؤية أنوثة جرى بترها لحياكته؟ وماذا عن شعر المرأة؟ هل يظل عورة إذا ما قصته وصنعت منه الغطاء ذاته الذي قد يستخدم لتغطيته؟
لكن كوفية حاطوم لا تطرح في الحقيقة أيًا من تلك الأسئلة، فهي في النهاية غرض صامت كل ما يفعله هو أنه موجود، أنه مستفز، أما الأسئلة فتولد من محاولتنا لتبرير اضطرابنا المفاجئ ولتفسير الغرض لعله يصبح أقل خطورة. قوة أعمال حاطوم تكمن في مقاومتها لمحاولات تفسيرها، وإصرارها على نقل معناها بطريقة غرائزية ومحسوسة، ومع ذلك واضحة كالشمس.
باستخدام أغراض توضيحية، تعيد حاطوم تعليمنا كيفية النظر إلى الأشياء، كمحو أمية بصري. لا غرض بريء، ولا غرض يسلم من علاقات القوى أو من عنف أخرس يختبئ في ثناياه، لا يحتاج إلا إلى قلبة بسيطة، إلى من ينكزه، حتى يكشر عن أنيابه، ولا أحد أبرع من حاطوم في إيقاظ ذلك البعبع الكامن في الأشياء ومن ثم تركه بلا أي وعظ أو تحذير لإخافتنا مثل أطفال، كي يستخلص كل منا الدرس الذي يستحقه.
قوة أعمال حاطوم تكمن في مقاومتها لمحاولات تفسيرها، وإصرارها على نقل معناها بطريقة غرائزية ومحسوسة، ومع ذلك واضحة كالشمس
ماذا لو ألصقنا فنجاني شاي ببعضهما مثلًا؟ يكفي النظر إلى عملها T42 من عام 1999 ليصبح من الواضح أنهما كانا ملتصقين منذ البداية. فناجين حاطوم هي أغراض مستفزّة وفي ذات الوقت حساسة جدًا وقابلة للكسر، فيها شيء من الابتزاز العاطفي الخاص بجلسات الشاي العائلية، بالمحادثات الشائكة التي لا ترضي إلا طرفًا واحدًا. هنا لم يعد من الممكن للشخصين أن يشربا معًا، أحدهما سيأخذ كل شيء، إلّا إذا قرر الآخر الرد على عنف الغرض بعنف جديد وكسر الفنجان ليكسب حريته، على حساب خسارة الآخر وجرحه، أو ربما تدميره بالكامل، أو تدمير الفنجانين معًا. وبمناسبة الحديث عن الدمار، تزداد كابوسية العمل عندما نعرف أن عنوانه «تي فور تو»، الذي يُلمح إلى كلمة شاي الإنكليزية، وإلى الأغنية الشهيرة شاي لشخصين، هو أيضًا اسم دبابة.

عمل « T42»، منى حاطوم، 1999.
في إحدى مقالاته[3] عن حاطوم، يرى إدوارد سعيد في الأغراض المنزلية هذه تعلقًا بوطن لا تمكن العودة إليه لإنه لم يعد موجودًا كما عرفناه، ونوعًا من العنف الذي يمارسه المنفى على ذاكرتنا، مُحمّلًا الأغراض اليومية هلوسات وندبات مستخدمها، والذي يعيد خلقها على صورته لتصبح مسوخًا عالقة بين أماكن مختلفة: «تصرّ الذاكرة على أننا كنا نعرف تلك الأغراض، ولسبب ما، لم نعد نعرفها، وتستمر مع ذلك بالتعلق بها (…) تتحول البيتوتية إلى سلسلة من الأغراض العدائية وغير المرحِبة، وظيفتها التي لم تعد منزلية، تنتظر تعريفًا. هي أشياء لا يمكن إنقاذها، لا يمكن إرسال تشويهاتها ليجري تصحيحها أو إصلاحها، فالعنوان القديم (ولو أنه لا يزال موجود) لا يمكن الوصول إليه».
في عمل من نوع آخر، تعاونت حاطوم مع لاجئات فلسطينيات في لبنان لإنتاج أقمشة مطرزة قامت بنشرها مثل الغسيل في غرفة العرض، وهو عمل قد يبدو عاديًا في البداية، حتى يقوم عنوانه، اثنتا عشرة نافذة بتفعيل السحر الكامن فيه: فجأة تتحوّل كل قماشة إلى نافذة على مدينة فلسطينية ما.
يعيدنا ذلك إلى عصر النهضة، حين وصف الفنان والمنظّر الإيطالي ليون باتيستا ألبيرتي اللوحة الجيدة بأنها «نافذة» نشاهد من خلالها قصة ما، وهو المبدأ الذي قام عليه الفن الغربي حتى القرن العشرين. أما عمل حاطوم فيأتي كرد ساخر على ألبيرتي، فهو عبارة عن اثنتي عشرة نافذة مستحيلة، لا تُطلّ إلا على وطن تجريدي من الألوان، الأفق فيه مسدود، تدل فيه كل تطريزة على فكرة بلدة أو مدينة فلسطينية دون أن ترينا إياها، ربما لأنها لم تعد موجودة أو لأن مواجهتها تفوق تحملنا، فنغطي على ركامها برموز تراثية تعطينا نوعًا من الدفء والألفة بينما تخنقنا سرًا، فكل نوافذ حاطوم لا يمكن أن تُدخل نَفَسَ أوكسيجين واحد، وغرفة العرض مسدودة لا متنفس فيها.
مجددًا، لا يمكن تجاهل البعد النسوي لتلك النوافذ. ففنون التطريز اعتبرت تاريخيًا حرفًا ثانوية لا ترقى إلى مكانة النحت والرسم والعمارة، التي حرمت النساء من ممارستها أساسًا، وبالتالي يأتي عمل حاطوم كاستمرار لأفكار نسوية بدأتها الكاتبة الأميركية أليس ووكر[4] عندما نادت بإعادة النظر في قيمة تلك الأعمال «الثانوية» كشاهد وحيد على موهبة اضطرت للتعبير عن ذاتها بأدوات محدودة. وفي السياق العربي، حيث لم تمتلك النساء، قبل القرن العشرين، أي دور يذكر، تقريبًا، في كتابة التاريخ أو في الممارسة الفنية، يقدم التطريز طريقة بديلة لكتابة الوطن، ليس عبر تسلسل من الأحداث السياسية التي صنعها الرجال، بل عبر علاقة حسية مع الألوان والزخارف التي تربط الأرض بالعائلات وبالممارسات التي حملتها معها نحو المنفى. إضافة إلى ذلك، فإن تعليق الأقمشة بملاقط غسيل يسهّل تخيل أم أو زوجة تنشرها على السطح في مخيم ما، نافذتها الوحيدة نحو وطنها هو «أمان» عملها المنزلي. أما الغسيل فهو «معلق» حرفيًا، في حالة انتظار لن تنتهي.
إلى جانب الأغراض اليومية، تمتاز أعمال حاطوم بهوس عربي آخر هو الخرائط. سواء أكان ذلك في عملها الشهير بقعة ساخنة، أو في المدن ثلاثية الأبعاد، تتعامل حاطوم مع الخرائط بطريقة تذكر بأستاذ الجغرافية في مسرحية سعد الله ونوس «حفلة سمر من أجل 5 حزيران»، والذي يخبئ الأجزاء الممزقة من خريطة الوطن العربي في درج مكتبه على أمل منحها حياة أخرى أو محاولة لفهم كيف ولماذا سقطت عن الخريطة.
موقع حاطوم كفلسطينية منفية في لندن ليس شيئًا حققت شهرتها بالرغم عنه بل بسببه، وبسببه أيضًا نجحت بإخراج الفن المعاصر الغربي من بعض الطرق المسدودة التي وصلها
في عملها فعل مضارع مثلًا، من عام 1996، قامت حاطوم برسم خريطة اتفاقية أوسلو بالخرز على أكثر من ألفي صابونة نابلسية. قد يكون أقوى ما في العمل هو رائحة الصابون الواخزة التي تنعش ذاكرة الزائر وتشوشها معًا بمجرد دخوله الغرفة، وتنفذ بنضارتها في مسامات الفراغ الميت والمعقم لصالة المعرض البيضاء، تخرق حياديتها ونقاءها، تمامًا كما تخرق جدية الحدود المرسومة عليها والتي ستذوب أصلًا بمجرد ذوبان الصابون. فإن كانت الحدود قد فرضت عنوة على الصابون (أي الأرض)، فإنه يرد بطريقة أخرى وبمنطق آخر، فتطغى حاسة الشم بغرائزيتها على حاسة النظر الأكثر عقلانية، محررةً فكرة الوطن من قيود الخرائط والأراضي ليصبح شيئًا نحسه في الهواء، يحيط بنا ويخترقنا.
تتميز الكثير من أعمال حاطوم بذلك التوتر الدائم بين مكون عقلاني يحمل دمغة المؤسسة (الذكورية أو الاستعمارية أو البيروقراطية)، كالخريطة والنافذة المسدودة ومساحة العرض ذاتها، ومكوّن حسي قد يستدرج المُشاهد العربي برموز ذات ثقل عاطفي في سياقه، أقوى من أن ينجح بالتحكم بها أو تفسيرها بشكل عقلاني، كالكوفية والتطريز والصابون النابلسي. يدخل المكوّنان في أزمة مع بعضهما، ويقوم التوتر بين هذين القطبين، كما في بطارية، على صعق المشاهد وإيقاظه.
بين استقائها المستمر من مخزون بصري ونفسي عربي، واستخدامها ذلك المخزون لخلق أعمال ترفض التصالح مع ذاتها ومع الفراغ المعروضة فيه، يصبح من الواضح أن لتجربة حاطوم كامرأة عربية فلسطينية دورًا بنيويًا في عملها. أمّا أن يشعر بعض النقاد الغربيين بحاجة إلى تصفية البعبع العربي في عملها واستملاكه كمنتج غربي فهو شيء طبيعي، فلطالما وجد الفن الغربي (كأي فن آخر) حلولًا لمشاكله في أماكن أخرى، من الفن اليوناني الذي تبناه فنانو النهضة لإخراج أوروبا من العصور الوسطى، وحتى الفنون الإفريقية والآسيوية التي رأى فيها فنانو نهاية القرن التاسع عشر بديلًا عن الطريق المسدود للفن الأكاديمي الغربي، فكانت مسؤولة عن إشعال فتيل الفن الحديث. وموقع حاطوم يجعل منها المرشح الأمثل لتسهيل ذلك اللقاء وضمان أن يتم بطريقة متبادلة وعادلة، فوجودها في مشهد اتسم بمزيج من الارتباك واللامبالاة تجاه الحال العربي جعل منها المؤهل الوحيد لابتكار أدوات جديدة تنجح بالتعبير عن قضايا هي وحدها أدركت مدى إلحاحها. موقع حاطوم كفلسطينية منفية في لندن ليس شيئًا حققت شهرتها بالرغم عنه بل بسببه، وبسببه أيضًا نجحت بإخراج الفن المعاصر الغربي من بعض الطرق المسدودة التي وصلها، واستخدامه كوسيلة لمساعدة فئات المجتمع المهمّشة.
في النهاية، تبقى صفة «ملتزم» قديمة وفجة على أعمال بتفرّد وخصوصية أعمال حاطوم، والتي تختلف عن أي فن «ملتزم» بقدرتها المستمرة على التشكيك بذاتها. بين يديها، تنجح أكثر الرموز الفلسطينية حميمية في مخاطبة قضايا تمس الجميع دون أن تفقد خصوصيتها، فهدف حاطوم بالنهاية ليس الفصل بين تجربة عربية أو غربية، بل إيجاد المشترك بينهما للفصل بين الجيد والسيء في التجربة الإنسانية ككل، أو ربما لتذكيرنا بأن ذلك الفصل ليس بالسهولة التي نظنها.
-
الهوامش
[1] . Van Assche, C. (Dir.), (2015) «Mona Hatoum». Paris: Centre Pompidou.
[2] حركة فنية ظهرت منتصف الستينيات تقوم على استخدام الحد الأدنى من الموارد الممكنة لإنتاج أعمال فنية غالبًا ما تمتاز ببساطتها الشديدة.
[3] Said, E.W. (2000) «The Art of Displacement: Mona Hatoum’s Logic of Irreconcilables» in Mona Hatoum: The Entire World as a Foreign Land. London: Tate.
[4] Walker, A. « Everyday use », 1973.