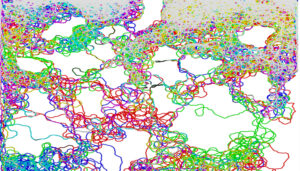تصر العروس بأن شيئًا من الشمس سيدخل البهجة إلى حياتهما الجديدة، فالبيت الذي جلبها زوجها إليه مظلم وخانق بأبوابه الموصدة. بعد إلحاح، يتنازل الزوج عن المفاتيح تباعًا وتأخذ العروس بفتح الأبواب واحدًا تلو الآخر. خلف أول باب، تُصعق الفتاة بغرفة تعذيب، ومن ثم بخزانة أسلحة خلف الباب الثاني، يتبعها كنوزٌ ملطخة بالدماء، ثم بركة دموع، وهكذا حتى تصل آخر باب وقد فهمت ما ينتظرها. منه تخرج ثلاث نساء خرساء، أرواح الزوجات السابقات اللواتي قُتلهن قبلها. يُلبس الزوج عروسه الجديدة مجوهرات زفافها داعيًا إياها لأن تنضم إليهن في مملكته المظلمة.
على وقع موسيقى بيلا بارتوك الساحرة، تستعيد أوبرا «قلعة ذو اللحية الزرقاء» واحدة من عشرات الحكايا الشعبية التي تعالج الفكرة ذاتها، أن مقبرة النساء منازلهن. فالعمارة، ممارسة لطالما احتكرها الذكور، تتحول في الحكايا هذه (كما في الفضاءات المنزلية الحقيقية) إلى حليف للرجل في فرض نموذجه عن السلطة والشهوة وفي تقييد جسد المرأة ضمن متاهات من الغرف والأبواب لا بد لمفاتيحها أن تكون، مجازيًا وحرفيًا، بيده هو.
لا عجب أن يخيم كابوس المنزل المتوحش هذا على الأدب النسائي ابتداءًا من آن رادكليف في القرن الثامن عشر ببطلاتها العالقات في قلاع عتيقة ومظلمة ووصولًا إلى كلاسيكيات الأخوات برونتي وماري شيلي ودافني دي مورييه، والتي تتضمن جميعها بشكل أو بآخر بيتًا مرعبًا وفتاة مسجونة تجري تصفيتها ببطء. أمّا في الفنون التشكيلية، فيجب انتظار سبعينيات القرن العشرين لنرى ظهور مجموعة فنانات نجحن في شيطنة المنزل والتعبير عنه كآخر عدائي يهدد بالقضاء على أجسادهن.
عند الدخول إلى «فندق الخشخاش، الغرفة 202»، وهي غرفة صممتها الفنانة السريالية دوروثيا تانينج في السبعينيات، تنتاب الزائر قشعريرة على مرأى الأشلاء المتدلية من الجدران والأثاث، مخلوقات مترهلة تشبه الحشرات، تفشي بحياة مدفونة عميقًا في الجدران بدأت بالتسرب منها.
يلمح عنوان العمل إلى أغنية من طفولة الفنانة تتحدث عن انتحار زوجة زعيم عصابات في فندق يحمل نفس الاسم. لكن قراءة العمل على ضوء حادثة فردية غير كافٍ، فذلك الرعب البيتوتي والأليف الذي يعشش بين ورق الجدران المتورد والأثاث العتيق يخيم على الكثير من لوحات تانينج، حيث تهوم فتيات بملامح خدرة في متاهات من الغرف الخانقة والأبواب نصف المغلقة، يقبع خلف كل منها شر ربما عصي على التأويل، أو ربما مجاز ملتوٍ عن عنف ذكوري مضمر.
لكن رعب الغرفة 202 يبدو أكثر تعقيدًا من مجرد تهديد ذكوري مباشر، فالمخلوقات المتورمة هذه أنثوية بلا أدنى شك، وربما تكمن كل أستذة تانينج التقنية في التخفيف من حدة تلك «الوحوش» بإعطائها ملمسًا ناعمًا وطريًا يستكين إلى محيطه، وكأنها لا تقتحم خصوصية البيت من الخارج بقدر ما تولد منه كأجنة مجهضة، كخطأ بيولوجي تفشل العمارة الصماء باحتوائه. في النهاية، قد تكون تلك العمارة هي الوحش الحقيقي، وحش يمكن ربطه بحضور ذكوري عبر سلسلة من المجازات وبالاعتماد على لوحات أخرى للفنانة. فالرجل يكاد يغيب عن لوحات تانينج، كأن العمارة تنوب عنه، لكنه إن ظهر، كما في «بورتريه العائلة» هذه، فهو يجثم بثقله على المنزل كتجسيد لذلك الحضور الشرير، وكأنه يخرج من الجدران ليكشف عن سر جفاءها وتوحشها.
من الضروري مع ذلك تجنب الوقوع في فخ التحليل النفسي للفنانة عبر أعمالها، خصوصًا وأن تانينج قد عاشت حياة زوجية أكثر من سعيدة، وقد يكون من الأسلم رؤية تلك الحساسية تجاه علاقة المنزل بجسد المرأة كحساسية جمالية قبل كل شيء، يمكن ردها (باعتراف الفنانة) إلى تراكم من التصويرات في الأدب والفن، بُهرت بها منذ شبابها وحاولت تطويرها وإسقاطها على حياتها الخاصة.
مقابل النبرة النفسية لتانينج، قارب الجيل اللاحق من الفنانات موضوع المنزل بأجندة نسوية معلنة تقصدت طرح الموضوع بشيء من التحدي والمعاركة السياسية. فعام 1975، قدمت الفنانة مارثا روزلر عرضها المسجل «سيميائيات المطبخ»، والقائم على قائمة أغراض مطبخية بالترتيب الأبجدي، تسمي رولز كل منها ثم تقوم بحركة توضح كيفية استخدامها.
يلمح العرض إلى برامج الطبخ التي غزت الشاشات الأميركية وهدفت إلى تلقين النساء الاستخدام الصحيح للسلعة هذه أو تلك من أجل النجاح بمهماتهن المنزلية. ولكن بعكس مقدمات التلفاز البشوشات والمتأنقات، تقدم روزلر الأدوات بمزيج من البرود والإحباط. برنامج تلفزيوني رديء ومحرج تحاول الفنانة من خلاله التنازل عن شخصيتها لتصبح صورة تلفزيونية مثالية دون أن تنجح. بحركات خرقاء وتهديدية، تلمح روزلر أن لتلك الأغراض المطبخية استخدامات عنيفة، وتترك المشاهد مذعورًا غير متأكد مما إذا كان المستهدف من حركة الفعس أو الفرم هو قطعة خضار أو جسد المرأة ذاتها: «يا للحماسة… إبهامي بدلًا من بصلة»، تعود البارانويا المطبخية تلك إلى الأذهان عبر قصيدة سيلفيا بلاث (التي ذهبت هي الأخرى ضحية اعتداء مطبخي حين انتحرت خنقًا بوضع رأسها داخل فرن مطبخها).
عندما تصل روزلر إلى آخر الأبجدية، تقوم برسم الأحرف الأخيرة عبر جسدها، كأنها أرهقت ما حولها من أغراض لتصبح هي الغرض. تتوج تلك الخاتمة عملية تشييء المرأة وتحولها من كاتالوج وظائف مطبخية فيه شيء من الفعل إلى تمثيل لغوي مسطح لا ذات إنسانية خلفه ولا فاعل، نص دعائي يُدمغ بجسدها دون الحاجة إلى وساطة الواقع وأغراضه.
مقابل تمثيل الشاشات للمرأة كمفعول به لخدمة الرجل، تتبنى روزلر (مثل معظم فناني ما بعد الحداثة) تقنية ذكية. فبدلًا من تقديم تمثيل مضاد تظهر فيه المرأة كفاعل ينقل صوت واقعه التعيس، تقوم الفنانة باستملاك الشكل الدعائي حرفيًا، بكل غبائه وفراغه، من أجل تفكيكه من الداخل وإعادة قراءته بعكس نيته الأصلية. عبر فشلها المسرحي في لعب الدور المخصص لها، تنجح روزلر بإخراج الفن النسوي من ثنائية إما مثالية تلفزيوينية أو واقعية واعظة، وذلك بتمثيلها للتفاوت بين الإثنين، لاستحالة لقائهما، ولما تخلقه تلك الاستحالة من قلق.
بداية الثمانينيات، شاهدت الفنانة الفلسطينية منى حاطوم سيميائيات المطبخ في لندن، وقامت بعده بسنوات بالذهاب بقلق رولزر المنزلي إلى مراحل كابوسية. فإن كانت روزلر لا تزال تسيطر على أغراض البيت ولو شكليًا، فإن الأغراض في فن حاطوم تتحول إلى وحوش عملاقة تسيطر على أجسادنا وترعبنا. في «المفرمة الكبيرة» مثلًا، تعيد حاطوم صناعة فرامة لحمة وجدتها في بيت أمها بعشرات أضعاف حجمها الأصلي، فتتحول إلى حشرة عملاقة يمكنها بسهولة فرم إنسان. كذلك الحال في عملها «انقسام أكبر»، وهو جدار ساتر على شكل مبشرة جبنة عملاقة، يعمل من خلاله الغرض المطبخي على فصل فراغات المنزل وحجبها عن بعضها، مثل مشربية لا تسمح إلا بأنواع محدودة من الرؤية المفلترة عبر شفرات حادة تهدد الجسد إذا ما اقترب منها أكثر من اللازم.
في إحدى المقابلات، تعبر حاطوم عن نفور من المطبخ يعود لشبابها في بيروت والتوقعات منها بإتقان مهامها المطبخية، كأي فتاة عربية سيجري تزويجها. لكن أعمال حاطوم المنزلية غالبًا ما تأخذ أبعادًا سياسية أيضًا، ففي عملها «بيت» من عام 1999، تصطف مجموعة أغراض منزلية معدنية على طاولة، يسري فيها تيار كهربائي وأضواء تجعلها مصدر خطر، لكن المشاهد ممنوع أصلًا من الاقتراب بسياج معدني يحول بينه وبين وطن مكهرب بعيد المنال، يهدد بإفناء سكانه.
يمكن تلخيص الأعمال المذكورة في هذا المقال بكونها جميعًا أشياء في غير موضعها: أجساد غريبة تتدلى من الجدران، المرأة داخل الخزانة، مفرمة اللحمة في معرض فن… جميعها تنويعات على الظلم الأول لنساء وجدن أنفسهن في غير مواضعهن.
بإمكاننا ترتيب جميع الأعمال الفنية تلك في سرد فظ بعض الشيء، يبدأ من مرحلة الذعر أمام الأغراض والعمارة في أعمال تانينج وحاطوم، تليه مرحلة المقاومة اليائسة في فيديو روزلر، ومن ثم المرحلة النهائية عندما يبتلع المنزل جسد المرأة. في «المرأة المنزل» للفنانة لويز بورجوا مثلًا، تصبح المرأة هي المنزل، مجرد جسد بلا وجه مطوّع لتحريك المنزل. كذلك الحال في «خزانة البياضات» للفنانة ساندرا أورجيل، حيث تخرج امرأة بيضاء لامعة من داخل خزانة، يحيطها ما يكفي من المناشف لخنقها في الأمان الحريري لمنزلها. باستخدامها لمانيكانة عادية، تفتقر لأي ملامح فارقة، تؤكد الفنانة أن ربة المنزل هي قطعة غيار بلاستيكية كغيرها، لا رغبة لها ولا شخصية، تتخذ من خزانة الحمام مسكنًا تنسل منه وإليه حسب الحاجة، مثل أشباح زوجات ذو اللحية الزرقاء في ظلام قلعته.
من المنطقي تشارك كلمتي «ظُلم» و«ظَلام» لذات الجذر اللغوي، فالظلم وفق لسان العرب هو «وضع الشيء في غير موضعه»، وبالفعل، يمكن تلخيص الأعمال المذكورة في هذا المقال بكونها جميعًا أشياء في غير موضعها: أجساد غريبة تتدلى من الجدران، المرأة داخل الخزانة، مفرمة اللحمة في معرض فن… زائر المعرض داخل المفرمة. جميعها تنويعات على الظلم الأول لنساء وجدن أنفسهن في غير مواضعهن.
تختلف الفنانات المذكورات في كثير من التفاصيل، خصوصًا في رفض بعضهن مسمى فن نسائي أو نسوي وتبني أخريات له. مع ذلك، تؤكد جميعهن بشكل أو بآخر على أن المستهدف الأول من الظلم المنزلي للمرأة هو جسدها. يظهر ذلك الجسد أحيانًا تحت تهديد العمارة والأغراض المنزلية، لكن الوضع يتعقد عندما يشكل الجسد ذاته التهديد. يظهر ذلك في «المرأة السكين» لبورجوا وفي الأجنة المتورمة للغرفة 202، مخلوقات تهدد بمنحنياتها وفجاجتها طهارة المكان.
في «وومانهاوس»، عمل جماعي من عام 1972 تولت فيه كل فنانة مهمة تصميم غرفة ما من بيت وهمي، جاء من نصيب الفنانة جودي شيكاجو تصميم الحمام، والذي اقتصر على إظهار ما تتعلم كل فتاة إخفاءه في المنزل منذ بلوغها، آثار الحيض وما يتعلق به من مواد وأدوية. تصدمنا تلك الغرفة أولًا لمظهرها الدموي، وثانيًا لأنها تعيدنا في دائرة مغلقة إلى الغرف الملطخة بالدماء لقلعة ذو اللحية الزرقاء في حين أن المعطيات صارت أعقد بكثير، مع تحول جسد المرأة إلى سبب توحش المنزل وضحيته في آن واحد.
يمكن تفسير الدور المتناقض هذا إذا ما رأينا في شيطنة الفنانة المعاصرة للمنزل استمرارًا لشيطنة الرجل لها ولجسدها. لكن هنا تظهر مجددًا حدود اللغة النقدية التي لا يمكنها إلا أن تفسر وتتهم وتعمم، أن تنفي وتؤكد، بعكس الأعمال المذكورة التي تمتلك قدرة نقدية مختلفة لا تمر باللغة ولا بمحاججاتها المنطقية. عبر ظلام الأبواب نصف المفتوحة والأغراض المتضخمة والمهجنة، يحترف الفن المعاصر طرح الأسئلة بطريقته الخاصة وتعقيدها بحيث تأبى حلولها السهلة.