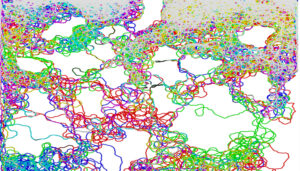زعم عالم الفراسة السويسري يوهان كاسبار لافاتير في القرن الثامن عشر أن اليونانيين القدماء فاقوا بجمالهم أبناء الأجيال اللاحقة.[1] دليله على ذلك كان مئات التماثيل والرسومات اليونانية التي وصلتنا من القرون الأولى قبل الميلاد، وكانت هذه التماثيل، الواقعية جدًا في تصويرها، تظهر بالفعل أشخاصًا على درجة عالية من الجمال الجسدي.
حتى القرن الخامس قبل الميلاد، ظلت التماثيل الذكرية اليونانية شبيهة بمثيلاتها المصرية: تتقدم إحدى الساقين الأخرى، الذراعان ملتصقتان بالأفخاذ في وضعية متصلبة، الجذع نحيل يكاد يخلو من التفاصيل، والوجه فجّ الملامح بعيون لوزية كبيرة وحواجب متصلة مع الأنف، جسدٌ كل ما فيه مختصر ومبسط. تغير ذلك في أواسط القرن، حين أخذت التماثيل الذكرية في مدينة أثينا تحديدًا، ولأسباب لا تزال غائمة، تسعى نحو واقعية غير مسبوقة في تاريخ الفن اليوناني أو غيره. وحوالي العام 440 قبل الميلاد، قام النحات بوليكليتوس بإنجاز تمثاله «حامل الرمح» ليعتبر لاحقًا بيان تأسيس للجسد اليوناني الكلاسيكي بنمطه المعروف اليوم: العضلات بارزة ومرسومة بوضوح دون أن تكون متضخمة، الجسد مصقول خال من الشعر لا أثر فيه لأي ترهل أو تجاعيد، ولا حتى عابرة، الوجه خالٍ من أي تعبير أو انفعال، الأنف مستقيم والعيون هادئة وتأملية.
جاء «حامل الرمح» تمرينًا نظريًا، وتطبيقًا لـ«قانون بوليكليتوس»، وهو مجموعة نسب رياضية مفصّلة وضعها النحات في محاولة للتوصل إلى وصفة للجسد المثالي، تضمنت تعليمات من قبيل أن يساوي طول الجسد سبع مرات طول الرأس وما إلى ذلك. عُمّمت هذه الوصفة بمجرد نجاحها على مئات التماثيل اللاحقة، فنُسخ الجسد ذاته تارةً بخوذة حربية ليصير تمثالًا لآريس إله الحرب، وتارة على جرة فخارية ليصير مجرد صبي يسكب الخمر في وليمة، وطُبّق على تماثيل الذكور حصرًا.[2]
هكذا تكاثرت الأجساد العارية في الفن اليوناني، حتى يظن متأمّله في متحف ما اليوم بأن شوارع أثينا القديمة كانت تعج برجال مفتولي العضلات يتجولون عراة في الشوارع، أو أن اليونانين القدماء، كما ظن لافاتير، فاقوا سائر الشعوب جمالًا وكمالًا.
الحقيقة كانت طبعًا أعقد من ذلك، وإن كنا لا نمتلك بعد الصورة الكاملة عنها. فقد جمع مؤرخو الفن على مدى عقود أدلة ساعدت على فهم العلاقة الوثيقة بين ولع الأثينيين بنموذجهم المنمّط عن الجسد الذكري وبين مجتمعهم وممارساته الدينية. من جهة، كانت غالبية التماثيل الذكرية العارية التي وصلتنا نذورًا إلى الآلهة نصبها أغنياء المدينة في الفضاء العام (كما تشير النقوش الموجودة حولها وأماكن اكتشافها)، لكننا نجهل في كثير من الحالات ما إن كانت تلك النذور تمثل صورة الإله المهداة إليه، أم مقدم الهدية، أم بطلًا أسطوريًا، أم مجرد جسد جذاب لا على التعيين.
من جهة أخرى، تكشف النصوص القديمة بأن العري في أثينا لم يكن مقبولًا على الإطلاق باستثناء سياق وحيد هو التدريبات الرياضية. انطلاقًا من تلك المعلومة، يربط مؤرخ الفن نايجل سبيفي تطور تلك التماثيل في القرن الخامس قبل الميلاد وسعيها نحو الكمال بظهور الألعاب «البان-أثينية»، وهي ألعاب رياضية موسمية شبيهة بالألعاب الأولمبية، شارك فيها أبناء المنطقة واتخذت شكل عيد ديني كبير لعبادة الإلهة أثينا. تضمنت تلك الألعاب، بالإضافة إلى المباريات الرياضية التقليدية، مسابقات جمال للشباب، كُرّم من خلالها أولئك الذين شرّفوا نظر الآلهة بجمال هيئتهم. وهكذا، يقترح سبيفي بأن الجسد اليوناني النمطي جاء نتيجة دراسة النحاتين الدقيقة لأجساد أولئك الرياضيين، والذين كانوا أقلية في الحقيقة.
تكاثرت الأجساد العارية في الفن اليوناني، حتى يظن متأمّله في متحف ما اليوم بأن شوارع أثينا القديمة كانت تعج برجال مفتولي العضلات يتجولون عراة في الشوارع.
أمّا الأهم من ذلك، فهو أن أولئك الرياضيين الذين ألهموا التماثيل الأثينية، ومن ثم اليونانية عمومًا، كانوا حصرًا من أبناء النبلاء. لم يضطر هؤلاء للعمل لكسب رزقهم، وأمضوا بالتالي أيامهم في صالات الرياضة، التي لم تكن مكان تسلية بقدر ما كانت جزءًا من تربية جسدية وفكرية صارمة، تضمنت دروس قتال وموسيقى وحساب وفلسفة وبلاغة. شكل الجسد اليوناني إذًا نموذجًا للاقتداء لعامة الشعب، أكثر منه صورة صادقة عن ذلك الشعب، فقد ولد في مجتمع كانت فيه الرياضة والعناية بالجسد امتيازًا طبقيًا ذا أبعاد دينية وأخلاقية. أن تملك جسدًا جميلًا في أثينا يعني إذًا أن تمتلك أكثر من مجرد ذلك، النسب والسلطة وما يأتي معهما من ميزات تعليمية وصفات كالفضيلة والنبل والسمو الأخلاقي. يبرر ذلك التعبير اليوناني «كالوس كاجاثوس»، أي «جميل وجيد»، وهما صفتان استخدمتا دائمًا معًا وعنت إحداهما الأخرى أوتوماتيكيًا،[3] وهو ربط بين حُسن المظهر وحسن المضمون يقبع مذّاك في صميم عقدتنا من الجسد اليوناني، خصوصًا مع ترسخه لاحقًا في مقولات من قبيل «العقل السليم في الجسم السليم»، والتي لا تزال تحيط بنا اليوم رغم سذاجتها وعواقبها الكارثية كما سنرى.
من غير المستغرب أن يكون أصل تلك المقولة رومانيًا، فقد كان الرومان أول من حمل عقدة الأجساد اليونانية وعاش معها، في مزيج من الإعجاب والإحباط. فمن القرن الثاني قبل الميلاد، أي بعد انقضاء عصر أثينا الذهبي، كانت روما تتمدد عبر المتوسط لتتحول من جمهورية صغيرة وهامشية إلى قوّة عظمى. وفي سياق غزواتهم للمدن اليونانية، عاد الجنرالات الرومان إلى روما محمّلين بتماثيل برونزية ورخامية مدهشة، فاقت بكمالها تماثيل الرومان الأولى، التي بدت فجأة بائسة وبدائية. عُرضت تلك الغنائم في المعابد والشوارع مثيرةً امتعاض الطبقات المحافظة من الرومان، مثل المؤرخ تيتوس ليفيوس، الذي رأى في إدخال التماثيل اليونانية العارية إلى روما سوءًا كبيرًا، مفضلًا عليها التماثيل الطينية المحتشمة لروما.[4]
أمّا بلوتارك، وهو مؤرخ يوناني عاش في العصر الروماني، فقد لام أحد الجنرالات الذي عاد من غزواته و«زين المدينة بأغراض ذات جمال وسحر يوناني»، مفسدًا بذلك طباع الرومان الخشنة، وملهيًا إياهم عن الكدّ والقتال بالبحث عن الجمال.[5] لم تمنع تلك الاعتراضات من أن تكون الغلبة للجسد اليوناني، ومن أن يقوم إمبراطور مثل كلاوديوس بإلصاق رأسه على جسد يوناني من غير المرجح أن يكون قد امتلكه في الواقع. بالمقابل، حالت معايير الحشمة الرومانية دون استيراد الجسد اليوناني بشكله الأصلي، ففي تمثال كلاوديوس -كما في المئات غيره من التماثيل الرومانية المنجزة وفق النموذج اليوناني-، حرص النحاتون على تغطية عري الإمبراطور جزئيًا بقماشة تتدلى من كتفه.
أمّا الفضل في الخطوة التالية والأهم من عقدتنا مع الأجساد اليونانية، فيعود إلى مؤرخ الفن الألماني يوهان يواكيم فينكلمان، الذي كرّس معظم كتاباته في القرن الثامن عشر لدراسة وتعظيم الفن اليوناني، خصوصًا التماثيل الذكرية الكلاسيكية. بكتابته عن تمثال أبولو هذا، ألصق فينكلمان بالتماثيل اليونانية وصفه الشهير: «البساطة النبيلة والجلال الهادئ»، ليربط مجددًا وبشكل أقوى مما مضى الاعتقاد اليوناني بتلازم الجمال والفضيلة. بل وأبعد من ذلك، وفي وقت بدأ فيه تدهور القيم الملكية في أوروبا، ربط فينكلمان كمال الجسد اليوناني المنحوت بحرية اليونان وديمقراطية أثينا، جاهلًا بأن «الديمقراطية» الأثينية كانت في الحقيقة أبعد ما تكون عن المفهوم بمعناه الحديث.
لم يمنع ذلك أفكار فينلكمان من أن تنعكس سريعًا على أعمال معاصريه. فمع الثورة الفرنسية، سارع الفنانون المساندون للثورة والديمقراطية إلى إعادة إحياء الفن اليوناني، وبعد قرون لم يتوان فيها الفنانون عن تمثيل ملوك بدناء أو نبلاء نحيلين، عاد الجسد اليوناني ليصبح مرادفًا إجباريًا للفضيلة، فقام نحات مثل أنطونيو كانوفا بنحت نابليون بونابارت على هيئة مارس، إله الحرب الروماني، تمامًا كما فعل كلاوديوس والأباطرة الرومان من قبله. لم يكن هدف التمثال إيهام الناس بأن نابليون كان ممشوق القامة أو ذا أنف مستقيم، بل ربط شخصه بنموذج تاريخي، بجسد كان في الحقيقة رمزًا افتراضيًا للبطولة أكثر منه تعبيرًا عن جسد حقيقي.
مع صعود البرجوازية في القرن التاسع عشر، بدأ الجسد اليوناني يفقد افتراضيته تلك ليتصادم أكثر فأكثر مع الواقع اليومي. لم يعد النموذج حكرًا على تمثيلات الحكام والأبطال، فمع تعميم الخدمة العسكرية، وفرض التعليم ومعه الصالات الرياضية في أوروبا، عاد الجسد اليوناني ليعبر عن قيمة اجتماعية جديدة هي «الفحولة». تتبع الباحث جورج موس تاريخ ذلك المفهوم ونموه في الأوساط البرجوازية الصغيرة، خصوصًا أواخر القرن التاسع عشر، حين ظهرت نوادٍ شبابية هدفت إلى مقاومة ما رأته البرجوازية الصغيرة كسلًا وانحلالًا أخلاقيًا ومجتمعيًا فتك بالغرب، كان من أعراضه انتشار الفن الرمزي والحديث، وتغير المجتمع عمومًا في سياق المدن الصناعية الكبيرة. غالبًا ما تبنت تلك الحركات لنفسها الجسد اليوناني ذاته، حيث يظهر الشباب بأجساد مفتولة وعارية وسط الطبيعة، كنوع من رفض جماعي للحداثة وعودة لأصالة ذكورية مفقودة صار اليونان القدماء رمزها.[6]
تحت الحكم النازي، كما في أثينا، صار الجسد الذكري ملكًا جماعيًا وشأنًا عامًا، وصار من واجب المواطن الألماني شحذه إلى أقصى الدرجات كي يخدم به قضية أمته.
وصلت تلك الأيديولوجيات الفحولية لنتيجتها المنطقية في الثلاثينات من القرن العشرين. فقد كان هتلر من أشد المعجبين بالجسد اليوناني بكل ارتباطاته الأخلاقية. وبعد شرائه عام 1938 لتمثال «رامي القرص»، وهو نسخة رومانية عن تمثال يوناني من القرن الخامس قبل الميلاد، خطب هتلر بالحشود في ميونخ محمسًا إياهم لزيارة متحف المدينة وتأمل التمثال: «ستدركون أن الحديث عن التقدم يصبح ممكنًا فقط عندما نصل إلى هذا الجمال بل وحتى عندما نفوقه إن أمكن». في الفترة ذاتها، أخذ آرنو بريكر، أحد النحاتين الرسميين للرايخ الثالث، بتزيين المباني الحكومية والساحات الألمانية بتماثيل امتزج فيه الجسد اليوناني بالملامح الألمانية، بينما لمعت المخرجة ليني ريفنشتال بفيلمها «أوليمبيا»، الذي صور الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1936، مع تركيزه على الأجساد المصقولة للرياضيين الألمان، خصوصًا في بدايته الشهيرة التي تلمّح علنًا إلى تمثال هتلر المفضل «رامي القرص»، في إشارة إلى أن العرق الآري هو الوريث الشرعي لليونان وتفوقهم على باقي الشعوب.
يشير موس إلى أن تبني الجسد اليوناني العاري من قبل النازيين هدّد بالتعارض مع القيم البرجوازية، كالحشمة والمحافظة الجنسية، لكن وللمفارقة، ساهم ذلك التناقض بين الرغبة بالعودة إلى اليونان والخوف من الإيحاءت الجنسية، في تأكيد الطابع المجرد واللامنفعل للجسد اليوناني أكثر وأكثر: «لم يعد بالإمكان تعريض النظر إلى جسد إلا إذا كان أملسًا بدون شعر، مصقولًا وخاليًا من أي خواص فردية ومن أي شحنة جنسية. بنقائه وسحنته البرونزية، يصبح الجسد رمزًا تجريديًا للجمال الآري (..) هي أجساد يمكننا تبجيلها لكن لا يمكن اشتهاؤها ولا حبها».[7] تحت الحكم النازي، كما في أثينا، صار الجسد الذكري ملكًا جماعيًا وشأنًا عامًا، وصار من واجب المواطن الألماني شحذه إلى أقصى الدرجات كي يخدم به قضية أمته. لكن إن كانت فوقية الأجساد الجميلة في أثينا ما قبل الميلاد فوقيةً طبقية واجتماعية قبل أي شيء، فقد صارت أيام الرايخ الثالث فوقية عرقية، يرثها الإنسان دون إرادته. والخلاصة هي أن اليهود والغجر والمعاقين والمثليين، أي كل من لا يملك (برأي النازية) جاهزية بيولوجية للسعي نحو الصورة الرسمية للفحولة بجسدها الكبير والمفتول والأشقر، لا حل إلا بتصفيته، وهو ما كان.
قد لا يبدو وكأن البشرية قطعت طريقًا طويلًا مذّاك، ففي أفلام مثل «هرقل» مثلًا، من إنتاج ديزني، لا يزال الأبطال الطيبون يتمتعون بأجساد يونانية مصقولة «جميلة وجيدة»، بينما يظهر الأشرار بأجساد مترهلة وأنوف معقوفة. لا تزال عقدتنا من الجسد اليوناني حية إذًا، ولو أن ذلك الجسد لم يتوقف منذ ولادته عن تغيير دلالاته دون أن يغير شكله. فبعد أن كان رمزًا لميّزات دينيّة وطبقية، صار رمزًا ديمقراطيًا ومن ثم فحوليًا وعرقيًا، بينما يبدو اليوم وكأنه قد تقاعد عن تلك المسؤوليات ليصبح مجرد صورة في متناول أي منا. فبينما يتزايد الضغط على الشباب لتكبير عضلاتهم من أعمار صغيرة، تعلمنا أفلام يوتيوب كيف نحصل على «جسد إله يوناني في خمس خطوات»، وتشجع عيادات التجميل حتى اليونانيين أنفسهم على تبديل أنوفهم بـ «أنوف يونانية». بكلمات أخرى، قد تكون مفارقة الجسد اليوناني الكبرى اليوم أن يكون العصر الذي لم يعد فيه لذلك الجسد أي دلالة سياسية أو اجتماعية موحدة هو العصر الذي يُدفع فيه الناس أكثر من أي وقت مضى نحو استجلابه من عالم الصور إلى أرض الواقع.
-
الهوامش
[1] George L. Mosse, L’image de l’homme, L’invention de la virilité moderne, Paris 1997, p. 31.
[2] جاء العري الأنثوي متأخرًا ومحدودًا في الفن اليوناني، كما عرف ماضيًا ومستقبلًا مختلفًا يجعله يستحق مقالًا منفصلًا.
[3] Nigel Spivey, Understanding Greek Sculpture, London 1996, p. 36-43.
[4] Titus Livius, The History of Rome, Book 34, ch. 4.
[5] Plutarch, Parallel Lives, Life of Marcellus.
[6] George L. Mosse, L’image de l’homme, L’invention de la virilité moderne, Paris 1997, p. 111.
[7] George L. Mosse, L’image de l’homme, L’invention de la virilité moderne, Paris 1997, p. 195.