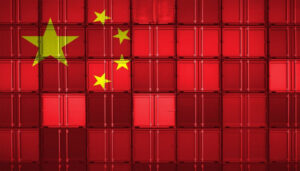شهد العالم الشهر الماضي حملات جديدة من تحطيم التماثيل انطلقت من مجموعة مدن أميركية عقب مقتل جورج فلويد، واستهدفت بشكل أساسي تماثيل شخصيات تاريخية مرتبطة بالفوقية البيضاء مثل كريستوفر كولومبوس أو زعماء الكونفدرالية الأميركية المدافعين عن العبودية، رافقتها حملات مشابهة في مدن بريطانية وفرنسية استهدفت تماثيل لرموز الماضي الاستعماري لكلتا الدولتين. وأعادت تلك الأحداث إلى الواجهة النقاش القديم بين المدافعين عن القيمة الجمالية والتاريخية لتلك المعالم، وأولئك الذين يرون فيها أداةً لمنظومة تمييزية تؤكد سلطتها على الفضاء العام.
أما من وجهة نظر تاريخ الفن والدراسات البصرية، فلم يجد بعضنا مفرًا من التلذذ بمتابعة التفاصيل الصغيرة لطقوس تدمير التماثيل، والتي بدت أكثر من مألوفة. مشاهد مكررة منذ فجر التاريخ: المتظاهرون يحاولون النيل من رأس التمثال برشّ عيونه أو قصّه، أو بإغراق جسده في النهر، والمسؤولون يضربون التحية له أو يفرزون دورية شرطة لحمايته. تصرفات تشير إلى سؤال غريب يتربص خلف النقاش المعتاد حول شر أو خير التماثيل: لماذا نميل أساسًا إلى معاملة التماثيل ككائنات حية، كـ«تجسيد» لمنظومة ما؟
كيف تفسّر «الإحيائية» تعامل الناس مع الصور والتماثيل؟
عند قيام الربيع العربي، وُصفت تماثيل الأسد والقذافي بـ«الأصنام»، كلمة أوتوماتيكية ظاهرًا، لكنّها تساهم مضمونًا في شرعنة تحطيم تلك التماثيل كاستمرار طبيعي لتحطيم الأصنام في مكة؛ كحركة تحررية من المفترض أن تنقل بالتاريخ من جاهلية ما إلى مرحلة أكثر تنورًا وحداثة. فقد جاء اعتراض الديانات التوحيدية على الأصنام انطلاقًا من كونها تشكل نوعًا من «الإحيائية»، أي الإيمان بأن حضورًا ما، إلهيًّا أو إنسانيًّا، يحلّ في صورة أو غرض ميت.
بالفعل، حوت قبور الفراعنة تماثيل بمقاسات مختلفة عملت كأجساد مضيفة لروح المتوفى التي تعود بين وقت وآخر، بينما يشهد مؤرخون مثل بوزانياس في القرن الثاني الميلادي على تماثيل يونانية (بما فيها آلهة) جرى ربطها بالسلاسل أو نحتها دون أقدام كي لا تهرب من مكانها. الأمثلة لا منتهية، ومن السهل صرف النظر عنها كمعتقدات بائدة تجاوزها الإنسان الحديث، لكنّ ما يحدث اليوم يذكّر بأن الموضوع أكثر تعقيدًا. بالرغم من وعينا الكامل بأنها مجرد مواد ميتة وبأن قيمتها رمزية، نستمر جمعينا بمعاملة بعض الصور كما لو كانت فعلًا حية.
في كتابه «ما الذي تريده الصور؟» يجادل ميتشل بأن علاقتنا الإحيائية مع الصور لم تتغير كثيرًا اليوم. بالرغم من وعينا الكامل بأنها مجرد مواد ميتة وبأن قيمتها رمزية، نستمر جمعينا بمعاملة بعض الصور كما لو كانت فعلًا حية. تظهر تلك الازدواجية بشكل صارخ لدى الحركات الدينية المعادية للتصوير: بما أن الأصنام لا قوة لها ولا حياة فيها، يسأل ميتشل، لماذا كل هذا الإصرار على تكسيرها؟ وكأنها تشكل تهديدًا، أو أن الله سيغار أو يغضب من حجر. عادةً ما يجيب محطموا الأصنام بأنهم لا يؤمنون بتلك الصور، لكنهم يحطمونها لتخليص غيرهم ممن قد يؤمنون بها.
لكن ميتشل يرى في تكسير صورة ما خلقًا أوتوماتيكيًا لصورة أخرى تحل محل القديمة، بل وقد تكون أقوى منها. يصبح دمار الصنم صنمًا بحد ذاته، صورةً مادية أو ذهنية تُمجّد كجزء من هوية مضادة جديدة، تمامًا كما صارت صور دمار مركز التجارة العالمي أقوى من صور المركز قبل الدمار، وذريعة للحرب على الإرهاب.[1]
يضيف ميتشل بأن تدمير الصور (الإيكونكلاسم، بالوصف الأكاديمي) ليس إلا الوجه الآخر لحب الصور (الإيكونوفيليا).[2] يوم وقع الإمبراطور الروماني تيبيريوس مثلًا في غرام تمثال رياضي يافع أمر بنقله لغرفة نومه، مستفزًا بقراره غضب أهل روما الذين ثاروا مطالبين بعودة التمثال إلى الفضاء العام. حتى أدبياتنا المعاصرة لا تبخل بسرديات مشابهة تربط بين الوقوع في غرام الصور وبين دمارها أو دمار من يهيم في حبها، سواء أكانت صورة دوريان جراي في رواية أوسكار وايلد أو لوحة المرأة المجهولة في فيلم فريتز لانج. أن نحب صورة أو أن ندمرها يعني أن نعترف بها ككائن ما، عدو أو صديق لا يهم، فذلك لا يغير من جوهر العلاقة الإحيائية مع الصورة، علاقة، بحسب ميتشل، لا مناص لنا منها مهما حاولنا.
بدأت مجالات تاريخ الفن والدراسات البصرية تهتم بتلك الظاهرة منذ القرن الماضي، فأشار فيليب برونو مثلًا إلى وجود صنف خاص من الإنتاج البصري يتميز بكونه يُعامل معاملة أشخاص.[3] قد نظن أن تلك الظاهرة تقتصر على البورتريهات، أي الصور الشخصية، مرسومةً أو منحوتةً أو فوتوجرافية، لكن برونو يشير إلى أن القضية أكثر التواءً. فمن جهة؛ يمكن لصورة ما أن تكون مطابقةً لهيئة أحد ما دون أن تمتلك حضوره الاجتماعي، مثل شخصيات الدعايات مسلوبة الروح والمحضر. ومن جهة أخرى، تُعامل الكثير من المنتجات البصرية معاملة أشخاص بالرغم من كونها غير تصويرية، أي لا تمت إلى هيئة الشخص بصلة، مثل شعارات النبالة أو الجمرات الثلاث.
قد يكون العثمانيون مثلًا قد حجبوا الصور البيزنطية في كنيسة آيا صوفيا عند تحويلها إلى مسجد، لكنهم لم يبتعدوا كثيرًا عندما استبدلوها بميداليات ضخمة كتبت عليها أسماء «الله» و«محمد» و«أبي بكر» و«عمر»، والتي تعمل كنوع من البورتريهات، الفرق الوحيد أنها مكتوبة بدلًا من أن تكون مصوّرة. الصور، بحسب ميتشل، هي واحدة من بقايا التفكير السحري الذي يقاوم محاولات عقلنته، وعلى أي شخص يدعي عكس ذلك أن يأخذ صورة لأمه ويحاول قص عينيها.
تتشارك تلك المنتجات البصرية نيابتها عن شخص ما اجتماعيًا لدى غيابه فيزيائيًا. في بعض الحالات، قد تكون تلك النيابة أكثر من مجرد نيابة رمزية أو عاطفية، فقد تكون قانونية، حيث أتتنا شهادات من العصور الوسطى مثلًا عن دروع تحمل شعارات عائلية تنوب عن أرستقراطيين متوفين في المناسبات الرسمية،[4] وحتى اليوم، تخضع التوقيعات وصور الحكّام لمعاملة قانونية تشبه معاملة الأشخاص، تزييفها أو التعرض لها بأي شكل يجلب عواقب مشابهة للتعرض لأشخاص أحياء، ويُخضع الجاني إلى تشريعات أقرب للتابوهات البدائية منها للقوانين منطقية.[5] فالصور، بحسب ميتشل، هي واحدة من بقايا التفكير السحري الذي يقاوم محاولات عقلنته، وعلى أي شخص يدعي عكس ذلك أن يأخذ صورة لأمه ويحاول قص عينيها.[6]
يمكننا حتى الذهاب أبعد من ذلك بالحديث عن الصور الإباحية، والتي تثير ردات فعل هرمونية مطابقة لما يثيره أشخاص حقيقيون (إن لم تكن أفضل)، وكأن أجسادنا تعجز عن التمييز بين الواقع والصورة، الشيء الذي يستطيع أي حيوان بدائي فعله. ربما لسنا مخلوقات عقلانية أو حديثة لهذه الدرجة إذًا، ربما لا مهرب من أن نتشارك تكويننا الاجتماعي مع الصور، أن نعيش عبرها وبالرغم عنها.
التنازع على الفضاء العام
لكن مشكلة الصور لا تأتي من شخصنتنا لها، بل من تشريع تلك الشخصنة لمصلحة البعض. لطالما كان التصوير حكرًا على الأقوياء، لدرجة أن الرومان -الذين كانوا بيروقراطيين شرساء- أوجدوا مفهوم «الحق بالصورة» (Ius Imaginum) وهي مجموعة أعراف تقرر من يحق له من النبلاء صناعة تماثيل له ولأجداده لاستعراضها في الفضائين الخاص أو العام، وهي عملية معقدة تتطلب تصويت مجلس الشيوخ واسترضاء الآلهة. لا يختلف الوضع اليوم إلا شكليًا، حيث يبدو حق تشيرشل أو كولبير بنشر صورهم في الساحات قائمًا على حساب حقوق ضحاياهم الذين يبقون بلا تمثيلات رسمية.
في سياق الصراع على تمثيل متساوٍ في الفضاء العام، قد يكون استخدام طرق قتل خاصة بالبشر على الصور مؤشرًا على سهولة الخلط بين إدانة الشخص وإدانة المنظومة، على تحويل المشكلة إلى مشكلة «شخصية». لكن لحسن الحظ، يقدم التاريخ مؤشرات مضادة تظهر أن علاقتنا بالصور ليست بالسذاجة التي يلمح لها باحثون مثل ميتشل، فالرومان مثلًا اعتادوا (بعكس سابقيهم اليونان) على نحت رأس التمثال الرسمي من قطعة رخام منفصلة عن الجسد بحيث يمكن تبديله بتبدل الظروف. وفي إمبراطورية شاعت فيها «لعنة الذاكرة»، أي الرغبة بمحو آثار إمبراطور سابق مُدان، كانت تكفي إزالة رأس نيرون مثلًا واستبداله برأس فيسباسيان، أو تشويه ملامح الرأس بإعادة نحتها لتشبه قدر الإمكان ملامح الإمبراطور الجديد. تشكل لعبة الرؤوس تلك أكثر من مجرد توفير للوقت والموارد، فهي تبين أن الإمبراطور ليس فردًا بل وظيفة اجتماعية، جسد حكومي له الدور ذاته سواء امتلك هذا الوجه أو ذاك.
اليوم كذلك، يعي الكثير من المتظاهرين بأن المسألة ليست مسألة تبديل رؤوس بل أجساد، ليست مشكلة أشخاص بل تمثيلات سياسية، مشكلة صور. وبناءً عليه، فللصور أن تُقتل بطرق مختلفة عن البشر. قد تكون الطريقة المعتادة والصحيحة سياسيًا لقتل صورة ما هي متحفتها، بعزلها عن منصبها تحت علبة زجاجية مع ورقة تشرح قصتها وتسمح بتأملها كقطعة فنية أو تاريخية. لكن الفضل يعود للمتظاهرين باستباق تلك الحلول السهلة والحيادية بحلول أكثر تسييسًا: إن كانت بعض الصور تفرض علينا معاملتها كأشخاص، فمن الحري بنا لعب لعبتها حتى النهاية، وذلك بالالتفاف على التمثال لقتل صورة ما به وزرع صورة جديدة، بـ«استنطاق الأصنام» بدلًا من تكسيرها، حسب تعبير ميتشل. عام 2011 مثلًا، قام بعض البلغاريين بتلوين صرح الجيش الأحمر السوفييتي في صوفيا، محولين العساكر إلى شخصيات رسوم مصورة أميركية مثل سوبرمان ومكدونالدز، بينما قام المتظاهرون الشهر الماضي بإتباع اسم تشيرشل بعبارة «كان عنصريًا»، وهي حركة -على بساطتها- تفتح جرحًا نازفًا في الفضاء العام، تستملك قوة التمثال بعكس نواياه لتدين به التاريخ بدل أن تمحوه أو تجمّله.
باختصار، غالبًا ما تكون أقل الحركات تخريبًا ماديًا أكثرها عنفًا فكريًا. وفي ختام الحديث عن التاريخ الطويل لتحطيم الصور، يخيم على الأذهان مثال أخير مؤثر، تلك المخطوطة العربية لمقامات الحريري المسماة بـ«مقامات سان بيترسبرج»، من القرن الثالث عشر. لسبب ما، قام صاحب الكتاب بخطَ رقاب وعيون الشخصيات المصورة بقلم أسود أنيق، كما لقتلها رمزيًا. من الواضح أن المخطوطة ثمينة وجميلة، ربما أجبر مالكها على فعل ذلك في سياق حملة تفتيش أو تطرف ديني، ربما تعلق بها ولم يرد تخريبها بالكامل، أو ربما فعل ذلك تطيرًا من الشخصيات المنمنمة التي تبادل الناظر إليها النظر، وقد تأخذ في أي لحظة بالمشي والكلام. تشعّ الرسوم المشطوبة تلك بقوة رهيبة، ربما لأنها تختصر علاقتنا المعقدة والمتضاربة إزاء كثير من الصور، اليوم وبعد قرون، نرغب بدمارها ونؤخذ بها في ذات الوقت.
-
الهوامش
[1] MITCHELL, W. J. T., What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago/London, The University of Chicago Press, 2005, p. 126.
[2] Ibid., 93.
[3] BRUNEAU, Philippe, «»Le Portrait«», Ramage, no. 1, 1982, p. 71-93.
[4] BELTING, Hans, An Anthropology of Images, trans. Thomas Dunlap, Princeton/Oxford, Princeton University Press, 2011 [2001], p. 67.
[5] MITCHELL, W. J. T., What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago/London, The University of Chicago Press, 2005, p. 128.
[6] Ibid., p. 7-9.