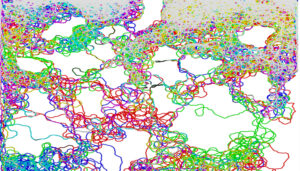تدخل باريس شهرها الثاني من الحجر، وترقد ألوف اللوحات وحيدة في المتاحف بعد حياة طويلة وحافلة. فلنتخيل للحظة الجاليري الكبير لمتحف اللوفر في سكينة هانئة، بمجرد دخوله، على اليسار، تقبع إحدى تلك اللوحات التي عرفت أيامًا أفضل. عادةً ما يتجاوزها الزوار بشيء من عدم الراحة في طريقهم إلى الموناليزا، ليس فقط بسبب وجود رجل ضخم مربوط إلى عامود، تخترق جسده السهام، بل كذلك لأن الفنان، أحد أول من احترفوا قواعد المنظور، تلاعب به بحيث يشعر المشاهد بأنه أخفض مما هو عليه، بأن القدّيس يجثم عليه من فوق. يضاف إلى ذلك أن اللوحة معلقة بحيث يواجه مستوى نظرنا قدمي القديس الشهيد، حيث جلادوه بملامحهم الجافة، شخصيات هامشية مثلنا على وشك الخروج من المشهد.
لكن الرجل لا يأبه بهم ولا بنا، بل يتطلع إلى سماوات بعيدة. حزنه يبدو مضاعفًا اليوم، فالحجْر على القديس سيباستيان أيام وباء مثل أن تمنع نجم سينما من لعب الدور الذي ولد من أجله.
تبدأ الحكاية أيام الاضطهاد الروماني للمسيحيين، حين أمر الإمبراطور بإعدام المؤمن سيباستيان رميًا بالسهام، فأنجاه الرب بمعجزة. وبعد ذلك بقرون، عندما زحف «الموت الأسود» على أوروبا، صار المؤمنون يستحضرون ذكرى سيباستيان ليتحول إلى القديس شفيع الأوبئة. ربما جاء الرابط بين القديس والطاعون من قصة نجاته من موت لا نجاة منه، أو ربما من طريقة إعدامه، فقد ساد الاعتقاد طويلًا بأن الطاعون ينتقل على شكل حزم من الهواء الفاسد، يصيب جسد ضحيته ببقع دامية تمامًا كما تصيب الأسهم جسد القديس.
بحدود عصر النهضة، صار سيباستيان الشخصية الدينية الأكثر شعبية بعد المسيح والعذراء، فكان من الشائع أن يلجأ المصلون إلى صوره طلبًا للشفاء، وكان إذا ما أصيب ابن عائلة ميسورة بالطاعون، ينذر رب العائلة لله لوحة مشابهة يدفع لتنفيذها وإهدائها إلى كنيسته مقابل شفاء المريض.
جاءت لوحتنا هذه في سياق مشابه. فأندريا مانتينيا (1431-1506)، أحد ألمع فناني النهضة في إيطاليا، رسم لوحته هذه غالبًا كنذر مرتبط بالطاعون، ولو أننا لا نعرف أي تفاصيل عن ظروف إنتاجها. أمّا عن تاريخها، فيجمع المختصون على الفترة ما بين 1478 و1480، حين ضربت جائحات طاعون حادة شمال إيطاليا ومن ضمنها مدينة مانتوفا الصغيرة، حيث عاش الفنان.

لكن لوحة مانتينيا هذه ليست أيقونة دينية عادية. أول ما يثير الريبة فيها هو فيض التفاصيل المعمارية، والتي نطلق عليها صفة الـ«أناكرونية»، أي تلخبط الإحساس بالتاريخ. فمن المفترض بقصة سيباستيان أن تدور في الحقبة الرومانية، لكن العامود الروماني الذي رُبط إليه يبدو منهارًا منذ قرون، وكأن الفنان رسمه كما رآه هو في القرن الخامس عشر لا كما كان ليراه القديس. يتعقد الانفصام التاريخي أكثر وأكثر في خلفية اللوحة، حيث يلتفّ درب ترابي على يمين القديس، يصعد من مدينة رومانية منهارة نحو مدينة محصنة من العصور الوسطى، ومنها إلى مدينة ثالثة تجاور الغيوم وتبدو أقرب للمدن الإيطالية التي عاصرها الفنان. يترافق المسعى هذا بالأسهم التي تخترق جسد القديس، والتي تعمل مثل إشارات مرور ترسل بنظراتنا تدريجيًا نحو السماء، مشيرةً بين حين وآخر إلى تفصيل معماري هنا أو شتلة تين هناك.
يخلق اللعب على الزمن هذا فضاءً هجينًا يجمع بين حاضر المشاهد والماضي الغابر للقصة، وكأن القديس الشاب يتراءى للمصلي خارج أي كادر روائي، معلقًا في فضاء سرمدي، تمضي من حوله القرون وتبيد الحواضر والإمبراطوريات بينما يبقى هو مستقيمًا مفعمًا بالحياة، يجذب أسهم الوباء صوبه مثل «مانعة صواعق»، بحسب تشبيه المؤرخ ليو شتاينبرج.
خلف العظة الشكلية تلك لبقاء المسيحية وانتصارها على الوثنية، يكمن انبهارٌ لم يعد سريًا بالحضارة الرومانية الوثنية، انبهار أصاب الطبقات المتعلمة في سائر مدن النهضة الإيطالية. حتى خيار الفنان بربط القديس إلى عمود بدلًا من شجرة أو عود خشبي، كما جاء في النصوص، ما هو إلا حجة إضافية للتغني بتفاصيل الأطلال الرومانية من زخارف ونسب أنيقة.
إضافة إلى الولع النهضوي العام بالحضارات الكلاسيكية، انتقد مانتينا لولعه الخاص بالحجارة، الشيء الواضح في طريقة فتحه لبطن العمود مثلًا ليظهر تعاريق الحجر، كما قد يفعل بائع خضار ببطيخة ليبيعنا إياها، أو في كاتالوج الحجارة التي يكومها عند قدمي القديس، طوب آجري، رخام أبيض، رخام بني (..) طريقة للمشاركة في المباراة الشائعة آنذاك بين الرسم أوالنحت. فإن استطاع مانتينيا بضربات فرشاة رقيقة أن يحاكي أي حجر في الوجود، خام أو منحوت، فذلك يثبت تفوق الرسم على النحت. ربما كان ذلك أيضًا التلميح من وراء القدم الحجرية المكسورة التي يضعها بجانب قدم القديس، أو ربما هي تلميح آخر لتفوق الإنسان المسيحي على الأصنام.
كان القديس سيباستيان واحدًا من الاستثناءات النادرة التي سمحت فيها الكنيسة للفنان برسم جسد شبه عار. وفي سياق الكبت الكاثوليكي الصارم، جاءت وضعية القديس الشاب بالأسهم التي تخترق جسده المفتول متنفسًا لم يتردد الفنانون ولا زبائنهم باستغلاله حتى النهاية. لهذا السبب، يزخر تاريخ الفن بسيباستيانات تتبارى بأجسادها المشدودة بالحبال ونظراتها الدامعة وما إلى ذلك من تلميحات مثلية قارب بعضها الإباحية.
لم يبدأ تاريخ الفن بالاعتراف بالدور الجنسي لهذه اللوحات إلا حديثًا، خصوصًا مع دراسات مثل «قوة الصور» لدافيد فريدبيرج، الذي جادل بأن الدور الجنسي للوحات لا يمكن فصله عن الدورين الفني والديني. بالفعل، قد تكون تعلية الطاقة الجنسية عبر الصور وتوجيهها نحو العبادة إحدى أقوى السياسات البصرية التي مارستها الكنيسة الكاثوليكية. مع ذلك، لا يخلو الأمر من بضع حالات خرجت عن السيطرة، ربما أشهرها ما يرويه فازاري عن لوحة للقديس سيباستيان أُزيلت من كنيسة في فلورنسا بعد أن اعترفت المصليات بأنهن «خطئن من وراء شهوانيتها».
لكن بالنسبة لفناني النهضة وزبائنهم من الطبقات المخملية، لم يكن الهوس بالكمال الجسدي مجرد تفريغ جنسي مجاني، فعلاقة الفنان بالجسد مرت، كالعمارة، عبر ولع بالحضارتين الرومانية واليونانية، وبتماثيلها التي تناثرت عبر إيطاليا، «أصنام» لطالما نظرت الكنيسة إليها بمزيج من الحسد والريبة قبل أن تجد طريقها لهدايتها إلى المسيحية، إن صح التعبير. فالقديس سيباستسيان الذي كان مجرد رجل ضامر وسقيم في القرن السابق أخذ أيام مانتينيا يكتسب جمال إله يوناني، وكان بذلك إحدى الثغرات التي تسللت من خلالها صور الآلهة القديمة إلى الكنيسة لتخدم هدفًا جديدًا هو التوفيق بين الكمال الجسدي للإنسان الروماني/اليوناني والكمال الديني للإنسان المسيحي.
عبر المعادلة الجديدة تلك، صاغ فنانو النهضة نموذجًا جديدًا عن الجسد البشري تحت تأثير الفلسفة الأفلاطونية الجديدة، حيث لم يعد، كما كان في الكاثوليكية، مصدر خطيئة وعار، بل خطوة لا بد على الإنسان تقبلها والمرور بها للوصول إلى الله. لوحة مانتينيا تمثل ذلك الانصهار بين الفكر والمادة بشكل شبه حرفي، فبملامحه العظمية وملمس جسده الكلسي، يبدو القديس الشهيد إنسانًا وتمثالًا معًا.
بدأت مقالي هذا مصممًا الحديث عن الأوبئة، لا عن الرومان والأجساد العارية والفلسفة النيو-أفلاطونية. لكن التحويلة التي يجبرنا مانتينيا على أخذها لا تعني أن الطاعون لم يكن ذا حضور يذكر، بالعكس تمامًا، فالأوبئة تحلو في القرن الواحد والعشرين مقارنة بعصر النهضة، حين كان من المعتاد أن يعيش المرء ثلاث أو أربع جائحات، ومن المعتاد أكثر ألا يعيش من أساسه ليرى الثانية أو الثالثة. تحولت تلك الجائحات إلى روتين، وترافقت بتشريعات حجر صارمة عزلت مدنًا وعائلات عن بعضها، دون الحديث عن الشلل الاقتصادي والبارانويا الجماعية التي دفع ثمنها الأجانب واليهود والفقراء، الذين زُج بهم خارج المدن. كانت الوفيات بالألوف، والمصاب يموت في غضون أيام من إصابته.
كان مانتينيا ذاته في صدام مباشر مع الوباء، فقد عاش موجة طاعون حادة في مدينة بادوفا منتصف القرن، قبل أن تسلبه جائحة ابنه بيرناردينو إضافة إلى دوق مانتوفا، راعيه ومشجعه الأول، كل ذلك عام 1478، أي في الفترة ذاتها التي رسم بها لوحته.
لا نعرف ما إن كان فنانو النهضة قد عاشوا عملهم هذا كنوع من الهروب أو عبادة دينية أو مجرد روتين لكسب الرزق، لكن الأكيد هو أن وباءً مميتًا لم يكن ليمنع فنانًا مثل مانتينيا من أن يجلس في عزلته، ربما حتى تحت الحجر، ويرسم لوحة منمقة يغوص في تساؤلاتها عن البشر والحجر، وعن مكاننا في التاريخ وفي الكون. ذات الشيء يمكن أن يقال عن بوتيتشيلي وبيروجينو وغيرهما من معاصري مانتينيا، ممن يؤم لوحاتهم أشخاص أصحاء بملامح حريرية وأجساد رشيقة راقصة أبعد ما تكون عن سياق جنوني كهذا. لكن للصور حياة موازية للواقع، تتفاعل معه عبر أقنية ملتوية ومعقدة، لكنها قلما تنصاع له ولمآسيه بشكل حرفي. لحسن الحظ.
مع مجيء الربيع، تنتظر اللوحة في البهو العريض للمتحف، زائرها الوحيد «صباح مجيد تخترق فيه الشمس القديس سيباستيان بسهامها»، حسب كلمات بروست، أحد معجبيها الكثار. قوتها تكمن اليوم في كونها عن الطاعون شكلًا، وعن كل شيء آخر مضمونًا، عن الدين والدنيا والجنس، عن شتلة تين وأزمان بائدة. تلك الأشياء ذاتها التي قد نلجأ إليها اليوم تحت الحجر تكتسب في لوحة مانتينيا نبرةً طارئة، يؤكد لنا القديس بوضعيته المزهوة أنها ليست ضربًا من التسلية أو إمضاء الوقت، ليست تفاصيل ثانوية، بل حركة دفاعية تستحضر من خلالها الصورة كل ما هو إنساني فينا لتقهر به الموت، مؤديةً بذلك دورها مجددًا، للمرة ما بعد الألف.