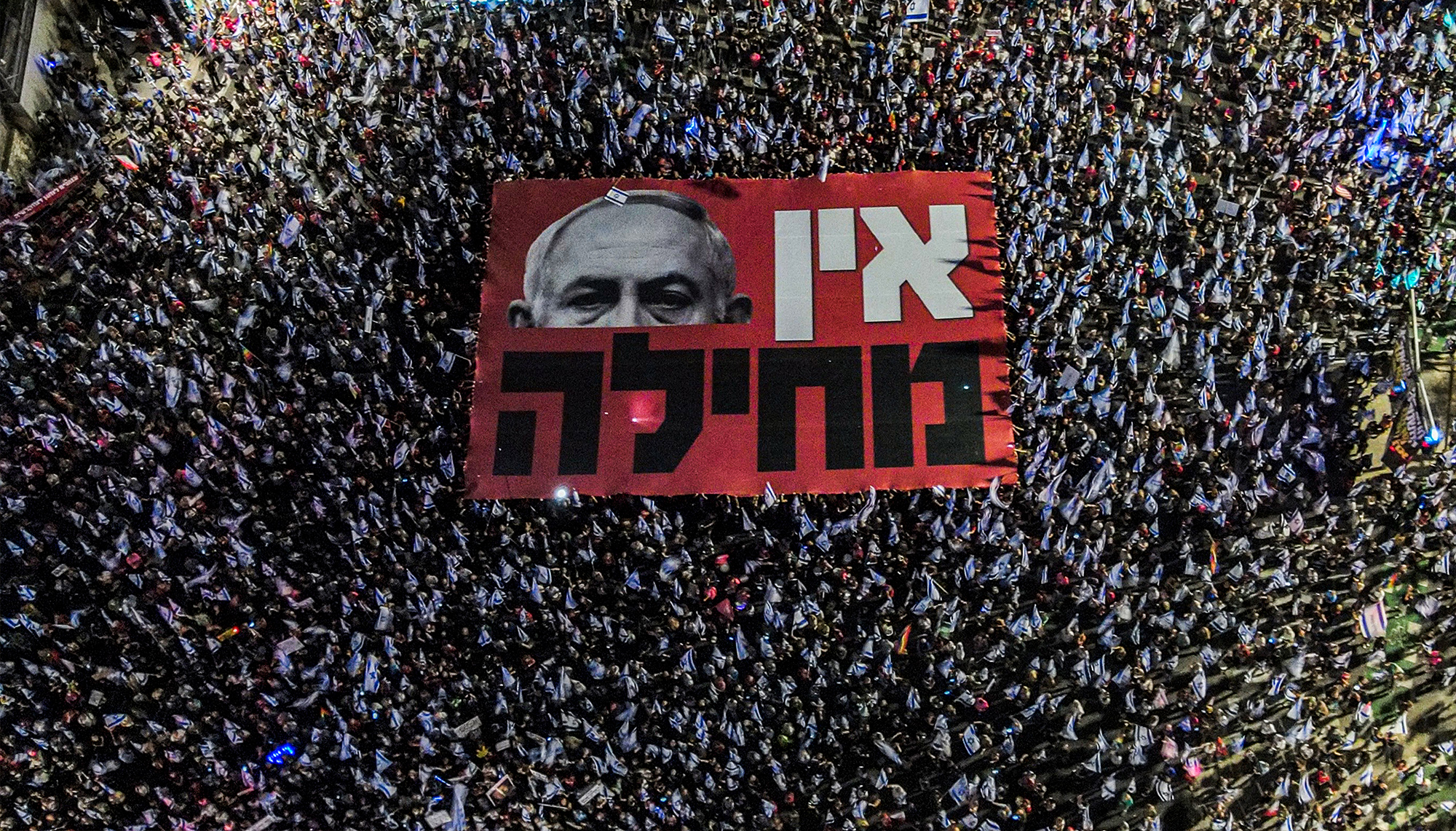( هذا النص جزء من ملف أنتجته حبر في الذكرى العشرين لرحيل الكاتب الأردني مؤنس الرزاز، لقراءة باقي مواد الملف اضغط/ي هنا)
ترك مؤنس الرزّاز (1951-2002) أثرين لم يُنشرا حتى الآن وهما: «مذكّرات روائي» التي بدأ بكتابتها منتصف التسعينيات على وجه التقريب ووصلت عدد صفحاتها قرابة مئتي صفحة، و«سيرة جوّانية» التي بدأ بكتابتها نهاية التسعينيّات وهي أطول من المذكّرات.
لم يطلّع على الأثريْن غير أفراد عائلتهِ وبعض الأصدقاء.[1] نشر مؤنس فترة إدارته تحرير مجلّة أفكار نتفًا من السيرة الجوّانية على صفحات المجلّة، ونشر بعضًا منها كذلك في صحيفة القدس العربي، وذلك قبل وفاته بقليل.
كان مؤنس قد بدأ بكتابة السيرة الجوّانية في العام 1998 تحت عنوان «سيرة جيل» فكتب على كرّاسة مدرسيّة وأنجز منها ما يُعادل 50 صفحة، من قياس (A4) ثم توقف عن الكتابة،[2] إذ لم يكن ما كتبه يلبي طموحه في كتابة نصّ صادم يختلف عن كتب المذكّرات العربية التي يسرد أصحابها البطولات الشخصيّة.
منذ الأول من كانون الثاني 2001 عاد مؤنس من جديد للكتابة مدفوعًا بمبدأ ينقله عنه صديقه هاشم غرايبة، وهو أن الروائي لا يكون روائيًا بحقّ، إلّا إن كان على معرفة حقيقيّة بالمدينة وقاعها الذي يضمّ المنبوذين والمنبوذات.
لهذا بدأ بالكتابة بشكل أسرع وبشكل مختلف وبجرأة أكبر، واستعان بـ«كميّات عظمى من الكحول» كي يستجمع الجرأة الأدبية الكافية لهذا النوع من الكتابة، وكي يضمن عدم تراجعه عمّا سيكتبه لاحقًا. وقرّر عدم اطلاع أحد المتخصصين على ما يكتب وعدم مراجعتها من قبله كي لا يعود الرقيب الذي بداخله إلى شطب شيء منها، «العريّ الفاضح والاعتراف القبيح لا يحتمل مراجعة، فالشجاعة الأدبية لا تتكرر مرتين إزاء سطوة الرقابة الداخلية الذاتية».[3]
داخل هذه الاعترافات أشار مؤنس إلى حوارات أجراها مع جبرا إبراهيم جبرا تعود لنهاية السبعينيات تدور حول خلو الأدب العربي من أدب الاعترافات، وهي تكشف كذلك تأثره باعترافات القديس أوغسطين، وجان جاك روسو، فيما يروي المقربون منه أن قرأ مذكرات الراقص الروسي فاسلاف نيجينسكي والمغربي محمد شكري.
عرف مؤنس حياة زاخرة، إذ عاين في حياته انقلابين عسكريين في سوريا والعراق، وحربًا أهلية، ثم مقاومة «إسرائيل» في لبنان، ودخل مصحات نفسية في بريطانيا بسبب الكآبة، وتعرّف على أعلامٍ في الفكر والأدب العربيّ. عارض السلطة ودخل فيها، كتب روايات وضعته كعلامةٍ فارقةٍ في مسيرة الرواية العربيّة.
يقدّم مؤنس في هذه الاعترافات جوابًا لكل الذين يسألون عن سبب كتابته للمذكرات، فيقول: «السبب الرئيس الذي يدفعني إلى كتابة اعترافاتي يكمن في التقاط حاستي السادسة مؤشرات خفيّة تشير بشكل شبه قاطع إلى أنني سوف أفارق هذه الدنيا، وأنتقل إلى الرفيق الأعلى ما بين عام 2000 وعام 2007»[4] وهذا ما كان، فقد توفي في شباط 2002.
يؤكد أصدقاء مؤنس الذين اطلعوا على النص الكامل أن ما نشره مؤنس أو قرأه عليهم آخر أيّامه لم يكن غير النصوص الأقل جرأةً وصراحةً في هذه السيرة. اليوم وبعد وفاته التي مرّ عليها عشرون عامًا، واندثار ما نشره في أرشيف الصحف والمجلّات التي فُقِد بعضه، تعيد حبر نشر أجزاء ممّا كان مؤنس قد نشره من هذه السيرة، محاولين قدر الإمكان ألّا نعدل على النصوص الأصلية أبدًا.
واليوم، وبعد عشرين عامًا على رحيل مؤنس، لا زال أصدقاؤه يسألون عن السبب الذي منع نشر سيرته الجوّانية أو على الأقل كتابه: اعترافات روائي.
نصوص منتقاة من «السيرة الجوّانية»
أبي يدرك أنّ مدير المدرسة والأساتذة يعاملوني معاملة خاصة. وأنّ الناس، وما يسمى بـ«العامّة» والبسطاء كانوا يبجلونني بالامتيازات، يغمرونني بالمحبة والكرم والإخلاص، لأنني ابنه.
عام 1969، على ما أذكر، أنشأت جبهة التحرير العربية (واجهة حزب البعث الفدائية) قاعدة في «العينة» قرب الكرك. ما زلت أذكر الماء والأشجار واستقبال الناس المميَّز لي ما إن يعرفوا اسم والدي.
كنا نزور الكرك بين الحين والآخر، ودعانا رجل من عشيرة «الهواري» إلى العشاء في «بيت راس» على شرف وجود مؤنس منيف الرزاز في المنطقة. وبدأ الهرج عن منيف الرزاز وانتهى بالقضية الفلسطينية. «ختيارية» وشباب يجلسون على بُسُطٍ تحاصر الغرفة الفسيحة كحزام داخلي. تدور وتلفّ مع دوران الغرفة.
قال رجل شيخ إنه لا ينسى كيف أنقذ والدي ابنته من موت محقّق. قال: «ألله سبحانه وتعالى (وأشار إلى سقف الغرفة) والتكتور والد هذا الزلمة (أشار نحوي) أنقذاها. ألله كتب لها عمرًا جديدًا. والتكتور منيف نفّذ ببراعة. وما رضي ياخذ فلسًا واحدًا». قال كهل يجلس إلى جانب الشيخ: «كان يجمع، سبحان الله، بين الحكمة ونضال إنسان مؤمن بأنه يحمل رسالة». قال شاب: «تقصد يا حاج أنّه طبيب ممتاز، ومفكر جيد، ومناضل صلب العود». قال الكهل كالمُحتَجّ: «وهل غلطت حتى تشرح كلامي. طبعًا». قال الشاب: «ثمة فارق بين «الحكيم» أي الطبيب، وبين الحكيم أي المُفكر».
طرد الكهل ذبابة عن وجهه، وتناول كأس الشاي بحركة تنمّ عن انزعاج. قال: «جاي تعطيني دروس، وتتفلسف عليّ وإنت ما طلعت من البيضة بعد. أقول مطر تقول شتاء، وبعدين معك؟».
كنتُ أشعر بالناس يغمرونني بالمحبة والمعاملة الخاصة. وإذا كنتُ أنا قد اطمأنيت بعض الاطمئنان وارتحت «غارشًا» نتيجة هذه المعاملة. فقد كان والدي منزعجًا منها أشدّ الانزعاج.
في اليوم الـ13 من التدريب في قاعة «العينية» داهمنا أبي عند الفجر. استنفر المعسكر، وهجم قائد المعسكر، أبو العبد، عليه، وراح يقبِّله. وهتف البعض بهتافات تحيي الحزب والوالد.
بعد أن ألقى أبي كلمة حماسيّة أمام الشباب. قال لأبي العبد: «أريد المحضر اليومي أو البرنامج اليومي لنشاطاتكم». خرج أبو العبد (وأظن أنه كان ضابطًا من عشيرة الغرايبة التي تقطن في شمال الأردن قرب إربد) من الخيمة، وقال لأبي وهو يناوله «دفتر اليوميات العسكرية»، أي الدفتر الذي يحتوي على جميع تفاصيل حياتنا هنا بالإضافة إلى برامج التدريب الذي لم ننته منه بعد.
هذا الكيان كله هو مؤنس. الوحش والقديس. القرصان والفيلسوف.الغرائزي والمثالي. البطل والمشوه. عليّ أن أتعلم قبولي كما أنا كليّ: إعاقاتي وهباتي.
كانت الشمس قد بدأت تُطلّ مرسلة شعشعتها شحيحة حذرة، كأنما ترغب في جَسّ نبض العالم قبل أن تصل إلى الذروة، وأن تتحسّس برويّة وصبر إذا كان الليل قد زرع لها ألغامًا ومقالب قبل انسحابه. ما كان الليل يثق بالنهار. وما كان النهار ينام في الليل تحفُّزًا واحترازًا. فما إن تُطلّ (أرصدة) الشمس الذهبية، حتى ينسحب الليل لينام في منطقة أخرى من الكوكب، حيث لا نهار. كأنها رحلة الشتاء والصيف، طيور تحلق نحو الشرق، وطيور تحلق نحو الغرب في رحلات تفرضها الطبيعة فرضًا. قلت لابن خالتي هيثم: «الإنسان لم يدجّن الطبيعة بعد. الحرب ما زالت في أوجها». أشاح هيثم. كان شابًا عمليًا، ولا يحب أن تميل أذنه نحو حوار فلسفيّ أو فكريّ.
تناول أبي القهوة العربية بهدوء، ثم شرب الشاي وأفطر مع الشباب. أبو العبد كاد يطير فرحًا. سيكتشف الدكتور لوحده، دون إشارة من قائد المعسكر (الغرايبة) أنه كان يعامل ابنه مؤنس معاملة خاصة محفوفة بالامتيازات.
عزّزت شعشعة الشمس خيوطها، ونسيج استطلاعاتها، وقرون استشعارها، بنار أقوى. صارت مواقع الخطوط المتقدمة الذهبية منيعة حصينة. هتف أبي بلهجة تشي بالعصبية والغضب: «لا أرى اسم مؤنس في لائحة الحراس الليليين»، ارتبك أبو العبد، وقال متلعثمًا: «البرد قارص في الليل دكتور. وصحة مؤنس لن تتحمل الوقوف في العراء في الليل البارد. إنه أصغر المتدربين سنًّا وأقلهم وزنًا». قال أبي بحدّة وقد انتفخت أوداجه، بغضب واضح وهدوء من يغالب في سبيل ألا تفلت أعصابه: «هل أنا طبيب أم لا؟»، قال أبو العبد ردًا على هذا السؤال الغريب الذي جعله يستريب استرابة رجل يشعر أن صديقه يقوده إلى فخّ: «طبعًا دكتور. طبعًا. وهل ثمة من يشكك»، سأله أبي مقاطعًا: «هل يحب الأب ابنه أم يحقد عليه؟»، ظهرت البغتة في وجه أبو العبد، المشكلة تكمن في جهله لموقع اللغم حتى يتجنبه. قال وقد امتقع وجهه وشعر أن الدكتور يستفزّه: «لا، لا يمكن للأب أن يحقد على ابنه». فقطب أبي وقال: «إذا كان كل ذلك صحيحًا ومتماسكًا منطقيًا، فلماذا لا يشارك مؤنس في نوبات الحراسة. أنا طبيب وأعرف أن صحة مؤنس تليق بصحراء الليل التي جربناها في «الجفر» (عام 1957 على ما أذكر). ولو كنت أعتقد أن أجواء الصحراء القاسية ستهدّ حيله، لما كنت لبيت رغبته وجعلته يلتحق بمعسكر التدريب هذا».
هرع أبو العبد، وكأس الشاي في يده ويده ترتعش غيظًا، ولعله كان يقول في نفسه: (الحق عليّ لأنني عاملت ابنك معاملة خاصة، خرجي، أستحق كل هذا التعنيف). هتف مناديًا مساعده. أقبل المساعد وأدى تحية عسكرية. قال أبو العبد إنّ فترة التدريب سوف تنتهي بعد خمسة أيام. سأل على مسمع من أبي (عن قصد طبعًا): «كم هي مدة الحراسة العادية التي يقوم بها الشباب؟»، ردّ المساعد: «ثلاث ساعات رفيق».
قال أبو العبد بخبث من يرغب أن ينتقم بشكل غير مباشر: «يبدو أننا نسينا وضع مؤنس في قائمة الحراس. ضعه في القائمة وليحرس كل ليلة ست ساعات حتى يوفي الساعات المطلوبة».
جحظت عينا أبي، لكنه فطن إلى ما يدور في خلد أبو العبد فلم يعلّق. قضى النهار معنا، ثم قفل عائدًا إلى عمان بالسيارة العسكرية. وبدأت حملة اضطهاد ضدي لم يشهد تاريخي شبيهًا بها. أبو العبد أصدر أوامره بأن أحرس كل ليلة ست ساعات، رغم أن الرفاق كانوا يحرسون ثلاث ساعات ليلية فقط، ثم يُستبدَلون بفدائيين شبعوا نومًا (نسبيًا). وأمر أبو العبد بأن أشغل أكثر مواقع المعسكر وحشة ورائحة كريهة. فقد كان المكان الذي أمرني أن «أناوب» فيه ست ساعات أشبه ما يكون بقفر لا شجرة تظله ولا جبل يردع برده، كان مكشوفًا للعدو، وكنت مكشوفًا للبرد. وكان قرب هذا الموقع دغل كثيف يستخدمه الرفاق بديلًا للمرحاض. وكان يحلو لي أن أختفي في الدغل تقيةً للبرد، ولكن دون دفع ثمن الروائح المنتنة.
اكتشفت أنني أمام خيارين أحلاهما مُرّ. البرد والخطر، والدغل الشائك والروائح الكريهة التي تنتقل عدواها إلى الإنسان أحيانًا، فاخترت البرد والخطر.
حين عدنا إلى عمان، روى هيثم متضاحكًا شامتًا ما جرى لي في الليالي الخمس الأخيرة. في غرفتهما أعلنت أمي عن امتعاضها، وقالت إنّ قلب أبي لا يعرف الرحمة. وهتف أبي: «ينبغي ألا يتمتع بمزايا تفصله عن الآخرين من أقرانه». وكنتُ أنا وهيثم في الصالة، نستمع إلى جدالهما العقيم. فالذي حصل حصل، ولا داعي لتناول الموضوع مرة أخرى.[5]
—–
1978 مصحة باودن هاوس – هارو – لندن
أدخلوني إلى مصحة الأمراض النفسية مرة أخرى.
استقبلني الدكتور تونكس بابتسامة باهتة وقال: «آمل أن «نطوعك» بطريقة أفضل هذه المرة». «إنهم» يحاولون إعادة تأهيلي كي تقبلني مؤسسة الناس. «إنهم» بقيادة الطبيب تونكس يرغبون في قولبتي وتنميطي، يسعون عبر قصفي بالمهدئات، ذات الآثار الجانبية المرعبة، إلى تقليم مخالب مرض كآبتي المزمنة، وإعادة نصف جنوني إلى جادة الصواب، واقتلاعي من رمال إدمان الكحول المتحركة، وإثابتي إلى طريق الرشد.
(لم أكن قد قرأت أعمال ميشيل فوكو بعد)، كانوا، في المصحة، يعدون العدة لدفع نمردتي نحو الانصياع الكامل والاستسلام. وكانت غالبيتي متواطئة معهم، فقد أدركني الرهق من فرط السباحة ضد التيار.
دخل الدكتور الإنجليزي تونكس إلى غرفتي، وقف أمام سريري ودس يديه في جيبي سرواله، ثم قال: «ها قد مضى عليك أسبوع كامل في المصحة. لا أرغب في أن أحبطك، لكنني لست متفائلًا. أنت لست يائسًا بما فيه الكفاية. المرة الماضية حين لذت بي عام 1974 كنت قد بلغت قعر حضيض هاوية اليأس، لهذا نجحت في معالجة كآبتك الحادة وإدمانك. هذه المرة معنوياتك أفضل، يأسك أقل، يعني فرصك في الشفاء أقل!».
بعد نصف قرن من المكابدة والاشتباك بالسلاح الأبيض مع أمراضي، ها أنا أعلن وضع حدّ للصراع، أقبلني كما أنا.
في المرة الأولى عام 1974 خرجت من ذات المصحة وقد تحولت كائنًا طبيعيًا سويًا متصالحًا مع نفسه، بفضل مساعدة الدكتور تونكس وطاقم المصحة من أطباء وممرضات. إلا أن هذه الهدنة أصيبت بانتكاسة قوية في العام 1978. فعادت يدي تلتمس الكأس بإفراط، وسرعان ما عادت بذور مرض كآبتي إلى النمو نموًا مستفحلًا.
وأتفكر اليوم -في أواخر العام 2001- ترى لماذا قاومت أمراضي هذه كل تلك المقاومة المستميتة؟ لماذا رفضت حقيقة مغايرتي للأكثرية العادية، ومباينتي للغالبية السوية، ومفارقتي للتيار العام الطبيعي؟ لماذا تواطأت مع مؤسسات الانضباط في المجتمع، ضد اختلافي وانزياحي؟ لماذا لم أقبلني كما خلقني الله؟ فأنا لست مجرد سكير ملتاث بالكآبة ومفتقد للتأقلم مع الدنيا. أنا، بالإضافة إلى ما سبق، موهوب باركني الله بهبة الإبداع والخلق. وأنا رهيف شفيف حساس، وثائر متمرد يتمتع بحب أصدقائه.
هذا الكيان كله هو مؤنس. الوحش والقديس. القرصان والفيلسوف.الغرائزي والمثالي. البطل والمشوه. عليّ أن أتعلم قبولي كما أنا كليّ: إعاقاتي وهباتي.
غير أنني بددت ثلاثة أرباع عمري في محاولات يائسة للانقلاب على طبيعتي المغايرة كي أتحول رجلًا آخر لا علاقة له بي. قصدت رجلًا سويًا مقبولًا من القضاة الرصينين والمدرسين والسجانين والمتجهمين والأطباء النفسانيين الوقورين، يالسنوات العبث والهدر.
الساعة السابعة والستون تحت الصفر: في جمهوريتي الجوانية جماهير لا جمهور، قبائل لا قبيلة، أقليات مشظاة لا أغلبية. في أزقتي الخلفية تقدميون يعانون من رغبات ملحة في الانتحار. فاشيون لا يتورعون عن المحبة، محاربون محطمون يتأبون الاستسلام. متصوفون أوغلوا في الشطح وغالوا في النشوة.
وعشاق، عشاق محترفون، يفضلون الحرية على الحب إذا ما اشتبكا بالسلاح الأبيض من خلية إلى خلية ومن جسد إلى جسد.
أنا جمهورية؟ بل مجرة جمهوريات في حالة صراع!
عن إعاقتي الثالثة
إذا كانت إعاقتي الأولى تجلت في مرض كآبة مزمن وحاد. وإعاقتي الثانية تجسدت إدمانًا للكحول، فإن إعاقتي الثالثة هي الإعاقة الأغرب والأعجب، قصدت افتقاري القدرة على التعامل مع تفاصيل الدنيا المادية اليومية.
مثلًا: لا أفقه شيئًا من علوم المطبخ وفنونه، للأسف. لا أكاد أميز بين الملفوف والزهرة والقرنبيط، ولا بين الملوخية والسبانخ (عماء النكهات) ولا أتقن إعداد الشاي أو القهوة ولا سلق بيضة، بلا مبالغة.
ومثلًا أميّ في علم البنوك، تعلمت الفرق بين حساب التوفير والحساب الجاري قبل سنوات قليلة فقط. وما زلت أعاني من كتابة الشيكات فأمزق عدة أوراق قبل أن أجيد كتابة ورقة شيك مثل الناس والعالم. أما الكمبيالات فقارة غير مكتشفة بالنسبة لي حتى اليوم، وشراء قميص أو بنطال مهمة شاقة عسيرة، نعم إلى هذه الدرجة.
أما التكنولوجيا فحدث ولا حرج، وآخر ما استطعت إنجازه على هذه الدرب بعد جهد جهيد هو القدرة على التعامل مع جهاز الفاكس، أما ما هو أكثر تقدمًا منه كالكمبيوتر فما زال طموحًا بعيد المنال.[6]
—–
بوح
ولدت مغايرًا لأب مغاير وأم مغايرة. كان اختلاف أمي وأبي إيجابيًا، ولم نكتشف أن اختلافي حاد في سلبيته إلا بعد ولوجي إقليم المراهقة. لم يكن أبي رجلًا عاديًا. كان مفكرًا بارزًا حاز جائزة جامعة الدول العربية لأفضل عمل سياسي فكري، عن كتابه «معالم الحياة العربية الجديدة» وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره بعد. وما إن غذّ في أربعينياته حتى انتخب أمينًا عامًا لحزب البعث الحاكم في سورية (1965) خليفةً لميشيل عفلق.
في العام 1977 انتخب وصدام حسين وشبلي العيسمي أمناء عامين مساعدين للأمين العام ميشيل عفلق في بغداد. علمًا بأنه تولى قيادة الحزب في الأردن إثر انشقاق عبد الله الريماوي في أواخر الخمسينيات، ناهيك عن لعب دور بارز في الهيئات القيادية للمقاومة الفلسطينية في عمان أواخر الستينيات. ومعه عرفت امتيازات السلطة في عاصمة الأمويين، ثم طعمها المهيب الرهيب المبالغ فيه في عاصمة العباسيين. كما تحسست نكهة العيش في صفوف المعارضة بشكل أو بآخر في هاتين العاصمتين، بالإضافة إلى عمان.
كنت أدرك أن لا أمل لي في شفاء كامل. كنت أدرك، منذ وقت مبكر، أنني خسرت المعركة، فسعيت إلى أن لا أخسر الحرب كلها.
وكان رجلًا مقبلًا على الحياة. بل كانت الحياة والاستمتاع بها فنًا يتقنه أيما اتقان. قدرته على السخرية لاذعة. صاحب نكتة وفكاهة. يغني بصوت عذب إذا استخفه الطرب. وكان مناضلًا ذا إرادة حديدية. أما أمي «لمعة بسيسو» فلم تكن امرأة عادية كذلك. كانت من أوائل البنات الأردنيات اللواتي واصلن دراستهن الجامعية خارج عمان. إذ درست الأدب الإنجليزي في كلية بيروت للبنات. وعرفها مثقفو عمان الأربعينيات أديبةً مجيدة وعضوًا نشطًا قياديًا في الحركة النسائية والاجتماعية، كما تمتعت دائمًا بجاذبية أخاذة وإرادة حديدية، وميل لافت للفن والموسيقى الراقية.
أنا كنت مغايرًا، أختلف عن الأغلبية العادية وأختلف عن أمي وأبي المختلفين أصلًا عن الأغلبية السائدة.
كان اختلافهما إيجايبًا وكان اختلافي سلبيًا. كانا غير عاديين، وكنت غير عادي وغير طبيعي معًا! فأنا مبدع من جهة ومريض من جهة أخرى. وإذ اكتشف والداي مرضي في وقت مبكر، فإنهما لم يكتشفا موهبتي إلا في وقت متأخر. وكان لهذا التفاوت في التوقيت أثر مؤلم مبهظ عليهما. فهما لم يتأكدا من أن موهبتي أصيلة غير عابرة ولا طارئة إلا مع كتابي «النمرود» الذي صدر عام 1980 في بيروت، بينما كانا في الإقامة الجبرية في بغداد تحت ظل حكم الرفاق! أما أول إشارات اختلافي السلبي فقد بدت صارخة منذ عام 1966.
—–
الساعة الخامسة والعشرون
مصحة باودن هاوس – هارو – لندن
(1974)
عيونٌ خمد وميضها البشري. عيون انحطمت جذوة سحرها. عيون ناعسة ذاوية.
«فاليوم» يخدّر محركات الحماسة. «تريبتزول» يقلص غدة الإقبال على الحياة، مع وعد باستعادة التوازن.
مدمنو كحول، مكتئبون مرضيون، غير أسوياء، منخطفون، مدمرون، مقاومون، طالبو نجدة، أصحاب أمزجة انتحارية. طاقات لم تُعدّ إعدادًا محكمًا لمقاومة ضغوط تخطتها. منهارون عصبيون. حالات شيزوفرينيا واكتئاب اكلينيكي تعالج بالصدمات الكهربائية. بالٌ مرهقة، خيال مقعر، ذاكرة مرضوضة، هلوسات.
أنا الفتى الذي ضل في حقبة الخداج، وظن أنه مشروع بطل قومي يساري سيحرر فلسطين ويوحد العرب، ثم يحطم قيود البروليتاريا منتصرًا على المشروع الرأسمالي الكولونيالي الغربي.
ممرضات شقراوات فاتنات متعاطفات، ومرضى يقاومون. وجوه شاحبة، وجوه مزلزلة، وجوه ضربت ملامحها عواصف هوج مدمرة. نظرات زائفة، نظرات واهنة.
أي خطايا مرعبة ارتكبنا في حيوات سابقة -أو مستقبلية- كي نستحق كل هذا العناء، وكل هذا الاختلاف؟
الاختلاف الذي كان هدفًا أيام المراهقة بات عبئًا رهيبًا.
المغايرة التي كانت أملًا مرجوًا ووعدًا فاتنًا، وحلمًا يسعى إليه الجسورون منا، باتت كابوسًا جهنميًا، ومصيدة لا سبيل إلى التحرر منها.
سوف أقول كل شيء جهارًا نهارًا. سوف أصرخ من الأعماق بحرقة: كان من الممكن أن تكون هذه الدنيا أعظم كمالًا، وهذا الإنسان أفضل تقويمًا، وهذه الحياة أكثر عدلًا وأقل شقاءً. كان كل هذا ممكنًا، فلماذا؟
فليسقط ظلام الإرهاب.
ولتسقط «روليت» الجينات الخطرة والطابع الزُحل.
2001
بعد نصف قرن من المكابدة والاشتباك بالسلاح الأبيض مع أمراضي، ها أنا أعلن وضع حدّ للصراع، أقبلني كما أنا. أحب أمراضي -أنا حر- أزينها بالحلي والأقراط وأزاهير الفل. بتّ أرى جنوني جميلًا، وعصابي هدية مباركة من السماء. ألم يصطفني العصاب وحدي من دون كل أحفاد جدي الخمسة عشر؟ كأنني نبي اختاره الله واصطفاه وأغدق عليه رسالة شاقةً تستهدف نشر الهدى ومحاربة الضلال.
مرضي باهر، انهياراتي أخّاذة وأمسد شعرها. شروخي مباركة.[7]
—–
لم تكن معركتي الضارية ضد قوى «نصف جنوني» تستهدف أن أظفر بالتوازن النفسي.
لا، كنت أدرك أن لا أمل لي في شفاء كامل. كنت أدرك، منذ وقت مبكر، أنني خسرت المعركة، فسعيت إلى أن لا أخسر الحرب كلها.
كان هدفي في المقاومة البطولية المستميتة ضد الجنون الكامل والانهيار الدائم الخروج بأخف الخسائر.
أما أن أربح الحرب وأنتصر انتصارًا حاسمًا قاطعًا عليّ، فأمل تخليت عنه نهائيًا منذ منتصف التسعينيات. أي بعد اشتباك بالسلاح الأبيض مع إعاقتي نحو ربع قرن. أريد الخروج من حرب الاستنزاف الجوانية هذه بنصف هزيمة فقط. أي طموح مترف!
تجلى طموحي مثلًا في أن أموت موتًا طبيعيًا مبكرًا، لا منتحرًا![8]
—–
يوم عادي في حياتي. الساعة العاشرة والنصف صباحًا. هل أستغيث بعموم عشائر الرزايزة؟
أمي مريضة مقعدة مكتئبة. ابنتي كنده تدرس في الطابق الثاني، وهي منقبضة القلب قلقة على حالي وحالها! ابني منيف في جنوب بريطانيا يدرس، ابنتي نور في شرق غرب بريطانيا تدرس. شقيقي عمر في واشنطن يقيم هناك، ابنة أخي آية في واشنطن وما زالت في الحضانة، انتهت عشيرة الرزايزة.
لا أعتقد أنها ستنقرض، سوف نقاوم باستيلاد ذرارينا. يا لبؤس تهافت التهافت. يا لبؤس فلسفة العقل الخالص! يبدو أنه خالص فعلًا.
الساعة العاشرة والنصف وخمس دقائق. في غرفة القعود، الممر في بيتي – اللا بيت، لا أحد في المدينة، لا أحد في الفضاء، عزلة جارحة، والوحشة وحش ضار ذو أنياب مميتة، وهو في.
إنني أمضي إلى الأقصى، قصدت أقصى الأقصى، أقف على حافة هاوية النهاية، أقاوم نداء الانتحار ببطولة غير مسبوقة، بطولة تستفز القوى النبيلة في أعماقي السحيقة. بيتي منزل وليس مسكنًا، الإنسان يسكن إلى مسكن فيقيم في جو من السكينة، بيتي كان مسكنًا قبل رحيل الرفيقة ثم تحول منزلًا ينزل فيه المرء مثلما ينزل في بنسيون. لقد أصبح مجرد House بعد أن كان Home!
من كان منكم بلا خطيئة فليرجمني براجمات الحمم.
الثامنة مساءً.
غدوت مثقلًا بالكحول، ها أنا أنبعث من جديد متأثرًا بضباب الخمر في الرأس، سأداعب كآبتي بإصبع قدمي، سأجعل من جفلتي ترف لهو ولعب، سأكركر سطوة سوداويتي المتجهمة تحت إبطها.
الثامنة والنصف ليلًا. أتجشأ توترًا، ثم يتنفس صباح صدري المثقل بانقباضه.
خاطر الانتحار: عاجي بستائر جهنمية، بناء معقد ذو أنفاق، أسرار، في بوابته الرئيسة مهب رهبة المهابة.
تعالوا لنقيم عريشة القلق في حقل الهذيان ذي الردهات المباحة. أنا الفتى الذي ضل في حقبة الخداج، وظن أنه مشروع بطل قومي يساري سيحرر فلسطين ويوحد العرب، ثم يحطم قيود البروليتاريا منتصرًا على المشروع الرأسمالي الكولونيالي الغربي. قبل سبعة أشهر من نضوج جنين الخراب، خربت، ولم أنتبه. أبي الطبيب هو الوحيد الذي لاحظ.
أنا الضلال، والضليل قيس. أنا ضال بطبيعتي الهازلة المأساوية. وفي غمرة متاهة ظلالي ضللت!
(بعض العرب يخلطون بين حرف الضاد وحرف الظاء!)
(بيبر) الكلبة تفهمني، أعرف ذلك من نظراتها المتعاطفة الحزينة، يبدو أن الحيوان على صعيد الحدس متجاوز للإنسان، فالحضارة لم تلحق الضعف بغرائزه وحواسه، ذراري حدسه لم تنقرض بسيف دخان المصانع!
عاش الشغيلة، مع ذلك!
مزاجي أشعث جعدي متطاير، الخمر تسرحه بأناقة وتهذيب محكم، ثم تنكشه دفعة واحدة، كأنها تستدرجه بدهاء لا طعم له. ثم تبطش به في شركها بلا معنى.
الأربعاء 23/1/2002
دائمًا تنفجر زوبعة الغضب العنيف المكبوت في أعماقي متخذة توقيت الفجاءة.
دهاؤها محبوك بإحكام، توحي لي بعامل خارجي فجرها. مجرد ضحك على ذقني لا ينطلي عليّ. عامل الكهرباء أزعجني، أو خبر آثار امتعاضي، أو تعليق قاله أحد معارفي فاستفزني، لكنها كلها أسباب ثانوية، مزيفة، لا يتجاوز تأثيرها القشة التي قصمت ظهر البعير.
أعترف وأقرّ، على أنني أزعم وأدعي أن لحمي كان، وما زال، مرًا، صحيح أنني أنحني أمام النوبة العاصفة كلما اجتاحتني من الداخل، لكنه انحناء داهية يتجنب الانقصاف والكسر.
آليات الزوبعة الجوانية تعتمد التراكم الجهنمي اللئيم، الوئيد، طويل النفس والبال، تتراكم بصمت، تنمو سرًا، تتفاقم على رؤوس أصابعها فلا تلفت انتباه صاحبها، ضحيتها، وهي في أحشاء روحه، تستفحل، تتجهم، تنكمش، تتورم، تتعرض لصواعق مشحونةً بتوتر نزق، وحاملها غافل سادر، ثم تلجأ بلؤمها إلى تكنيك الحواة وألاعيب المشعوذين وحبائلهم. فتقذف قنبلة دخانية صوتية منبعثة من العالم الخارجي للتضليل، كأن أسمع تعليقًا مزعجًا من أحد معارفي. تعليق يفقس مزاجي، فتنتهز حالة التدهور المؤقت المجنون فرصتها الحرجة وتنفجر صريحة عنيفة متدفقة بحمم وقوة مدمرة في شتى الاتجاهات الجوانية: الأعصاب، الشرايين، البال. تدمر في طريقها الصمام الذي يفصل بين الشعور واللاشعور، تخترق الحجاب الحاجز بين الوعي واللاوعي. تستفز شتلة حب الموت وتصفع سباتها بطاقة عنيفة، تبعث الرغبة النائمة في تدمير الذات، رغبة جامحة مظلمة لا تقف عند حدود ولا تعترف بخطوط حمراء.
اندلعت زوبعتي الجوانية السوداء مساء الأربعاء بينما كنت متهالكًا على زجاجة السم الهاري (ويسكي من نوع رديء)، نوبة كاسحة حاولت مغالبتها فغلبتني بيسر مهين، واجتاحتني من داخلي إلى مجالي الحيوي الخارجي كله. وبسطت سيطرتها الجهنمية علي، فتلبستني مستعمرة محتلة، ثمة انقلابات بيضاء، ثمة انقلابات حمراء، هذا انقلاب أسود!
فزعت إلى أقراص المهدئات، فما أن اختلطت بالكحول حتى ازداد الطين بلّة (يا حبيبي).
واصلت نوبة نصف الجنون فرض سيادتها الجوانية عليّ ثلاثة أيام بالتمام والكمال، استنجدت بأعز أصدقائي كي لا أبقى (معي) وحيدًا، (معي) خطر وأخافه، علّ أحبائي في مثل هذه اللحظات أن يحموني مني، (إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك) أقصد الرحيل عن (معي) أو (عني)، لجأت! كيف ألجأ والقصف جواني؟ كيف ألجأ وأنا القصف، المقصوف والقاصف؟
مهنا الدرة، يوسف الحسبان، سميحة خريس، هاشم غرايبة، سعود قبيلات، وقفوا إلى جانبي، وأخمدوا نار نوبة التدمير الذاتي العاصفة هذه بمحبة غامرة أغدقوها عليّ، كعادتهم.
في عزّ النوبة المدمرة التي طالت عدت إلى (المنقذ من الضلال) الغزالي، عاضدني أيضًا طوال ثلاثة أيام وكياني الجواني يندفع في متاهة اضطراب عنيف، تدفعني قوى جبارة ملتبسة لم أستطع لها ردًا، تقذفني في دهاليز لا نهائية. جدرانها يأس أسود وأرضها ضياع أشعث خشن، وأنا تعطلت كوابحي واختلّ توازني.
قوى غامضة مقوضة سادية تدفعني بقوة في دهاليز تتقيأ هزلًا أسود من فوقي وتحتي وبين يديّ وعليّ، تعرفت على هذا الضرب من ضروب الهزل منذ عشرات السنوات، لمست ملامحه الملتبسة وشممت رائحته المحيرة، وذقت طعمه الملغز، هل الهزل الأسود في حياتي ورواياتي سلاحي ضد الانهيار الكامل؟
أم أن عزة نفسي تواجه مقصلة إعداماتي بقناع مفتعل مقهقه يخفي خلفه وجهًا تراجيديًا؟
أعترف وأقرّ، على أنني أزعم وأدعي أن لحمي كان، وما زال، مرًا، صحيح أنني أنحني أمام النوبة العاصفة كلما اجتاحتني من الداخل، لكنه انحناء داهية يتجنب الانقصاف والكسر، ثم أعود بعد السقوط نحو قاع الهاوية والتمرغ على وحل الانزياح الرغيد، للوقوف مجددًا على قدمي بكبرياء شامخة، وأنا أكركر في عبي شامتًا بالهزيمة المنكرة التي ألحقتها مقاومتي النبيلة الجبارة بفلول نوبة الدمار المتغطرسة، أزعم وأدّعي أنني صمدت صمودًا بطوليًا وإن بشق الأنفس، فلم أدّع وأزعم أن مثل هذه المعارك مع ذاتي يسيرة هينة أو رخية رائعة، إنها اشتباكات لا تعترف بأي مواثيق ومعاهدات ، وتعتمد الضرب تحت الحزام نبراسًا وقاعدة.[9]
—–
مدمن السم الهاري أنا، والمحارب الملتزم، الذي يتقيأ في الصباح قبل تناول الفطور ومع غسيل الأسنان.
عينان داميتان منتفختان. وجع في المعدة، دوار في الدماغ. مطرقة خفية تكسر عظام الجسد الجعدي. ثمة حاجة إلى كيّه لعله يغدو سلسًا.
أربع ضربات قاضية لم تقض على المحارب النمرود المنبوذ النبيل الخاسر:
اعتقال الأب 1957.
انقلاب الأعمام 1966.
مؤامرة الرفاق 1979.
هجرة الحبيبة 1995 – 2001.[10]
—–
تلك الليلة ولد الولد المرمي من مستشفى في السلط إلى جبل اللويبدة في عمّان. من بحر الوعد إلى أتون تورق فيه أمراض العصاب والانهيار وجنون الكآبة الإكلينيكية.
من نعومة اللحمة على ذراع باردة لأم مثقفة حنون، مرورًا بالمعتقلات، وأحكام الإعدام والمنافي الموحشة الباردة، والإقامات الجبرية فوق «الصالون الأخضر» مقابل البريد.
وعلى خاصرة دجلة.
ليكن عاقرًا ذلك النهار في 3 ديسمبر.
ليكن رمادًا يبابًا قفرًا ذلك الليل في 3 ديسمبر.
لتفتح الكحول في دماغي أزهار شرّ، ونصال مقاصل، وخبث مقاصد.
لتكن غابات سرير هذا المخلوق الموحش الزحل فوهات براكين ومعابد عزلة.
لتكن مروجه صوانًا وأصابعه دواليب محاجر. لتكن مجرات هذا الكائن الحي الغريب ذبذبات الجحيم وموجات الخلل.
ليت غيمة من مطر صخري هبطت على صدره الهش، تلك الليلة، وهو يناغي. ليته هلك فوق لغم حين حبا.
3 ديسمبر: ذلك اليوم المشؤوم لتخطفه مخالب العدم. ليجرفه عرق البروليتاريا الرثة طوفانًا على طوفان.
فلتقبض عليه شموس النهايات فتضع حدًا لفجره قبل أن يشتدّ ساعد ضحاه.
هل ثمة رسالة، معنى، حكمة، في تقلب هذا المخلوق الحي على شوك النار؟
كل ألسنة النار صبار. فأي فرن تبخر كل ذلك الظل الذي «نوت» أمي أن تغدقه علي مولودًا كي لا يزعجني ضوء النواحة في البيت الصغير؟
أماه: لقد ذوى الظل واستشرس القيظ. والصهد يلحس روحي بلسانه الصاهر.
انهضي. قومي من مقعدك المتحرك وخلصيني! غطيني بشرشف الليل البارد لعل نزيفي تحت مجرات الشموس يجف ويخمد.
ثمة من يقرأ ما وراء الموسيقى. ما تحت جدل هيغل من نبض وخفق مضاد. ثمة من يحاول باستماتة «دسترة» نهر التاريخ العظيم.
هي تريد ثريا صاحب روح خفيفة؟
وماذا تفعل بمخلوق جيناته جينات قديس، وطبائعه -مقاصده- طبائع وحش خرافي؟ وفوق هذا وذاك، يحكي لغة غريبة لا مترجم لها إلا «المعري» المقعد أصلًا!
أماه، العزلة تشفطني نحو كهف الرحم حيث الحصن الوحيد، ساعديني.
أنا الإنسان، ابن آدم، الذي تحوّل وحشًا جريحًا في نهاية حربه ضدّ الظلام.
أنا صريع الكآبة الذي سقط مضرجًا بأحلامه الخضراء كالجرجير.[11]
—–
حران زريقات
ما بعد 2001، حقبة العبث والسكينة والاستقرار.
الساعة الصفر كانون الثاني 2002.
اشتد الألم في صدري فتركت مكتبي في الوزارة وانطلقت إلى عيادة الدكتور حران في مستشفى الأردن. قلت إن صدري منقبض. ابتسم ابتسامته المشرقة المطمئنة المعهودة وقال مداعبًا: «كل ما يجري حولنا مثير لانشراح الصدر لا انقباضه، أنت تسبح ضد التيار!»، وامتلأ فمه بالضحك المر. قلت بذات اللهجة التهكمية المريرة: «شايف شايف، على الرغم من كلّ إنجازاتنا وانتصاراتنا يوجعني قلبي، أنا جحود وليس في يدي حيلة. هكذا هي جبلتي!». فحصني على الجهاز وقال مقطبًا: «ما في شي. بس على سبيل الاحتياط بدنا نعمللك بكرة قسطرة. تعال بكرة في وقت مبكر». ثم كتب شيئًا على ورقة ورفع رأسه نحوي. قال: «مين رح يجي معك؟»، تراجعت خطوةً إلى الوراء وقلت مداعبًا بمرارة: «أنت تعرف أنني مقطوع من شجرة. مالي حدا أو ما في حدا على رأي فيروز». كنت أدّعي، فلي أخوة أحباء ما أكثرهم، من مروان شقيق الدكتور حران إلى يوسف، مرورًا بمازن ومحمد ومحمد الثاني وهاشم وسعود. معظمهم بعثيون سابقون ورثت صداقاتهم من أيام الحزب زمان. بعضهم شيوعي سابق.
أقرّ أن قلق الدكتور حران أثار الأمل مجددًا في نفسي: «ترى، هل سمعت عزرا، آلهة الموت في أساطير «الرزايزة»، ندائي فلبت ودنت».
هي ليست آلهة الموت بالضرورة، هي آلهة نقل المرء من الدنيا إلى عالم السكينة الكاملة، حيث لا مصحات مجانين ولا سجون ولا انقلابات ولا إقصاء ولا حروب. هناك حيث الرحمة واسعة الآفاق والمحبة عميقة الأغوار (هل هي سذاجة؟) يسألني يوسف وهو يعض على غليونه الذي يشبه غليون واطسون رفيق شرلوك هولمز: «يا أخي أنا مش فاهم حكايتك مع استعجال الموت. أنت مرتاح ماديًا، روائي ناجح بكل المقاييس، أبناؤك أصحاء والحمد لله، مدلل في وزارة الثقافة، أصحابك يحبونك. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا أقول أنا الذي خسرت كلّ شيء؟»[12]
—–
سوف أسمي هذا الكتاب: الكتاب الأسود. ذلك أنه فعل احتجاج وحرد على الدنيا، وثورة ترشق الأقدار الغاشمة بالفضيحة.
لكنه كتاب لا يخلو من اخضرار يانع: ثمة أيام وأسماء ووجوه حلوة لا مرارة فيها ولا قتامة.
حكاياتي الصغيرة مع أبنائي نور ومنيف وكندة وآية. علاقتي بعمر. غزلي بثلاث سيدات.
صداقاتي. أمي. إلخ، إلخ إلخ.[13]
-
الهوامش
[1] منهم: سعود قبيلات، هاشم غرايبة، سميحة خريس، الراحل إلياس فركوح. وجعفر العقيلي.
[2] بحسب الروائية سميحة خريس التي اطلّعت على هذه الأوراق، مجلّة ثقافات، عدد 3، 1 تموز 2002. ص 105.
[3] مؤنس الرزاز مجلّة أفكار، عدد 301 شباط 2014، ص 98.
[4] مؤنس الرزاز، مقتطع من السيرة الجوانيّة نقلها جعفر العقيلي الذي اطلع عليها، وكتب عنها بمجلّة أفكار عدد 301 ص 97.
[5] نشر هذا النص في العدد 301 من مجلة أفكار، الصادر في 2014.
[6] نشر هذا النص في العدد 161 من مجلّة أفكار، الصادر عام 2002.
[7] نشر هذا النص في العدد 158 من مجلّة أفكار، الصادر عام 2001.
[8] هذا النص منشور في العدد 3881 من جريدة القدس العربي، الصادر عام 2001.
[9] هذا النص منشور في العدد 3 من مجلّة ثقافات، الصادرة عام 2002.
[10] هذا النص منشور في العدد 3881 من جريدة القدس العربي، الصادر عام 2001.
[11] هذا النص منشور في العدد 3881 من جريدة القدس العربي، الصادر عام 2001.
[12] هذا النص منشور في العدد 3967 من جريدة القدس العربي، الصادر عام 2002.
[13] هذا النص منشور في العدد 3881 من جريدة القدس العربي، الصادر عام 2001.