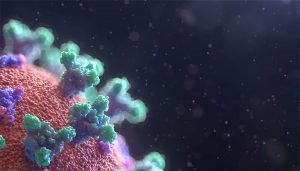الرياح تهب نحو ألمانيا، ولا يسمحون للأطفال باللعب بالخارج في فرانكفورت.[1]
يتحدث مسلسل «تشرنوبل»، ذو الإنتاج الأمريكي والبريطاني، عن حادثة مفاعل تشرنوبل النووي في عام 1986، كيف تم التسبب بها وكيف تم التعامل معها. يقوم المسلسل في جزء كبير منه على كتاب «أصوات من تشرنوبل» للكاتبة سفيتلانا أليكسافيتش التي جمعت شهادات من سكان مدينة «بريبيات». يركز المسلسل على أربع قصص: قصة عالم وسياسي يقومان بإدارة الكارثة ومنعها من التفاقم، وقصة عائلة رجل إطفاء يتعرض لكميات قاتلة من الإشعاع، وقصة عالمة تسعى لكشف الحقيقة وراء الحادث، وقصة قصيرة عن ثلاثة جنود سوفييت يشاركون في عمليات التنظيف والتطهير في فترة ما بعد الكارثة.
ليس هنالك أي شك في قيمة مسلسل كعمل روائي، فالتمثيل الجيد واختيار القصص بعناية (وكأن المسلسل مجموعة من القصص القصيرة) والتركيز على وطأة معاناة الضحايا وأقربائهم والأثر الأكبر للكارثة بالنسبة إلى الأمة السوفيتية جعل هذا العمل قويًا من دون شك. إلا أنه جودة المسلسل لا تغني عن معرفة السياق السياسي والاجتماعي والثقافي الذي تم إنتاجه فيه، فمن المستحيل في تلك السياقات، سواء أكان العمل من إنتاج غربي أم روسي أن يكون نقيًا من السرديات المسيّسة المناسبة للمنتجين والجمهور. فمجرد قيام شركة غربية أمريكية أو بريطانية بإنتاج عمل عن حادثة تشرنوبل، هو بحد ذاته عمل سياسي يماثل قيام شركة روسية أو صينية إنتاج مسلسل عن القصف الذري الأمريكي لليابان.
ليس مسلسل «تشرنوبل» الأول من نوعه، ففي عام 2002 صدر فيلم «K-19 The Widow Maker» الذي يحكي قصة حادثة على متن غواصة نووية سوفيتية في عام 1961 عندما تعطل نظام تبريد المفاعل النووي في الغواصة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 28 من البحارة الذين حاول بعضهم إصلاح المفاعل بحيث تعرّضوا إلى التسمم الإشعاعي . يظهر الفيلم في نهايته كيف تم منع الضحايا وعائلاتهم من الحديث عن تلك الحادثة وكيف تم إهمالهم ورفض منحهم ميداليات «أبطال الاتحاد السوفيتي»، لأنها لا تعطى إلا للمقاتلين القدماء. وفي عام 2018 صدر فيلم «Kursk» والذي يتحدث عن حادثة غرق غواصة نووية روسية أخرى في عام 2000 أي في حقبة ما بعد الشيوعية. ركز هذا الفيلم بالذات على رفض الروس للمساعدة الغربية في إنقاذ أفراد طاقم الغواصة، الذين توفوا جميعًا بسبب نفاد الأكسجين من الغواصة العالقة في قعر البحر.
هنالك جانب سياسي في هذا النوع من المسلسلات والأفلام (المبنية على أحداث حقيقية) يتحدث عن «عدم فعالية» النظام السوفيتي أو عن «الهيمنة الروسية» على الدول المحيطة، خاصة بعد أحداث أوكرانيا عام 2014. يتجلى ذلك جيدًا في مسلسل «تشرنوبل» من خلال نقطتين؛ الأولى هي كيف جعل رجال السياسة ومتخذو القرار أمن السكان وصحتهم وحياتهم في أسفل قائمة أولوياتهم، والثانية هي كيف تمت التغطية على أسباب الحادث التي لا تتعلق فحسب بإهمال القائمين على إدارة المفاعل بل إهمال الدولة التي صادقت على التصاميم التقنية للمفاعل قبل عقد من الحادثة رغم تحذيرات العلماء. تركز الحلقتان الأخيرتان في المسلسل على محاولة كشف الحقيقة ونقلها إلى الوكالة الدولية للطاقة الغربية في مدينة فيينا، أي إلى العالم الغربي.
الدعاية السياسية في «تشرنوبل» القائمة على انتقاد أنظمة الحكم غير الغربية وغير الليبرالية ليست السمة الوحيدة البارزة في العمل. فهنالك جانب ثقافوي في مثل هذا الإنتاج الذي ركز على صفة جوهرانية نرجسية في الثقافة السوفيتية والثقافة الروسية هي الهوس بالنصر والرهاب من الهزيمة والإذلال. هذا الجانب أضعف العمل وضمه لقائمة كبيرة من الإنتاجات الثقافية الغربية من الأفلام والمسلسلات والكتب التي تتحدث عن الطاقة النووية والسلاح النووي من جهة، وإهمال «غير الغربيين» لقيمة الحياة الإنسانية من جهة أخرى.
تاريخ الآخر النووي
هذا الشعور بالقلق في الثقافة النووية الغربية على حياة «غير الغربيين» من الإدارة المهملة والقمعية من قبل «غير الغربيين» أنفسهم كان قبل نهاية الحرب الباردة خوفًا من هذا الآخر. ففي عام 1949 نجح السوفييت في تجربة قنبلتهم الهيدروجينية الأولى. عندها، استطاع الآخر «غير الغربي» أن يصبح خطرًا لا على نفسه فقط بل على غيره وعلى قلب المعسكر الغربي و«طريقة الحياة» الغربية. أدى ذلك إلى حدوث تغيرات جذرية في الثقافة الشعبية الغربية وخاصة الأمريكية بتفشي «الخوف الأحمر» و«المكارثية» و«البارانويا من القنبلة»، بل وانتشار ظاهرة العقارات والبيوت التي تباع مع ملاجئ مضادة للهجمات النووية.
مجرّد قيام شركة غربية أمريكية أو بريطانية بإنتاج عمل عن حادثة تشرنوبل، هو بحد ذاته عمل سياسي يماثل قيام شركة روسية أو صينية إنتاج مسلسل عن القصف الذري الأمريكي لليابان
بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، تغير مصدر التهديد وأصبح هنالك شبه إجماع بين السياسيين والمثقفين والأكاديميين والصحفيين في الغرب على عدم التعايش مع فكرة انتشار السلاح النووي في العالم الثالث وخاصة في العالم الإسلامي.[2] عبّر كينيث ألدمان، أحد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عن تلك العقلية بقوله «إن الخطر الحقيقي يأتي من دولة عالم ثالث كئيبة ما تقرر استخدام تلك الأسلحة بسبب يأسها أو همجيتها».[3] الهيستيريا السياسية والإعلامية في الغرب حول البرنامج النووي العراقي العسكري كانت أحد أبرز الأمثلة على ذلك، مع أن السبب الأساسي وراء تطوير صدام حسين لذاك البرنامج كان هجوم سلاح الجو الإسرائيلي على «مفاعل تموز» ذي الاستخدامات السلمية في عام 1981. تلك الهستيريا الإعلامية كانت أحد أسباب حصار العراق والذي استمر حتى الغزو في عام 2003 بذريعة امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
أما بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، فقد عبّر بوضوح عن التحول في مصدر التهديد النووي ضد الغرب من الآخر الشيوعي إلى الآخر الإسلامي في كلمته لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012: «هنالك الذين يؤمنون أنه بإمكان ردع إيران المسلحة بالنووي كما تم ردع الاتحاد السوفيتي. هذا افتراض خطير، الجهاديون العسكريون مختلفون عن الماركسيين العلمانيين. ليس هنالك انتحاريون سوفييت، لكن إيران تنتج قطعانًا منهم. الردع نجح مع السوفييت، لأنهم في كل مرة واجهوا فيها خيارًا بين أيدولوجيتهم ونجاتهم اختاروا النجاة».
تمخضت عن الثقافة النووية الغربية عدة أفلام في حقبة ما بعد الحرب الباردة وما بعد الحادي عشر من أيلول، مثل فيلم الحركة الكوميدي «True Lies» والذي يتحدث عن منظمة إرهابية تدعى بمنظمة «الجهاد الدموي» تهدد بتفجير عدة رؤوس نووية في عدد من المدن الأمريكية ما لم تنسحب القوات الأمريكية من الخليج العربي/الفارسي. كذلك ظهر فيلم «The Sum of All Fears» المبني على رواية خيالية من كاتب الروايات العسكرية الأمريكي المحافظ والمحب للحروب توم كلانسي الذي يتحدث عن سقوط طائرة إسرائيلية تحمل قنبلة نووية في الجولان (الفيلم ليس دقيقًا البتة فقد تم تصوير الجولان وكأنه منطقة صحراوية) حيث عثر عدد من البدويين على القنبلة وباعوها إلى منظمة إرهابية تستخدم القنبلة النووية في محاولة لإشعال الحرب بين روسيا والولايات المتحدة. وكذلك الموسم الثاني من مسلسل «24» والذي تمحور حول خطة معدة من قبل تنظيم إسلامي لتفجير قنبلة نووية في مدينة لوس أنجلوس. أما فيلم «The Dictator» من تمثيل الصهيوني ساشا بارون كوهين فهو الأسوأ في هذا المجال بتصويره البرنامج النووي العسكري لإحدى الدول الشرق أوسطية المتخيلة بطريقة كوميدية واستشراقية ومهينة عندما ينشب خلاف بين الديكتاتور والعلماء حول أيهما أفضل الرأس النووي المدبب أم الرأس النووي الدائري.
الأبارتهايد النووي العالمي[4]
لا يمكن بالطبع فهم السياق الثقافي من دون فهم السياق الدولي السياسي والقانوني، وكيف يؤثر كل منهما في الآخر. إن منظومة منع الانتشار النووي الدولية (التي أنشأتها معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1968)، قسمت العالم إلى خمسة أقسام:
- الدول النووية الخمس المعترف بها في معاهدة منع الانتشار النووي (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا).
- الدول الحائزة على الأسلحة النووية (إسرائيل، باكستان، الهند). البعض يضيف كوريا الشمالية بسبب الخلاف القانوني على الانسحاب من المعاهدة من عدمه.
- الدول المحمية في مناطق مظلات ردع نووية (دول الناتو، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية).
- الدول الواقعة في مناطق خالية من السلاح النووي (منطقة معاهدة تلاتيلولكو في أمريكا اللاتينية والكاريبي، منطقة معاهدة بيليندابا في إفريقيا، منطقة معاهدة آسيا الوسطى، منطقة معاهدة جنوب شرق آسيا).
- المناطق الموجودة في أسفل هرم منظومة عدم الانتشار الدولية. تلك المناطق غير خاضعة لا للحماية المادية الرادعة ولا للحماية القانونية (الشرق الأوسط، شرق أوروبا).
هذا التمييز لا يتعلق فحسب بامتلاك الأسلحة النووية والقدرة على الردع من عدمه، بل له تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية بما يشمله من حرمان لدول العالم الثالث من الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والتطبيقات الطبية والزراعية والصناعية والبحثية للمواد النووية والإشعاعية، وكذلك حصار الدول المشكوك بامتلاكها برامج عسكرية، ووضع معايير قاسية على الصادرات والتجارة.
في تموز من العام 2017، وفي محاولة لتغيير نظام منع الانتشار التمييزي تبنّت دول العالم الثالث، بما يشمل مجموعة الدول العربية، معاهدة حظر الأسلحة النووية (وهي أول معاهدة تحظر تملّك الأسلحة النووية واستخدامها والتهديد باستخدامها بحيث تلتزم بها جميع الدول من دون تمييز، بعكس معاهدة منع الانتشار). إلا أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الغربية أعلنت، منذ آذار 2017، مقاطعتها لجلسات مفاوضات على المعاهدة ورفضها للانضمام. عبرّت نيكي هيلي، السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن ذلك الرفض عندما قالت: «نحن نود حظر الأسلحة النووية، لكن في هذا اليوم والوقت، لا نستطيع بصراحة أن نقول بأننا نستطيع أن نحمي شعبنا بالسماح للفاعلين الأشرار بالحصول على هذه الأسلحة وبمنعنا نحن الطيبين الذين يحاولون العيش بسلام من امتلاك تلك الأسلحة. (..) كأم، كابنة، ليس هنالك شيءٌ أريده لعائلتي أكثر من عالم خالٍ من الأسلحة النووية، لكن لنكن واقعيين، هل هنالك أي شخص يعتقد أن كوريا الشمالية ستوافق على حظر الأسلحة النووية؟».
إذن، فالخطاب الاستعلائي الأخلاقي الغربي بشأن التكنولوجيا النووية سلميّة كانت أم عسكرية هو خليط من الخوف من الآخر «غير الغربي» والخوف على هذا الآخر من نفسه وعلى مصلحته. الروس والشرق أوروبيين غير كفؤين ومهملون وخانعون للمركزية البيروقراطية والتفكير الجماعي (إلا بعض الأفراد المتنورين المهمشين كما جاء في المسلسل)، والعرب والمسلمون خطيرون وعنيفون وخانعون للقبيلة والمؤسسة الدينية، وكلّ هؤلاء من شرقيين وجنوبيين لا يقدّرون قيمة الحياة الإنسانية والحرية والفردانية.
في النهاية، إن الثقافة النووية الغربية هي جزء من الثقافة الغربية بمعناها العريض. وكما أشار جوزيف مسعد في كتابه «الإسلام في الليبرالية» فإن الغرب يقوم بعملية نفسية يسقط فيها الاستبداد على الآخر «غير الغربي» ليظهر بأنه ديمقراطي ومتحرر، ويسقط إهمال قيمة الحياة الإنسانية والكراهية والعنصرية والعسكرة على الآخر، مع تجاهلٍ تامٍ لحوادثه وكوارثه (مثل حادثة مفاعل فوكوشيما في اليابان والتحضيرات الرديئة لإعصار كاترينا في الولايات المتحدة) وتجاربه النووية (في الجزائر وفي جزر المارشال) وحروبه على الآخر (واستخدامه للأسلحة الذرية في هيروشيما وناغازاكي) ومع تغاضٍ تامٍ عن حقيقة أن الثقل العالمي للقوة الاقتصادية والعسكرية والنووية موجود لديه.
في حال أخرجنا مسلسل «تشرنوبل» من سياقه السياسي والثقافي والدولي المذكور في هذا المقال، فسنرى أنه هدية فريدة من نوعها إلى عالم التلفزيون (الذي انقطعتُ عنه طويلًا). ولا ينبغي نفي سردية المسلسل أو الامتناع عن مشاهدته، بل من الضروري الرجوع لاستكشاف مثل تلك القصص، خاصة تلك التي تحذر من خطر السلطوية وكوارثها. لكن علينا في الوقت نفسه الفصل بين الثقة في جودة الإنتاج الثقافي الغربي والثقة في مضمونه، بدلًا من الاقتناع الساذج بأن «Netflix» أو «HBO» هما البديل الثوري الذي فك أخيرًا عقدة فهمنا كآخر.
-
الهوامش
[1] من مسلسل «تشرنوبل»، الحلقة الثانية، في مشهد يظهر مقارنة بين حرص الدول الغربية البعيدة على حماية أطفالهم من تداعيات الكارثة بينما تفشل سلطات الاتحاد السوفيتي حتى في إخلاء مدينة «بريبيات» القريبة من محطة الطاقة النووية وذلك بسبب عزلهم للمدينة وحرصهم على عدم انتشار معلومات عن الحادثة.
[2] Hugh Gusterson. Nuclear Weapons and the Other in the Western Imagination. Cultural Anthropology
Vol. 14, No. 1 Feb., 1999, pp. 111-143.[3] ibid.
[4] Shane J. Maddock. Nuclear Apartheid: The Quest for American Atomic Supremacy from World War II to the Present. 2010. University. of North Carolina Press.