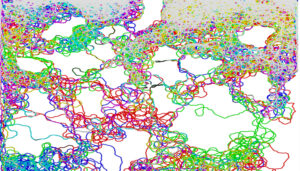أحدث الفنانان السوري هراير سركيسيان والفلسطينية أحلام شبلي في السنوات الأخيرة نجاحًا واسعًا. وما يربطهما هو الوسط المستخدم في عدد كبير من أعمالهما: الفوتوغرافيا. يعمل الفنانان من خلال عكس الشخصي والذاتي والذكرى على السياسي والعام عن طريق الصورة، سواء ثابتة أو متحركة، ووسائط أخرى أحيانًا كالأعمال التركيبية. يقتنصان القصص والتفاصيل التي ينساها التاريخ ويتغاضى عنها، ويظهران للعيان صورًا أقرب؛ صورًا من داخل الحدث، ضاعت وأُهملت بالتركيز على الصورة الكبرى والبروباغاندا السياسية. إنهما يظهران ما لا يبث في نشرات الأخبار، ما لا يراه الصحفي الحربي جديرًا بالنشر، في عصر الصورة الإعلامية التي تتغذى على الصدمة والدموية واستاطيقا الموت.
شبلي وسركسيان، اللذان تُعرض أعمالهما حاليًا في دارة الفنون في عمّان، يعملان خارج هذه الدوامة، وخارج قواعد الإبهار والمشهدية. يعملان بجد وببطء وبثبات، على إيصال السياسي، بل وإجبار فهم السياسي، دون إراقة قطرة واحدة من الدماء. إنهما لا ينقلان الصورة/الحدث للمشاهد، بل على النقيض، ينقلان المشاهد إلى مكان الحدث، أو بالأحرى، ينقلان المكان إلى مكان آخر، إلى الغاليري، حتى يغدو العمل بوابة سحرية تنقل المشاهد من مكان عرض العمل إلى مكان إنتاجه.
رحلة في البحر المتوسط: «أفق»
في عمل هراير سركيسيان، «أفق»، وهو فيديو تركيبي من قناتين (6 دقائق و58 ثانية) يعرض في غرفة معتمة في المبنى الرئيسي للدارة، يأخذ سركيسيان المشاهد في رحلة حقيقية، عبر تصويره لإحدى رحلات الموت التي يقوم بها اللاجئون السوريون الهاربون من الحرب في زوارق المتوسط. هذه الرحلة تعد من أقصر الطرق التي يسلكها اللاجئون وتصل بين شواطئ تركيا وجزيرة ماغيستي جنوب شرق اليونان. صور سركيسيان هذه الرحلة المرعبة بتقنية الكاميرا الطائرة (Drone). يجلس المشاهد في الغرفة ويتابع الرحلة منذ بدايتها في عرض البحر، يتخيل نفسه في مقدمة زورق، ولا اتجاه لينظر له سوى الأمام؛ سوى الأفق، هو الأمل وهو العذاب في الوقت ذاته. يبحر الزورق، ويتوه الرائي في ظلام موجات البحر الممتدة، والخالية من علامات يهتدى بها. لحظات ثقيلة من الانتظار والتوجس، والأمل وانقطاعه. اتساع البحر وعدم فهمه يؤجج لدى من يركبه مشاعر وذكريات متلاطمة. إنه فرصة إجبارية لمراجعة النفس، ومراجعة الماضي، وتخيل المستقبل. إنه اللامكان، وفي اللامكان كل الأفكار والأسئلة تغدو ممكنة.
مَنْ إذا التقاني مطلعَ الصبح
سيسكبُ رمادي في البحر المجنون؟
مَنْ سيأتي الآن
لينحرَ ثعبانَ انتظاري الضخم؟
أيُّ صوتٍ سيدثّرني بفرائهِ الناعم؟*
هذه الصدمة الثقيلة من الذكرى والشرود في عرض البحر، تنقطع فجأة حين تتراءى لنا جزيرة من بعيد، أي حين وصولنا نهاية الفيديو بالاقتراب من الشاطئ. تصل كاميرا سركيسيان ونصل نحن معها البر، بعكس الآلاف ممن غرقوا بأفكارهم ومخاوفهم، وأسئلتهم، وبماء المتوسط.



هراير سركسيان، «أفق»، 2018. في دارة الفنون. الصور عن موقع Universes in Universe.
احتلال: كيف يبدو المكان المستعمر بعد خطوط الخريطة؟
في سلسلة من 32 صورة لأحلام شبلي، التقطتها في مدينة الخليل، تظهر المدينة كفراغ عمراني وحضري، يتأثر بالسياسي والاستعماري، بحيث يخترع سكان المدينة طرقًا لحماية منازلهم وحاراتهم وبيوتهم من الهجمات والاعتداءات المستمرة، عن طريق وضع الأسيجة، والحمايات الفولاذية، والشبك، وغيرها من الوسائل التي تجعل الفلسطيني يخلق عسكرةً ذاتية دفاعية لعمارته في وجه العسكرة الاستعمارية. إنها الاضطرار لعسكرة الحميمي والخاص والآمن المفترض؛ البيت.
يظهر في سلسلة صور شبلي الفوتوغرافية تراكم الزمن الاستعماري. صورها تبدو هادئة، صامتة، لكنها تحوي طبقات من العنف الاستعماري المتجذّر في المدينة. في إحدى الصور الفوتوغرافية نرى درجًا معدنيًا في روضة أطفال مغطى بشبك حديدي للحماية. نحن لا نرى الأطفال، ولا نرى المستوطنين، ولا نرى الحدث، لكن مخيلتنا ستسمح تمامًا برؤية مشهد إلقاء حجارة على الأطفال من قبل المستوطنين الذين يحتلون المدينة ويسكنونها ويقسمونها ويقطعون أوصال شوارعها، ويخترعون حارات لهم، وينتزعونها من جسد المدينة الكلي، مما استدعى وجود هذا الشبك الحديدي في المقام الأول.
في إحدى الصور أيضًا نرى كشافات وكاميرات داخل مبنى ديني. يقول بارت في كتابه «الغرفة المضيئة» إن ما يجعل الصورة الفوتوغرافية مثيرة للاهتمام هو تزامن عنصرين متضادين متنافرين في آن، وهو ما نراه في سلسلة شبلي؛ التضاد بين المكشوف والحميمي، بين العنيف والآمن، بين العسكري والمُعسكَّر. إنها ما تبدو عليه الحياة اليومية فعلًا، وراء الخريطة المقطعة بجيوب تحوي مستوطنات داخل المدينة، ووراء كلمات النشرات الإخبارية وعناوين الصحف والتقارير الدولية.



أحلام شبلي، «احتلال»، 2018. في دارة الفنون. الصور عن موقع Universes in Universe.
تأتي صور شبلي الـ32 في أحجام مختلفة، تتراوح بين الحجم الأصغر (26.5 سم * 40 سم) إلى الحجم الأكبر (100 سم * 150 سم). تتلاعب شبلي بالحجم حسب نوع الصورة وكيفية تأثيرها على الرائي. فمثلًا، نجد بعض الصور الحميمية من داخل البيوت بأحجام صغيرة، وهي دعوة من شبلي للانضمام لهذا الفراغ الخاص والتدقيق فيه، دون اقتحامه. بينما نجد صورة فوتوغرافية بأكبر حجم، يظهر فيها منظور عريض من نقطة واحدة (one point perspective) لأحد شوارع الخليل، الذي يبدو مغلقًا بمكعبات إسمنتية. حجم الصورة وموضوعها، وحتى الارتفاع الذي ثبتت فيه في الغاليري، يجعل المُشاهد ينتقل إلى هذا الشارع، عبر بوابة انتقال مكاني خلقتها شبلي.
الصورة كسكين مسلط على نحر المهمل
بالرغم من أن الكاميرا بشكلها الأولي الذي انتشر بشكل محدود بين الناس اختُرعت عام 1839 على يد فوكس تالبوت، إلا أن أولى الصور التي التقطت ووصلت لنا تعود إلى التاريخ 1827 تقريبًا. بعد اختراع ما يمكن أن يطلق عليه كاميرا بحق عام 1839، كانت الكاميرا معظم الوقت أداة في يد النخبة، وانحصر استخدام الصور الفوتوغرافية حينها في ملفات الشرطة، وتقارير الحروب، والفن الإباحي، والتوثيق الموسوعي أو الأنثروبولوجي، وبطاقات البريد، وبشكل ضيق في الألبومات العائلية. بقيت الكاميرا محصورة الاستخدام، حتى اختراع الكاميرا الرخيصة وانتشارها، مرورًا ببدايات شركة كوداك وأفلامها على نطاق واسع بعد عام 1888، ومن ثم بدايات إنتاج كاميرات تعمل بأفلام 35 مم، بين الأعوام 1905 و1915، حيث أحرزت كاميراتي Tourist Multiple وSimplex مبيعات هائلة في هذه الفترة.
ساهم هذا التغيير في دمقرطة التصوير في الاقتصادات الرأسمالية بعيدًا عن الفنون الجميلة التي كانت حكرًا على مرتادي مدارسها وفنانيها، وأصبح التصوير نوعًا من الفن الذي يمكن للجميع تقريبًا ممارسته، وتراه في الألبومات العائلية الخاصة، وتجارب الهواة. ولم تعد فكرة إنتاج الصورة محصورة على المؤسسة، أو المصور، بل أصبح الشخص العادي أيضًا منتجًا للصورة، يلتقط الصور أثناء السياحة، وصورًا تذكارية، عائلية، وغيرها، وربما يبيعها. فبانتشار الكاميرا، لم يعد هذا الشخص مستهلكًا للصورة فقط من مصادرها، كالصحف. وقد وصف جون برجر هذا التغيير قائلًا إن الفوتوغرافيا أصبحت وسيطًا مناوئًا للرأسمالية وللفن المحتكر أو المقترن بالمهارة والموهبة، كفن اللوحات الزيتية في القرن السابع عشر. كان هدف اللوحة حينها تخليد اللحظة؛ إيقاف الزمن، وترك أثر خالد يدل عليه. إنه تسجيل للحياة والموت. لكن الكاميرا أتت بعد ردح من الزمن، لتسمح تقريبًا لأي شخص بالتقاط وتسجيل موتنا وحياتنا على الأرض. إن للتصوير بعدًا وجوديًا عميقًا، وإن لم يكن المصور واعيًا له.
لكن قبل الانتقال للحديث عن التصوير اليوم، علينا أن ننتبه إلى أن انتشار الكاميرا على نطاق واسع جرى بالأساس بمساعدة إحدى أذرع النظام الرأسمالي، وهو إنتاج السلعة على نطاق واسع (mass production) وبسعر ملائم، حتى انتشرت بين أيدي العامة. نعيش اليوم في عصر الصورة، ويمكن القول إن التصوير الفوتوغرافي هو أحد أبسط وأدق وأسرع الطرق في نقل وتجميد حدث ما، وأكثرها تأثيرًا في العامة. فالصورة الفوتوغرافية – كما الفيلم، وبعكس اللوحة – من الممكن أن تُجمع على فهمها والأثر الناتج منها مجموعة كبيرة من الناس، بينما لا يمكن دومًا أن نحصل على الأثر والمشاعر ذاتها من اللوحة نفسها. فاللوحة تسمح بالاجتهاد، وتسمح بإنتاج أنماط مختلفة من «الحقيقة» للرائي، بينما تسقط الصورة على رائيها كالموت، فهي تمثل «الحقيقة» لواقعيتها.
مع هذا الانتشار الهائل للصورة اليوم، وانتشار تطبيقات نشر الصور واللحظات، مثل إنستغرام وغيره، يبدو تساؤل «كيف للصورة الفوتوغرافية الفنية أن تحتفظ بسلطتها وأهميتها» تساؤلًا مشروعًا جدًا، خاصة وأن الصورة الفوتوغرافية كعمل فني، لم تفقد فقط أهميتها حين أصبح من الممكن إعادة إنتاجها ميكانيكيًا، كما حدث مع كل عمل فني آخر، بل أصبحت أهميتها في خطر أيضًا كونها تنتج أصلًا بأداة صممت للإنتاج الموسع والميكانيكي؛ بالكاميرا التي نستطيع بكبسة زر أن نحصل على آلاف النسخ الحقيقة والإلكترونية لصورة واحدة من صورها. إذا كان العمل الفني صورة رقمية، فإن رؤية الصورة من أي مكان على الإنترنت تعني رؤية العمل الأصلي حقًا، وليس صورة عنه، كما يحدث حين نرى صورة عن أي عمل فني نفذ بالأصل بوسيط آخر غير الفوتوغرافيا. لكن أهمية الصورة كعمل فني تكمن اليوم في مقدرتها على الابتعاد عن قواعد الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. أي أن أهميتها تأتي من ماهيتها، وليس وسيلة إنتاجها أو مكان عرضها. كما أن كونها مادة خام وغير معدلة يعطيها تميزًا في الفن المعاصر، الذي بات شديد النقاء من ناحية فكرته وطريقة إنتاجه الفيزيائية: أي صورته النهائية.
لقد قطعنا أشواطًا طويلة منذ مقال فالتر بنيامين الشهير «العمل الفني في عصر الإنتاج الميكانيكي». فاليوم، يمكن إنتاج وإعادة إنتاج كل شيء وفي كل مكان تقريبًا. فقد أصبح أيضًا بالإمكان إعادة إنتاج الواقع وخلقه ونقله في مكان آخر عبر تقنيات كالهولوغرام والواقع الافتراضي وغيرها. لذا علينا ألا نشغل بالنا كثيرًا بطريقة الإنتاج وعدد النسخ. هناك إحصائية من العام 2014 تقول إن العالم يرفع كل يوم أكثر من 1.8 مليار صورة على الإنترنت، أي أنه كل دقيقتين، تلتقط البشرية بالتقاط كمية صور تتجاوز في عددها مجموع الصور التي التقطت قبل 150 عامًا. هذا الانتشار الهائل والولع بالصورة جعلا أهميتها كعمل فني تتراجع أو تهمل. فمثلًا لم يعيّن متحف تايت المعاصر (Tate Modern Museum) قيّم معارض مختص بالفوتوغرافيا سوى عام 2009. ربما هذا ما جعل الفوتوغرافيا تجد طرقًا أخرى لتتسرب إلى حياة الناس بعيدًا أيضًا عن الغاليري. تأتي أهمية الفوتوغرافيا كطريقة ممتازة لنقل حقيقة أو فكر ما، لذا سنجد «فن فوتوغرافيًا» على إنستغرام، كما يمكن أن نجده في الغاليري.
إن الصورة، كعمل فني ناجح، ليست تلك التي هدفها الصدمة، أو التأثير العاطفي، أو المشهدية، بقدر قدرتها على خلق مساحة جديدة للتفكير، وفاصل للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي تهمل وتنسى بسبب سرعة الحياة وسرعة تدفق المعلومات. في هذه الفئة، نجد عملي شبلي وسركسيان الفوتوغرافيين. إنهما دعوة للرؤية عن كثب.
* من قصيدة للشاعر السوري جولان حاجي بعنوان «باب موارب».