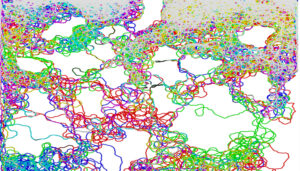من بين ردود الأفعال الوافرة التي أثارها فوز بوب ديلان بجائزة نوبل للأدب، تبرز إلى السطح تلك الأصوات التي أشارت إلى العلاقة التي تربط المغني الأمريكي بـ«إسرائيل»، ودفاعه عنها وعن حروبها، كما ظهر ذلك بارزًا في أغنيته «فتوة في الجوار» التي غنّاها أثناء غزو «إسرائيل» للبنان عام 1982. وقد أراد بعض من نبشوا في تاريخ ديلان المؤيد لـ«إسرائيل» تقديم تبريرات لفوزه بالجائزة، ومدى انحياز الجائزة سياسيًا وفق أجندات معينة تختار عبرها من يفوز ومن لا يفوز. وبعيدًا عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا الرأي، فإن ارتباط فنان كبير كديلان بدولة عنصرية كـ«إسرائيل» وتبريره لجرائمها يفتح نقاشًا من نوع آخر حول دور الفنون والآداب عمومًا في الارتقاء بالإنسان وأخلاقه وطريقة نظره إلى إخوته في الإنسانية، أيًا كانت أصولهم وأديانهم.
إذا انتقلنا إلى السياق الأردني، فقد ثارت في الأشهر الأخيرة نقاشات حادة ملأت الفضاء العام في الأردن حول تعديل المناهج الدراسية. وقد قدّم كثير من الداعين إلى تعديل المناهج فرضية مفادها أن المناهج في الأردن تخلو من الاهتمام بالنصوص الفنية والأدبية الكبرى التي تسهم في العلوّ بالطلبة إلى آفاق إنسانية فسيحة، وتبعدهم عن التطرّف والعنف وكراهية الآخر. الأدب بأنواعه المختلفة، والموسيقى، والفنون التشكيلية، والسينما وغيرها من الخطابات الجمالية تلعب دورًا أساسيًا، بحسب أصحاب هذا الرأي، في إذكاء روح الأنسنة في نفوس الطلبة، وتفتح أعينهم على معاني رحبة تشكل نقيضًا لكثير من النصوص التقليدية التي تمتلئ بها الكتب المدرسية في الأردن، دينيّة كانت أو اجتماعية. الفنون والآداب تصبح إذن وسيلة من وسائل الحماية الإنسانية التي قد تسهم، مع غيرها من العوامل، في إنتاج جيل أكثر تقبلًا وتسامحًا.
سأحاول في الفقرات التالية أن أبيّن اعتراضي على هذه الفرضية، وأكشف عن مدى اختزالها وتبسيطها، ليس فقط لأسباب التطرف والعنف التي تشكل بالطبع قلقًا كبيرًا في الأردن كما في غيره من بلاد العالم، ولكن أيضًا لطبيعة الفنون والآداب وأثرها المزعوم في تقليل ميل الإنسان إلى الكراهية والعنف ورفض الآخر. وسأعتمد بداية على طرح العلاقة المشار إليها أعلاه بين ديلان و«إسرائيل». هل تشكّل الفنون والآداب حقًا رادعًا أمام نزعات العنصرية والكراهية التي تنتشر بين كثير من الناس؟ كثيرًا ما يصدم محبو فنان أو كاتب ما حين يكتشفون آراءه السياسية والاجتماعية وما فيها من اعتقادات كانوا يتخيلون أن طبيعته، كفنان وأديب، بعيدة كل البعد عنها. كيف يمكن لشاعر يكتب عن الحب والقلق والفقر والبؤس، أن يكتب، في الوقت ذاته، مديحًا في حرب شرسة أو تبريرًا لقتل أبرياء أو حتى دعوة صريحة للعنف والدم؟ هل ديلان الذي غنّى لـ«إسرائيل» هو نفسه ديلان الذي غنّى أغانيه الاجتماعية الشهيرة في حركة حقوق الإنسان الأمريكية في الستينيات؟
تقوم مثل هذه التساؤلات على نظرة رومانسية مثالية للفنون والآداب، وتفترض علاقة ميكانيكية مباشرة بينها وبين الابتعاد عن كل ما يسبب الدمار والكراهية للآخرين. تصبح الفنون والآداب في هذه النظرة جسرًا يعبر عليه البشر من مرتبة إلى أخرى أكثر رقيًا، وترياقًا يحميهم من الانزلاق نحو التوحش والتحيّز ضد الآخر. لكن نظرة واحدة إلى حياة الفنانين والأدباء والمجتمعات التي ازدهرت فيها الفنون، سيما في العصر الحديث، كفيلة بالكشف عن الخلل الذي تحمله هذه النظرة. البريطانيّون الذين كانوا يحتلون العالم ويفتكون بالشعوب وخيراتها هم نفسهم الذين كانوا يذهبون في مساءاتهم إلى المسارح الشكسبيرية ويقرؤون جين أوستن وديكنز وكوليردج، وأمريكا العنصرية ضد السود في القرن الماضي هي أمريكا فوكنر وهيمنغواي وهوليوود، وألمانيا النازية كانت تقدس موسيقى بيتهوفن وفاغنر. كيف يمكن لهذه «النقائض» أن تجتمع؟
الحقيقة أن هذه ليست نقائض، واجتماعها في شخص أو مجتمع واحد لا يجب أن يثير استغرابًا. لنعترف بداية أن العدالة وجهة نظر، وأن ما تراه حقًا هو ذاته ما يراه عدوك باطلًا. هذه حقيقة إنسانية مؤسفة، لكنها أمر واقع لا فرار منه. المجتمع الذي يبكي لمشاهدة أفلام كازابلانكا وذهب مع الريح ويحتفل، في الوقت نفسه، بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما لا يرى في حالته ابتعادًا عن المثال الأخلاقي الذي كان يجب للفنون أن تقوده إليه. على العكس تمامًا، فإنه يرى أنه يمارس حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه وعن وطنه، والحرب التي تبدو للبعض استعمارًا قد تبدو للآخر حاجة أخلاقية لإصلاح أخطاء هذا العالم.
الشعر ليس حقنة نضعها في الطلاب لنخرج منهم بشرًا أكثر محبة للعالم.
ثمة أمر آخر أكثر وضوحًا. الفنون والآداب ذاتها لم تزدهر، على مدى التاريخ، كما ازدهرت وسط حاضنة العنف والحرب التي كان البشر يخوضونها ضد بعضهم. ما هي الإلياذة والأوديسة إن لم تكن غناء للحرب؟ لنلق نظرة فقط على شعر المعارك عند العرب. تشكل قصيدة أبي تمام الأسطورية «فتح عمورية»، إحدى أعظم قصائد الحروب التي تغنّى بها العرب إلى عصرنا الحالي، وهي في بعض أبياتها تصل إلى درجة التلذّذ بمرأى الدماء والقتل الذي وقع للروم على يد جيش المعتصم. هل كان أبو تمام يرى في نفسه داعية للعنف والكراهية حين نظم هذه القصيدة (المدهشة بكل المقاييس، بالمناسبة)؟ أغلب الأناشيد الوطنية في العالم الحديث تدعو للقضاء على ما يسمى بالأعداء، والفرنسيون تحديدًا ينادون في نشيدهم «إلى السلاح أيها المواطنون» على وقع موسيقى أخّاذة. أيّ ابتعاد عن العنف هذا الذي تساهم فيه الفنون؟
ماذا عن الفنانين والأدباء أنفسهم؟ النظرة الحالمة لهذه الفئات من البشر تتجاهل أن الفن والأدب نوع من التطرف، بالمعنى اللغوي للكلمة. الفنان والأديب يمتازان عادة بحدة عاطفية تدفعهما إلى أقصى الحالات الإنسانية في رؤيتهما للأشياء. الحب يصبح قرينا للفناء، والوطن إلهًا من نوع خاص، والكراهية، بالضرورة، حقدا وغلّا شديدين. والفنان، في كل حالاته العاطفية، يصدر من الذات نفسها التي تستطيع أن ترى في الأشياء ظلالًا قد لا يستطيع غير الفنان أن يعبّر عنها. يمكن للشاعر، الذي يعتقد مثلا أن عِرْقه أو دينه أو وطنه أعلى شأنًا من غيره، أن ينتج نصًا رائعًا، ومليئًا، في الآن نفسه، بعنصرية وكراهية بغيضة.
الآداب والفنون، برأيي، عنف من نوع خاص. عنف ضد الحقيقة التي تمقتها الفنون والآداب وتسعى إلى تحويلها إلى مجازات. الشاعر يمارس عنفًا نحو اللغة ذاتها، بحرفها عن معانيها الأصلية، وإجبارها على أن تقول ببراعة ما لا تقوله عادة، والفنان التشكيلي يمارس عنفًا ضد اللون نفسه، وأشكال البشر، ومظاهر الطبيعة. الفنون والآداب هي رفض البشر أن يظلوا صامتين، عن طريق «فرض» صوتهم ولونهم وشخصياتهم على الحياة رغمًا عنها. وكلما ازداد الفن «عنفًا» مع مادته الخام التي يشتغل عليها، ازدادت فرص خلوده وبقائه.
من يرى أن زيادة نسبة الفنون والآداب في المناهج الأردنية سيقلل من ميول العنف لدى الطلبة عليه أولًا أن يعرف معنى العنف الذي يسعى إلى إزالته. الشرطة التي تقتحم وكرًا للمجرمين وتطلق الرصاص عليهم هي، بمعنى ما، تمارس العنف والكراهية. والجيش الذي ينشأ على تقديس الوطن وسحق أعدائه يعيش للعنف وعبره طوال حياته. هل يدخل هذا ضمن العنف المدان الذي نريد حماية طلبتنا منه؟ أعرف أن هذه قد تبدو أسئلة بلاغية يسهل الجواب عليها، وأدرك أننا حين نتحدث عن العنف في الأردن فإننا غالبًا ما نقصد الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، لكن من يضع الحدّ الفاصل بين عنف وآخر في نفوس الطلبة؟ وإذا كان البعض يؤمن أن هناك عنفًا مبررًا وآخر غير مبرر، فما شأن الفنون في ذلك؟
الفنون والآداب ضرورة إنسانية، وطاقة جمالية مدهشة، لكن لا علاقة لها بما يسمى بالارتقاء بالإنسان بعيدًا عن العنف وشيطنة الآخر وكراهيته. قد تقتل وأنت تستمع إلى موزارت، وقد تكون عنصريًا في ذات الوقت الذي تبكيك فيه أغاني عبد الحليم حافظ. وسينما تارانتينو وكوراساوا وفاسبندر، على روعتها، قد تشكل للبعض دليلًا عمليًا للذبح والانتقام والتخلص من الأعداء. ونحن نتناسى أن العنف بحد ذاته يستلزم خياًلا واسعًا، وأن من يقضي الشهور للتخطيط لعملية إرهابية يملك بالضرورة قدرة عالية على تصور سيناريوهات ووضع خطط وافتراض نتائج. الإرهاب والتطرف قضايا مرعبة حقًا، لكن الفنون والآداب آخر الأبواب لحلها. نضحك على أنفسنا إن اعتقدنا أن أمسيات الأوبرا والمسرحيات دواء ضد الكراهية، ونصف أدباء مصر وفنانوها برّروا العنف الذي حدث في ميدان رابعة العدوية عام 2013، فقط لأنه حدث ضد من يرونهم أعداء.
الإنسان أعقد من أن يكون حالة ميكانيكية، والشعر ليس حقنة نضعها في الطلاب لنخرج منهم بشرًا أكثر محبة للعالم. ليس هذا دفاعًا عن المناهج الأردنية أو دعوة لإبقائها على حالها، ففيها الكثير مما يستوجب التعديل، لكنه انتقاد لما أراه تجاهلًا للفيل في الغرفة وجريًا وراء حلول سهلة اختزالية لمشكلة معقدة كالإرهاب. الثقافة عامل بلا شك، لكنها أصبحت الهدف الأسهل للباحثين عن وصفة سحرية للشفاء مما نحن فيه. من يريد القتل سيقتل. على وقع نص ديني، أو قصيدة حب، أو لوحة فنية، سيقتل. لماذا؟ المؤكد أنه لا حضور الأدب في حياته، ولا اختفاؤه منها، سيقدمان الجواب المنشود.