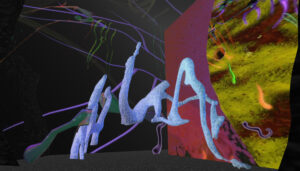تبدأ القصة في ألمانيا، وتحديدًا في «سنوات فايمار» التي استمرت من العشرينيات وحتى عام 1933، وسُمّيت نسبة إلى جمهورية فايمار التي قامت بين الحربين، واحتضنت، بالرغم من عدم ازدهارها سياسيًا ومعيشيًا، واحدةً من أهم فورات الثقافة الأوروبية في التاريخ الحديث. فقد ترافق انتهاء الحرب العالمية الأولى بنقلةٍ في الوعي الغربي، تجسدت بعشرات الحركات الفنية والفكرية التي حاولت البحث عن معنى جديد للحياة في أوروبا مدمرة ومبعثرة.
عام 1929، انفجر التأزم الاقتصادي بانهيار بورصة وول ستريت، وخلال بضع سنوات وصل الحزب النازي بزعامة هتلر إلى الحكم واعدًا الألمان بانتشالهم من مآسيهم. باختصار، يمكن القول إن السرعة التي هوت بها برلين من قطب للانفتاح والتعددية الثقافية إلى كابوس مفزع لم يعد اليوم نموذجًا مستغربًا بعد تكرره بدرجات مختلفة في عواصم عربية وعالمية.
عام 1933، تأسست وزارة النهضة الشعبية والبروباغاندا برئاسة غوبلز، أحد أقرب معاوني هتلر والمشرفين على «حماية الشعور الشعبي والوطني الألماني». في الفترة نفسها وُلد المصطلح (Entartete Musik) الذي يمكن ترجمته بالموسيقى المنحلّة، الفاسدة، أو المنحطة، وهي تهمة ضمّت أصنافًا شديدة الاختلاف من الموسيقى، جمعها مخالفتها للذوق الرسمي النازي.
لكن الفكرة ترجع إلى ما قبل ذلك، فعام 1850 نشر المؤلف الألماني فاغنر أطروحته اليهودية في الموسيقى، التي تعبق باحتقاره لليهود واعتبارهم عاجزين عرقيًا عن كتابة موسيقى جيدة. وخلال الثلاثينيات، جعل هتلر من فاغنر (الذي كان قد توفي) مؤلفه المفضل ورمزًا للموسيقي النازية، كما شكلت أوبراته التي تتناول مواضيع بطولية وملحمية، والمستوحاة غالبًا من الأساطير الجرمانية، نموذجًا عن اليوتوبيا الآرية المفقودة التي غذّت أكثر أحلام هتلر جموحًا.
عام 1937 افتُتح معرض الفن الفاسد في ميونخ، مُستعرضًا أعمالًا مُصادرة لفنانين حديثين، خصوصًا يهود، مرفقة بمقدمات استهجانية للتشهير بهم، ثم شهد العام التالي معارض مماثلة للموسيقى الفاسدة، وكان الانتقال من التشهير إلى التطهير سلسًا وعفويًا بفضل سنوات من الحقن الذي مارسته السلطات ليس فقط ضد الأقليات، بل ضد كل ما هو جديد أو مختلف.
كانت موسيقى الجاز الضحية الأولى، حيث ابتدأت ملاحقة العازفين ومصادرة التسجيلات، واستبدل الجاز في الإذاعات والمناسبات اليومية بما سمي «موسيقى الرقص الألمانية الجديدة»، وهي نوع من الجاز الحكومي المعقّم والمؤدى من قبل آريين حصرًا دون حماس زائد أو آلات «فاسدة» مثل الساكسوفون. وعام 1938، نال الجاز مرتبةً رفيعةً في معرض العار تحت اسم «الموسيقى الزنجية»، في إشارة إلى ما اعتُبر الهمجية والإباحية الناتجة عن دونية أصوله العرقية الإفريقية، والتي جرّت بدورها باقة التهم الأوتوماتيكية الأخرى مثل اليهودية والشيوعية.
أثناء سنوات فايمار، كان الجاز قد امتزج بباقي أنواع الموسيقى الخفيفة ليعيش مجده في الكاباريهات البرلينية، والتي كانت في العشرينيات منبرًا للنقد السياسي والاجتماعي الذي تميّز بسخريته السوداء، وبؤرة للحركات الثورية والتقدمية. وإن كانت الكاباريهات تشكل إزعاجًا للنازيين فإن المؤلف الموسيقي كورت فايل (1900-1950) رفع الإزعاج إلى مستوى الخطر، وميّز أعماله عن أغاني الكاباريه اليومية ببعد إضافي ناتج عن تمرّسه بالموسيقى الكلاسيكية، وعن ارتباطه بفكر اشتراكي ناضج حوّل أعماله إلى أداة ثورية.
عمل فايل في تلك الفترة مع برتولد بريخت، الكاتب الماركسي الذي غذّت أعماله محارق الكتب النازية في أنحاء ألمانيا. اشتهر الاثنان بأعمال مثل أوبرا صعود وانهيار مدينة ماهاجوني التي تقدم ديستوبيا سوداء عن مدينة وهمية من الرأسماليين والمجرمين. لكن عملهما الأشهر يبقى «أوبرا بثلاثة قروش»، والتي كُتبت لعدد قليل من العازفين وتكونت من أغانٍ قصيرة ومظلمة تتكلم بلسان شخصيات من قاع المجتمع، مثل القرصانة جيني التي تعمل في تنظيف أحد النزل على البحر بينما تنتظر قدوم سفينة القراصنة لتخليصها:
«في تلك الليلة تسمعون صرخة في الليل/ وتتساءلون ما قد يكون ذلك الصوت/ وترونني أكشّر عن ابتسامة وأنا أمسح الأرض/ وتتساءلون لماذا تبتسم هذه؟/ قد ترمون لي بقشيشكم وتنظرون إلى السفن/ لكني أعد رؤوسكم بينما أرتب الأسرّة/ الليلة، لا أحد سينام هنا».
إلى جانب سيمفونيات فايل وأعماله الأكثر كلاسيكية، تحتفظ القتامة الصادمة لمسرحياته مع بريخت بسحر خاص يعود إلى الشرخ المتعمد بين ألحان تكاد تكون ساذجة من جهة، وهارموني ثقيل ونصوص سوداوية من جهة أخرى. حيث يحدث مثلًا أن تروي أغنية ماك قصة الجثة الملقاة على قارعة الطريق والعائلة التي أحرق بيتها بموسيقى جاز طفولية، أو أن يجري مشهد انهيار مدينة ماهاجوني في الأوبرا المذكورة بينما تغني بنات الليل أغنية فوكستروت راقصة.
جاء تبني الفنانين لهذا الأسلوب كطريقة لصدم المشاهد بعبثية الواقع وحثه على التفكير، وكمضاد للرومانسية الفاغنرية التي تستجدي العواطف الغامرة بدل المنطق، تمامًا كما كان هتلر يفعل في خطاباته. وشيئًا فشيئًا بدأ شبيحة الحزب باقتحام عروض فايل، وصارت المسارح ترفض أعماله تحت الضغط النازي واتهامات اللاسلطوية والشيوعية، وطبعًا اليهودية. وعام 1933 تسرب إليه خبر وضعه على القائمة السوداء مع زوجته لينيا التي غنّت أعماله، فسارعا بالهرب عبر الحدود الفرنسية دون رجعة.
الضحية الثانية كانت الموسيقى اللامقامية بريادة آرنولد شونبيرج (1874-1951). فبالنسبة للنازيين ارتبطت فكرة كسر المقامات، وبناء نظام موسيقي يساوي بين النوتات، بالشيوعية، وأثارت كوابيسهم رؤية التراث الألماني العظيم يتفكك إلى فوضى غير مفهومة، مع أن اللامقامية أتت كاستمرار لذلك التراث، وكتطور طبيعي لأفكار فاغنر. عام 1933، هرب شونبرج إلى أميركا بعد تلقيه رسالة مشفرة من أخيه تنصحه بـ «تغيير الجو»، بينما شهد العام التالي المرة الأخيرة التي قدم فيها عملًا لا مقاميًا في برلين وسط هجومٍ وحشيٍ من الصحافة الحكومية. طبيعة اللامقامية التي تعبر عن انهزامية أمام التاريخ لم تناسب الإيجابية التي اعتنى النازيون بنشرها، لذلك هوجم أتباع شونبرج كجزء من «المؤامرة التخريبية لليهود-البلاشفة» بالرغم من كونهم غير يهود، بل وحتى متعاونين مع النازية كما في حالة فيبيرن، الذي تم التشهير بموسيقاه في معرض العار.
المصير الأسوأ كان من نصيب المؤلف إروين شولهوف، الذي بدا وكأن كل ما فيه مصمم خصيصًا لاستفزاز النازيين، فقد كان شولهوف يهوديًا وشيوعيًا ومثليًا، وجمعت موسيقاه اللامقامية بالجاز وبالحركات الطليعية مثل الدادا التي هدفت إلى تشكيل فن مضاد للبرجوازية. ربما أكثر ما يثير الإعجاب به إلى جانب موسيقاه الملوّنة والمتنوعة، هو جرأته في السخرية، وفي قول ما يريده بالأسلوب الذي يريده، ولو عنى ذلك تلحينه للبيان الشيوعي بكل برودة أعصاب وكأنه قصيدة، وفي ظل تصاعد النازية. حاول شولهوف اللجوء إلى الاتحاد السوفييتي، لكن الألمان كانوا أسرع بإرساله إلى أحد مخيمات الاعتقال، حيث مرض وتوفي عام 1942.
نال الأموات حصتهم من التطهير أيضًا، حيث خضعت أعمال كبار المؤلفين مثل موتسارت وهندل لمكياج نازي، وتولت مجموعات مختصة مهمة تعديل نصوص الأوبرات والأعمال الغنائية لاستبدال أية شخصيات إنجيلية بأبطال ألمان. يبقى فيليكس مندلسون (1809-1847) الضحية الأشهر، فبالرغم من شعبيته واللذة التي لا تقاوم لموسيقاه، اتهمه فاغنر في أطروحته المذكورة بالسطحية والابتذال، وبعدم قدرته على التعبير عن «المشاعر العميقة والراسخة للقلب البشري» والتي رأى فاغنر أنها هبة آرية حُرم منها مندلسون بسبب أصوله اليهودية. ومنذ وصول النازيين إلى السلطة، اتُخذت الإجراءات لمحي مندلسون من التاريخ، فحظر نشر وتقديم أعماله وجرت إزالة تماثيله وتغيير الشوارع المسماة باسمه.
مفهوم الموسيقى الفاسدة مُتغير حسب الطلب ما يبرر قدرته على جمع مؤلفين بهذا التنوع تحت خانة واحدة. فأحيانًا يكاد يكون الفساد طبيعة فيزيائية متأصلة، كالحديث عن تفاحة سليمة وأخرى مضروبة، فسادها يبدأ من وجودها أصلًا، كما في حالة النمساوي كورنجولد، الذي لا تختلف موسيقاه عن أي موسيقى رومانسية أخرى، لكن يهودية مؤلفها تكفّلت بحظرها. وفي حالةٍ مناقضةٍ، أعاد النازيّون نبش الملفات القديمة مكتشفين أصولًا يهودية للمؤلف الشهير يوهان شتراوس المتوفى قبل عقود، لكن الأهمية المُطلقة لفالسات شتراوس في تكوين الهوية الألمانية أدت إلى تعتيم الإدارة على الخبر مُبقية شتراوس في عداد الصالحين. وفي حالة هيندميث الذي لم يكن لا يهوديًا ولا معارضًا ولا حتى صاحب حداثة راديكالية، فإن عدم مجاهرته الكافية بالولاء كانت كافية لمنحه مكانًا مجانيًا في معرض عام 1938. تكمن حقيقة الفساد إذًا خلف المبررات الأخلاقية والفكرية والعرقية، وتولد من تلك المرحلة ما يكفي من الغطرسة التي تسمح لصاحب السلطة باختيار من يحق له أن يكون ومحو كل من لا يحق له، بما يتناسب مع التاريخ المزيف الذي يحاول كتابته.
بعد الحرب، عادت أعمال فايل إلى المسرح بعشرات اللغات، وأُعيد تأديتها من قبل الأوركسترات الكلاسيكية وفرانك سيناترا وفرق الروك والبوب على حد سواء، بينما أرسى شونبرج في الولايات المتحدة قواعد الموسيقى اللامقامية مغيرًا تاريخ الموسيقى إلى الأبد. أما طالبه فيبيرن فقد قُتل من قبل جندي أميركي على إحدى شرفات فيينا خلال تحرير المدينة، لكن تداعيات أعماله دفعت نحو التأسيس لما سمي بمدرسة دارمشتاد التي سيطرت على المشهد الأوروبي حتى الستينيات. هرب كورنجولد ليصبح من نجوم هوليوود وليترك وراءه جائزتي أوسكار وواحدة من أجمل كونشيرتوهات الكمان المكتوبة في القرن الماضي، أما ميندلسون، فقد استرجع مكانته في التاريخ بين أكثر المؤلفين الكلاسيكيين شعبية.
كما قادت الحاجة بعد الحرب مفكرين مثل أدورنو إلى البحث عن رؤيا جديدة عن الثقافة الغربية، الذي صرّح بأن «الشعر بعد أوشفيتز فعل بربري»، لإن إبادة ملايين البشر وإشعال الحرب كان على الأقل مدفوعًا، وإن بصورة جزئية، بفانتازيا تستمد شاعريتها من أبطال فاغنر الجرمانيين وعالمهم المثالي، بعكس الموسيقى المجددة التي تعاملت مع واقع أقل شاعرية وأكثر عصرية، ولأنه لا يمكن لمجتمع أن يستمر في اجترار ذات الثقافة ويتوقع نتائج مختلفة، خصوصًا عندما تعيش تلك الثقافة على الحنين لعصر ذهبي مفقود، فيصبح الخطر مضاعفًا.
في وقت تزدحم فيه أخبارنا اليومية بقصص الرقابة والقمع في العالم العربي وخطابات الكراهية والشعبوية في الغرب، قد يكون من المفيد أن نستمع مجددًا إلى فايل وشونبرج وهندميث، وأن نفكر فيما إذا كان كابوس الثلاثينيات قد انتهى فعلًا. قد يكون من المفيد أيضًا أن نتساءل حول ما إذا كان حظر كتابات شخص ما المقدمة الطبيعية لحظر الشخص نفسه، وتمهيدًا لعالم يكون فيه قتل الشخص مقبولًا، وحول عشوائية المعايير التي تحدد ما إذا كان هذا الشخص أنت أو «الآخر». خلف متعة الاستماع إلى قطعة فاسدة يكمن تذكير مقلق بأن حظر كتاب أو حفل موسيقي اليوم قد لا يتحول إلى محرقة بتلك السرعة، لكنه على كل حال يسير بذات الاتجاه.