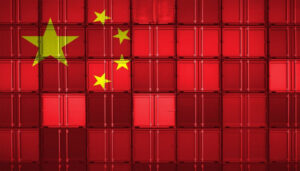بعد أيام من رفع أسعار المحروقات للمرة الثامنة خلال العام الماضي، أضرب أصحاب الشاحنات الأردنية عن العمل لنحو أسبوعين خلال الشهر الفائت مطالبين بتخفيض أسعار المحروقات وتعديل أجور النقل، إلى جانب مطالب تنظيمية وإدارية أخرى. وقد أضربت إلى جانبهم بين الحين والآخر -ولفترات محدودة ومتفاوتة- شرائح أخرى في قطاع النقل، إضافة إلى محال تجارية في بعض المدن، كما شهدت فترة الإضراب تظاهرات وإغلاقًا لبعض الطرق.
لكن الإضراب انتهى قبل أيام بعدما تعهد مسؤولون حكوميون بإيجاد حلول مُرضية لأصحاب الشاحنات، مطالبين بفكّ الإضراب خصوصًا بعد مقتل خمسة رجال أمن برصاص «خلية إرهابية» بحسب بيان مديرية الأمن العام. وهو ما كان، إذ استأنف أصحاب الشاحنات عملهم «فزعةً للوطن» كما يقول أحد منظمي الإضراب في مدينة الكرك.
صحيحٌ أن الإضراب توقف، وأن النقل من ميناء العقبة استؤنف بعدما تكدّست فيه البضائع لأيام، لكن مطالب أصحاب الشاحنات ما تزال اليوم محل تفاوضٍ مع مسؤولين في القطاع. ورغم أن أسعار المحروقات كانت الدافع وراء الإضراب، وكان تخفيضها على رأس المطالبات، إلا أنها لم تعد مسألة مطروحة في المفاوضات، كما يقول أصحاب شاحنات لـ«حبر»، بل إن سلسلة الاجتماعات التي عُقدت بعد العودة إلى العمل ركّزت على مسائل تنظيمية لم تصل الأطراف إلى اتفاقٍ حولها بعد.
يحدث هذا التعسّر في الاتفاق قبل أسابيع قليلة من بدء تطبيق قرار سعودي يقضي بمنع مرور الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عامًا عبر أراضيها (ترانزيت)، ما يزيد من مشقة أصحاب الشاحنات الأردنية. لكن، في كل الأحوال، ليست مشاكل قطاع الشاحنات وليدة القرارات السعودية أو الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، بل نتيجة نهجٍ حكومي أراد هيكلة القطاع وإدخاله في مسارات الخصخصة والتنافسية، ليدفع بعد قرابة عقديْن شريحةً واسعة من العاملين فيه إلى الخسارة والإحباط والهشاشة، فكيف وصل القطاع إلى هذه الحال؟
إعادة الهيكلة انسجامًا مع الخصخصة
تعمل في الأردن اليوم حوالي 21 ألف شاحنة موزعة على أنماطٍ مختلفة أبرزها الشاحنات التي تنقل القمح والشعير والمواد التموينية من ميناء العقبة إلى عمّان، وتلك التي تعمل في نقل الفوسفات والبوتاس من المناجم إلى الميناء، وأخرى هي «الحاويات» التي تنقل البضائع من العقبة إلى بقية المحافظات، وآخرها «البرّادات» التي تنقل المواد الغذائية إلى دول الخليج.
خلال الإضراب الأخير، طالما ردّد أصحاب الشاحنات مطالباتهم بوقف «تغوّل» الشركات على الأفراد العاملين في القطاع، وتنظيم دوْر الشاحنات في ميناء العقبة، وضمان العدالة في توزيع العمل عليها. لكن هذه المطالب ليست جديدة، إنما بدأت وتكررت مرارًا منذ العام 2005 عندما قررت الحكومة آنذاك إجراء تعديلات على بنية القطاع وإعادة تنظيم عمله، وهي ما وجد فيه أصحاب شاحناتٍ مساسًا بالعدالة والإنصاف بين مختلف العاملين في القطاع.
قبل العام 2005، ومنذ التسعينيات، تولّت شركة حكومية هي «الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية» إدارة وتنظيم دخول الشاحنات وخروجها من ميناء العقبة عبر نظام دورٍ يسري على كل الشاحنات، كما نظّمت وضبطت تسعيرة النقل التي تحصل عليها الشاحنات، ما حقّق من وجهة نظر أصحاب الشاحنات العدالة بينهم.
لكن، كان للحكومة وجهة نظرٍ أخرى، إذ اعتبرت أن نظام عمل الشركة الموحدة أضعفَ القدرة التنافسية حيث لم يوفّر لأصحاب البضائع الحرية في اختيار الناقلين، كما أنه يُخالف اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها، والتي تطلّبت فتح الأسواق والاعتماد على التنافسية في قطاع النقل واللوجستيات. تنسجم هذه الرؤية للقطاع مع توصياتٍ من البنك الدولي بإعادة هيكلة أنشطة النقل بالشاحنات، وهو يعتبر أن ملكية الأفراد -لا الشركات- لحصة واسعة من الشاحنات يحدّ من جودة الأسعار والخدمات.
زعمت الحكومة أن الهيكلة الجديدة ستعزّز التنافس، لكنها في الواقع أودت بالعاملين في القطاع إلى التنازع على مستويات عدة.
وعليه، أجرت الحكومة ثلاثة تغييرات جوهرية على القطاع هي: أولًا التحرّر من نظام الدّور الذي كان معمولًا به، وثانيًا تحرير أسعار النقل؛ أي إلغاء التسعيرة الثابتة وإخضاع القطاع لآلية العرض والطلب، وأخيرًا الدفع بتحويل القطاع من الملكية الفردية إلى ملكية الشركات.
ومن أجل تحويل القطاع إلى الشركاتيّة، تمهيدًا لتحرير الدّور والأسعار، وضعت الحكومة عام 2005 -عبر جملةٍ من الاتفاقيات والتعديلات التشريعية- آلية جديدة تنظّم عمل مالكي الشاحنات الأفراد ألزمتْهم من خلالها بالعمل تحت مظلة شركات النقل المرخصة بموجب عقد عملٍ بينهما، بحيث تلتزم شركة النقل من خلال عقودها الخاصة مع شركات التخليص والشحن بتوفير الحمولة لصاحب الشاحنة، كما تلتزم بالتعامل مع أصحاب الشاحنات الأفراد بنفس معاملة الشاحنات المملوكة لها بدون تمييز، فيما يلتزم صاحب الشاحنة بتوصيل البضائع مقابل أجرةٍ لا تقل عن 90% من الأجور الفعلية التي تعاقدت عليها شركة النقل. بكلمات أخرى، أصبح مالك الشاحنة الفرد بمثابة عاملٍ أو أجيرٍ عند شركات النقل الكبرى التي يحق لها اقتطاع عمولة مقدارها 10% من أجرة النقل الفعلية.
في الوقت نفسه، شجعت الحكومة المالكين الأفراد على تأسيس شركاتٍ خاصة بهم من أجل مزاولة أعمال النقل لفترة ما بعد تحرير الدّور، وجعلت باب العمل تحت مظلة الشركات مفتوحًا لمن لا يقدر منهم على تأسيس شركة.
هكذا قفزت عام 2005 أعداد شركات النقل بزيادة سنوية -هي الأعلى- تصل إلى 140%، إذ تمّ ترخيص قرابة 70 شركة جديدة في تلك السنة. وقد توزعت ملكيتها بين شركات كبرى كانت تعمل أساسًا في الشحن والتخليص والتحميل وغيرها، وأصحاب شاحنات أفراد تجمعوا معًا لتأسيس شركاتٍ متعارف عليها باسم «شركات الأهالي».
ما إن حُرّرت الأسعار وفقًا للعرض والطلب، وطُبّقت الآلية الجديدة، حتى بدأت الإشكاليات بالظهور، إذ لم تتمكن شركات الأهالي من منافسة الشركات الكبرى؛ المتخصصة والعاملة في أكثر من مجال، إذ لدى الأخيرة بطبيعة الحال قدرة أكبر على طرح أسعار منافسة في السوق. بالتزامن مع ذلك، تصاعدت شكاوى الملاك الأفراد، خصوصًا أصحاب الحاويات، من عدم منحهم حمولاتٍ مُرضية من قبل شركات النقل، فضلًا عن استيائهم من عمولة الشركات التي شكلت طبقة إضافية تزاحمهم وتقاسمهم شيئًا من أجورهم. دفع هذا الحال الملّاك الأفراد إلى التعامل بشكل مباشرٍ مع التجار والتعاقد معهم، مضطرين لتخفيض أسعارهم الاعتيادية بسبب ضغوط المنافسة؛ مع الشركات بشكل أساسي، ومع أقرانهم الأفراد من جهة أخرى.
مع الوقت، أثارت نتائج الهيكلة الجديدة احتجاجات واعتصامات متكررة لأصحاب الشاحنات، ما دفع الحكومة لإعادة النظر في بعض ما أحدثته من تغييرات، دون أن يعني هذا بأي حالٍ العودة إلى ما قبل 2005، بل على العكس، خلقت وضعًا هجينًا غير منظّم إلى حدّ بعيد.
فبعد حوالي عامين من الاستغناء عن الشركة الموحدة -الحكومية- بذريعة عدم الحاجة إلى نظام دورٍ لتحميل الشاحنات من ميناء العقبة، تعاقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة خاصة تدعى «نافذ للخدمات اللوجستية» لمدة عشر سنوات من أجل تنظيم دخول وخروج الشاحنات. وقد جاء هذا التعاقد «انسجامًا مع مبدأ التخاصية»، ونظرًا للقدرة والمرونة والكفاءة العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص، بحسب سلطة العقبة. لكن «نافذ» في الحقيقة لم تعُدْ فعليًا إلى إعطاء أدوارٍ للشاحنات كما كان الحال عليه أيام «الموحدة»، إنما منحت تصاريح دخول إلى العقبة للشاحنات التي تعاقد ملّاكها مسبقًا مع زبائن لهم من أجل نقل بضاعتهم، وتُمنح التصاريح مقابل رسومٍ تتقاسمها مع سلطة العقبة. أي أن «نافذ» لم تضمن دورًا لكل الشاحنات بغض النظر عن ملّاكها، ما يعني -مرة أخرى- منح أفضليةٍ للشركات الكبرى على حساب الملاك الأفراد.
وبعد قرابة عامين آخرين، تحديدًا في 2010، عادت الحكومة عن تحرير أسعار النقل، ووضعت حدًا أدنى من الأجور. وقد قال وزير النقل حينها علاء البطاينة -وهو الوزير ذاته الذي حرّر الأسعار سابقًا- إن هذا القرار جاء استجابة لشكاوى الشركات الناقلة والملاك الأفراد من تدني أجور النقل بشكل ملحوظ والمضاربات الشديدة والعمل بأجور تقلّ عن الكلف الحقيقية، عازيًا ذلك إلى الاختلالات بين العرض والطلب في ضوء تزايد أعداد الشاحنات بشكل ملموس خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ووجود فائضٍ في حجم الأسطول وانخفاض في أحجام النقل. دون أن يذكر -بطبيعة الحال- شيئًا عن أثر إعادة هيكلة القطاع على يد الحكومة، وانسحابها من تنظيم الدّور والأسعار.
هذه الإشكاليات التي وصفها البطاينة كانت تعني على أرض الواقع خسائر مادية تكبّدَها أصحاب الشاحنات الأفراد. وحتى لو كانت الحكومة -جدلًا- تحاول آنذاك استدراك خطئها في تحرير الأسعار، فإن الوقت حينها قد فات، لأن شكل القطاع وبنيته قد تغيّرت، بعدما أحدثت إعادة الهيكلة فروقات ضخمة في أحجام العاملين فيه، بين أفراد وشركات، وبالتالي لم يحلّ المشكلةَ قرارُ تحديد حدّ أدنى للأجور. والدليل على ذلك هو استمرار احتجاج أصحاب الشاحنات في السنوات اللاحقة، وأبرزها إضرابهم عن العمل لعشرة أيام عام 2012 ما أوقف عمليات المناولة في الميناء، وذلك احتجاجًا على عمولات شركات النقل بشكل خاص، وعلى آلية العمل الجديدة بشكل عام.
زعمت الحكومة أن الهيكلة الجديدة ستعزّز التنافس، لكنها في الواقع أودت بالعاملين في القطاع إلى التنازع على مستويات عدة؛ أولها بين الملّاك الأفراد والشركات عمومًا، وثانيها بين شركات الأهالي وشركات النقل الكبيرة، وأخيرًا بين الملّاك الأفراد أنفسهم بسبب زيادة أعداد الشاحنات والعاملين عليها مع مرور الوقت.
ارتفاع الكُلف وانخفاض الفرص
بعد الإضراب الأخير للشاحنات، تقرّر رفع الحدّ الأدنى لأجور النقل للشاحنات، بما فيها أجور الحاويات من حوالي 450 إلى 500 دينار. قبل هذا القرار، كان عيسى، وهو صاحب شاحنةٍ من الكرك، يتقاضى من شركة النقل مقابل كل نقلةٍ حوالي 400 دينارٍ بعد اقتطاع عمولتها. يتبع ذلك عدة نفقاتٍ أهمها: 270 دينارًا كلفة الديزل من العقبة إلى عمّان، و12 دينارًا رسوم تقتطعها شركة «نافذ»، و50 لسائق الشاحنة، و20 لتغيير الزيت شهريًا. هكذا يتبقى له حوالي 50 دينارًا من النقلة الواحدة، دون الأخذ في الحسبان ترخيص الشاحنة وتجديد إطاراتها وحاجتها لأي صيانة. «صرنا نوكل من صحة الشاحنة» يقول عيسى، في إشارة إلى أن الكلف التشغيلية دفعت أصحاب الشاحنات لإهمال صيانتها وتجديد إطاراتها.
يقول عيسى إنه يحصل على أربع نقلات شهريًا، بدخلٍ إجمالي قدره حوالي 200 دينار، سيُخصم منها لاحقًا تكاليف الترخيص والصيانة. ولا يمكنه الحصول على نقلاتٍ أكثر نظرًا للأعداد الكبيرة للشاحنات، التي ترى وزارة النقل أنها تفوق حاجة القطاع. يملك عيسى شاحنتين أخرييْن، إحداهما تعمل على نقل البضائع إلى السعودية، وتساهم هذه في الإنفاق على الشاحنتين اللتين تعملان داخل الأردن، لأن النقل إلى السعودية مجدٍ أكثر، حيث يتقاضى حوالي ألف دينار عن كل نقلة.
قبل أن يطال التغيير هيكلة قطاع الشاحنات، طال الحكومات ذاتها ومسّ بنيتها، فاتّبعت منذ أزيد من عقدين نهجًا اقتصاديًا ترك الناس يصارعون وحدهم محاولين الصمود في وجه السوق و«تنافسيّته».
كان النقل إلى دول الخليج، وفي مقدّمتها السعودية، الخيار الأكثر استقرارًا لأصحاب الشاحنات، خصوصًا في ظل العراقيل التي تواجههم في نقل البضائع إلى العراق وسوريا لاعتبارات أمنية ومسائل متعلقة بالتأشيرات وأسعار الشحن. لكن هذا الخيار لم يعد سهلًا، إذ تشترط السعودية ألا يتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات الداخلة إليها 20 عامًا، وقريبًا سيُطبق الشرط نفسه على تلك المارّة عبر أراضيها. هذا يعني أن على الكثير من أصحاب الشاحنات القديمة تجديدها، وفي حال أرادوا ذلك فإنهم مضطرون لشراء أخرى لا يزيد عمرها عن خمسة أعوام، حيث أن هذا ما تشترطه بدورها دائرة الجمارك الأردنية.
وعليه، فإن الخيارات المتبقية اليوم أمام العاملين في القطاع تنحصر في تجديد شاحناتهم بتكلفة تبلغ حوالي 70 ألف دينار، بحسب تقديرات عدد من أصحاب الشاحنات. أو الاكتفاء بالعمل عليها داخليًا بين العقبة وبقية المحافظات مقابل الحدّ الأدنى من الأجور على الأغلب، وهم يتخوّفون من عدم الالتزام به مستقبلًا، كما يقلقهم عدم وجود ضماناتٍ على توزيع عادلٍ للأحمالِ قد يوفّر لهم دخلًا معقولًا يغطي كُلف التشغيل.
ختامًا، يطالب عاملون في القطاع بالعودة إلى نموذج عمل الشركة الموحدة لضبط نظام الدّور، وبوضعِ الحكومة يدها على تنظيم العمل والتسعيرات، وهذه دون شكّ مطالبات محقّة ومشروعة، لكن إشكاليّاتها أنها تنسى أن ما أوصل القطاع إلى حالته اليوم هو أصلًا السياسة التي اتبعتها هذه الحكومات نفسها، وأن هذا نتاج «تنظيمها» له. ولو افترضنا جدلًا أن الحكومة عادت للتدخل مباشرةً في إدارة القطاع ممثلة بشركتها الموحّدة، فإن هذا على الأرجح لن يعني عودة العمل بطريقة عادلةٍ تنحاز للأفراد على حساب الشركات، إذ قبل أن يطال التغيير هيكلة قطاع الشاحنات، طال الحكومات ذاتها ومسّ بنيتها، فاتّبعت منذ أزيد من عقدين نهجًا اقتصاديًا يقوم على الخصخصة، وانسحاب الدولة من السوق، وإطلاق ذراع الشركات الخاصة، فيما تركت الناس -في كل المجالات تقريبًا- يصارعون وحدهم محاولين الصمود في وجه السوق و«تنافسيّته».
إن المشكلة أوسع من شركةٍ في قطاعٍ ما، إنها أساسًا في هذا النهج الاقتصادي، الذي لا توجد مؤشرات على أن الحكومة تعيد التفكير فيه، بل -على العكس- يبدو أنها تمضي فيه إلى آخره، غاضّةً النظر عن عجز بعض أصحاب الشاحنات عن تبديل إطاراتها، عازمةً فرض رسومٍ على استخدام بعض الطرق الرئيسية الحيوية، والتي ستسير عليها بالتأكيد هذه الإطارات المهترئة.