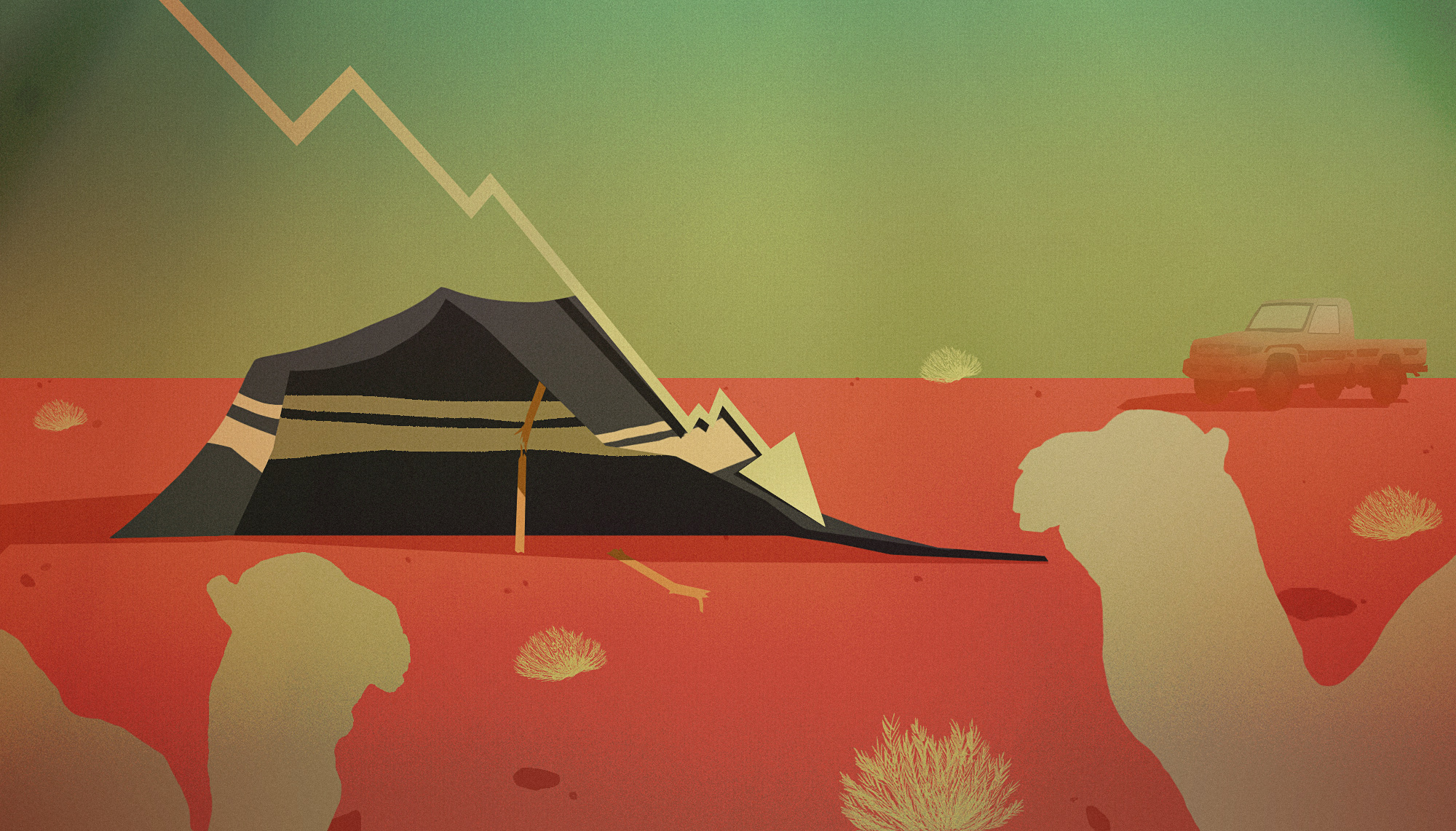من بين كل العناوين التي تطرح في نقاشات وأخبار «اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية»، تتركز الأنظار على عنوان بارز يتعلق بمقترح قانون جديد للانتخابات النيابية، وتوجد لجنة فرعية خاصة بهذا الموضوع. ونظرًا لأن صياغة القانون وإقراره نهائيًا لها مسارات دستورية، فإن مهمة اللجنة الحالية تكمن في تجهيز «الوصفة والمقادير»، التي قد تخضع لاحقًا عند طرحها على الحكومة ومجلس النواب القائم، لبعض التغيير وفق «الذوق والرغبة»، والمصلحة بالطبع.
ليست المرة الأولى التي يجري فيها نقاش مسبق للقانون، غير أنه هذه المرة، شكليًا أو فعليًا (وفق زاوية النظر التي يختارها القارئ)، فإن النقاش يجري داخل لجنة واضحة معلنة من حيث الأسماء والتوجهات. ومن المفيد أن نتذكر أنه باستثناء آخر مجلسين نيابيين (الثامن عشر والتاسع عشر)، فإن كل دورة انتخابات ابتداءً من عام 1989 كانت تشهد تغييرًا ما في القانون والأنظمة الخاصة به، وهذا يعني أننا مررنا حتى الآن بثماني جولات نقاشية حول هذا القانون. غير أن النقاش خلال العقود الثلاثة الماضية، كان من الناحية الفعلية يجري في دوائر خاصة، مع تكتم شديد في بعض الأحيان على دوافع التغيير ومحدداته، على المستوى الوطني، وعلى مستوى المناطق منفردة.
في كل حالات النقاش، بما فيها ما يجري حاليًا، ينصب التركيز على شكل المنتج النهائي المتوقع من الانتخاب وقانونه، أي على التركيبة المنتظرة أو المرجوة والمقترحة، لمجلس النواب، وكل طرف يناقش الأمر من زاوية الصورة التي يريدها للمجلس، وهذا أمر طبيعي ومفهوم. ولكن الملاحظ هو ندرة حالات نقاش الأمر من زاوية التداعيات والنتائج في الطرف الآخر، أي عند جمهور الناخبين وفي المجتمع وعند الناس عمومًا، خلال الاستعداد للانتخابات وأثناءها وبعد إجرائها.
تحاول هذه المقالة تتبع أثر صيغ قوانين الانتخاب المختلفة على المجتمع والعلاقات الاجتماعية السياسية، خلال العقود الماضية، وتعرض باختصار كيف تبدلت وتحوّرت الطرق التي تفاعل بها الجمهور مع تبدلات القوانين، أي كيف فهم الناس القوانين وكيف مارسوها على الأرض، وكيف أثرت على مواقفهم العامة الاجتماعية والسياسية على المستويين المحلي والوطني العام. ولغايات توسيع المقارنة، سوف تقدم المقالة نظرة سريعة على الحالة قبل عام 1989، أي قبل العهد النيابي الجديد، بعد ما سمي بمرحلة الانفتاح الديمقراطي.[1]
أعرض فيما يلي سيرة السلوك الانتخابي لناخبي إحدى المناطق، وهي لواءي الرمثا وبني كنانة، اللذان يشكلان الآن الدائرة الرابعة في محافظة إربد. ولكن المقالة لن تتوقف عند حدود هذين اللواءين، بل ستتناول الظاهرة على العموم.
ما قبل عام 1989
قبل عودة الحياة البرلمانية عام 1989 كان الناخبون في اللواءين المذكورين ينتخبون ضمن دائرة واحدة كبيرة تضم كل شمال الأردن، ابتداءً من الأغوار غربًا مرورًا بإربد وقراها، وجرش وعجلون والمفرق، وصولًا إلى الرويشد (واسمها آنذاك الإتشفور) في أقصى الشرق، وكان يقال إن على المرشح أن يتحرك «من الغور للإتشفور».
يتذكر مرافق أحد المرشحين من مدينة الرمثا عام 1964، وهو الآن في نهاية عقده الثامن، أن منطقة التحرك الواسعة فرضت نفسها على مجمل العملية الانتخابية، فلم يكن بمقدور المرشح أن يتحدث عن عشيرته أو مدينته أو منطقته الخاصة. وعلى العموم كانت العناوين السياسية الوطنية والقومية هي ميدان التنافس الرئيسي بين المرشحين، وكان يتعين على مدينة الرمثا مثلًا، أن تستقبل أي مرشح من خارجها، لأنها من دون ذلك ستحرم مرشحيها من الحركة في مناطق الآخرين.
كانت العناوين السياسية الوطنية والقومية هي ميدان التنافس الرئيسي بين المرشحين.
في عام 1984، جرت عودة استثنائية للحياة النيابية وذلك بدعوة المجلس السابق للانعقاد، أي دون انتخابات سوى للمقاعد التي شغرت بسبب الوفاة.
كان لمنطقة الشمال نصيب، فعقدت فيها جولة عام 1984 ثم في عام 1988، وكان النشاط الانتخابي مشابه إلى درجة كبيرة للحالة السابقة. ورغم أن الانتخابات عقدت في ظروف الأحكام العرفية ومنع النشاط السياسي الحزبي، غير أن الطابع السياسي كان واضحًا في الحملات وفي النتائج.
في انتخابات عام 1989 شكّل اللواءان (الرمثا وبني كنانة) دائرة واحدة ضمن محافظة إربد بحدودها الحالية، وأعطيا ثلاثة مقاعد. وكان هذا يعني أن على الناس (المرشحين والناخبين) الانخراط في علاقات تمتد على عدد كبير من القرى، والبحث عن تحالفات واسعة. كان على كل فريق أن يبحث عن حلفاء، وأن يصيغ لغة عامة، ويطرح برامج تخاطب جمهورًا متنوعًا. ففي لواءي الرمثا وبني كنانة، شُكل تحالف بارز، مبني على أسس عشائرية، بين أكبر تجمعين في اللواءين، بينما فاز مرشح ثالث خاض معركة سياسية واضحة، التف حوله المشتغلون بالسياسة وخاصة المعارضة (القومية واليسارية) من مختلف الاتجاهات ومن مختلف القرى والمدن والبلدات في اللواءين، ومن خارجهما أيضًا، ولم تجد أية مجموعة من الناخبين في أي موقع حرجًا من اتخاذ الموقف الذي تريده، وعلى العموم انخرط سكان اللواءين في علاقات متجاوزة للعشيرة الواحدة والمنطقة الواحدة.
عهد الصوت الواحد
في انتخابات عام 1993، بدأ العمل بقانون الصوت الواحد، وقد أبقى القانون على ثلاثة مقاعد للواءين، على أن يختار الناخب مرشحًا واحدًا. وبالنتيجة انقلبت حركة المرشحين والناخبين بشكل ملحوظ، فكل أخذ يبحث عن «جماعته» ويسعى لتحصينها من الاختراقات. ولكن مع ذلك، أوجبت صيغة القانون على المرشحين أن تكون حملاتهم عابرة للمدن والقرى والعشائر في اللواءين، وهو ما أبقى على فرصة معقولة لدائرة أوسع من العلاقات والبرامج، وحافظ على بعض محتوى الحملات الانتخابية وخاصة عند المرشحين الأقوياء.
هذه الحالة تبددت كليًا في انتخابات عام 2003، (لقد كان مبدأ الصوت الواحد بحاجة لتطوير خبرته في تفتيت الأصوات). ففي تلك الانتخابات، فُصل اللواءان عن بعضهما انتخابيًا وأعطي لكل منها مقعدين، ولكن مع بقاء مبدأ الصوت الواحد. تحت تأثير ذلك اندفع الناس في اللواءين إلى البحث عن دوائر أضيق للعلاقات والتحركات والبرامج، لم تعد هناك حاجة للخروج خارج اللواء، لقد تراجع محتوى الحملات والبرامج نحو الأهداف الضيقة التي تناسب جماعة الناخبين المفترضين وبالضد من الناخبين الآخرين، وقد ترافق ذلك مع الانتشار الواسع لفكرة «نائب الخدمات»، وبدأت عملية تسخيف الشعار العام والسياسي، وكتبت علنًا في مدن كبرى شعارات تقول «لا للمرشح السياسي ونعم لمرشح الخدمات».
لقد انحدر محتوى الحملات الانتخابية نحو التركيز على شخصية المرشح وانتمائه القرابي والمناطقي، وبرزت بقوة ظاهرة «الإجماعات» أو «ترتيب الدور» بين الراغبين في الترشيح، أو مقايضة المراكز الاجتماعية بين التجمعات، مثل فكرة: «أعطونا النيابة نعطيكم البلدية». وانهمك الجميع بسؤال طغى على كل العملية الانتخابية في البلد ككل وهو: «لماذا لا يكون المرشح منا دون غيرنا؟» وفي حالة الرمثا وبني كنانة، راحت العشائر والقرى تخلق محاور اتفاق أو خلاف جديدة أو تستعيد محاور الخلافات القديمة سعيًا إلى التحشيد الداخلي، وسعى جميع المرشحين بحماس نحو أضيق دائرة تضمن النجاح، أو تضمن ترسيب المنافس، أو الحصول على أصوات أعلى من أصوات خصم يتم تحديده، وكل مرشح يسعى إلى تعزيز دائرة علاقاته الخاصة، بل إن عشائرَ صارت تقدم مرشحين بهدف «اتقاء شر» المرشحين الأقوياء، فببساطة «لدينا مرشحنا».
الأمر نفسه تكرر عام 2007، ولكن مع الاستفادة من الخبرة «التفتيتية» السابقة، ولكن هذه المرة ترافقت الأجواء مع التدخلات التي لم يعد ينكرها أحد من قبل السلطة مما جعل المرشحين ينقسمون إلى صنفين: «مرشح موعود» أو «مضمون» و«مرشح على راسه». ومع هذا فإن الصوت الواحد ضمن الصيغة السابقة، وحتى انتخابات 2007، أبقى للمرشحين مساحة تحرك ضيقة، لكنها كانت تشمل اللواء كله في كل محافظة.
انحدر محتوى الحملات الانتخابية نحو التركيز على شخصية المرشح وانتمائه القرابي والمناطقي، وبرزت بقوة ظاهرة «الإجماعات» أو «ترتيب الدور» بين الراغبين في الترشيح.
يبدو أن صاحب القرار كان يطوّر بالتدريج من خبرة الدور التفتيتي للصوت الواحد، وقد تجلى ذلك في الانتخابات التالية عام 2010، التي جرت وفق صيغة عرفت بـ«الدوائر الوهمية»، أي تقسيم كل دائرة إلى عدد من الدوائر الفرعية مساوٍ لعدد مقاعدها، وهي دوائر «وهمية» لا تخضع لمكان الإقامة، بحيث يختار المرشح رقم الدائرة التي يريد الترشح فيها، كما يختار الناخب رقم الدائرة التي يريد أن يدلي بصوته فيها. وخلال أيام، تقاسم المرشحون الأقوياء الدوائر الفرعية، بحيث لا يتنافسون معًا، ودعا كل مرشح ناخبيه إلى اللحاق به إلى تلك رقم الدائرة التي اختارها.
كانت الحملات الانتخابية على شكل إعلانات كبيرة تحمل اسمًا وصورة إلى جانب رقم كبير هو رقم الدائرة. كانت تلك الصيغة التمثيل الأبرز والأوضح «والأقسى اجتماعيًا» للصوت الواحد الخالي من أي محتوى، سوى ما يتعلق بشخصيات المرشحين.
لم يستمر مجلس الدوائر الوهمية سوى سنتين، فقد بدأت موجات الاحتجاج الشعبي العام ابتداءً من عام 2010/2011، واستقالت حكومة سمير الرفاعي، وأجريت انتخابات جديدة، عادت للصيغة التي سبقتها مع إضافة حصة لقوائم على المستوى الوطني. فكان للناخب صوتان، واحد لمرشحه المباشر في منطقته، والثاني للقائمة الوطنية.
رغم ما أحدثته الصيغة من بعض التغير في محتوى الحملات الانتخابية، إلا أن شروط الفوز التي حددت الفائز مرشح القائمة الوطنية الذي يعتلي ترتيب قائمة الأسماء، قد نقل التنافس إلى السعي لاحتلال المرتبة الأولى في قائمة الأسماء، ما جعل القوائم تتمحور حول ممول الحملة، كما اتاح فرصة لأصحاب الحضور على وسائل الإعلام، وعادة من أصحاب تلك الوسائل.
صيغ «جديدة»
في عام 2015، وقبل حلول موعد انتخابات 2016، جرى في البلد نقاش كبير تحت تأثير الحالة السياسية الداخلية وفي المنطقة، وشكلت الهيئة المستقلة للانتخابات بهدف إبعاد الحكومات عن التأثير المباشر، وتحت هجوم واسع على الصوت الواحد، تقررت الصيغة الحالية؛ صيغة القوائم على مستوى الدائرة الواسعة نسبيًا (محافظة أو لواء)، وأعلنت الهيئة أنها أنهت الصوت الواحد وعادت إلى صيغة جديدة من قانون عام 1989 الذي كان الجمهور يمتدحه.
لكن في التنفيذ، ومباشرة، كانت الصيغة الجديدة تعني طريقًا ملتوية نحو الصوت الواحد، فالقوائم تشكلت مباشرة حول مرشح قوي يتحالف مع مرشحين لا ينتخبهم، وانتشرت فكرة مرشحي «الحشوات»، وهم مرشحون غير جديين، يكملون شروط تشكيل القائمة التي تعرف باسم «صاحبها» المرشح القوي الذي ينفق، وقد يدفع للمرشحين لقاء مشاركتهم له.
في البعد الاجتماعي، كان ذلك صوتًا واحدًا أكثر لؤمًا، وكانت نتيجته المجلسين الأخيرين اللذين حظيا بمستوى غير مسبوق من عدم الرضى.
التفاصيل كثيرة، وإذا كانت المقالة ركزت على مثال واحد ، فإن أي قارئ متابع يمكنه أن يتأمل حالة منطقته فيما يخص تبدل سلوك الناخبين، وبالأحرى تبدل أشكال النظر إلى العملية الانتخابية، وأثر ذلك على طبيعة الاجتماع السياسي على المستويين المحلي والوطني العام.
في العادة، يميل أنصار العملية الانتخابية، كما جرت في الواقع خلال العقود الثلاثة الماضية، إلى تحميل الناس المسؤولية، وينخرطون في حملات وعظ سياسي تحت عناوين «انتخاب الأفضل» وضرورة طرح البرامج، إلخ.
في الواقع، فإن الناس يتصرفون بشكل منطقي تمامًا، فببساطة، الانتخابات (أية انتخابات) تستهدف نجاح مرشحين، وكل فريق له الحق في تطويع القانون بما يخدم هدف فوز مرشحه. إن قانون الانتخاب من أكثر القوانين تأثيرًا في الحالة السياسية والاجتماعية والثقافية، وصاحب القرار هو من يحدد إن كان يريد ان يدفع بالمجتمع نحو التماسك والشخصية الواحدة، وأن يجعل التنافس في خدمة الوحدة، أو العكس.
لقد قادت قوانين الانتخاب المتتالية إلى بعثرة متصاعدة للمجتمع الأردني، وإن كان من غير الممكن التصدي لهذا النهج على الصعيد السياسي أو القانوني، بحكم طريقة سن القوانين السارية، فقد يكون على المجتمع أن يبحث عن الصيغ التي تكفل له الحد المعقول من الحماية الذاتية في وجه التفتيت الذي تفرضه هذه القوانين سنة بعد أخرى.
هكذا كان الأمر فيما مضى، وهكذا هو الآن، ونحن بانتظار الصيغة الجديدة لنرى أي دور سياسي واجتماعي سيقوم به القانون المنتظر، على مستوى المجتمع والبلد ككل.
-
الهوامش[1] الملاحظات الواردة المقالة ليست مجرد انطباعات أو تقديرات عن بعد، بل هي مبنية على ثلاث دراسات ميدانية تفصيلية إلى حد ما، كانت تستهدف التعرف على طرق الناس في اختيار المرشحين، أي ما يعرف في دول اخرى بـ«الانتخابات الأولية»، وقد اجريت الدراسات بالترافق مع انعقاد الانتخابات، وشملت مناطق المملكة كافة.