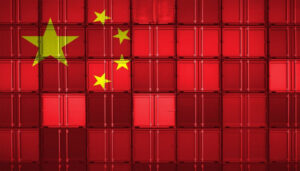هذا النص هو مقتطفات غير متتالية من أحد فصول مذكرات سمير أمين، الصادرة عام 2019 بعنوان «الثورة الطويلة في الجنوب العالمي: نحو أممية جديدة معادية للإمبريالية»، يصف فيها تجاربه الشخصية في زياراته العديدة للصين، وواقعها الاجتماعي والثقافي، وطبيعة الحياة والجدل السياسي فيها، كما رآه، ننشرها في الذكرى الرابعة لرحيله.
قادتني خياراتي السياسية إلى متابعة تطور الصين عن كثب منذ العام 1960. ومنذ العام 1980، ذهبتُ و[زوجتي] إيزابيل إلى الصين بانتظام وبقينا هناك لمدة شهر في كل مرة. لقد قسمنا وقتنا بين بيجينغ، حيث دعتني بانتظام معاهد أكاديمية مختلفة والتقيت بقادة الحزب والمسؤولين الاقتصاديين في البلاد، وزياراتٍ مُنسّقة إلى أماكن أخرى من هذا البلد العملاق. وهكذا، قطعنا آلاف الكيلومترات، من بيجينغ إلى تيانجين وشانغهاي ونانجينغ وهانغتشو (المقاطعات الساحلية الغنية في الشرق المتوسط)؛ من هونان إلى قويلين وقوانغتشو وهونغ كونغ؛ من بيجينغ إلى شيان (المقاطعات الفقيرة في الشمال الغربي)؛ من سيتشوان إلى كاشغر في أقصى الغرب. وما زلنا لم نزر ثلاث مناطق كبيرة: الشمال الشرقي (منشوريا سابقًا) ويونان والتبت.
التقط الرسامون الصينيون بإتقان تام جوهر الخصائص المميزة للمناظر الطبيعية المختلفة في البلاد، كالجبال المخروطية وقممها الممحية في الضباب. لكن لا شيء يرادف السفر عبر هذه المشاهد الرائعة التي لا مثيل لها في تجربتي. الصين هائلة؛ فهي تقدم للزائر مجموعة متنوعة لا حصر لها من المناظر الطبيعية بفضل مناخاتها المتنوعة، التي تمتد من المناخ السيبيري إلى شبه الاستوائي، ومن المناخ الموسمي الاستوائي على المحيط الهادئ إلى صحراء تكلامكان، الأشد هيبة من الربع الخالي أو صحراء تينيري، بتضاريسها التي تنحدر من جبل إفرست إلى واحدة من أخفض النقاط على وجه الأرض، وترتفع من سهول الأرز المسطحة إلى هضبة التبت وتشينغهاي وألتاي.
أتاحت لنا سيتشوان (مقاطعة يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة) عدة رحلات استكشافية جميلة. أحدها كان عبر حقول الأرز الغنية، التي تُمدّ بالمياه عبر نظام من السدود يعود تاريخه إلى العصور القديمة، بُني عبر «تحريك الجبال» بالمجارف والمعاول «لإسقاطها في النهر» ومنع مرورها. يقع سد آخر على المنحدرات الشاهقة على الجانب الشرقي من التبت، حيث جثمت أديرة بوذية باهرة. سافرنا أيضًا من تشونغتشينغ إلى ووهان في رحلة بحرية استغرقت أربعة أيام على متن سفينة برفقة بعض السياح الأجانب، بالطبع، ولكن بشكل رئيسي برفقة مصطافين من البرجوازية الصينية الجديدة، ومررنا بالأخاديد المدهشة لنهر اليانغتسي وروافده. كان ذلك في آخر عام قبل أن يغير السد الكبير الجديد تضاريس هذه الأماكن إلى الأبد. لزيارة أخدود أحد أكثر الروافد جموحًا، كان علينا مغادرة السفينة الكبيرة وركوب زورق تمكن بالكاد من مقاومة التيار. على ضفاف النهر، كان الفلاحون الصينيون البشوشون كعادتهم يراقبوننا باستمتاع. لقد أقاموا تجارة بأكملها على منتجات «الإنقاذ» (البسكويت، الشاي، الملابس الصوفية.. إلخ) توقعًا لحادث غرق محتمل، يا لها من فرصة جميلة للبيع! كان لمنظمي الرحلة الصينيين أيضًا ميل قوي للمخاطرة، إلى حد يكاد يكون غير مسؤول. ذات مرة، تأخرنا ولم نصل إلى ضفة نهر اليانغتسي حتى الليل. نظرًا لوجود دير رائع في أعلى الجبل أردنا زيارته، لم يترددوا في إعادة تشغيل المصعد الجبلي، وركبنا رغم العاصفة العنيفة، ثم زرنا الدير على ضوء مصباح يدوي!
في بيجينغ، خلف سور الصين العظيم، رأينا المدينة المحرمة والقصر الصيفي والعديد من المعالم الأثرية الأخرى. في شيان -وهي مدينة فاتنة لا تزال محاطة بأسوارها القديمة- رأينا المقبرة الاستثنائية الشهيرة لتماثيل الجيش الإمبراطوري. في نانجينغ، زرنا الجسر فوق نهر اليانغتسي، وغيره الكثير. في مدن مثل هانغتشو وسوجو وشاوشينغ وغيرها، كنا نتردد على المقاهي الجميلة المبنية على حدائق البحيرات الاصطناعية التي كان الصينيون مولعين بها. في شنغهاي، رأينا أحياء الموانئ المهيبة في عاصمة الرأسمالية الكومبرادورية هذه، التي قُسّمت إلى امتيازات أجنبية. سافرنا في الريف ذي الطمي المغبر الممتد على طول النهر الأصفر في طريقنا إلى يانان، وعبر حقول الأرز التي تغيب عن سهول الشرق المتوسط. لقد دُهشنا بجبال قوانغشي الرائعة حول قويلين، وسافرنا في نهر لي، ثم عبر قوانغدونغ على طول نهر اللؤلؤ. رأينا هوانغشان، الجبل الأخضر الذي كان مصدر إلهام الرسامين والشعراء، والذي نزلناه مشيًا عبر درج حجري يبلغ طوله 1860 مترًا. لحسن الحظ، كان هناك مدلك أقدام عند سفح الجبل.
في الصين، وهي دولة فقيرة [بالموارد]، لا يمكنك أن ترى الكثير من الفقراء. إنها على النقيض تمامًا من البرازيل، الدولة الغنية التي لا يُرى فيها سوى الفقراء.
عام 1980، أقمنا في دار الضيافة الرئيس المخصص لضيوف الحزب، على أطراف بيجينغ. لا شك أننا تلقينا معاملة خاصة، لكن لهذا السبب، أحببنا المدينة أكثر حين أقمنا في أحد الفنادق في وسطها، والتي أصبحت اليوم كثيرة جدًا.
خلال الحقبة الماويّة التي عشناها بشكل مباشر، قدمت بيجينغ مشهدًا لا يُنسى لنهر من الدراجات يملأ عرض شوارعها الهائلة بالكامل. «بدلة ماو» (التي ابتكرها سون يات سِن) بلونها الأزرق أو الأخضر (وهي الألوان العسكرية التي تبناها الشباب الذين أرادوا إظهار يساريتهم داخل الحزب)، مع القبعات التي ارتدتها الفتيات مائلة إلى أحد الجانبين، بشكل جعلهن يظهرن أشبه بأولاد الشوارع وزاد في سحرهن، كانت الزي الرسمي لجميع السكان. لم أجد ذلك بغيضًا على الإطلاق، بل على العكس، أعتقد أنها كانت طريقة جيدة للبدء في خلق بعض الشروط اللازمة لتكريس المساواة بين الأفراد. علاوة على ذلك، كانت السترة الزرقاء متينة وأنيقة. نجحت الصين في عهد ماو تسي تونغ -دون رغبة فعلية في ذلك- في خلق أزياء ثقافية ذات نطاق عالمي بقوة الجينز الأمريكي. اشترينا كميات من سترات ماو -الزرقاء والخضراء والرمادية- وما زلت أنا وإيزابيل نرتديها يوميًا تقريبًا عندما يسمح الطقس بذلك. قد ينظر إلينا البعض على أننا «ديناصورات»، لكن هذا لا يهم. اليوم، للأسف، تم التخلي عن هذا الزي الرسمي واستبداله بين الرجال بالبدلة وربطة العنق عديمة الهوية. لكن التخلي عن سترة ماو الزرقاء أو الخضراء يسمح للشابات الصينيات، اللواتي أجدهن جميلات عمومًا، بإبراز أناقتهن، بالفساتين الخفيفة وقبعات القش الصغيرة المزينة غالبًا بالزهور، أو الفساتين الصينية المشقوقة على الجانب، في المناسبات الرسمية.
بيجينغ مدينة غير اعتيادية. قبل التحديث المتسارع في السنوات الأخيرة، احتفظت بطابعها كعاصمة إمبراطورية صارمة. شوارع طويلة مستقيمة، ضيقة نوعًا ما، تحدها جدران رمادية بشكل موحد، تخفي خلفها اليامين. واليامين هو سكن أرستقراطي مربع يلتف حول فناء مغلق، يفصله عن الخارج باب صيني جميل. من الشارع، يمكن رؤية أسطح القرميد الملون، ويعزز تباينها مع الوقار الشديد للجدران التنوعَ الكبير في الألوان وغزارتها. عاش صديقانا سول وباتريشيا أدلر في أحد مباني اليامن الرائعة في شارع نانكاوتشانغ (الذي عاش فيه دينغ شياوبينغ عام 1949 عندما تم تحرير بيجينغ). كان ماو قد أمر في ذلك الوقت بإخلاء كل هذه المنازل الجميلة واستخدامها إمّا لإيواء أصدقاء أجانب أو كمدارس ومراكز ثقافية. كان سول أمريكيًا جاء برفقة بعثة لمساعدة الصين أثناء الحرب ضد اليابان. ومثل بيل هينتون، الذي كنت أعرفه أيضًا، بقي في البلاد ووضع كل مهاراته في خدمة الصين الماوية. كان لديه الكثير ليقدمه؛ فقد كان مثقفًا، حاذقًا، وضليعًا بالسياسة الأمريكية، بالإضافة إلى وجهات النظر الاستراتيجية التي قدمها حول الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة.
تعاملت السلطات الصينية دائمًا مع أصدقائها الأجانب بأكبر قدر من الثقة الأخوية، حتى خلال أقسى لحظات الثورة الثقافية، عندما كان «الشك» يثقل كاهل الجميع. من هذا المنظور، ليس هناك إطلاقًا ما يشبه سلوك السلطات السوڤييتية، التي كان تصرفها تجاه الأجانب في كثير من الأحيان أكثر من مقيت. مات سول، لكنه كان سيموت قبل ذلك بكثير لو لم يكن في الصين. فقد أصيب بسرطان الرئة، وخضع لعمليات متتالية من قبل أفضل الجراحين في بيجينغ، مما زاد في عمره عدة سنوات.
***
لم يكن تحديث الصين مدمِّرًا، وهذا أمر جدير بالملاحظة. فبعيدًا عن ناطحات السحاب -التي تنتشر سريعًا وتشكل مجموعات تتميز بأساليبها المعمارية المتنوعة، لكنها دائمًا ما تكون متباعدة بشكل جيد- يحرص الصينيون على ترك مساحة كبيرة للأشجار والحدائق التي يحبون التنزه فيها. تعرضت المدينة القديمة لبعض الدمار، لكن، من جهة أخرى، تم تجديد المناطق الأرستقراطية والتسوقية الأنيقة التي كانت قد تدهورت، وإن تم تجديدها أحيانًا أكثر من اللازم! كما حدث في كل مكان آخر في العالم الثالث، أدرك الصينيون متأخرًا أنه يجب الحفاظ على تراثهم. ترميم المدن القديمة، مثل شاوشينغ أو المناطق القديمة في كانتون [الاسم القديم لقوانزو] التي كانت تابعة للامتيازات الإنجليزية والفرنسية، هي شهادة على هذا الوعي.
بشكل عام، يجب الاعتراف بالنجاح الواضح للتحول الحضري الجديد في الصين -التي تضم الآن 400 مليون من سكان المدن،[1] 200 مليون منهم قدموا هم، لا أهاليهم، من المناطق الريفية- سواء من خلال الجودة أو الابتكار الحقيقي في التخطيط الحضري ومعظم مشاريع التطوير السكني. بنت الصين، قبالة هونغ كونغ، مدينة بنفس الحجم في 15 عامًا، هي شِنجِن التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة. أي أن الصين كانت قادرة في 15 عامًا على بناء مدينة بحجم المدينة التي احتاج الإنجليز 100 عام لبنائها. يجب عقد مقارنة هنا: برازيليا مدينة جديدة لكنها بشعة. لكن المدن الصينية الجديدة مثل شِنجِن مدن جميلة.
في الصين، وهي دولة فقيرة [بالموارد] (نجحت في إطعام 22% من سكان العالم بـ6% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم)، لا يمكنك أن ترى الكثير من الفقراء. إنها على النقيض تمامًا من البرازيل، الدولة الغنية التي لا يُرى فيها سوى الفقراء. إنني أختار كلماتي بعناية. فقد قطعت بالسيارة آلاف الكيلومترات عبر مقاطعات الصين الغنية والفقيرة؛ لم يكن هناك ما يمكن مقارنته بالفقر المروع الذي رأيته في كل خطوة في الهند أو مصر أو المكسيك أو البرازيل أو جنوب إفريقيا. كانت هناك قرى صينية غنية، تشابه تلك الموجودة في اليابان، وكانت هناك قرى فقيرة، مثلما كانت موجودة قبل 50 عامًا تقريبًا في بعض مناطق أوروبا، لكن لم يكن هناك ملايين الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، كما هو الحال في كل مكان آخر تقريبًا.
إن مبدأ الأرض كملكية مشتركة، ودعم الإنتاج الزراعي الصغير للعائلات التي لا تملك الأرض، بل حقوق استخدامها، هو مصدر هذه النتائج غير المسبوقة، فقد سمح هذا بالسيطرة النسبية على الهجرة من الريف إلى الحضر. فلنقارن ذلك بالنهج الرأسمالي، كما هو الحال في البرازيل مثلًا، حيث أفرغت الملكية الخاصة للأراضي الزراعية الريفَ البرازيلي. اليوم، يعيش 11% من السكان في المناطق الريفية، ولكن ما لا يقل عن 50% من سكان الحضر يعيشون في العشوائيات (الفاڤيلا)، ويبقون على قيد الحياة فقط بفضل «الاقتصاد غير الرسمي» (بما فيه الجريمة المنظمة). لا يوجد شيء من هذا القبيل في الصين، حيث يعمل ويعيش سكان الحضر، ككل، بشكل لائق.
***
الصينيون، كعاصمتهم، ليسوا اعتياديين. باستثناء التحدي الذي تمثله اللغة، ليس من الصعب التواصل معهم، فهم، عمومًا، فضوليون تجاه ملاقاة الأجانب ويفاتحونهم الحديث دون تردد. لم تعزل الحكومة الأجانب عن السكان أبدًا كما كان الحال في الاتحاد السوفييتي. أحب التنزه في شوارع بيجينغ. في أحد أمسيات أيلول الرطبة، ذهبت إلى ميدان تيانانمِن. الصينيون فلاحون وسلوكهم شعبي للغاية. امتلأت الساحة بالعائلات التي جاءت للتنزه: يفرشون أغطية بلاستيكية على الأرض، ويتمدد بعضهم على وسائد، بينما يجلس آخرون على مقاعد قابلة للطي، ويُخرجون علب البسكويت وترموسات الشاي، التي لا يخرج أحدٌ بدونها إلى أي مكان، فيما كان كثيرون يأكلون البطيخ. ناداني أحدهم ودعاني للانضمام إلى نزهتهم، فقبلت وحاولت الدردشة. كان عليهم أن يجندوا من المتنزهين المجاورين شابًا تعلم القليل من اللغة الإنجليزية. تحدثنا في السياسة، بطبيعة الحال، وبحرية عالية. بالنسبة لـ«السوق»، فقد كانوا ينظرون إليه على أنه جيد من بعض النواحي، لكن بقدر ما جعل بعض الناس أثرياء، فقد اعتُبر ذلك سيئًا.
إن مبدأ الأرض كملكية مشتركة، ودعم الإنتاج الزراعي الصغير للعائلات التي لا تملك الأرض، بل حقوق استخدامها، هو مصدر النتائج غير المسبوقة التي حققتها الصين، فقد سمح بالسيطرة النسبية على الهجرة من الريف إلى الحضر.
في التجمعات الصينية العامة، هناك تنوع اجتماعي كبير لا مثيل له في معظم مناطق العالم الثالث. يختلط الفتيان والفتيات بحرية، والعشاق لا يختبئون. لكن لو خدشنا هذا السطح قليلًا، كما يقال، فسنجد الجوهر الصلب للنظام الأبوي. هذا صحيح بلا شك، ولكن، مع ذلك، يمكن أن نرى التقدم [الاجتماعي]، على سبيل المثال، في السلوك الجريء للفتيات اللواتي لا يترددن في وضع الفتيان عند حدهم عند الضرورة، وبلا استحياء. لا يوجد ما يشبه ذلك في اليابان أو كوريا حيث ما تزال العادات الأبوية الأصلية نفسها تحكم جميع السلوكيات اليومية. يمكن ملاحظة نفس السلوك المنفتح بين زملاء العمل. فالصينيون، كما أسلفت، فلاحون ويحبون تناول الطعام في مجموعات. في العديد من المطاعم في المدن الصينية، تخصص نصف المساحة على الأقل لأكشاك مفصولة بستائر خفيفة، حيث يمكن للمجموعات أن تشعر بالراحة وتتمتع بألفة معينة في جو كهذا. لا تُضاع فرصة لتنظيم وليمة جماعية أو عائلية من هذا النوع: احتفالات رسمية، تقاعد زميل في العمل، ترقية زميل لمنصب جديد.. إلخ. الصينيون «دَفِشون»: يشربون كثيرًا (على الأقل، في هذه المناسبات)، ويأكلون ما استطاعوا، وكما قيل لي، يستخدمون لغة مباشرة وفجة نوعًا ما.
هناك جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية الصينية يجب ملاحظتها. رغم الثورة الثقافية، لم يتم القضاء على الكونفوشية، فنموذج القائد «المثالي» ظل كونفوشيًا: كيّس، رصين، هادئ، ومهذب. عندما كان ماو على قيد الحياة، كان يرتدي مثل الآخرين، لكن ما ميزه هو كياسته الرفيعة التي لم تنل تقديرًا كافيًا. كان وانج يوي «العجوز»، الذي كان مرشدنا خلال رحلتنا الأولى إلى الصين، نموذجًا مثاليًا لهذه الشخصية.
رغم أنها تحوي أبعادًا محافظة جلية، فإنني أدرك أن الأيديولوجيا الكونفوشية قد طورت أيضًا ما يبدو لي أنه صفات جيدة. خلال الحقبة الماوية، تم تقسيم القادة بشكل واضح إلى نموذجين: الكونفوشيون، الذين لم يكونوا جميعًا في صف واحد، بل كان بعضهم على اليمين، وبعضهم في الوسط، وبعضهم على اليسار؛ والبروليتاريون. جاء قادة النموذج الثاني مباشرة من الطبقة العاملة أو الفلاحين الفقراء الذين كانوا دائمًا تقريبًا مناهضين للكونفوشية من حيث المبدأ، لأسباب وجيهة (فالكونفوشية هي أيديولوجيا الطبقة المهيمنة في الصين التقليدية)، وكان الفلاحون منهم متأثرين بشدة بالطاوية. لم تعترف الثورة الثقافية سوى بهذا النوع الثاني من القادة كشيوعيين. اليوم، ظهر علانية نوع ثالث: النموذج البرجوازي. أقول بلا تردد: أسلوب هؤلاء محدث النعمة، وكومبرادوري، ومبتذل. في الفنادق الفاخرة، وعلى متن القارب أثناء رحلتنا البحرية على نهر اليانغتسي، كان هؤلاء (ولا يزالون) ظاهرين جدًا للعيان. من أين أتوا؟ معظمهم صينيون من الخارج، وكانوا دائمًا على هذا النحو. هل باتوا يترسخون في دوائر «الرياديين» الصينيين الجدد؟ على الأغلب.
***
أنا معروف في الصين. لقد تُرجمت الكثير من كتاباتي إلى اللغة الصينية، أحيانًا بسرعة أكبر من الإنجليزية (هذا هو الحال بالنسبة للمقابلات حول «الثورات العربية» والتطورات السياسية في إفريقيا وروسيا وأماكن أخرى). لذا، فقد استقبلني قادة مؤثرون في العديد من مؤسسات البلاد: معهد الماركسية اللينينية وفكر ماو تسي تونغ، ومركز السياسة العالمية، ومركز الصين للسياسة والاقتصاد المقارن، وجامعة تسينغ هوا، وجامعة بيجينغ، ودورية الفكر النقدي الدولي، ودورية الماركسية والواقع، ومجلة بيجينغ الثقافية، وكذلك صحيفة تشاينا ديلي ومحطات تلفزة. في بعض الأحيان، جرت استشارتي في مسائل صعبة ومثيرة للجدل في المؤسسة الصينية.
[من بين هؤلاء القادة الذي دعوني للحديث في الصين]، كان وِن تيجون أفضل خبير بظروف الريف، وقد تعلمت منه كل ما تذكره هذه المذكرات في هذا الخصوص. كما شاركني الفهم ذاته لضرورة مقاومة الصين للعولمة المالية، التي تمثل شرطًا لنجاح أي «مشروع سيادي» يرتقي لهذا الاسم. أما وانغ هوي، الذي نشرت أعماله وعُرف في الخارج، فقد أوضح لي المنظور الصيني للتاريخ طويل الأمد والآراء الصينية حول العالم المعاصر والتحدي الذي يمثله. بينما ساعدني هوانغ بينغ أكثر من أي شخص آخر في الوصول لفهم أفضل للتفاصيل الدقيقة للصراعات التي تنشأ داخل الطبقة السياسية الحاكمة في الحزب والدولة. وعن بُعد، تعلمت الكثير من لين شون، ليس عبر قراءة أعمالها فحسب، بل عبر نقاشاتي معها.
على وجه الخصوص، دعاني إلى الصين اثنان من الرفاق الذين شغلوا مناصب رفيعة نسبيًا في التسلسل الهرمي، وهما وانغ يوي وپو شان. كان الراحل وانغ مسؤولاً عن متابعة أنشطة الماويين في العالم الثالث. كان پو ووانغ أكاديمييْن، وفي رأيي، كانا من بين القادة الأكثر انفتاحًا وذكاءً واطلاعًا على ما كان يجري في العالم خارج حدود الصين. كنت دائمًا أستمتع بالحديث معهم.
خلال الحقبة الماوية، تم تقسيم القادة بشكل واضح إلى نموذجين: الكونفوشيون، الذين لم يكونوا جميعًا في صف واحد، بل كان بعضهم على اليمين، وبعضهم في الوسط، وبعضهم على اليسار؛ والبروليتاريون.
كان المترجم المكلف بمرافقتنا هو الشاب لي باويوان. درس لي في جامعة إيكس وتحدث الفرنسية بطلاقة. وعلاوة على ذلك، كان مثقفًا ويعرف فرنسا وحياتها الثقافية والاجتماعية والسياسية جيدًا. كان لي أفضل مترجم ممكن للمحاضرات التي ألقيتها، خاصة وأنني لم أرغب في تقديم تحليلاتي بدقة ووضوح أقل من أي مكان آخر. لقد تلقيت أسئلة صعبة حول النظرية الماركسية، وقدمت أطروحاتي حول الرأسمالية العالمية ومجتمعات العالم الثالث، ولا سيما تلك الموجودة في إفريقيا والعالم العربي. لقد أدركت، في هذه المناسبة، أن أطروحاتي لم تكن مجهولة في الصين. فقد تُرجم الكثير من كتاباتي ورُوّج في الدوائر الأكاديمية واللجنة المركزية للحزب، كما تم نشر بعضها للجامعات والجمهور، ولم أكن على علم بكل ذلك. (اسمحوا لي أن أشير بشكل عابر إلى أن السوڤييت لم يترجموا سطرًا واحدًا من كتاباتي، الأمر الذي لم يمنع بعضهم من «التنديد» بي في مجلاتهم!). أصبحنا ولي باويوان أصدقاء، وقد جاء هو وزوجته ييپينغ بعد ذلك إلى داكار، حيث كان السكرتير الأول للسفير، وقد رأيناهما مؤخرًا في بيجينغ.
لقد ابتكرت في الصين صيغة أسعدت مضيفينا، فقد فهمت جيدًا كم هو مرهق بالنسبة للصينيين استقبال كل هؤلاء الأجانب الفضوليين للتعرف أكثر عن بلدهم عبر الاستجواب المتكرر، دون تقديم أي شيء لمضيفيهم في المقابل. لذا، وضعت نفسي مكانهم، واقترحت على مضيفي التناوب: في أحد الأيام، سأحضُر نقاشًا يكون التركيز فيه على الصين ومشاكلها، وسأطرح أسئلة وأبدي تعليقات وما إلى ذلك. وفي اليوم التالي، أقدم عرضًا تقديميًا حول موضوع يتعلق بإفريقيا أو العالم العربي أو النظام العالمي أو مشاكل الاشتراكية والماركسية، ليكون بدوره محور نقاشنا الجماعي. نجح هذا النهج بشكل مثالي، وسمح لي بإقامة علاقة جيدة مع الصينيين. لم يعد بإمكاني إحصاء عشرات النقاشات التي شاركت فيها ضمن هذا الإطار، وبدعوة من معاهد أكاديمية مختلفة ومدارس إدارة في بيجينغ ونانجينغ وشنغهاي وتشنغدو.
في بعض الأحيان، جمّع المشاركون الصينيون الكثر أنفسهم وفقًا لانتماءاتهم السياسية، كما في البرلمان: يسارٌ ووسطٌ ويمين، كما هو الحال دائمًا وفي كل مكان. ما أدهشني هو أنه في كل مجموعة، كان هناك رجال -ونساء بدرجة أقل- من جميع الأعمار، من العشرينيات إلى الثمانينيات. وقد كان كبار السن يعامَلون دائمًا باحترام كبير من قبل أنصار وجهات النظر التي يمثلونها. ناقشنا القضايا بحرية كبيرة، لا يمكن مقارنتها بالجو السائد في العالم السوڤييتي، حيث لم يكن واردًا أن يُدعى شخص لتقديم عرض حول قضايا مهمة من وجهة نظر تدعي أنها ماركسية، دون أن تكون بالضرورة أرثوذكسية. في العالم السوڤييتي، كان أساتذة الولايات المتحدة الرجعيين هم من يتلقون الدعوات، وكان يصغى لكلامهم الليبرالي الفارغ باحترام، وحتى بإعجاب صريح. بخلاف الموقف الرسمي، كانت هذه هي وجهة النظر الوحيدة التي يمكن سماعها. في الصين كان الأمر مختلفًا تمامًا؛ فقد كانت النقاشات مفعمة بالحيوية، واحتدمت في بعض الأحيان مع دوي التصريحات المنطلقة من وجهات نظر مختلفة. لقد عبرتُ دائمًا عن وجهة نظري دون تحفظ، وإنْ بلغة لبقة دومًا، وهو ما رأيته مهمًا جدًا.
لقد أكسبني ذلك، على ما أعتقد، شرف أن أُعدّ صديقًا مخلصًا للصين، وأنا بالطبع كذلك. بالتأكيد، لدي آراء حول العديد من المشاكل فيها، لكنني لا أعتبر نفسي أحد أولئك الذين يعتقدون أنهم تناولوا حبة سحرية تضمن أن وجهة نظرهم هي الأفضل بالضرورة. أقدم حججي وأستمع إلى الحجج التي يقدمها الآخرون.
ختامًا، لن أقدم تنبؤات بعيدة المدى كالتي يقدمها علماء المستقبل الغربيين؛ هل ستكون الصين «حتمًا» الاقتصاد الأول في العالم -الرأسمالي والإمبريالي بالطبع- حتى دون أن تكون القوة العسكرية الأولى؟ (أشك في أنه من الممكن أن تكون الأولى في واحدة دون الأخرى)، أم سينهار هذا العملاق ذو الأقدام الطينية، مثل الاتحاد السوڤييتي الذي بدا في الثلاثينيات من القرن الماضي أنه يبني نظامًا متفوقًا على الولايات المتحدة وأوروبا المثقلتين بالأزمات؟ لن أقدم إجابة لسؤال زائف كهذا. بالنسبة لي، لا يزال التاريخ مفتوحًا؛ الأفضل والأسوأ كلاهما ممكن. وكل هذا يتوقف على تطور الوعي السياسي للشركاء والمعارضين الذين يقاتلون في مجتمع ما، في الصين كما في أي مكان آخر.
على أية حال، فإن مستقبل الصين يعتمد، في رأيي، على الصينيين. والغربيون الكثر الذين يقدمون المواعظ حول فضائل السوق أو الكفاءة أو حتى الديمقراطية، لا يمكنهم تحمل هذه الحقيقة. إن الصينيين، مثلهم مثل غيرهم، يعرفون كل ذلك، أو يمكنهم التعرف عليه بمفردهم. فخيارات الصين، كما هو الحال في أي مكان آخر، هي نتيجة الصراعات الطبقية وما يترتب عليها من حلول وسط. يمكن للمرء بالطبع أن يتأمل خيارًا معينًا، وأن يراه جيدًا أو سيئًا، وله الحق في أن يقول ذلك. لكن لا يسعنا، في رأيي، إلا أن نأمل أن تتمكن الصين من تثبيت نفسها كقوة راسخة قادرة على مواجهة الهجمات الخارجية. في الواقع، هذا شرط ضروري لبزوغ [السيناريو] الأفضل، من منظور المستقبل الاشتراكي للبشرية. وبهذا المعنى الدقيق، أنا «صديق للصين». وعلى هذا الأساس، أرفض رفضًا قاطعًا دعم أولئك الذين ينحازون في النهاية إلى الأهداف الاستراتيجية للهيمنة الأمريكية، المتمثلة في إضعاف الصين وتفكيكها من خلال دعم التبت وشينجيانغ، وتشجيع الميول الانفصالية بين الكومبرادور، وإبراز الشعارات «الديمقراطية» ظاهريًا التي يمكن التلاعب بها بكل بساطة لخدمة أهداف الإمبريالية المناهضة للاشتراكية. حقيقة أن أوجه قصور السياسات التي تنفذها دولة الحزب تخلق أرضية مواتية للعدو الإمبريالي هي مسألة أخرى، وأنا لا أخفي رأيي حول هذه النقائص. لكن الحل الذي تدعو إليه القوى المهيمنة في الرأسمالية العالمية ليس الخيار الأفضل قط، بل على العكس؛ إنه دومًا الأسوأ.
-
الهوامش