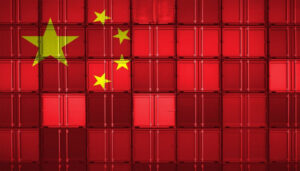لم يحتج الأمر أكثر من ساعات معدودة مساء 17 تشرين الأوّل حتّى يتحوّل الشارع اللبناني إلى كتلة من اللهب المشتعل. دون سابق إنذار انطلقت المظاهرات العفويّة في الساحات الرئيسيّة، وقطع المحتجّون الغاضبون الطرقات الرئيسيّة في العاصمة بيروت ومختلف المناطق، وسرعان ما أدرك الجميع أن انتفاضة ما بدأت بالحدوث. كانت الشرارة المباشرة تناقل وسائل الإعلام تصريحات لوزير الاتصالات محمد شقير تفيد بترحيب الجميع في مجلس الوزراء بفكرة ضريبة جديدة على اتصالات الواتساب، لكنّ الأمور على الأرض ذهبت أبعد من تصريح شقير بكثير: من دعوات إلى إسقاط حكومة العهد، إلى المطالبة بإسقاط العهد نفسه، والمقصود بطبيعة الحال عهد رئيس الجمهوريّة اللبناني ميشال عون. أمّا البعض الذي امتلك جرأة أكثر على الحلم، فذهب في الهتافات على الأرض إلى المناداة بإسقاط النظام الطائفي ورموزة قاطبةً. وإذا كانت الاحتجاجات قد اشتعلت على خلفيّة فكرة ضريبة الواتساب، فالأكيد أنّ ثمّة ما كان يتراكم على مدى السنوات الماضية، على شكل كرة نار تدحرجت ببطء، قبل أن يحدث في أيام ما لم يحدث خلال سنوات.
ألم الأزمة الاقتصاديّة
عمليًّا، ظهرت أولى بدايات الأزمة الماليّة في لبنان سنة 2011 مع تسجيل أوّل عجز في ميزان المدفوعات، لكنّها لم تحظى بالاهتمام الرسمي فعلًا إلا سنة 2016، ومنذ ذلك الوقت تعامل جميع أصحاب القرار مع مؤشّراتها النقديّة المباشرة بجديّة، خصوصًا أنّها مسّت للمرّة الأولى بالمسلّمات التي قام عليها النموذج الاقتصادي اللبناني منذ التسعينات: القدرة على تثبيت سعر الصرف، والحفاظ على سلامة مصدر تمويل الدين العام الأساسي، أي المصارف والنظام المالي. لكنّ الاهتمام البالغ بالمؤشّرات النقديّة وتفاعلاتها، والتركيز على المعالجات التي يجريها مصرف لبنان لاستيعاب تداعيات الأزمة، لم يوازِه أي اهتمام بآثار الأزمة على المستوى المعيشي والاجتماعي المباشر. وبينما كانت الدولة تحاول شراء الوقت قبل حصول الانهيار على المستوى المالي والنقدي، لم يلتفت المعنيّون إلى أنّ الأزمة راكمت خلال سنوات قليلة ما يكفي من أسباب الانفجار على المستوى الاجتماعي والشعبي.
فعجز ميزان المدفوعات مثلًا، بلغ حدود الـ5.3 مليار دولار حتّى شهر تموز الماضي، مقارنةً بـ757.2 مليون دولار في الفترة المماثلة تمامًا من العام الماضي، أي سبعة أضعاف العجز السابق. مع العلم أن هذا المؤشّر يختصر صافي التحويلات الماليّة بين لبنان والخارج، ويرتبط بشكل وثيق بقدرة البلاد على مراكمة العملة الصعبة لتثبيت سعر الصرف وتمويل فوائد الدين العام بالعملات الأجنبيّة. وكردّة فعل على على هذا العجز الهائل، توسّع المصرف المركزي في امتصاص العملة الصعبة من الأسواق من خلال عمليّات استثنائيّة، لتعزيز احتياطي العملات الصعبة لديه وحماية قدرته على التدخّل لتثبيت سعر الصرف.
وبينما كان المصرف المركزي يدرس المشهد ويتصرّف من الزاوية النقديّة والماليّة البحتة، كانت هذه السياسات تراكم آثارًا بالغة الأهميّة على المستوى المعيشي، وتحديدًا على شكل انكماش اقتصادي مؤلم من الناحية الاجتماعيّة. فامتصاص السيولة أدّى تدريجيًّا إلى تقلّص الكتلة النقديّة المتوفّرة في الأسواق، وهو ما ضرب بشكل مباشر أي قدرة على تحقيق نمو اقتصادي خلال هذه السنة. وبالنتيجة، كانت البلاد تعاني خلال النصف الأول من السنة من نسبة «صفر بالمئة» على مستوى النمو الاقتصادي بحسب تصريحات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ويبدو أنّ الأمور تتجه نحو نسبة سلبيّة في نهاية العام مع اعتماد الحكومة على سياسات تقشّفيّة على مستوى الإنفاق الاستثماري.
كل هذه الآثار على المستوى الاقتصادي كانت تعني المزيد من الضغوط على مستوى النشاط التجاري، وبالتالي فرص العمل المتوفّرة ونسب البطالة. وبينما يعاني اللبنانيون من غياب الإحصاءات الدوريّة والدقيقة في ما يتعلّق بنسب البطالة تحديدًا، كان الجميع يتناقل يوميًّا أخبار المؤسسات التجاريّة التي تقفل هنا وهناك، والموظّفين الذين خسروا عملهم بفعل إقفال مراكز عملهم نتيجة الأزمة. ومع تفاقم الوضع المعيشي، تزايدت نسبة القروض المتعثّرة في المصارف، والتي لم يعد أصحابها قادرين على تسديدها بفعل تعثّر الأوضاع الاقتصاديّة. وفيما ركّزت وسائل الإعلام على مخاطر هذا المؤشّر على ميزانيّات المصارف، كان هذا المؤشّر بحد ذاته دلالة على مدى تدهور الأوضاع على المستوى الاجتماعي.
كان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم يشعرون بثقل الأزمة الماليّة على أكتافهم، وكذلك الموظّفون الذين ينتمون عادةً إلى الفئات محدودة الدخل. لكنّ في الوقت عينه، كان الجميع يسمع أخبار كبار المودعين الذين كانوا ينقلون ببساطة ثرواتهم إلى الخارج للهروب من آثار الأزمة وتداعياتها، دون أي ضوابط من أصحاب القرار النقدي والمالي. ومن ناحية أخرى، كان الجميع يتناقل أخبار الفوائد الخياليّة التي كانت تمنحها المصارف إلى هؤلاء، بدعم من مصرف لبنان الذي كان يمنح بدوره فوائد خياليّة للمصارف مقابل إيداع هذه الأموال لديه، لامتصاص السيولة بالعملة الصعبة وزيادة احتياطي العملات الأجنبيّة لديه.
باختصار، لطالما استفادت حلقة ضيّقة منتفعة من طبيعة النموذج الاقتصادي اللبناني، حين كان النظام المالي ينتفخ، من خلال الفوائد المرتفعة التي تُدفع على الدين العام لصالح المصارف وكبار المودعين فيها، وكان ذلك على حساب الأغلبيّة الساحقة من محدودي الدخل ودافعي الضرائب. وحين أصبح هذا النموذج على حافّة الانهيار، ذهبت السياسات المعتمدة إلى رمي المزيد من الأثقال على كاهل هذه الفئات مرّة أخرى. كل ذلك كان يخلق تدريجيًّا شعورًا عامًا بانعدام العدالة في ما يتعلّق بتحمّل آثار الأزمة الاقتصاديّة القائمة، ويراكم المزيد من أسباب الانفجار.
تناقضات النظام السياسي
بينما كانت التناقضات الاجتماعيّة تتفاعل منذرةً بانفجار وشيك، كان النظام السياسي يشهد بدوره تناقضات سياسيّة موازية تمهّد لفقدان الإجماع حول التسوية الرئاسيّة التي أنتجت وصول ميشال عون إلى سدّة الرئاسة وتكوين «الحكومة التوافقيّة» الحاليّة. فكعكة المشاريع التي لطالما تقاسمها أقطاب السلطة تقلّصت إلى أدنى حدود مع الأزمة الماليّة التي يمر بها لبنان، والتي فرضت على الحكومة التقشّف إلى أقصى حد امتثالًا لشروط الأطراف المانحة من دول ومؤسسات دوليّة. ومع تقلّص منافع السلطة ومشاريعها، تزايدت التناقضات والخلافات بين أطرافها تدريجيًا. وبمعنى آخر، كان وصول النموذج الإقتصادي إلى حافّة الهاوية مجرّد تمهيد لوصول تقاطع المصالح بين هذه الأطراف إلى طريق مسدود في الوقت نفسه.
لكنّ مسألة أخرى بالغة الأهميّة كانت تحدث، فالتقارب بين التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهوريّة الحالي ميشال عون ويرأسه صهره وزير الخارجيّة جبران باسيل، وتيار المستقبل الذي يرأسه حاليًّا رئيس الوزراء سعد الحريري، كان يثير حفيظة الكثير من الأطراف التي بدأت تشعر أن هذه التقارب سيأتي على حساب حصّتها من منافع النظام الموجود. فالقوات اللبنانيّة برئاسة سمير جعجع بدأت تشعر أن نفوذ العونيين المتزايد في السلطة بدأ يهدد امتدادها في «الشارع المسيحي»، بينما شعر وليد جنبلاط بانحسار نفوذه داخل الحكومة نتيجة المسألة نفسه، خصوصًا مع تحريك العونيين لبعض خصومه المباشرين في جبل لبنان الجنوبي الذي يُعد معقله.
اقرأ/ي أيضا:
كانت هذه التناقضات الداخليّة مجرّد تمهيد لانفراط عقد إجماع القوى السياسيّة المشاركة في الحكومة، وهو ما انعكس لاحقًا باستقالة وزراء القوات اللبنانيّة مع اشتداد موجة الاحتجاجات، وانضمام محازبيها إلى المتظاهرين في عدّة مناطق. وفي الوقت نفسه، بدا سلوك وليد جنبلاط أقرب إلى مواكبة الإحتجاجات القائمة من خلال خطابه، مع عدم الوصول إلى مرحلة الاستقالة المباغتة من الحكومة ربّما حفاظًا على علاقته مع رئيس الحكومة سعد الحريري. وفي الواقع، يبدو أن الحزبيْن أدركا باكرًا أن تقلّص حصّتهما من غنائم السلطة والنظام السياسي لم ينتجا فقط عن تقارب طرفي التسوية الرئاسيّة (عون والحريري)، بل أيضًا عن تردّي واقع الدولة المالي نتيجة وصولها إلى مأزق اقتصادي ونقدي كبيرين، ولذلك، ربّما أراد الحزبان أخذ موقف متميّز عن باقي أطراف السلطة للتخلّص من الآثار السياسيّة التي يمكن أن تصيبهما على المستوى الشعبي نتيجة أي انهيار اقتصادي شامل مقبل.
ومع تناقضات الأطراف المنخرطة في إدارة النظام السياسي نفسه، كان ثمّة سخط عام يسري في الشارع نتيجة تكرار حوادث قمع الحريّات، بما كان يوحي بعودة الدولة البوليسيّة. فبين إلغاء حفل فرقة مشروع ليلى خلال الصيف الماضي ووقوف الدولة في موقع المتفرّج على قمع السلطة الدينيّة لحفل فنّي انتظره كثير من اللبنانيين، وتكرار استدعاء الناشطين إلى التحقيقات نتيجة مواقف أو تصريحات مناهضة لبعض الزعماء، كانت الخشية تتصاعد من تقلّص هامش الحريّة في المجتمع اللبناني، وهو ما كان يولّد شعورًا متزايدًا بضرورة التصرّف إزاء هذا الاتجاه الذي بدأ عهد الرئيس ميشال عون بأخذه. وفي الواقع، ثمّة ما يوحي بأن لجوء الدولة إلى هذا الدور البوليسي كان مجرّد إدراك منها لانسداد أفق النظام على المستوى السياسي العام، ولحاجته إلى دور بوليسي قمعي قادر على فرض التوازنات المطلوبة على الساحة السياسيّة.
وفي النتيجة، خلق كل ذلك إقرارًا عامًّا بوجود مأزق في بنية النظام السياسي، يوازي مأزقه الناتج عن وصول النموذج الاقتصادي إلى طريق مسدود، وهو ما كان يفتح الطريق تدريجيًّا للأحداث الأخيرة التي شهدتها شوارع لبنان. وبمعزل عن كل التوازنات القائمة بين أقطاب السلطة، والتناقضات التي كانت تتفاعل بينها، سرعان ما أخذت الأمور على الشارع منحى جذريًا رافضًا لجميع الأطراف المشاركة في السلطة، والتي ساهمت في وصول البلاد إلى هذا الوضع.
حرائق الغابات وحرائق السياسة
قبيل اندلاع الاحتجاجات، كان اللبنانيّون يشاهدون على شاشات التلفزة الحرائق التي كانت تغطّي مساحات واسعة من المناطق الحرجيّة، وكان ثمّة إقرار عام بوجود تقصير وفشل فادح لدى السلطة السياسيّة إزاء هذه الأحداث. ساهمت تلك الأحداث في رفع منسوب الاحتقان لدى الشارع اللبناني، وأضافت أسباب جديدة لديه للاقتناع بعدم وجود أي جدوى لانتظار «الإصلاحات» المطلوبة من هذه الطبقة السياسيّة تحديدًا، خصوصًا بعدما تبيّن وجود مروحيّات مكلفة لمكافحة الحرائق بحوزة الدولة اللبنانيّة، تم شراؤها سابقًا ولم يتم بذل الجهد المطلوب لصيانتها والحفاظ عليها.
في المحصّلة، شهد لبنان خلال أيام قليلة ما لم يشهده منذ سنوات. فمنذ الحراك المدني الأخير سنة 2015، لم تشهد الساحات هذا الزخم والتمرّد الذي شهدته الأيام الماضية. وبينما تظافرت عدّة عوامل سياسيّة وإقتصاديّة وبيئيّة لتدفع الشارع بهذا الاتجاه، لا يبدو أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها قريبًا. فالزخم الذي شهدته الشوارع خلال الأسبوع الماضي يوحي بوجود إصرار غير مسبوق على متابعة الانتفاضة في وجه النظام السياسي حتّى النهاية. وإذا كان ثمّة هامش من الاختلاف بين المتظاهرين حول الهدف القصير الأجل من التحرّكات، فالأكيد أن التحرّكات بحد ذاتها تشكّل اليوم مأزقًا شعبيًا غير مسبوق لجميع الأطراف المشاركة في السلطة، حتّى تلك التي تحاول اليوم الابتعاد عن طبق السلطة بعدما وجدت عمق الأزمة التي دخل فيها النظام.