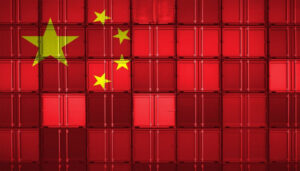نشر هذا المقال بالإنجليزية في مجلة «ديسينت»، بإذن من المجلة والكاتب، وهو مقتبس من كتاب «الأتمتة والعمل في المستقبل».
غيّر الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي الطريقة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض ومع العالم حولنا. ما الذي يمكن أن يحدث إذا انتقلت هذه التكنولوجيا الرقمية من الشاشة واندمجت أكثر في العالم الواقعي؟
روبوتات صناعية متقدمة وسيارات وشاحنات ذاتية القيادة، وأجهزة الكشف عن السرطان، كلها تبشر بعالم من الراحة، ولكنها في الوقت ذاته تشعرنا بالقلق. على أي حال، ماذا سيفعل البشر في مستقبل مؤتمت إلى حدٍّ كبير؟ هل سيكون بإمكاننا أن نهيئ مؤسساتنا لتدرك أن الحلم الإنساني بالحرية يحتمل أن يحققه عصر جديد من الآلات الذكية؟ أو هل يمكن لهذا الحلم أن يكون كابوسًا؟
يطرح خطاب الأتمتة الجديد هذه الأسئلة ويصل إلى نتيجة مستفزة: البطالة التقنية قادمة، ويجب التحكم بها عن طريق اعتماد دخل أساسي شامل، باعتبار أن شرائح كبيرة من الناس ستفقد إمكانية الحصول على الأجور التي يحتاجونها للعيش. هل كان منظرو الأتمتة على صواب في اعتقادهم هذا؟
يأتي تصاعد خطاب الأتمتة اليوم كردٍ على توجه عالمي حقيقي: هناك عدد قليل من الوظائف لعدد كبير من الناس. نقص الطلب المستمر على العمالة يظهر في تغيرات اقتصادية مثل انتعاشات البطالة وركود الأجور، وتفشي انعدام الأمان الوظيفي. كما يظهر على شكل ظواهر سياسية يحفّزها انعدام المساواة: كالشعبوية والبلوتوقراطية، وظهور النخبة الرقمية أصحاب التملك البحري بالاستيلاء، المهتمين بالهرب إلى المريخ على متن الصواريخ عوضًا عن تحسين حياة الطبقة الرقمية الكادحة التي سيتركونها وراءهم في كوكبنا المشتعل.
يمكننا الإشارة إلى الجماهير العاطلة والمشردة في مدينة أوكلاند في كاليفورنيا من جهة، ومن جهة أخرى وعلى بعد أميال قليلة فقط في فريمونت، نرى طاقم العاملين المكون من روبوتات في مصنع تسلا. من السهل أن نصدق أن منظري الأتمتة على حق، ولكن تفسيرهم بأن التغيرات التكنولوجية الجامحة تقضي على الوظائف هو ببساطة أمر غير صحيح.
الطلب على العمالة سيكون منخفضًا بشكل دائم
هناك نقص مستمر في الطلب على العمالة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل أكبر في بلدان مثل جنوب أفريقيا والهند والبرازيل. ولكن ما يسبب هذا النقص هو في الغالب عكس ما يذكره منظرو الأتمتة. إن نسبة إنتاجية العمل لا ترتفع في الواقع، بل تنخفض. كان على هذه الظاهرة أن ترفع من الطلب على العمالة، ولكن توجهًا آخر طغى على انخفاض الإنتاجية: الوضع الذي شرحه عالم الاقتصاد الماركسي روبرت برينر تحت مسمى «الكساد الطويل» (Long Downturn)، ثم أطلق عليه علماء اقتصاد آخرين اسم «الركود المزمن» (Secular Stagnation)، إذ نمت الاقتصادات بوتيرة بطيئة وبصورة تدريجية منذ السبعينيات.
ما السبب؟ عقود من فرط الإنتاجية الصناعية العالمية التي دمرت عجلة النمو الصناعي، ولا يوجد بديل لذلك حتى الآن. على الأخص في الأنشطة بطيئة النمو ومنخفضة الإنتاجية، التي تشكل أغلب قطاع الخدمات. حين يتباطأ النمو الاقتصادي، تنخفض معدلات خلق الوظائف. إن النمو المتباطئ -وليس تقويض فرص العمل الناتج عن التكنولوجيا- هو ما سبب انخفاض الطلب العالمي على العمالة.
في جهودها لإنعاش الاقتصادات الراكدة، قضت الحكومات ما يقرب من نصف قرن في فرض سياسات تقشفية قاسية على شعوبها، حيث نقص الإنفاق على المدارس والمستشفيات وشبكات المواصلات وبرامج النفع العام.
إذا امتدت نظرتنا بعيدًا عن تركيز منظري الأتمتة على المصانع الآلية الجديدة والروبوتات الاستهلاكية التي تلعب البينغ بونغ، سنرى عالمًا ببنية تحتية متداعية، ومدنًا تعاني من انحسار التصنيع، وممرضات مرهقات، ومندوبي مبيعات يتقاضون أجورًا منخفضة. كما سنرى كميات ضخمة من رأس المال المُأمْوَل، مع تضاؤل الأماكن التي يمكن استثماره فيها.
في جهودها لإنعاش الاقتصادات الراكدة، قضت الحكومات ما يقرب من نصف قرن في فرض سياسات تقشفية قاسية على شعوبها، حيث نقص الإنفاق على المدارس والمستشفيات وشبكات المواصلات وبرامج النفع العام. وفي الوقت ذاته لجأت الحكومات والمشاريع التجارية والعائلات للاقتراض، الذي شجعه الانخفاض الشديد في معدلات الفائدة.
وضعت هذه التوجهات الاقتصاد العالمي في وضع وخيم في وقت يواجه فيه أحد أكبر تحدياته على الإطلاق: الركود العالمي الناتج عن كوفيد-19. أصبحت أنظمة الصحة المتداعية تفيض بالمرضى، وأغلقت المدارس التي كانت مصدرًا مهمًا لتغذية العديد من الأطفال، بالإضافة لكونها مساحة يحتاجها الأهالي بشدة لرعاية أطفالهم خلال النهار. وفي هذه الأثناء كان الاقتصاد ينهار. وبغض النظر عن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية الهائلة، من غير المحتمل أن تتعافى الاقتصادات الضعيفة بسرعة من الصدمة.
مع انخفاض معدلات الاستثمار، لا يكون هناك داعٍ للخوف من الأتمتة
لهذا السبب، لا يصح التنبؤ بقدوم موجة من الأتمتة الناجمة عن الجائحة. رغم أن ما سبب خسارة الوظائف لم يكن التغير التكنولوجي فحسب -على الأقل ليس الآن-، ولكن منظري الأتمتة مثل مارتن فورد وكارل بينيدكت فري يزعمون بأن انتشار الجائحة سيسرع من الانتقال إلى مستقبل أكثر أتمتة. ويقولون إن ما سنفقده من الوظائف لن يعود أبدًا، لأن الروبوتات التي تقوم بالطبخ والتنظيف والرعاية وإعادة التدوير ووضع مشتريات البقالة في أكياس، لا يمكنها أن تصاب بفيروس كورونا المستجد أو تنقله للآخرين، بعكس نظرائها من البشر.
ستقدم القليل من الشركات على استثمارات كبيرة، بينما تكتفي معظم الشركات بالقدر الذي تملكه من الطاقة الإنتاجية، وبهذا يتم التوفير بالاستغناء عن العمالة والإسراع من وتيرة العمل لبقية العمال.
هنا، التبس الأمر على منظري الأتمتة فخلطوا بين الفائدة التقنية من انتشار الأتمتة -وهي بحد ذاتها تعتبر فرضية ضعيفة أكثر من كونها استنتاجًا مثبتًا- وبين جدواها الاقتصادية. لا يمكننا إنكار أن بعض الشركات قد استثمرت في روبوتات متقدمة كرد على أزمة كوفيد-19. حيث اشترت وول مارت لمحلاتها في الولايات المتحدة روبوتات ذاتية القيادة، تمسح البضاعة وتنظف الممرات. وتوقعًا لتضاعف الطلبات الإلكترونية، تجرب بعض محلات البيع بالتجزئة استخدام الروبوتات في مراكز تلبية الطلبيات، لمساعدة العمال على تجميع الطلبيات بشكل أسهل.
ولكن استخدام هذه التكنولوجيا سيكون على الأرجح استثناءً عن القاعدة حتى مستقبل قريب. لا توجد أسباب لتوقع ارتفاع الطلب بعد حالة الركود الشديد، وبالتالي ستقدم القليل من الشركات على استثمارات كبيرة، بينما تكتفي معظم الشركات بالقدر الذي تملكه من الطاقة الإنتاجية، وبهذا يتم التوفير بالاستغناء عن العمالة والإسراع من وتيرة العمل لبقية العمال. هذا بالضبط ما قامت به الشركات بعد الركود الأخير.
في غالب الأحيان، يفترض المعلقون أن عجلة الأتمتة تسارعت في العقد الثاني من الألفية، ويسندون توقعاتهم للمستقبل على هذا الافتراض الخاطئ للماضي. في الواقع، لا يوجد هناك طلب لتبرير هذه الاستثمارات. في الولايات المتحدة، شهد العقد الثاني من الألفية أقل معدلات من تراكم رأس المال ونمو الإنتاجية في زمن ما بعد الحرب، وستزيد أزمة كوفيد-19 من هذه التوجهات، والتي ستؤدي إلى موجة أخرى من إنعاش البطالة في العقد القادم.
ستندثر الوظائف حتى دون الأتمتة
سيخلّف الركود المرتبط بأزمة كوفيد-19 حول العالم تركات من البطالة ونقص العمالة من الصعب التعافي منها. تقدّر منظمة العمل الدولية أن العالم فقد في أشهر نيسان وأيار وحزيران من عام 2020، حوالي 14% من ساعات العمل، أي ما يعادل 480 مليون وظيفة من القوة العاملة العالمية التي تقدر بثلاثة مليارات ونصف مليار عامل. فاقمت التغيرات الجارية منذ زمن في سوق العمل من غربلة السوق التي أحدثتها الجائحة. خلال نصف القرن الماضي، كان قطاع الخدمات يشكل 70% أو 80% من العمالة في البلدان ذات الدخل المرتفع، و50% من العمالة في العالم. تؤثر حالات الركود في العادة على قطاع الخدمات بدرجة أقل، حيث غالبًا ما يكون الإنفاق على الخدمات مزدهرًا خلال فترات الكساد، على عكس الإنفاق على السلع المعمرة كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر. يقول عالم الاقتصاد غابرييل ماثي أن لحالات الإغلاق الكامل الناتج عن الجائحة تأثيرعكسي، إذ ضرب قطاع الخدمات بشكل أكبر.
بعد ظهور انحسار التصنيع لم يثبت أي قطاع آخر نفسه كبديل مناسب. إذ بعد تقلص محرك النمو الصناعي النشط سابقًا، أصبح الاقتصاد العالمي بلا محفز.
ومع انهيار الإنفاق على الخدمات الذي ترافق معه انهيار مدخول العديد من العمال، حدث انخفاض في طلب المستهلكين تردد صداه في الاقتصاد مسببًا آثارًا فادحة على العمال حول العالم. لفقدان الوظائف تأثير أكثر سلبية على النساء، اللاتي يشكلن نسبة كبيرة في أنشطة كتجارة التجزئة التي تأثرت بالإغلاق بشكل أكبر. النساء أيضًا يشكلن نسبة كبيرة من الخط الأول في عمال القطاع الصحي. وقد أجبرن بالطبع على القيام بمعظم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي نتجت عن الجائحة. لا يقتصر الأمر على رعاية المرضى والمحتضرين، فحسب بل العناية بأكثر من مليار طفل من الذين أبعدوا عن مدارسهم منذ شهر آذار 2020 أيضًا.
فاقم التحول إلى عالم يسوده قطاع الخدمات من التبعات المدمرة للجائحة، والآن سيبطئ هذا التحوّل من وتيرة الانتعاش. ذكر عالم الاقتصاد وليام بومول في الستينات أن قطاع الخدمات هو في الأغلب قطاع راكد. إذ على عكس الصناعة في عصرها الذهبي، لا تُظهِر الخدمات عامةً أنماطًا حيوية من التوسع الذي تدفعه المعدلات العالية لنمو الإنتاجية وانخفاض الأسعار. في المقابل، يعتمد الارتفاع في الطلب على الخدمات عامة على الآثار الجانبية لابتكارات زيادة الإنتاج التي تحصل في قطاعات اقتصادية أخرى. هناك رابط واضح بين النمو العالمي لقطاع الخدمات الراكد والركود المتفاقم للاقتصاد ككل.
بعد ظهور انحسار التصنيع -الذي بدأ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الستينات ثم باقي العالم في العقود التي تلتها- لم يثبت أي قطاع آخر نفسه كبديل مناسب. بعد تقلص محرك النمو الصناعي النشط سابقًا، أصبح الاقتصاد العالمي بلا محفز.
ارتفاع البطالة سيزيد من اللامساواة الاقتصادية
رغم ضعف محرك النمو الاقتصادي العالمي، سيكون على العمال أن يجدوا طريقة لكسب الأجور في زمن الجائحة وما بعدها. ومع الوقت، ستحل أشكال مختلفة من العمالة الناقصة محل البطالة. بمعنى آخر، لن يكون لدى العمال أي خيار سوى العمل في وظائف بأجور أقل أو في ظروف أسوأ. ومن لم يجد أي عمل على الإطلاق سيضطر للعمل في القطاع غير الرسمي أو يخرج من القوة العاملة كليًا.
كما كان الحال بعد حالات الكساد، سينتهي الأمر بالسواد الأعظم من العمالة الناقصة في العالم إلى العمل في وظائف الخدمات المنخفضة الأجور. أصبح قطاع الخدمات الذي يشهد باستمرار معدلات إنتاجية منخفضة ويدفع أجورًا منخفضة هو الجهة الأساسية لخلق الوظائف في الاقتصادات الراكدة. في هذه الوظائف، تشكّل أجور العمال جزءًا كبيرًا نسبيًا من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون. ما يسمح لشركات الخدمات برفع الطلب على منتجاتهم عن طريق ربط أجور العمال بالزيادة الضئيلة في الإنتاجية التي تحدث في الاقتصاد ككل. تستخدم المشاريع الصغيرة والعائلية، والتي تشكل نسبة كبيرة من القوة العاملة غير الرسمية في العالم، استراتيجية مماثلة لمنافسة الشركات الكبيرة، فتخفض من الأجور المنزلية إلى أقل قدر ممكن.
مع ارتفاع العمالة الناقصة، تزداد اللامساواة، إذ يمكن لجماهير الناس أن يحصلوا على عمل طالما ظلّ ارتفاع أجورهم خاضعًا لمتوسط الأجور. يشير عالما الاقتصاد ديفيد أوتر وآنا سالومونز إلى أنه «لا ينبغي لإحلال العمالة أن يعني بالضرورة انخفاضًا في العمالة وأوقات العمل والأجور»، ولكنه يمكن أن يختبئ خلف الإفقار النسبي للطبقة العاملة، حيث «الأجور -ثمرة ساعات من العمل والكسب الناتج عن كل ساعة- ترتفع بسرعة أقل من القيمة المضافة».
ساهم هذا الإفقار في تغير بنحو 9 نقاط مئوية من العمالة إلى رأس المال في دول مجموعة العشرين، خلال الخمسين سنة الماضية. انخفضت حصة العمالة في كل أنحاء العالم 5 نقاط مئوية ما بين عام 1989 ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية، لأن نسبة متنامية من نمو الأجور تقع تحت سيطرة أصحاب الأموال.
اقتصاد الوفرة
ما يميز الحياة في الاقتصادات الراكدة هو انعدام الأمان الوظيفي -وهو ما حدث في سنوات الكساد كما حدث في 2020-، والذي صور ببراعة في أعمال ديستوبيا الخيال العلمي مثل في الوقت المحدد (In Time) وأطفال الرجال (Children of Men) وريدي بلاير ون (Ready Player One)، التي يسكنها بشر زائدون عن الحاجة، يعيش أغلبهم بالكاد، ويكسبون عدة دقائق إضافية من الحياة مرة تلو الأخرى. بينما يكدس الأغنياء كميات كبيرة من الأموال التي تشعرهم بما يساوي الخلود.
علينا أن نفهم الوفرة بشكل مختلف، لا على أنها اجتياح تقني، بل كعلاقة اجتماعية يمكننا تطبيقها دون الحاجة إلى المزيد من الاكتشافات التكنولوجية.
من المهم جدًا لهذا السبب بالذات أن نراجع خطاب الأتمتة اليوم، لا لنتصدى للتفسير الخاطئ للنقص المزمن في الطلب على العمالة فحسب، بل لحث الجهود لحلّ مشكلات العمالة العالمية المزمنة من خلال توجه طوباوي.
في عالم يعاني من الجائحة وانتشار اللامساواة والنيوليبرالية المنفلتة، وتصاعد النزعة القومية والتغير المناخي، يوحي منظرو الأتمتة للناس رؤية لمستقبل يرتقي فيه البشر للمرحلة القادمة في تاريخنا -مهما يعني ذلك- وأن التكنولوجيا ستساعد في تحريرنا جميعًا لنكتشف ونتبع أحلامنا. كما حدث في طوباويات الماضي، علينا أن نحرر هذه الرؤى من أوهام أصحابها التكنولوجية والتكنوقراطية ليدركوا كيف يحدث التغير الاجتماعي الإيجابي.
في الواقع، يمكننا أن نحقق عالم ما بعد الندرة الذي يستحضره منظرو الأتمتة، حتى لو كانت أتمتة الإنتاج مستحيلة. السؤال هنا هو ما الذي يتضمنه تحقيق «اقتصاد الوفرة»؟ حسب خطاب الأتمتة، تعتبر الوفرة العتبة التي سنعبرها يومًا متسلحين بتقنيات جديدة وعظيمة. علينا أن نفهم الوفرة بشكل مختلف، لا على أنها اجتياح تقني، بل كعلاقة اجتماعية يمكننا تطبيقها دون الحاجة إلى المزيد من الاكتشافات التكنولوجية، ونظل في الوقت ذاته ضمن حدود الاستدامة البيئية.
أن نعيش في عالم الوفرة يعني أن نعيش في عالم يضمن فيه الجميع دون استثناء الحصول على المسكن والغذاء والملبس والمرافق الصحية، والماء والصحة والتعليم، ورعاية الطفولة وكبار السن، ووسائل الاتصال والمواصلات. الأمن المادي الثابت الذي يحققه مثل هذا المبدأ هو ما يسمح للناس بالسؤال «كيف سأقضي أوقات حياتي؟» عوضًا عن سؤال «كيف سأستمر في العيش؟». بدل انتظار حصول حل تكنولوجي، يمكننا أن نصل لعالم الوفرة بأن نتعاون في القيام بالأعمال التي لا تزال ضرورية في حياتنا ولا يمكن أتمتتها. نحن في حاجة ماسة للقيام بذلك الآن أكثر من أي وقت مضى. في غمرة الركود الناتج عن كوفيد-19، وأمام أزمة مناخية أكبر في السنوات القادمة، علينا أن ندشن عالم ما بعد الندرة من خلال توفير فرص الحصول على السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها كل إنسان ليعيش، بغض النظر عن مساهماته الوظيفية.
الحل الوحيد هو دمقرطة الإنتاج
سيستلزم تحقيق عالم الوفرة منا إعادة تنظيم الإنتاج بطريقة راديكالية. لا يمتلك للناس اليوم أي قول في الطريقة التي يتم فيها عملهم. يذهب معظمهم للعمل كل يوم فقط لأنهم سيجوعون لو لم يفعلوا ذلك. في العالم الذي يضمن فيه الناس احتياجاتهم، تتم دمقرطة العمل. يتشارك الناس العمل لإنجازه، وفي المقابل تمنح العلاوات حسب المهارات والقدرات، مما يقلل من كمية العمل المطلوب على كل فرد، وفي ذات الوقت يضمن أن لدى الجميع فرصة الحصول على وقت فراغ كافٍ.
في عالم يعاني من الجائحة وانتشار اللامساواة والنيوليبرالية المنفلتة، وتصاعد النزعة القومية والتغير المناخي، يوحي منظرو الأتمتة للناس رؤية لمستقبل تساعد التكنولوجيا فيه في تحريرنا جميعًا لنكتشف ونتبع أحلامنا.
قدّر و. إ. ب. دو بويز أن «نظام الديمقراطية الصناعية» في المستقبل، ستكون ساعات العمل فيه من ثلاث إلى ست ساعات كل يوم، وهي «كافية» للسماح «بوقت فراغ للاستجمام والرياضة والدراسة وممارسة الهوايات». بدل إجبار البعض على العمل في وظائف وضيعة من أجل أن يعمل آخرون في مجال الفن، يقول دو بويز أن من الممكن أن «نكون كلنا فنانون وأن نعمل كلنا في مجال الخدمة كذلك». هذه الرؤية لمجتمع ما بعد الندرة هي ما كانت تعنيه الاشتراكية والشيوعية قبل ارتباطها بالتخطيط المركزي الستاليني والتصنيع الجنوني.
الطريق إلى مجتمع ما بعد الوفرة يسده الآن نخبة قليلة من الأغنياء الذين يحتكرون قرارات الاستثمار والعمالة، ولا يهتمون بدمقرطة الاقتصاد. منذ أربعين عامًا، تلوّح هذه النخبة الصغيرة بالتهديد بسحب الاستثمارات من اقتصاد هش سلفًا، لتخضع الأطراف السياسية واتحادات التجارة لمطالبها المتمثلة في لوائح تجارية أكثر مرونة، وقوانين عمل أكثر تساهلًا، وأجورًا بوتيرة نمو أكثر بطئًا، و-وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية- تريد الإنقاذ المالي للقطاع الخاص، والتقشف للقطاع الحكومي. وحين يتظاهر جزء من هذه النخبة، وعلى الأخص في سيليكون فالي، بدعم مقترحات مثل نظام الدخل الأساسي الشامل (UBI)، فلأن هذا النظام لا يهدد سيطرة النخبة على الاستثمار والعمالة. لكي ينجح نظام الدخل الأساسي الشامل في تمهيد الطريق لاقتصاد ما بعد الندرة، على منظري الأتمتة أن يطرحوا تحليلًا صحيحًا: ينشأ نقص الطلب على العمالة اليوم من أتمتة سريعة للإنتاج. في تلك الحالة، ستكون المشكلة الأساسية التي يواجهها المجتمع هي إعادة تنظيم التوزيع. ارتفاع اللامساواة الاقتصادية سيحله توزيع رواتب أكثر من نظام الدخل الأساسي الشامل.
في المقابل، لو كان نقص الطلب على العمالة نتيجة خفض القدرة الفائضة عالميًا وتباطؤ الاستثمار لمعدلات النمو الاقتصادي، سيصبح هذا الصراع المتعلق بالتوزيع صراعًا بلا جدوى، سادًا الطريق نحو مستقبل أكثر حرية. نظرًا للمعارضة التي تشكلها النخبة الغنية التي تحتفظ بالسلطة، بزجها الاقتصاد في الفوضى من خلال تقليص الاستثمار، علينا أن نصل لاقتصاد الوفرة من خلال الحركات الاجتماعية والنضالات التي تسعى لتغيير الإنتاج بحد ذاته.
هناك أعداد كبيرة من الناس الذين يكافحون أعراض النقص طويل الأمد في الطلب على عمالتهم، بما فيها ارتفاع اللامساواة وانعدام الأمان الوظيفي، وإجراءات التقشف وجرائم الشرطة في المجتمعات الفقيرة والمصنفة عرقيًا. كشفت السنوات العشر الأخيرة عن موجات من المظاهرات والإضرابات التي عمت ست قارات، من الصين وهونغ كونغ إلى العراق ولبنان، ومن الأرجنتين وتشيلي إلى فرنسا واليونان، ومن أستراليا وإندونيسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في عام 2010 ثم عاودت الظهور مرة أخرى في عام 2020.
علينا أن ننخرط في الحراكات التي تولد من هذه الصراعات، وندفعها للمضي قدمًا نحو عالم أفضل، تكون فيه البنية التحتية للمجتمعات الرأسمالية تحت سيطرة جماعية، ويعاد تنظيم وتوزيع العمل، ونتغلب فيه على الندرة من خلال منح السلع والخدمات مجانًا، وبالتالي تتضاعف قدراتنا الإنسانية مع انفتاح آفاق جديدة من الحرية والأمان الوجودي. حين تكون هذه الحراكات منظمة بامتياز ومتناغمة داخليًا ومع بعضها البعض، ستنجح في إكمال هذه المهمة التاريخية، المتمثلة في إخضاع الإنتاج واكتشاف مفهوم جديد لما يعنيه أن نكون بشرًا، أن نعيش في عالم يخلو من الفقر وأصحاب المليارات، ومن المهاجرين عديمي الجنسية ومعسكرات الاحتجاز، ومن حيوات تعاش في كدح وشقاء بلا أي وقت للراحة، ناهيك عن الحلم.
إذا فشلت هذه الحراكات، حينها ربما سيكون أفضل ما قد يحدث هو حصولنا على نظام الدخل الأساسي الشامل، وهو مقترح تدرسه الحكومات حاليًا كحل محتمل للركود الحالي. ليس علينا الكفاح من أجل غاية محدودة، بل علينا أن ندشن كوكبًا أكثر استدامة في زمن ما بعد الندرة.
* آرون بناناف: باحث في جامعة هومبولدت في برلين. اقتبس هذا المقال من كتابه الأول، «الأتمتة والعمل في المستقبل»، الصادر من دار فيرسو في نوفمبر 2020. يعمل بناناف على كتابه الثاني عن التاريخ العالمي للبطالة.