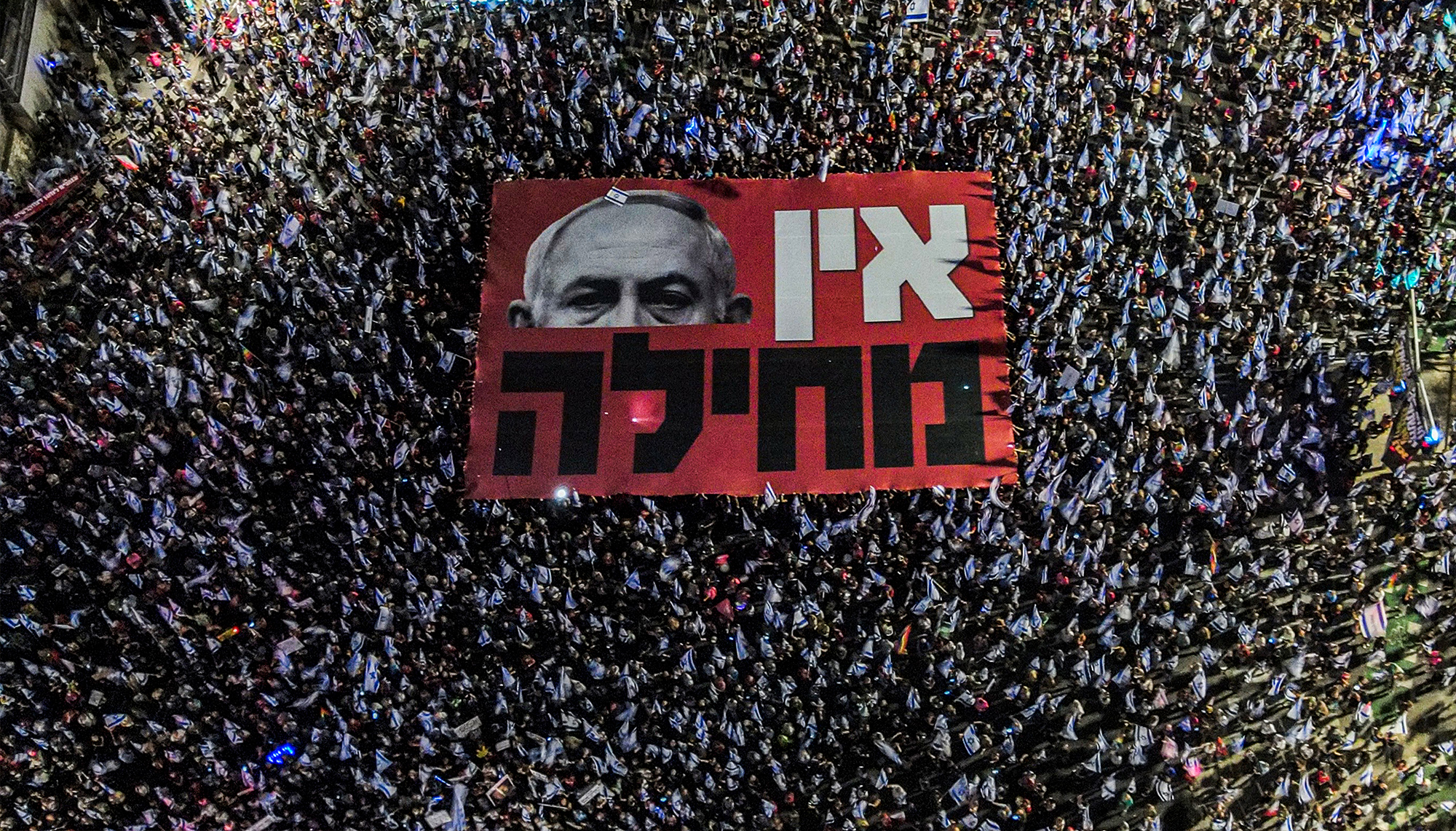مجازر كثيرة مرّت بعدها. ولكل مجزرة حُزنها الذي يحتفظ بجذوته في أعماق القلب، إلى أن تجيء المجزرة التالية. والمجازر تتوالى، والحزن يتوزع بينها كأعشاب برية. إلّا أن هذه المجزرة التي انقضت عليها تسع سنوات بقي حزنها يزيد ولا يتوزع. حزنها أبدي لا يزول.
الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 2009
في ظهيرة هذا اليوم تأهب مجموعة شبان من بلدة «خزاعة»، جنوب قطاع غزة، للخروج إلى مدينة خان يونس غربًا، بعد بداية اجتياح «إسرائيلي» لشمال البلدة. وقبل الانطلاق، تجمّع الشبان عند نقطة معينة، أمام باب منزل صديقهم ومالك مطعم يعملون به، استعدادًا للنزوح غربًا خِشية المدفعية والقصف الإسرائيلي. في تلك الظهيرة، اتصل بي صديقي حسن:
- «محمود، يلا تطلع معنا».
- «لا، رح أضل بخزاعة، بس رح أميّل أشوفكم قبل ما تطلعوا».
- «طيب يلا بنستناك، اتطولش».
بعدها بدقائق قليلة، وأثناء نقاش مع أمي التي كانت ترفض تحرّكي على دراجتي الهوائية، خوفًا من استهداف طائرات الاستطلاع، التي يسمّيها أهل غزة «الزنانات»، سمعنا دوي غارة قرب المسجد الصغير الذي يبعد كيلو متر واحدًا عن بيتنا. اتصلتُ فورًا بحسن، صديقي الذي اتصل منذ دقائق، كي أعرف مكان القصف لأنه بالقرب من المسجد، أجابني في المحاولة الثانية:
- «محمود، أنا ما بسمع من الصاروخ، جيبلنا إسعاف، إحنا مكان ما بنوقف دايمًا (..) يمكن غسان استشهد».
كيف يمكن للموت أن يكون بهذا القرب؟
اتصلتُ على رقم الإسعاف «101» من هاتف أرضي، وكان الخط مشغولًا، وأمي تسأل: «مال ابن خالتك؟».
حاولتُ من هاتف خلوي، والجميع يحاول كذلك، وبعد نحو خمس دقائق رد الإسعاف:
- «ألو، أيوه، شو حالتك؟»
- «أيوه، في استهداف في شارع الجامعين بخزاعة، ومجموعة مصابين».
- «نعم صحيح، بس المعلومات بتقول إنو الكل استشهد في هاي الغارة، وعنا تعليمات ما نروحها، لأن القصف المدفعي عنيف، لكن حنشوف».
كنت أريد التأكد من أن ضابط الإسعاف مخطئ، وأنهم فعلًا جرحى. مرّة ثانية، حاولتُ الاتصال بحسن، لكنه لم يجبني. اتصلتُ بصديقٍ آخر، حمدان، فردّت أخته الصغيرة أسماء، ذات التسع سنوات. كانت منهارة وتبكي بشدة:
- «حمدان متصاوب، جيب إسعاف، تخلهوش يموت».
- «هو عايش؟ إنت متأكدة؟»
- «متصاوب برجله وراسه ومغمى عليه. بس بتنفس».
- «يلا الإسعاف جاي».
هذه هي الحرب إذًا، والكل في خطر. وتبقى المسألة كيف للبعيد عن دائرة الموت أن يساعد الأقرب لها، فالموت يحاصرك كأنه قرينك، ويجيئك حتى في دائرة الأمان.
اتصلتُ بالإسعاف مرة أخرى، ولكن لا إجابة. الكل يحاول، ولا إجابة. مرّت عشر دقائق كأنها الدهر، ولا إجابة إلى الآن، الخطوط مشغولة باستمرار، كيف لا؟ هذه حرب.
اتصلتُ مرة أخرى، وأجاب الإسعاف:
– «شو حالتك؟».
- «يا أخي في متصاوبين بخزاعة، كيف بتقولوا عنهم شهدا؟».
- «خزاعة منطقة ممنوع الدخول إلها بسبب القصف المستمر عند مدخلها، حاولوا تنقلوا المصابين بسيارات».
لكن خزاعة كانت شبه فارغة، فقد نزح معظم أهلها قبيل الاجتياح خوفًا من قذائف المدفعية العمياء، التي تطال المآذن في علوها، ورجال المقاومة في خنادقهم. أظن أن جنود الاحتلال وضباطه يبتهجون أكثر حين يُصرّح لهم باستخدام المدفعية، فهي غالبًا ما توقع مجازر أكبر، وبوضوح تسمع تهليلهم في المناطق الحدودية أثناء تلقيم القذائف، وبعد انطلاقها. دقائق وعادت أسماء لتتصل من جديد:
– «محمود، جيب إسعاف، تخليش أخوي يموت».
- «الإسعاف جاي، خليكي معاه».
جاء جارنا وقال إن هناك شهداء نتيجة القصف: «ممدوح قديح، وعلاء أبو ريدة».
إن تحدثتُ عن علاء فسأكون مثل الأمهات اللواتي يرثين أولادهن أمام عدسات الصحفيين في أول ساعات استشهادهم، لقد كان شابًا منضبطًا وخلوقًا، لقد كان مقاومًا هادئًا، ابن «سرايا القدس»، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. احتجز معي في حزيران\حزيران 2007 في موقع كرم أبوسالم، وعاد معي بعد يومين حافيًا بعد أن رفضنا البساطير العسكرية الحمراء المهترئة من ضابط جيش الاحتلال. وأي مجنون هذا الذي يجرؤ على انتعال حذاء أحمر في خزاعة! ومع ذلك تلقينا عدة رصاصات من جنود الاحتلال تحت أقدامنا بعد ابتعادنا أمتارًا قليلة عنهم. قطعنا نحو سبعة كيلومترات مشيًا تحت الشمس، أكلنا بطيخًا من إحدى المزارع لتخفيف حدة العطش، لكن دون فائدة، كان ذلك قبل تموز بيومين.
تناوبتُ بين الرد، بهدوء، على مكالمات أسماء والتأكيد على أن حمدان المصاب في رأسه لن يموت، وبين الصراخ ومناقشة ضباط الإسعاف الذين أكدوا أن إحدى سيارات الإسعاف حاولت الدخول لبلدة خزاعة وفشلت نتيجة كثافة النيران. بعدها قلت للإسعاف، في حال قدومكم من الناحية الجنوبية للبلدة، الشوارع الرملية القريبة من الحدود هادئة الآن، لأن الاجتياح في شمال البلدة. اقتنعوا، وجاء مع السيارات شبان من خزاعة، ليرشدوا السيارات إلى الطريق. لم أكن وحدي، إذ يبدو أن عشرات الاتصالات كانت تطالب سيارات الإسعاف بالتوجه إلى خزاعة، وتقترح خيار الشوارع الرملية. دخلت عدة سيارات، فرحت عندما سمعت صوت الإسعاف. هكذا إذًا، دائرة الموت تنحصر قليلًا حين تصلك صافرة الإسعاف، وصَلت بعد خمسين دقيقة وستة اتصالات من الأخت الصغيرة التي تناشدك فيها: «تخلهوش يموت».
مرت سيارات الإسعاف مسرعة، وكان الأهالي على طرفي الطريق، الطيران منخفض، الآليات ليست بعيدة، والقصف قريب. عرفت وقتها أن انتشالهم كان جولة ربحناها.
خلال دقائق عرفنا أسماء الشهداء «ياسر قديح وابن أخوه الطفل محمد» وهم من سكان المنزل المقابل لمنزل صديقنا، وأصحاب شجرة التين، مكان التجمع الدائم لنا.
نجا حمدان وحسن ومدحت وإيهاب وسالم وسامر، وفي اليوم التالي شيعنا الشهداء إلى المقبرة الشرقية المحاذية للحدود، كنت أدفع حسن المصاب على كرسي متحرك بعد إصراره على المشاركة في التشييع، كنت أفكر في حال حدوث قصف مرة أخرى، «كيف رح أجيب إسعاف؟».
عاد أهالي بلدة خزاعة ممتلئين بالحزن والحسرة. حاولتُ الدخول من شارع آخر غير الذي تم الاستهداف فيه، لكن في حال حدوث ذلك سوف نمر عبر شارع حدودي والخطر فيه أكبر. قبل الوصول إلى المكان، رأينا سيارات الدفاع المدني تغسل الدم. كانت البقع كبيرة، وآثار أشلاء الشهداء واضحة، ولا يوجد أكثر وجعًا من مشهد الدم المغسول الذي يجري مع المياه في الشوارع الرملية نحو الحدود.
الخالة أم شحدة، والتي تسكن في البيت المجاور لشجرة التين الذي سقط تحتها الصاروخ، رأت يد أحد الشهداء التي سقطت في منزلها بعد القصف، وهي حتى اليوم، وبعد تسع سنوات على المجزرة لا تتكلم. شو رح تقول أصلًا بعد هالشوفة؟.
كان باب بيت أحد الشهداء، ياسر قديح، ملطخًا بدمه، حتى الياسمينة صار لونها أحمر، لن يجلس على الباطون المصبوب على شكل تكية مرة أخرى. ترك خمسة أطفال لأخيه، الذي فقد ابنه الوحيد في الاستهداف.
بجانب مكان الاستهداف رأينا مكان سقوط شهيد آخر، غسان أبو زر. ركض مسافة بعيدة نسبيًا بعد إصابته، كان جسمه ساخنًا من الإصابة، مع أنه يعرف الحرارة أكثر من الجميع، فهو الذي كان يقضي اليوم كلّه أمام فحم «الارجيلة» في عمله، ترى ذلك في الحروق على يديه بوضوح. شظيةٌ صغيرةٌ في القلب كانت سبب استشهاده، كان الموت يعلمُ كيف يدرك غسان صاحب البنية القوية.
قبل المجزرة
قبل يوم المجزرة، قضى شبابُ خزاعة ليلتهم وهم يطفئون قنابل الفوسفور التي تعرّفنا عليها للمرة الأولى في تلك الحرب. كنا نركض طوال الليل في الشوارع، ولم ننم للحظة ونحن ندفن «ألعاب الموت النارية» في أرض خزاعة، كنا نختبئ عند سقوط قنبلة الفوسفور مثل المطر من السماء، وندفن الشظايا المشتعلة مكانها بسرعة فور سقوطها على الأرض، كأننا نزرع لنكسب قوتنا.
وفي الخامسة فجرًا، تقريبًا، هدأت وتيرة القصف، وبعد عودتنا كانت ملابسنا الشتوية معبقة برائحة الفوسفور وبعضنا احترقت ملابسه، وضع صديقي غسان «بكرج الشاي» على النار وقال:
-«ها، شاي بنعنع ولا فوسفور؟»
ضحكنا كأننا لم نكن في حرب، شربنا القليل من الشاي قبل أن تقع غارة بالقرب من المسجد الكبير تلاها اشتباكات مع المقاومة، وكان إطلاق نار كثيف لقوات خاصة باتجاه مقاوم يختبئ خلف لوح زينكو أمام سوبر ماركت أبناء البلد، حاولت سيارة الإسعاف انتشاله، لكن إطلاق النار كان يمنع الوصول إليه.
زحف غسان فجأة بين الرصاص ولحق به شاب آخر، سحبا المقاوم، الذي خسر قدميه ليلتها، قبل أن نحمله إلى سيارة الإسعاف.
كان حسن يشرب شايًا مخمّرًا من شاي غسان، يبكي ويضحك على مواقفه المجنونة، ويحك رأسه بأظافره فتتساقط شظايا ناعمة جدًا، لنقرر بعدها أنا وصديق آخر استخراج الشظايا من تحت الجلد بإبرة وملقط.
في غرفة لا يوجد بها مدخنين اقتربت منفضة السجائر «الستالستيل» على الامتلاء، قطع حديدية أطرافها حادة، لونها لون المعدن المحترق، لو نظرت لها كأنك تنظر للموت في عينيه مباشرة.
بعد المجزرة
بقي ممدوح في العناية المركزة أسبوعًا قبل استشهاده. كان الحزن واضحًا في تشييعه، أذكر أنني كنت أهتف: «يا أم الشهيد زغردي، كل الشباب أولادكي»، فتقول أمه: «أولادي يا خالة، لكن مش زي ممدوح». ومنذ ذلك اليوم أهمس لنفسي، «طبعًا محدش زي ممدوح، ومحدش زي الشهيد».
كان الاجتياح مستمرًا، ولكن بوتيرة بطيئة نتيجة قرار جيش الاحتلال وقتها بأن يكون الدخول البري جزئيًا، هذا الوضع منعني من زيارة صديقي حمدان في المستشفى، خفت أن أخرج من خزاعة ولا أستطيع العودة إليها، «وشو يعني لو مرجعتش؟» إلى اليوم لا أعرف الإجابة.. لم أخرج لزيارته.
لكن بعد ساعات من استيقاظه من الغيبوبة كان قد عرف برواية أخته أسماء والإسعاف، فاتصل بي:
- «مرحبا» (بصوت ضاحك).
- «هلا هلا، الحمدلله عالسلامة».
ضحك ساخرًا وقال: «تخليش حمدان يموت، آه؟».
كان حمدان فرحًا لأن الجميع قد نجوا حسب ظنه، كان يعتقد بأن أصدقاءه الآخرين مجرد جرحى يرقدون في غرفة أخرى.