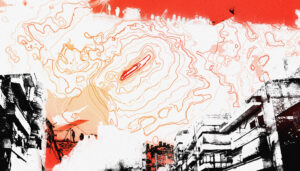اعتاد الناس حول العالم، ومن بينهم الكثير من النشطاء، الاكتفاء بإلقاء اللوم في الحروب على الدول وعلى الجماعات المسلحة. وفي هذا السلوك انعكاس للغة القانون الدولي التي تعترف فقط بهذين الطرفين للحرب. هذا السلوك ينسينا الدور التاريخي الذي لعبته وتلعبه الشركات بشكل غير مباشر في إشعال الحروب.
في سوريا مثلًا، توفّر شركات غربية الأسلحة والتكنولوجيا التي تسهم في قتل البشر، وفي ميانمار دعمت شركات غربية سياسات قمعية من أجل ضمان ربحها، هذا إضافة إلى دور بعض الشركات في الحروب عن طريق توفير المرتزقة والخدمات الأمنية ضمن إطار المتعاقدين العسكريين، في أفريقيا وفي العالم العربي.
عدالة الفائز: تطور ثقافة «الاستثمار البريء» في المحاكم
لم يأت تجاهل القانون الدولي للشركات في الحرب صدفةً، وإنما جاء نتاج تطور تاريخي مُشبعٍ بثقافة رأسمالية تقوده نحو توجهات سياسية محدّدة، ويظهر هذا التجاهل في قطع العلاقة السببية ما بين التجارة والحرب.
تبدأ قصة الشركات مع المحاكم الدولية بعد الحرب العالمية الثانية عندما حوكمت الشركات التي كانت تدعم الحكومات الألمانية واليابانية في محكمة نورمبرغ. حينها، وجدت المحكمة أنه كان للشركات دور مهم في دعم هاتين الحكومتين؛ وبذا أدينت شركة (أي جي فاربن)، إحدى شركات الأدوية والكيماويات الألمانية التي عملت مع النظام النازي لتطوير أسلحة كيماوية وفرض العمل القسري على المساجين، ولاحقا حُكِمَ على 13 من مديري الشركة بالحبس. وبالرغم من أهمية هذا القرار إلّا أن علينا أن نتذكر دومًا أن هذه الإدانة قد جاءت في ظل محاكمة الفائزين في الحرب للخاسرين فيها، بكلمات أخرى هناك سابقة قانونية تاريخية لمحاكمات الشركات لكن شركات الدول الخاسرة فقط.
هذا الموقف «المتشدد» من قبل محكمة نورمبرغ بحق بعض الشركات لم يستمرّ طويلًا، فالمتابع لها يجد أنها اتخذت مواقف أقل شدة بحق آخرين، فمثلًا في قضية شركة فليك، والتي اتهم مدراؤها باستخدام الشركة لغايات الاتجار بالبشر ودعم النظام النازي، تمت إدانة ثلاثة مدراء من أصل ستّة، لمدد تتراوح بين السنتين والسبع سنوات. هذا التراجع جاء نتيجة رغبة الحكومة الأمريكية في طمأنة الشركات الدولية والصاعدة إلى أن قطاع الأعمال يُعامل معاملة المواطن العادي، وإلى أنه لن يكون على الشركات التي تساعد أحد أطراف الحرب الباردة أي مسؤولية شخصية أو مادية، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومع سنوات الحرب الباردة، وتقدّم العولمة، توزعت القوة والمسؤولية بحيث غدت معرفة من فعل ماذا أكثر صعوبة، فمن ناحية ساد أسلوب الحرب بالوكالة المرتبط باستخدام المتعاقدين العسكرين كأداة سياسة خارجية، ومن ناحية أخرى أدى التطور التكنولوجي الى الفصل ما بين الفاعل والجريمة.
ملاحقة الشركات التي تلعب دورًا في حروب المنطقة بواسطة القوانين المحلية
بالرغم من هذا الاستمرار في تجاهل دور الشركات في الحروب، إلّا أن عدة تحركات لملاحقة الشركات حول العالم تمكنت من تحقيق إنجازات ما؛ ففي أواخر سنوات السبعين قرر محامي مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة إعادة إحياء قانون «الأفعال الضارة التي تلحق الأجانب»، وهو قانون من القرن الثامن عشر يتيح للأجانب رفع قضايا مدنية للتعويض عن خروقات القانون الدولي، فجاءت القضية التاريخية فيلارتغا ضد بينا-ايرلا التي طالبت فيها عائلة مواطن بيروفي بالتعويض من شرطي بيروفي سابق أصبح من سكان الولايات المتحدة قتل ابنهم تعسفًا في البيرو، وحصلوا على تعويض مقداره 10 ملاين دولار. لاحقًا تم استخدام هذا القانون لملاحقة الشركات الأمريكية بسبب الخروقات التي ترتكبها عبر الحدود. تم استخدام هذا القانون من قبل مواطنين عراقيين لملاحقة شركات كانت تدير السجون الأمريكية، ومن قبل الكنائس السودانية لملاحقة شركات النفط التي ساهمت استثماراتها في تمويل نظام البشير الذي ارتكب جرائم بحق المواطنين المسيحيين خلال الحرب السودانية الأهلية الأولى، وكذلك رفعت أربع عائلات فلسطينية ورايتشل كوري (الناشطة الأمريكية التي قتلت أثناء محاولة منع جرافة من هدم منزل فلسطيني) قضية على شركة كاتربيلار التي تبيع إسرائيل الجرافات التي يتم استخدامها لهدم المنازل الفلسطينية وقتل الفلسطينيين.
انتهى عدد من هذه القضايا بتسويات مالية، وتم صرف معظمها من قبل المحكمة إمّا لغياب الأدلة أو لكون القضية مرتبطة بخيارات سياسية للخارجية الأمريكية أو لكونها متعلّقة بأسرار دولة مثلًا.
برأي الخبيرة القانونية غريتجي بارز فإن تحيزات المحاكم الأمريكية تحت هذا القانون في ما يتعلق القضية الفلسطينية يعكس مدى تأثر المحاكم الأمريكية بالسياسة، إذ تبيّن بارز الرفض المتكرر للقضايا التي رفعها الفلسطينيون في مقابل إدانة المحاكم الأمريكية جهات فلسطينية مختلفة عبر السنين.
كما يعاب على هذه القوانين أنها تتبنّى مفاهيم ضيقة للسببية، فلا تربط ما بين الشركة والفعل في الحالات التي يكون دور الشركة فيها غير مباشر كحالة (كاتيربيلار) -مع أن السبب الرئيسي لفشل القضية كان، برأي المحكمة، تعلقها بسؤال سياسي-.
في الوطن العربي، لا وجود لمثل هذه الآليات التي تتيح للمتضررين بشكل غير مباشر من أعمال الشركات الأجنبية ملاحقتها. والأسوأ ربما هو أن العديد من اتفاقيات الاستثمار في الوطن العربي تعفي المستثمرين الأجانب من واجباتهم تجاه المجتمع المحلي.
أما المحاكم الأوروبية فمع أن توجهاتها بشكل عام لا تؤيد ملاحقة الشركات للمطالبة بتعويضات مادية عن الأضرار، إلّا ان أوروبا تشهد حاليًا تغيّرًا في الثقافة العامة حول الموضوع، خاصة بعد أن أقر البرلمان الفرنسي مؤخرًا قانونًا يتمحور حول امتداد مسؤولية الشركات لحماية حقوق الإنسان، وبذا أصبحت الشركات الفرنسية -ذات الحجم المعين- ملزمة بإجراء دراسات موسعة حول تأثيرها على المجتمعات المحلية، وأصبحت مسؤولة أمام المحاكم عن أي أثار سلبية لها على حقوق الانسان في الدول الأخرى، ومن بينها الآثار السلبية في حالة الحرب.
ملاحقة الشركات على الصعيد الدولي
أمّا على الصعيد الدولي، فبالرغم من غياب الشركات عن نصوص قانون المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني، إلّا أنه وبعدما تفاقمت المصائب الإنسانية الناتجة عن أعمال الشركات، ظهر في سياق الأمم المتحدة عدد من المبادرات كان آخرها هو المبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان عام 2011 بعد استشارات دامت لسبع سنوات أدارها جون رغي أستاذ القانون في جامعة هارفارد.
تصب المسؤولية وفقًا لهذه المبادئ على الدول التي يوجد فيها مقر الشركة الأم والدول التي تستثمر فيها الشركات وبالتأكيد على الشركات ذاتها.
تعد هذه المبادئ مرجعًا قانونيًا غير ملزم، لكن تم اعتماد العديد من مفاهيمها بشكل طوعي من قبل العديد من الشركات حول العالم، وتمت الموافقة على المبادئ من قبل عدد كبير من الدول، مثل دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا بالرغم من التباطؤ في دمج هذه السياسات في القوانين المحلية.
وتعمل حاليًا اللجان المختصة في الأمم المتحدة على كتابة مسودة لاتفاقية عالمية حول الأعمال وحقوق الإنسان بغرض عرضها على الدول للتوثيق وإدخال هذه المبادئ للحيز الإلزامي في القانون الدولي.
ورغم أن هذه المبادئ عملية، وتحقّق تقدّمًا ما، إلّا أنه يجب علينا ألّا ننسى أنها لا تقدّم حلًّا جذريًا للمشكلة. وبالتالي فإن تعاملنا مع هذه المبادئ على أنها الوسيلة الأساسية للتعامل مع الموضوع قد يؤدي إلى التغاضي عن الأسباب الرئيسة لهذه المشاكل والمتجذّرة في البنية الاقتصادية والسياسية العالمية.
فمثلًا، تعتمد هذه المبادئ على لغة حقوق الإنسان، التي تعتمد، بدورها، على أسلوب الإشارة إلى النتيجة لا الوسيلة، فمثلًا هناك حق للجميع بالحياة الكريمة لكن حق الحياة الكريمة يستلزم نموًا اقتصاديًا في دول العالم الثالث، وهذا ما جادلت بشأنه الحركة الاقتصادية الجديدة في سنوات السبعين من القرن الماضي، عندما طالب الناشطون بحق التقدم الاقتصادي المبني على سياسات داعمة لدول العالم الثالث، لكن تم رفض هذا الطلب ولاحقًا اختفت الحركة بعد أزمة الديون في أميركا اللاتينية وبقيت «حقوق الانسان» تتصف بالرسمية والشكلية.
وحتى لو افترضنا قبول الشركات لهذه المبادئ من باب الحفاظ على صورتها في الإعلام ففي إشارتها لحقوق الإنسان فقط، تتناسى الشركات الصورة الأكبر، ألا وهي أن استثماراتها نتاج عن صفقات مبنية على أسس استغلالية، وأنها تستفيد من عقود استثمارية ثنائية ما بين الدول، عادة ما تتصف بالتحيّز لمصلحة المستثمر، فمثلا يحتوي العدد الأكبر من عقود الاستثمار الثنائية ما بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث على شرطٍ ينص على واجب الدولة بتعويض المستثمر في حال تغيرت أيٌ من القوانين التي تمس به حتى وإن كانت قوانين لمصلحة الشعب المحلي مثل قوانين العمل أو قوانين متعلقة بالبيئة، وقد تراجعت العديد من الدول حول العالم عن إقرار تشريعات مفيدة للمجتمعات المحلية خوفًا من واجب دفع هذه التعويضات للمستثمرين الأجانب كمصر والأرجنتين .
استخدام المبادئ الدولية في سياق المستوطنات
بعد الإدانة الواسعة للمستوطنات من أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة عام 2016، بدأت هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتشكيل فرق عمل للبحث عن طرق الضغط على «إسرائيل» لوقف الاستيطان والانتهاكات الإنسانية بحق الفلسطينيين. وبما أن الأمم المتحدة قد استهلكت عددًا هائلًا من الباحثين لإدانة «إسرائيل» فقد حاولت الهيئة اتخاذ «تحويلة» للضغط عليها من خلال إدانة الشركات التي «تستفيد من، وتفيد المستوطنات» بتشكيل قائمة بكافة الشركات التي تمارس نشاطات معينة مرتبطة بالمستوطنات.
في نطاق هذه الحملة صدر مؤخرًا عن مكتب هيئة الأمم المتحدة تقرير أولي حول الشركات في المستوطنات اعتمد فيه الباحثون على المبادئ التوجيهية للأعمال وحقوق الإنسان السابق ذكرها. في التقرير تشير الهيئة للشركات التي تمارس النشاطات الآتية: توفير آلات هدم أو بناء أو مراقبة للمستوطنات، أو توفير خدمات أمن وحراسة أو خدمات بنكية (كقروض للمستوطنين والمستثمرين في المستوطنات) أو أي خدمات أخرى تساعد في الحفاظ على المستوطنات مما يشمل خدمات النقل والسياحة والاتصالات وغيرها. بالإضافة إلى أي استثمارات أخرى تضرّ السوق الفلسطيني أو البيئة الفلسطينية أو تتضمن استغلالًا للموارد الطبيعية.
يوضح التقرير دور الشركات في الحفاظ على المستوطنات وتنميتها من خلال توفير القروض للمستوطنين وتمويل المشاريع القائمة فيها مثلًا، من ناحية أخرى يوضح التقرير كيف تستفيد هذه الشركات من القوانين الإسرائيلية التي تشجع وتقلل من كلفة الاستثمار في المستوطنات من خلال تصنيف المستوطنات مناطقَ أولوية وطنية، وتوفير البنية التحتية المطلوبة لبناء هذه المشاريع والتمييز الصريح في قوانين العمل التي تشجع المستثمر على استغلال العامل الفلسطيني بأقل كلفة ممكنة.
كان إجراء البحوث والتقارير حول المستوطنات ممكنًا نظرًا لسهولة تحديد المساحة والزمن للاحتلال، لكن هل من الممكن القيام بدراسات مشابهة في حروب أكثر تعقيدًا يختلط فيها الحيز المكاني والزماني مثل الحرب في سوريا أو في اليمن؟
القضية الوحيدة التي تم رفعها على شركات متواطئة في سوريا هي القضية التي رفعتها عدة مؤسسات حقوقية على عدد من مديري شركة «لافارج» لمسؤوليتهم الشخصية، بتهمة تمويل الإرهاب، بعد دفع الشركة رشوات لتنظيم الدولة (داعش) من أجل البقاء في سوريا، وحتى «تضمن أمن موظفيها، وتكون في الصف الأول عندما تدعو الحاجة لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء المعارك».
من ناحية أخرى، وكما هي الحال بالنسبة للمبادئ التوجيهية تتصف هذه الحملة بالراغماتية، فهي من ناحية تمثل توجهًا نحو وسائل مختلفة للضغط على «إسرائيل» في ظل الامتناع السياسي عن إدانتها، من خلال لغة إنسانية وتكتيكات مجتمع مدني مثل أسلوب تسمية الفاعل و«جلب الخزي له»، بالإضافة إلى إشارتها إلى النطاق الاقتصادي الأوسع لطبيعة تدخل هذه الشركات في المستوطنات. بالرغم من هذا تختبئ وراء الحملة توجهات تطبيعية ترسم المستوطنات على أنها المشكلة الوحيدة في الاحتلال و «دولته» متناسية الأبعاد الأوسع لهذا الصراع، ومتغاضة عن تاريخ «الدولة الإسرائيلية» بوصفها مؤسسة وجدت على العنف والتهجير والتطبيع، وعن واقع هذه «الدولة» المبني على العنف الممنهج على المستوى الجسدي، والنفسي والثقافي الموجه نحو الشعب الفلسطيني.
أخيرًا، التوجه العالمي نحو نقد فكرة «براءة الاستثمار» وربط الشركات بالتوجهات السياسية والاقتصادية يمثل خطوة في غاية الأهمية تساعدنا على تطوير فهمنا للنزاعات في المنطقة، لكن هل ستكون ملاحقة الشركات فقط للمنتصرين في الحرب كما حدث في محاكمات نورمبرغ؟ أو مشبعة بالسياسة كمان هو الحال من خلال «أداة الملاحقة عبر الحدود» في الولايات المتحدة؟ أو تطبيعيًا كما هو الحال في المبادئ التوجيهية؟