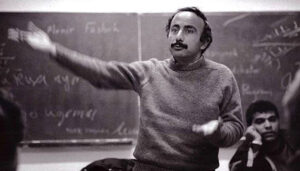لقد أعاد الاعتصام المفتوح لطلبة الجامعة الأردنية قضية التعليم العالي إلى صلب النقاش العام، باعتبارها قضية وطنية كبرى لا تناقش بمعزل عن قضايا المجتمع والدولة، ولعل ذلك الإنجاز الأول الذي حققه.
لا يخفى على أحد أن هناك أزمة حقيقة تواجه مستقبل التعليم العالي في الأردن؛ أزمة بدأت مع التحول الطبيعي للجامعة من مؤسسة نخبوية إلى مؤسسة وطنية، وازدياد أعداد الطلبة بشكل لم تستطع الدولة استيعابه مع المحافظة على مستوى جيد من التعليم في الوقت نفسه، وأصبح السؤال الذي يؤرق الدولة: كيف نستوعب هذا الكم البشري المتدفق على مؤسسات تعليمية شابة؟
أسس هذا الوضع معادلة حرجة جدًا قائمة على ثنائية «التعليم مقابل استيعاب الطلاب»، حُسمت المعركة مبكرًا لمصلحة الاستيعاب بعد أن شرعت الدولة أبوابها للقطاع الخاص للمساهمة في عملية الاستيعاب، فدخل رأس المال الخاص إلى قطاع التعليم بهدف الربح الخالص (سلعة مقابل مال). أثبتت الكثير من التجارب أن التعليم مثل الصحة، لا يمكن الاستثمار به من أجل الربح، فهذه قطاعات لها علاقة بالصالح العام، أي أنها متعلقة بمجمل مصالح الشعب، ومن غير الممكن على الإطلاق أن تخضع لقوانين السوق دون أن تؤدي إلى نتائج كارثية على المستوى الوطني.
ماذا فعل رأس المال الخاص وعقليته بالتعليم العالي؟
أول خطوة كارثية قام بها رأس المال الخاص الذي أدخلته الدولة لحل مشكلة الاستيعاب كانت تدميره لفكرة التعليم الجامعي المتوسط «كليات المجتمع»، وتفريغها من أي بعد تعليمي، وتشويهها وفقدان الثقة المجتمعية بها والتعامل معها كمؤسسات ربحية مستقلة، لا كجزء من نظام تعليمي متكامل، يقوم على ثلاثة أركان رئيسية (تعليم ثانوي، تعليم جامعي متوسط، تعليم عالي).
مشروع إنشاء المؤسسات التعليمية ذات السنتين بعد المرحلة الثانوية، الذي أقرته وزارة التربية والتعليم عام 1980 حين حوّلت معاهد المعلمين والمعلمات إلى كليات مجتمع، كان من الممكن لو تطور بالشكل المناسب أن يقدم حلولًا عادلةً لمسألة تزايد أعداد الطلبة، تقوم على نظرة شمولية للتعليم واتساق المراحل التعليمية، كمنظومة تعليمية متكاملة.
لقد فشلت الدولة في منع تحول الجامعات العامة إلى كليات تدريس، وفشلت حتى في تأمين هذه العملية التدريسية.
لأسباب سياسية-اقتصادية عديدة من الصعب التطرق لها هنا، ظهرت عدم قدرة الدولة على تمويل التعليم العالي، وانتقلت عقلية القطاع الخاص إلى الجامعات العامة، حيث تم اللجوء إلى برنامج الموازي والرفع المتزايد للرسوم الجامعية، باعتباره «الحل» الأسهل لمسألة نقص التمويل وازدياد عدد الطلبة، وأصبح الهدف من مؤسسة الجامعة هو استيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب -لأهداف سياسية- وبأقل قدر ممكن من التمويل. حيث يصرف الجزء الأعظم من هذا التمويل على الأجور، للمحافظة على استمرارية العملية التعليمية، أي أنه إنفاق يجري من أجل تمويل عملية هدفها فقط أن تستمر، بمعزل عمّا تريد الدولة من منظومة التعليم العالي ككل، وأهمية الاستثمار برأس المال المعرفي، والمكتبات والمختبرات والبنية التحتية للجامعات، والبحث العلمي، وتوجيه الطاقات بناءً على الأهداف الوطنية العليا.
لقد فشلت الدولة في منع تحول الجامعات العامة إلى كليات تدريس، وفشلت حتى في تأمين هذه العملية التدريسية بعد الإخفاقات المتتالية للجامعات العامة في استغلال مصادر التمويل، وأصبحت الدولة تتحرك بعقلية «بدنا نقرّي الولد»، مثل أي مواطن همّه أن يؤمن مصاريف تعليم ابنه لكي يحصل على شهادة ومن ثم «بيحلّها ألف حلّال»، وعجزت حتى عن هذا.
الدول الحقيقية لا تتحرك بعقلية الأفراد والجامعات ليست كليات تدريس، لكي يُعتقد أن الأقساط تكفي لتمويلها. فمهما بلغت هذه الأقساط لن تكفي لتمويل جامعة، بالمعنى الحقيقي لمشروع الجامعة الوطنية وعلاقته بالمجتمع والدولة، فضلًا عن أن فكرة السطو على جيوب الناس واستغلال حاجاتهم مرفوضة أساسًا، وسيكون لها انعكاسات سلبية على بنية المجتمع.
دولة تتخلى وطبقة لامبالية
مع غياب مشروع دولة قائم على الإنتاج، والاكتفاء بمشاريع خاصة حول النخبة السياسية الحاكمة، نشأت طبقة خدماتية-تجارية، ليست معنية على الإطلاق بالمساهمة بدينار واحد من أجل دعم أو تطوير التعليم، وذلك لغياب التفاعل بين ضرورات الإنتاج من جهة والتعليم والبحث العلمي من جهة أخرى، وهذا بسبب طبيعة هذه الطبقة الريعية غير المنتجة. فالطبقات البرجوازية في أماكن أخرى بالعالم –بغض النظر عن رأينا بها- أُجبرت على دعم التعليم والبحث العلمي، لأمور لها علاقة بتطوير الإنتاج والارتقاء به. أما «برجوازيتنا»، فلم تكتفي فقط بعدم المساهمة في تطوير التعليم، بل أن جزءًا كبيرًا منها ساهم في تحويل التعليم إلى سلعة، تدر لهم الأرباح، وفي العبث بمؤسسات تعليمية بناها أبناء المجتمع الأردني للأجيال.
الكثير من أبناء هذه الطبقة ممن هم من أشد المعارضين لفكرة مجانية التعليم، يضربون أمثلة سطحية عن نجاح التعليم الخاص في بلدان عديدة كالولايات المتحدة الأمريكية، دون أي تمييز ما بين التعليم الأهلي والتعليم الخاص من جهة، ودون أدنى إدراك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست على الإطلاق النموذج الأمثل لعدالة التعليم.
الجامعات الأمريكية الكبرى التي يتفاخر أبناء هذه الطبقة بالدراسة فيها ويعتبرونها النموذج الأوحد الذي يقاس عليه، تعتمد بشكل كبير على التبرعات والأعطيات التي تقدم من قبل الأغنياء لوقفية الجامعة (Endowment)، لأمور لها علاقة بالمكانة الاجتماعية والضرائب. وتستثمر إدارة الجامعة أموال الوقفية ليتم تمويل الجامعة من فوائدها وعائداتها. وتتفاوت الوقفيات من جامعة لأخرى، فجامعة بيركلي تصل وقفيتها إلى أربعة مليارات دولار، بينما تصل وقفية جامعة ستانفورد إلى 20 مليار دولار، ووقفية جامعة هارفارد إلى 36 مليار دولار. أما في بلادنا، فماذا قدّم الأغنياء من أجل النهوض بالتعليم العالي والارتقاء به؟
عندما تخلت الدولة شيئًا فشيئًا عن مسؤوليتها الاجتماعية، بالتزامن مع نشوء طبقة لامبالية وغير معنية إلا بمراكمة الأموال، ومع ازدياد عدد الطلبة بشكل متسارع، انعكس ذلك على مجمل البنية الاجتماعية في البلاد. وبدل أن يكون التعليم أداة رئيسة لجسر الهوة بين الطبقات يتسلل الفقير من خلالها، وبدل أن تساعد هذه الأداة في نشوء طبقة وسطى واسعة، أدى التعليم بشكله الحالي إلى توسيع الهوة بين الغني والفقير، وجعل التعليم حكرًا على من يستطيع أن يدفع الرسوم.
ماذا تبقى من التعليم العالي؟
بعد تحويل الجامعات إلى كليات تدريس، وتدهور نوعية التعليم، سيطرت العقلية الأمنية على مجمل العملية التعليمية، وفُرضت منظومة علاقات قوة، من علاقات قاعات التدريس إلى علاقة الطالب بالأستاذ وصولًا إلى رئاسة الجامعة. وتبلورت هذه العقلية بأشكال مختلفة تبدأ بالرقابة على ما يقوله الطالب، وما ينتجه من أوراق وأبحاث، تحديدًا في الدراسات ذات الطبيعة المعرفية السياسية، وصولًا إلى الرقابة على تنظيم الطلبة لأنفسهم على أساس سياسي أو فكري أو مطلبي. يحدث هذا في مكان من المفترض أن يُؤسَّس من خلاله لمجتمع حر، يقوم على حق الطالب بالمعرفة، لكن الواقع في الجامعة الأردنية «أم الجامعات» يشير إلى انحدار كبير على هذا الصعيد. فكل أحلام الطالب المتعلقة بالحرية الأكاديمية وحرية التفكير وطرح الآراء تتبخر عند أول اختبار حقيقي في حق الطالب بالحصول على المعرفة. ونرى هذا بوضوح في أقسام السياسة والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع، فهذه التخصصات التي من المفترض أن تخلق حالة واسعة من الجدل بين الطلاب من جانب والطلاب وهيئة التدريس من جانب آخر، باتت تقوم بمجملها على التلقين من قبل الأستاذ المحاضر والحفظ من قبل الطلاب، وانعدام النقاش، وسيطرة رأي الأستاذ على مجمل صيرورة المساق التدريسي. وإن كان ذلك يحدث في برامج الماجستير، فما بالك بالبكالوريس؟
لقد بات الوضع في فضاءات هذه الأقسام مبكيًا، فالعقلية الأمنية والأبوية متجذرة فيها بعمق. فبعد تحول الأستاذ الأكاديمي إلى موظف، تنهكه كثرة المحاضرات اليومية، لم يعد فيها معرفة تنتج، ولا مساحة للطالب للتفكير.
في عام 2012، كنت طالبًا في قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، وقد قدمت مقترحًا لرسالة الماجستير بعنوان «التحولات السياسية وارتباطها بتغيير مناهج التعليم بالأردن 1980-2010». رفضت اللجنة المشرفة المقترح، بحجة أنه في الفترة المذكورة «لم تخضع المناهج لأي تغيير» ولم يحدث فيها «أي تحول سياسي بالأردن»، بالتالي كان المقترح «مرفوضًا ولا يستحق الدراسة». هكذا بالضبط علّق رئيس اللجنة على مقترح الرسالة.
بدل اتهام الطلبة بأنهم أصحاب «أجندات خارجية»، على المسؤولين الذين أوصلوا التعليم إلى هذا الحال أن يثبتوا بأنهم أصحاب «أجندات وطنية».
بعد ستة شهور من البحث في متحف مناهج التعليم في مدرسة السلط الثانوية، أجبرت على تغيير عنوان الدراسة إلى «تحولات في القطاع العام الأردني، حالة عمال المياومة نموذجًا». وبعد الشطب والتعديل المتكرر أفرغت الدراسة من أهميتها وأصبحت بعنوان «الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية لعمال المياومة في القطاع الزراعي الأردني». في يوم المناقشة، كان للإهداء نصيب لا بأس به من اهتمام لجنة المناقشة، فقد كان نص الإهداء الأصلي «إلى عمال المياومة، مشاعل الحراك الشعبي الأردني، إلى والديّ الأعزاء، ولكِ أنتِ طبعًا». أحد اعضاء لجنة المناقشة، سألني بصيغة سلطوية أبوية، «عن أي حراك تتحدث؟ لا يوجد شيء اسمه حراك، ومن هي هذه الفتاة المذكورة بالاهداء؟»، وغضب بشدة عندما قلت له: «الإهداء شأن خاص، والأجدى باللجنة أن تناقش الرسالة وليس إهداء الرسالة». وافقت اللجنة على تخرجي بعد أن قمت مُجبرًا بشطب الفصل الذي له علاقة بعمال المياومة وارتباطهم بالحراك الأردني، وتغيير نص الإهداء ليصبح: «إلى عمال المياومة، إلى والديّ الأعزاء».
هذا مثال بسيط على واقع الحال في أقسام إنتاج المعرفة المتعلقة بالسياسة والمجتمع، وعلى علاقة الأستاذ بالطالب القائمة على الاستعلاء والأبوية، والتي تأخذ أشكالًا أخرى مثل التهكم والضحك من قبل رئيس الجامعة الأردنية ومذيع التلفزيون الأردني، على إجابات رئيس اتحاد الطلبة، الطالب محمد السعايدة أثناء الاتصال الهاتفي الذي أجري معه على برنامج «الأردن هذا المساء».
هذه العقلية الأمنية تأخذ أشكالًا قمعية حادة عند تحرك الطلبة بشكل جماعي والتعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم على قضايا نقابية مطلبية. وما رأيناه من هجوم على اعتصام طلبة الجامعة الأردنية، سواء من أقلام لصحفيين أو من إدارة الجامعة نفسها، ما هو إلا مؤشر على هذه العقلية الأمنية، وعلى خطاب التهديد والاتهامات الموجهة للطلبة المعتصمين والتشكيك بنواياهم. والدليل على ذلك تشبيه هتافات الطلبة بالهتافات التي أُطلقت في سوريا، ومهاجمة الحملة الوطنية لحقوق الطلبة (ذبحتونا) باتهامها «بترويع الطلبة» و«إثارة الفتن والقلاقل»، والإشارة إلى وجود مندسين يتعاطون المخدرات والمشروبات الروحية في الاعتصام الطلابي. هذه الحملة الجنونية لم تكن لأن الطلبة تحركوا ضد رفع أسعار الموازي والدراسات العليا فقط، بل لأنه بعد كل هذه السنين من القمع الفكري والسياسي، وسن القوانين لتفتيت الجسم الطلابي، والتحكم بمجالس الطلبة، وتزوير الإنتخابات، وتخويف الطلبة من بعضهم البعض، وفي ظل حالة الترهيب السياسي وقمع الحريات، استطاعت مجموعة من الطلبة أن تخرج بشكل منظم وديمقراطي لتقول «لا».
إن التعليم العالي في الأردن يمر بأزمة حقيقية بحاجة إلى تكافل جميع الجهات للخروج منها. وبدل اتهام الطلبة بأنهم أصحاب «أجندات خارجية»، على المسؤولين الذين أوصلوا التعليم إلى هذا الحال أن يثبتوا بأنهم أصحاب «أجندات وطنية» والخطوة الأولى لهذا تبدأ باحترام أصوات الطلبة وتلبية مطالب المعتصمين، ثم الدعوة إلى مؤتمر وطني يُدعى إليه تربويون وخبراء في التعليم واقتصاديون ورجال أعمال وأحزاب سياسية، وتستنفر كل الجهود للخروج من الأزمة الحقيقية التي تعاني منها منظومة التعليم العالي في الأردن.
* الصورة أعلاه بعدسة معاوية باجس.