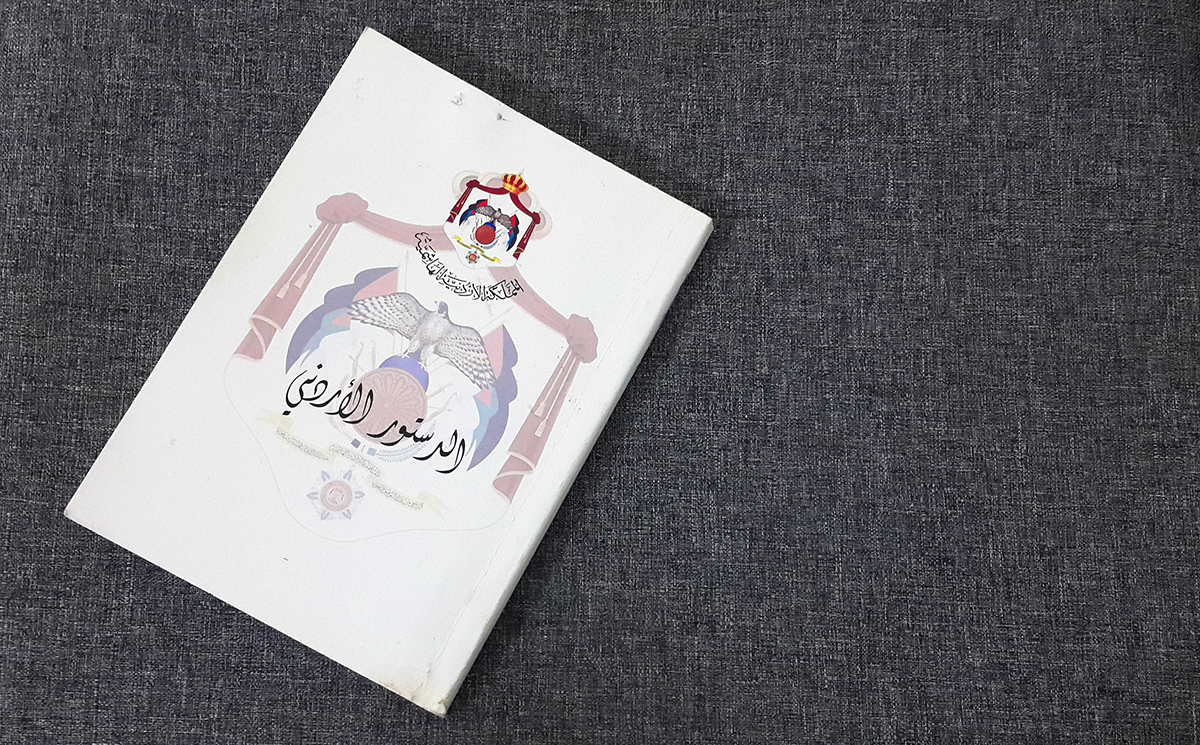يصعب، في وقتنا الحاضر، العثور على نظام قانوني لم يستعِر من الأنظمة القانونية الأخرى كنتيجة لتبادل الخبرات، أو الاستعمار، أو العولمة أو غيرها من الأسباب. تقع هذه الممارسة بشكل عام ضمن ممارسة أكبر هي تبني الفلسفة القانونية الرائجة، ففي مناطق عديدة حول العالم، لم تكن مفاهيم الملكية والإيجار والمحاكم متداولة بالشكل الذي نعرفه، وكانت المشاكل الاجتماعية تعالج بأسلوب آخر قبل زرع نظام قانوني أجنبي همّش الممارسات القانونية السابقة.
وتعد الاستعارة القانونية أحد آثار تنازع القوى العالمية، إذ أن قوانين الدول المهيمنة غالبًا ما تصبح الأساس لغيرها من الدول، ويمكن الاستدلال على هذا عند دراسة أنماط الأنظمة القانونية في الدول التي استعمرها البريطانيون والفرنسيون في القرنين الماضيين.
نظرًا لكون الأردن دولة نشأت في ظل الحكم العثماني الذي يرتكز نظامه القانوني على القانون الفرنسي بالأصل، ولاحقًا الانتداب البريطاني الذي جلس ممثلوه في الغرف التشريعية، فإن القسم الأعظم من قوانيننا لم يتطور بشكل عضوي يتناسب مع احتياجات الشعب، بل من خلال استعارة القوانين من دول أخرى. فالدستور الأردني يرتكز على مفاهيم من الدستور البلجيكي، في حين يمثّل قانوننا المدني مزيجًا من الشريعة والقانون المدني الفرنسي، وقانون التجارة يرتكز بالأساس على القانون الفرنسي أيضًا، أمّا النسخ الحديثة منه كقانون المُلكيّة الفكرية فهي مستوحاة من قوانين منظمة التجارة الدولية. وتتسم العديد من هذه القوانين بكونها ذات ترجمة رديئة أو تناقضات ناتجة عن النقل الحرفي، كما حدث في قانون التجارة البحرية المستعار من قانون التجارة البحرية اللبناني ذي الأصول الفرنسية، والذي يعالج النزاعات بين ميناءين أردنيين رغم وجود ميناء واحد في الأردن فقط. أما لقانون العقوبات، فهو ذو أصول فرنسية أيضًا، فحتى تخفيف العقوبات في جرائم الشرف يجد أصله في القانون الفرنسي، لكن بخلاف الأردن عدّلت فرنسا هذا النص في عام 1975.
في الأوساط الأوروبية، هناك جدل فقهي قانوني مطول بدأ في سبعينيات القرن الماضي بقيادة الفقيه الأسكتلندي ألان واتسون حول ما إذا كانت الاستعارة وسيلة جيدة لإثراء القوانين. يرتكز هذا الرأي إلى أن استعارة المفاهيم الرومانية من قبل الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر قد أدى إلى إثراء قوانينها. بالمقابل، يرى جانب آخر من الفقهاء، يمثّله الفرنسي بير لو غراند، أن الاستعارة القانونية تتجاهل العلاقة ما بين القانون والثقافة المحلية، وتفترض أن القالب ذاته يعمل بالفعالية نفسها في كافة الدول.
بشكل عام، ليس من السهل حسم الجدل حول ما إذا كانت هذه الممارسة إيجابية أم لا، إذ أن نجاحها يعتمد بالأغلب على أسلوب الاستعارة؛ فهناك استعارة تُطوّع القوانين لتتأقلم مع الأنظمة المحلية بدرجة كبيرة، ومن أبرز الأمثلة على هذه الحالة القانون المدني التشيلي، والذي يمكن اعتباره قانونًا ناجحًا لأن كاتبه أندرياس بيلو جمع بنوده واختارها من بين مجموعة قوانين عالمية على مدار عشرين عامًا، وعدّلها بشكل يتناسب مع التاريخ والثقافة القانونية التشيلية بشكل كبير، مما جعل القانون التشيليّ أساسًا للقانون المدني في العديد من دول أمريكا اللاتينية ذات الثقافة الشبيهة.
لكن، على الجانب الآخر من المشهد، قد ينتج عن الاستعارة تشويه للنظام المحلي، كما سبق وحصل لدى العثمانيين حوالي عام 1860، عندما تم إنشاء المحاكم النظامية، والتي تعد أساس نظام المحاكم الحالي في الأردن، بشكل يتطابق ونظام المحاكم الفرنسي. كان لهذه الاستعارة أثر رئيسٌ في تقليص دور مجالس الشريعة التي كانت المؤسسة القانونية الرئيسية فيما سبق وكانت ميزتها أنها متاحة للجميع بشكل مجّاني. حصرت هذه الاستعارة دور مجالس الشريعة، المجانية، بالقضايا المتعلّقة بالحياة الخاصة للأفراد كأمور الطلاق والميراث. لذا، يرى الباحث آفي روبين أن نظام المحاكم البيروقراطي المزروع في الدولة العثمانية قلّص من فرص الوصول للعدالة في القضايا التي تتعلق بالعلاقات العامة والمالية لتشمل الطبقات الغنية فقط (لأن الفقراء لم يكونوا قادرين على الانتفاع منها بسبب تكاليفها).
الاستعارة القانونية الحديثة في الأردن: قرار حكومي سياسي
في المحكمة الدستورية الفرنسية يقف ممثل الحكومة ليدافع عن القانون ويتحدث باسمه مع أن القانون يصدر فعليًا عن مجلس النواب، والسبب وراء ذلك هو أن الحكومة هي من تكتب القانون، في حين يقتصر دور مجلس النواب على التصويت. وضْع القوانين في الأردن يشابه وضعها في فرنسا، والحكومة في نهاية المطاف هي المشرّع.
غياب الشفافية والعلانية، يعتبر واحدًا من أبرز أسباب تهميش عملية التشريع في الأردن ودورها في صقل الثقافة السياسية والاقتصادية. ومع أن ديوان التشريع والرأي يعرض القوانين للاستشارة، فهو غالبًا ما يعرض نصوصها دون تفسير أسباب تعديلها، أو أصل النص، وثم لا ينشر أي تقارير تبيّن رد الديوان على الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الجمهور والمؤسسات المعنية. هذا بخلاف إجراءات التعديلات القانونية في دول أخرى، فمثلًا عادة ما تلجأ الحكومة البريطانية إلى تعيين خبراء يخرجون بتقارير مفصلة وتوصيات، يتم نشرها ومشاركتها علنيًا بهدف استدراج التعليقات للخروج بتقرير نهائي يقدم مبادئ وأفكار لكتابة مسودة لمشروع القانون.
مع أن عملية «التشريع» في الأردن تكون في العادة أقرب إلى تبني قانون أجنبي وتعديله، إلّا أننا نادرًا ما ننتبه إلى الآثار المترتبة على عملية الاستعارة هذه، رغم آثارها السياسية والاجتماعية. أمّا الدوافع وراء عملية الاستعارة هذه، فربما يكون السبب الأبرز لها هو ما يذهب إليه الفقيه القانوني ألان واتسون، وهو أن الاستعارة «أسهل من التفكير». وربما يكون خلف الاستعارة أسباب لوجستية بحتة، مثل أن تكون الحكومة بكل بساطة تحاول التقليل من تكاليف لجنة التشريع واختصار عبء عملها. أو أن يكون أعضاء اللجنة التي يفترض بها صياغة القانون قد درس في الدولة التي تم تبني قانونها، وهي حالة رائجة عالميا، ويمكن ملاحظتها في القانون الأردني الذي تحوّل من كونه فرنسي الطباع، عندما كان جل القانونيين الأردنيين يدرسون في فرنسا، إلى بريطاني أو أمريكي الطباع بعدما أصبح هناك عدد من القانونيين المتعلمين في تلك الدول.
ومن بين الأسباب التي قد تدفع نحو الاستعارة، الرغبة في «صناعة الشرعية»، أي أن القانون وبما أنه مطبّق في دولة متقدمة فهذا يعني أن استعارته وزرعه لدينا سيكون مناسبًا، مع أن التجربة تقول أن نجاح القانون بعد استعارته من دولة متقدّمة ليس أمرًا مضمونًا.
أخيرا، قد يقترن خيار القانون الذي سيتم تبنيه بالضغوطات الخارجية السياسية أو الاقتصادية؛ الاستعمار قديمًا والسيطرة الاقتصادية ومصالح الشركات الكبرى ضمن نطاق العولمة حديثًا. ومن الأمثلة على هذا العلاقة بين قوانين مكافحة الفساد وصندوق النقد الدولي، وكذلك العلاقة بين قوانين حق المؤلف وشركة مايكروسوفت. بالتالي ليس من الغريب أن يجلس ممثلو هذه الجهات الأجنبية في غرفة التشريع الأردنية، مما قد ينتج عنه قوانين متحيّزة للجهات الخاصة أو الجهات الدولية عوضًا عن المواطن الأردني.
لقد كان للاستعارات القانونية المتراكمة دور في إفراغ القوانين من هدفها المرجو، فيلاحظ على الحكومة الأردنية انحيازها نحو القوانين الجامدة والمعقدة إجرائيًا، التي، رغم الاستقرار الذي تحث عليه، تفشل في رعاية مرحلة انتقالية تضمن الاستقرار وتوفير التكاليف في المستقبل، ومن أهم الأمثلة التوضيحية في هذه الحالة زرع المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية: زرع الوجه الآخر للحكومة
إنشاء المحكمة الدستورية، كان واحدًا من بين أهم المطالب التي نادت بها المظاهرات التي شهدها الأردن في العام 2011، بسبب الرغبة في خلق جسد قانونيّ جديد يراقب دستورية القوانين والقرارات الحكومية. المحكمة الدستورية أو الرقابة الدستورية بشكل عام تلعب دورًا مهمًا منفصلًا عن كل من الحكومة ومجلس النواب في العديد من الدول، من خلال تقديم رأي آخر حول السياسات العامة للدولة. لكن تبني الأردن لنموذج المحكمة الدستورية الحاليلم يسفر عن الأهداف المرجوة، إذ لم تخرج المحكمة حتى يومنا هذا بأي قرارات ذات تأثير جذري، رغم مرور خمسة أعوام على تشكيلها. ولا زالت قرارات المحكمة الدستورية، إلى الآن، مرتبطة بأمور تقنية تمس الحكومة، بشكل لا يقارن بقرارات نظيرتها الفرنسيّة التي نادرًا ما تنظر في الأمور التقنية التي يفترض أن يحكم بها القضاء الإداري بصفة الاستشارية. وفي الحالات التي تعاملت فيها مع السياسات العامة للدولة كانت إجابتها انعكاسًا لسياسات الحكومة لا غير، فمثلًا في قرار المحكمة حول اتفاقية المطار التي تعطي امتيازًا مدته 25 عامًا لمجموعة المطار الدولي، اعتبرت المحكمة أن هذه الاتفاقية قد تم التصديق عليها بشكل ضمني في قانون الطيران المدني ولا حاجة للتصديق عليها من قبل مجلس النواب، عوضًا عن تمكين النواب من خلال عرضها عليهم بشكل فردي. من ناحية أخرى، تستخدم المحكمة في أجوبتها وسائل عديدة من وسائل «تسييس» القرارات، من أهمها التهرب من القرارات المهمة من خلال التذرّع بأخطاء إجرائية كعدم دفع رسوم المحكمة في قضية طعنت بدستورية قانون الانتخابات رقم (25) لسنة 2012 أو عدم صحة الإحالة في القضية رقم (1) لعام 2014 حول الطعن بنصوص من قانون الانتخابات ذاته.
إن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي هي وليدة استعارة الحكومة الأردنية لقواعد المحكمة الدستورية الفرنسية. واختيار هذا النموذج يعد استثناءً على التأثر الأردني الحديث بالقوانين الأنجلوساكسونية التي كان يمكن الاستعانة بها للخروج بنظام مراجعة دستوري أكثر انفتاحًا. كما يتجاهل هذا النموذج العديد من الخيارات الأخرى، كالغرف الدستورية الخاصة في محاكم التمييز في كوستاريكا، التي تتيح للمحكمة فرصًا أفضل للنمو بشكل يتناسب واحتياجات الشعب الأردني نظرًا لاستقلال القضاة في هذا النموذج.
على صعيد آخر، تعد المحكمة الدستورية الفرنسية فريدة من نوعها، وتتعرض لانتقادات مستمرّة، من أهمها: أولًا، بسبب بيروقراطيتها، إذ أنها لا تسهّل تقاضي المواطنين أمامها، وهو ما نلاحظه كذلك مع المحكمة الدستورية الأردنية، والتي كان يفترض بها معالجة جزء صغير من سوء التمثيل البرلماني الذي يعاني منه المواطن الأردني، حتى مع قانون الانتخابات الجديد، والذي كان يمكن تفاديه من خلال السماح بالقضايا الجماعية أو التمثيلية من قبل النقابات العمالية أو الأحزاب، كما فعلت العديد من دول أميركا اللاتينية عند تبنيها لمحاكم دستورية. وثانيًا، في مجال استقلالية قضاتها وخلفياتهم، إذ أصبحت المحكمة الدستورية منصبًا للمتقاعدين ذوي الخلفية السياسية المتوافقة مع النظام، ورغم الانتقادات الموجهة لهذه الجزئية إلّا أن الحكومة الأردنية ذهبت بالاتجاه المعاكس، وعدّلت النص الأصلي من خلال استبدال توزيع سلطة تعيين القضاة بين الحكومة والبرلمان والأعيان، بإعطاء الملك السلطة الحصرية لتعيين كافة أعضاء المحكمة.
لم تلجأ معظم الدول النامية للاستعارة القانونية لهذه الدرجة، خاصة في موضوع الرقابة الدستورية نظرًا لحداثته النسبية، بل حاولت الكثير منها ابتداع سياسات أخرى، مثلما حدث في الحالة الكولومبية، إذ أن الدستور الكولومبي يسمح في مادته 242 لأي مواطن بالطعن في دستورية القوانين، وهي ميزة لا مثيل لها في الدساتير الأوروبية.
إن الاستقلال والشفافية في عملية النمو القانوني هو أيضًا جزء من استقلال الدولة. والاستعارة القانونية دون دراسة الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقوانين في ديوان التشريع والرأي أو مجلس النواب في ظل عدم توافر أي طاقم يساعد النواب في فهمها كما يوجد في الكونغرس الأمريكي يعيق تقدّم الدولة على كافة الأصعدة.
خضع القانون المدني الفرنسي مؤخرًا لتعديلات على مستوى واسع، نشرت معها الحكومة كافة القرارات التي اعتمدتها لإجراء هذه التعديلات. في حين يبقى القانون المدني الأردني، الذي يعتمد على القانون الفرنسي والشريعة، على حاله، وبكافة تناقضاته ونصوصه القاصرة، كنموذج للاستعارة القانونية التي تنكر العلاقة ما بين الثقافة المحلية والقانون. ما الذي سنفعله في السنوات القادمة، هل ننسخ تلك التعديلات الفرنسية الحديثة، أم نخرج بتعديلات خاصة بنا بشكل شفاف، أم نحافظ على القانون الحالي بالرغم من قصوره؟
*شهد الحموري، طالبة دراسات عليا في تخصص القوانين الاقتصادية في معهد الدراسات السياسية بباريس.
هذه المقالة مبنية على دراسة أجرتها الكاتبة. للعثور على كافة مراجع المقالة، راجع/ي نص الدراسة كاملًا المنشور باللغة الإنجليزية على موقع أكاديميا.