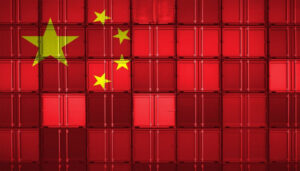أخيرًا، كشف رئيس الوزراء عمر الرزاز عمّا أسماه «مشروع النهضة الوطني» الممتد على مدى عامين، بهدف «توظيف طاقات الأردنيين وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل بمشيئة الله».
من حق المواطنين أن يتساءلوا إذا كان هناك أي اختلاف بين محاور هذه الخطة وبين أولويات خطة الحفز الاقتصادي (2018-2022)، التي أطلقتها حكومة هاني الملقي، أو محاور مشروع «رؤية الأردن 2025»، بطبعة عبد الله النسور. فالمشاريع الثلاثة تتشارك في عناوينها وتغليفها وتعليبها، إلا أن الصدمات الاقتصادية والمجتمعية التي تعصف بالأردنيين، وتعاقب سوء الإدارة تجعل هذه الخطط أحلامًا، في غياب ملايين الدنانير المطلوبة لتحقيق الوعود، وآليات تنفيذ مستندة إلى نظام فصل ومراقبة ومراجعة. وفي الأثناء، ينزلق الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والعباد من سيء إلى أسوأ، وسط تخبط داخلي مرعب، وضغوط إقليمية غير مسبوقة.
بدا الرزّاز واثقًا في التفرد بمنتج مختلف، وكأن أسلافه كانوا يعملون على طريقة «أبو خشبة». لكن ما سمعناه منه قبل أيام كان أقرب إلى خلطة مشاريع «زوّقتها» حكومته وربطتها بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في تداخل مع موازنة 2019. إذ يخلو برنامج العمل المقترح -بطبعته الأخيرة- من برامج إصلاح سياسي متكاملة تتجاوز المقترحات المحدودة المتفرقة، ما يوقع المواطن في تساؤلات فيما إذا كنا مقبلين على عملية إصلاح سياسي حقيقية أم «تنمية سياسية» بـ«حبال طويلة» و«لف ودوران» كما درجت عليه العادة. كما يخلو من عقد اجتماعي جديد، ذلك الذي بشرتنا به الحكومة لدى تشكيلها على أكتاف حراك الدوار الرابع والمحافظات هذا الصيف.
تقول الحكومة إن مشروع النهضة يعكس خطاب العرش الأخير، الذي ركّز على ثلاثة محاور: دولة القانون، دولة الإنتاج ودولة التكافل، بحيث تكرّس جميعها مفهوم «دولة الإنسان الأردني». والسؤال كيف تتكرس هذه الدولة دون صون الحريات (وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير) التي تتراجع يوميًا، وعندما ينذر الرئيس ببقاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد أن أسرّ أمام نشطاء شباب قبل أسابيع بأن بعض بنوده «مصيبة».
تمر خطة الرزاز على الكثير من الشعارات دون توضيح تفاصيلها. فقد سمعنا كثيرًا عن تعزيز الشفافية والنزاهة، لكنّهما تُنتهكان يوميًا بفعل الانتقائية في تطبيق القانون ومكافحة الفساد من خلال معاقبة صغار الموظفين وترك الكبار يحلقون. أما المال العام وشعارات المحافظة عليه، فهو في مهب الريح ولم يبق منه الكثير أصلا ليُحمى. كما أن الاستقرار المالي المنشود في الخطة لا يتحقق من خلال فرض المزيد من أدوات الجباية، والتلكوء في مكافحة التهرب الضريبي، وبخاصة في قطاعات الصحّة والمحاماة والهندسة المعروفة، بثغرات التهرب. أما الحديث عن رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الإداري، فيغيب عنه أهمية وجود قرار سياسي جاد بالتعامل مع تبعات إعادة الهيكلة.
هل للحكومة أن تشرح كيف ستستقطب استثمارات جديدة وتخلق آلاف فرص العمل، بينما يهجرنا مستثمرون هربًا من الضرائب والخاوات والرشاوي والعراقيل البيروقراطية في سوق محدودة النمو؟ لا تقول لنا الحكومة من أين ستأتي بمخصصات خلق فرص عمل جديدة، حتى وإن فصلت مواقعها، ولا مخصصات توسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطني وقاعدة التأمين الصحي لـ80 % من السكان، ناهيك عن مخصّصات إحياء «خدمة علم» بحلّة جديدة. ولا نعلم كيف يتسق ذلك مع كون ميزانية الدولة بالغة الصعوبة، إلى الحد الذي دفع نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، للضغط على اللجنة المالية في مجلس الأعيان لإعادة مشروع قانون الضريبة إلى النواب، بعد تعديلات نيابية قيل إنها ستخفّض عائدات الضريبة المقترحة بواقع 100 مليون دينار.
إن إصرار الحكومة على منهجية رفع سقف التوقعات الشعبية، والبون الشاسع بين القول والفعل، تطيح بشعبيتها تدريجيًا.
من جهة أخرى، فإن مشاريع النقل العام جزء كبير من خطّة «النهضة الاقتصادية». لكن هل يتفق هذا التركيز على النقل مع تكليف وزير واحد بحقيبتي النقل والبلديات، وهما ملفان ضخمان على تماس مباشر بحياة الناس، خاصة بعد أن تكشّفت أبعاد صعوبة إبقاء الملفين بيد شخص واحد في غمرة إضراب عمال الوطن قبل أسابيع؟ إن إصرار الحكومة على منهجية رفع سقف التوقعات الشعبية، والبون الشاسع بين القول والفعل، تطيح بشعبيتها تدريجيًا.
وسط عدم اليقين، يطل السؤال الأهم: من سيراقب مدى التزام الحكومة بتطبيق مؤشرات هذه الخطة حتى يترسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يتحدث عنه الرئيس؟ فعجز مجلس النواب، ممثل الشعب وأهم أداة للتشريع والرقابة، يتكشف يوميًا بعد تمرير قانون ضريبة الدخل، (ولعل موازنة 2019 ستمر بنسب تصويت مشابهة). أما الإعلام الرسمي والتقليدي -العام والخاص- في جيب الحكومة وصناع القرار على نحو غير مسبوق. وخلال أسابيع، ستمرّر على الأغلب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيساوي بين من يسيء استعمال منصات التواصل الاجتماعي لاغتيال الشخصية ومن يلجأ إليها لممارسة حق الرأي والتعبير، بعد أن أُغلقت سبل الإعلام التقليدي في وجهه. كيف ستتحقق المراقبة بموضوعية قائمة على فرز المعلومات وجمع الحقائق في ضوء كل ذلك؟
لم يعد المتابع قادرًا على فهم موقف الحكومة وخارطة تحالفاتها مع قوى سياسية أعيد إحياؤها، ترغب في طمس مسؤوليتها عن تضعضع البنية التحتية التي كشفتها العواصف والسيول أخيرًا. كما أن الحكومة نزعت نحو إقصاء فئات سياسية، نقابية، حزبية ومجتمعية كان بعضها يتشارك مع الرزاز في الطموح والرؤى. فالحكومة تحالفت سرًا وعلنًا مع مراكز قوى جديدة وقديمة لتفتيت هذه الشرائح. ويتجلّى ذلك في انحناء الرئيس أمام مجموعة سياسية لا تشبهه من الناحية الفكرية أو القيمية، مقابل توفير غطاء سياسي فعّال في هذا المشهد البائس، وسط تكلس أدوات إدارة الدولة وعقم اللعبة السياسية. فمن أول يوم، لم تعكس حكومة الرزاز أفكاره التي عهدناها فيه قبل التكليف: عقد اجتماعي محدّث، دولة قائمة على التكافل الاجتماعي، حماية كرامة المواطن وسيادة القانون وحرية الرأي والتعبير، فضلًا عن مآلات استمرار الاقتصاد الرعوي.
لقد قبل الرزاز أن يتحمل المسؤولية وهو يدرك أن ولايته العامّة لن تكون إلا في تراجع. وشكّل الحكومة وهو يدرك حدود اللعبة السياسية «والفيتو» المرتبط بها قبل أن يدخل الملعب، ووعد بإحداث تغييرات تدريجيًا من الداخل. لكن الواقع يكشف أن حكومته لن تستطيع الفوز بالمعركة على صهوة «التويتر»، بل عبر مجلس وزراء فاعل ووزراء منتجين، وبالخروج من إطار تشكيل اللجان واجترار حوارات لا تفضي إلى نتائج، وبحمل المسؤولية الدستورية والأدبية والأخلاقية لكل ما تحمله الولاية العامة من معنى.
كل ذلك يدفع للتساؤل: في أي خندق يريد الرزاز أن يتذكره الأردنيون بعد أن يترك الدوار الرابع؟