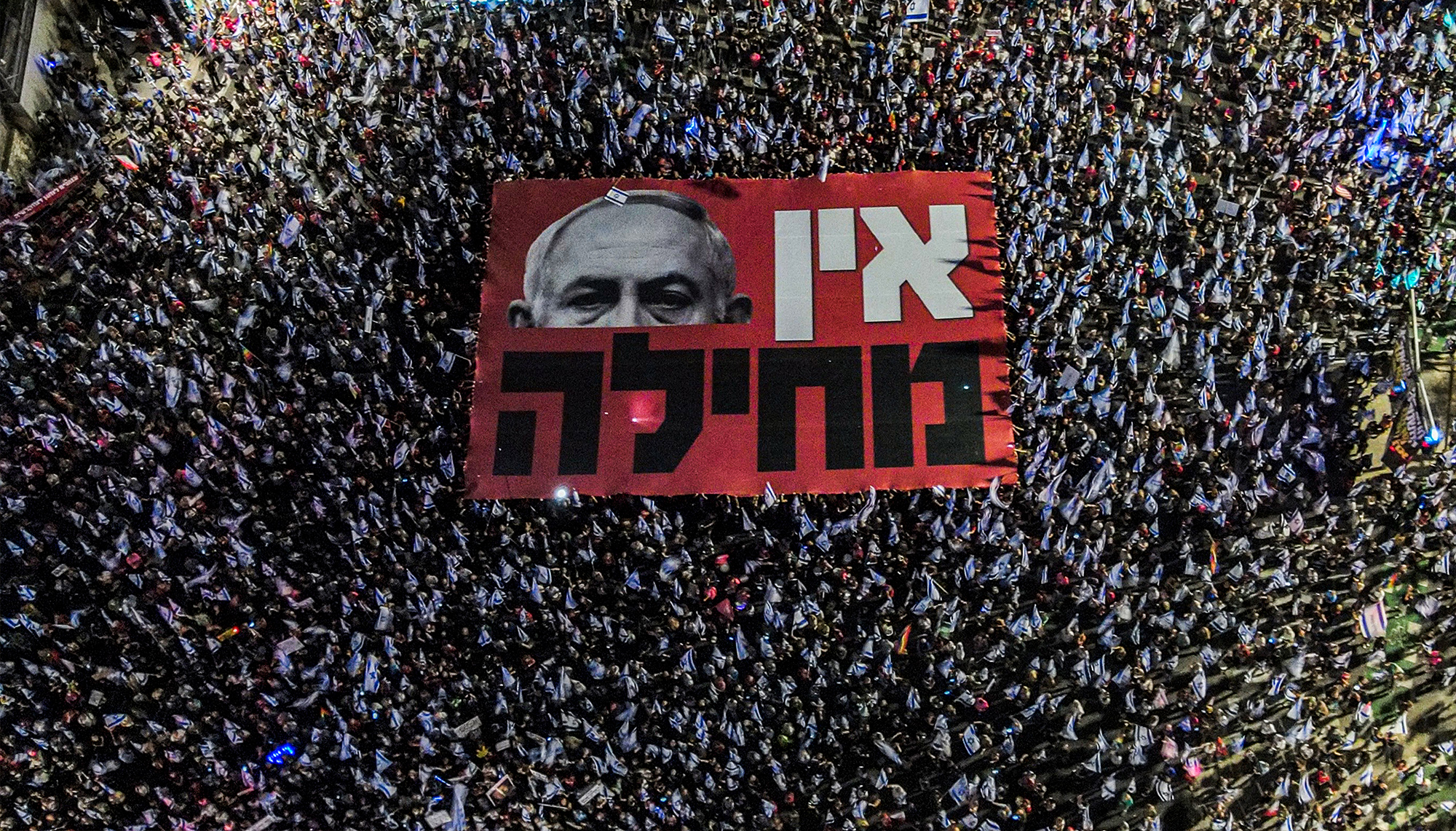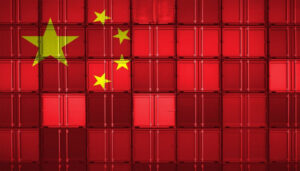نشر هذا المقال بالإنجليزية في مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس، في آب 2022.
قبل عدة عقود، حين انتقلت إلى مدينة نيويورك، تقدمت لشاغر مساعدة شخصية لكاتبة. تخيلت نفسي كسكرتيرة تترجم التصريحات الملهمة إلى أشعار. لكن بدلًا من ذلك، وجدت نفسي أطلب السترات وأعيدها، وأرتب مواعيد قص الشعر، وأحجز لوجبات من ثلاثة أطباق لأعضاء الطبقة المثقفة الذين لم ألتقيهم أبدًا. كانت مديرتي تقطن وزوجها، وهو مدير أعمالها المالية، وأبناؤهما في بارك أفنيو، في شقة عالية ذات ستائر فاخرة ونوافذ بثلاث طبقات عازلة للصوت. وكانت تستعين بخدمات حسب الطلب: مدربين شخصيين، ومتسوقين شخصيين، ومدرب أشعار شخصي، ومدرب أوبرا شخصي. وقد كنت واحدة من أربع عاملات بدوام كامل، إلى جانب مربيتين إيرلنديتين مقيمتين، وخادمة فرنسية. كنا نسارع أربعتنا خلال فترة الغذاء البالغة نصف ساعة إلى المطبخ لاستخدام صنبور المياه ذي المقابض المذهبة، الذي كان يوفر ماء مغليًا فوريًا لصنع الشاي أو الحساء، نرتشف ونضحك ونتذمر من مديرتنا.
أثناء إحدى هذه الوجبات، بدأت المربية الأساسية محادثة على الهاتف في الزاوية، ثم أغلقت السماعة على عجل. أومأت وهي تشير إلى مقبض الهاتف المذهب أنها تعتقد أن مديرتنا كانت تتنصت عليها. فيما نحن مجتمعات لتناول الحساء، أخبرتهن أن مديرتنا كانت دائمًا تطالبني بتقارير عما تدور حوله محادثاتنا، وهمستْ المربية بأنها واثقة من أنها رأتها تتنصت خارج باب المطبخ. بدا ذلك مضحكًا للوهلة الأولى، ثم لم يعد كذلك، وبدأ خيط رفيع من التوتر يشق طريقه عبر الغرفة.
بعد بضعة أسابيع، طُردت الخادمة. لم يكن واضحًا ما إذا كان فصلها يتعلق بالحديث الذي دار، لكن حين يغرز جنون الارتياب مخالبه فيك فإنه لا يتركك بسهولة. بات التنبؤ بأجورنا وزياداتنا صعبًا. كانت اثنتان من طاقمنا تعتمدان [في إقامتهما] على البطاقات الخضراء. فجأة، أصبحت هذه الظروف التي كانت مدار العديد من أحاديثنا مصدرًا لانعدام الأمن، وكففنا عن تناول الغذاء معًا، تدريجيًا، ثم دفعة واحدة.
كنت أفكر مؤخرًا بهذه التجربة الصغيرة المحبطة ونحن نواكب تفجر استثمارات الشركات في مجال مراقبة أمكنة العمل. يبدو عام 1995، الذي التحقت فيه بهذه الوظيفة، عتيقًا إلى حد يكاد يكون محرجًا، وكأنه جزء من حقبة السذاجة الرقابية. إذ لم يكن هناك فيسبوك أو غوغل يلاحق الناس في كل مكان يذهبون إليه، ولا إعلانات مشخصنة إلى حد مفزع. قضى الأمريكيون آنذاك ما معدله 30 دقيقة شهريًا على الإنترنت، وكانت الرقابة اللصيقة على مدار الساعة مقتصرة على المستهدفين بتحقيقات الإف بي آي.
في العشرات من أماكن العمل التي عملت فيها حتى بلوغي الـ24، كنت أسجل موعد دخولي وخروجي، وأسارع في غسل الصحون عند مرور المشرف، وأزِن الفاصولياء التي التقطتها، وأساوم حتى أغادر باكرًا مقابل تنظيف عدد إضافي من الحمامات، وأكتب تقارير لمعلمة الصف الثالث التي عاونتها في الصف. حتى الإكراميات التي استلمتها أثناء عملي كنادلة كانت من شأني أنا، لا المطعم. كان مدرائي يعرفونني بشكل سطحي -ملابسي وإنتاجيتي العامة- ولم يعرفوا ما أفكر أو أحس به خارج العمل، إلا إذا اخترت أنا مشاركة ذلك.
كانت ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين نقطة تحول في مجال الرقابة، إذ انطلقت فيها الشركات في أولى فورات شراء أجهزة رقابة الأداء الإلكترونية. عام 1987، تمت مراقبة قرابة ستة ملايين عامل [في الولايات المتحدة] بطريقة ما، مثل كاميرا فيديو أو مسجل صوت؛ وبحلول 1994، تم تتبع حوالي واحد من كل سبعة عمال إلكترونيًا في أماكن عملهم، أي حوالي 20 مليون شخص، وتزايد الرقم باطراد من ذلك الحين. عندما استُبدلت أشرطة الفيديو بتقنية الأجهزة الرقمية التي تستطيع مسح مواقع متعددة في وقت واحد، حوّلت الكاميرات التي ثبتت بدايةً لحماية أماكن العمل من السرقات نظراتِها النهمة من السلع إلى العمال. أما نقطة التحول الكبرى الثانية في مجال رقابة الأداء إلكترونيًا فهي التي تجري الآن، مدفوعةً بالتقنيات القابلة للارتداء، والذكاء الاصطناعي، وكورونا. لقد تزايد استخدام الشركات لبرمجيات الرقابة بمعدل 50% عام 2020، أولى سنوات الجائحة، بحسب بعض التقديرات، وما زال مستمرًا في النمو.
تعد تقنيات التتبع الجديدة هذه متطفلة وواسعة الانتشار. تتتبع الشركات بهدف الأمن والكفاءة، ولأنها تستطيع التتبع. فهي تعاين الحركات والمحادثات والروابط الاجتماعية وأثرها، وتحفظها وتحللها. إن كان التوسع الرقابي الأول استيلاءً مناطقيًا موطدًا السلطة على الشخص بكامله أثناء العمل، فإن الثاني يشبه تصديع الأرض، إذ يغير التركيب البنيوي لتواصل البشر مع بعضهم ومع أنفسهم.
يتوجب على بعض سائقي الشاحنات الذين يقودون لمسافات طويلة، قيادة شاحنة مسطحة طولها 17 مترًا مسافة 966 كيلومتر يوميًا، بينما تحدق بهم كاميرات فيديو طوال الوقت، تراقب أعينهم ومفاصلهم واختلاجاتهم وتصفيرهم وحركات رقابهم. تخيل أنك تعيش أمام كاميرا فضولية تشبه وجه المدير لأشهر بلا انقطاع فيما هي تمسح مقصورتك، التي تمثل منزلك في أغلب الأحيان. في واحد من منتديات ريديت العديدة الغاضبة والتي تدور حول السائقين المراقبين بالكاميرات، كتب سائق شاحنة بأنه سيتحمل الكاميرا فقط «إذا ما منحه صاحب الشركة بثًا غير محدود على مدار الساعة من داخل منزله». «إن بضعة مئات الأميال هذه يوميًا هي الوقت الوحيد الذي أملكه لنفسي، وأشعر وكأنه يُفسد الآن،» يضيف آخر. «أرغب بأن أعبث بأنفي وأحك خصيتي بسلام يا أخي». وقد وصف سائق حافلة الرغبة البشرية في «ليّ قسمات وجهك بشكل غريب أو التكلم مع نفسك أو الغناء رفقة أغنية (..) يمكنني أن أشعر بانخفاض جريان هرمون الكورتيزول عبر جسدي في وظيفتي الثانية حيث كانت الحافلات أقدم ولا يوجد كاميرات داخلها. هذا الأمر يجعلك سقيمًا ومرهَقًا».
يقرأ أصحاب العمل رسائل العاملين الإلكترونية، ويتتبعون استخدامهم للإنترنت، ويستمعون إلى محادثاتهم. بينما يجبر الممرضون وعمال المستودعات على ارتداء شارات الهوية وأساور المعصم أو ملابس برقاقات تتبع تحركاتهم، وتقيس خطواتهم وتقارنها مع زملائهم وخطواتهم في اليوم السابق.
يمكن لأساور المعصم التي تطوق جلدك، مداعِبةً العصب الوسطي، أن تُستخدم في المستقبل لإرسال إشارات إليك أو لرئيسك، وقياس عدد الدقائق التي قضيتها في الحمام. لدى أمازون التي تتبع بدقة كل ثانية من نشاط عامل المستودع، وكل فاصل وحديث، براءة اختراع لسوار معصم يمكنه، بحسب النيويورك تايمز، «إرسال نبضات بالموجات فوق الصوتية وبث راديو يتعقب مكان وجود يد العامل بالنسبة لصناديق المخزون»، ومن ثم يتذبذب ليقود العامل نحو الصندوق الصحيح. كما أن هناك «قبعة ذكية» تستخدم بين سائقي الشحن، تراقب موجات الدماغ عند الإرهاق.
يمكن للبرمجيات الجاهزة المستخدمة في الموارد البشرية أن تراقب نبرة صوت العمال. روجت «كوجيتو»، وهي إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال، لمنتجها على أنه «مدرب معزز بالذكاء الاصطناعي يحسن البشر من خلال تحليل المكالمة الصوتية وتقديم التغذية الراجعة المباشرة». فبينما يجني العمال 15 دولارًا في الساعة ويتعاملون مع شكاوى المستهلك في حجيرة، عليهم الانتباه جيدًا إلى شاشة منبثقة تبدأ بالوميض إذا ما تكلموا بسرعة، وإذا كان هنالك تداخل بين صوتهم وصوت العميل، أو إذا طال الصمت. إنه «التعاطف على نطاق واسع»، كما تتبجح الشركة.
تضع الرقابة الإلكترونية جسد الشخص المتعقَب في حالة من اليقظة المفرطة الدائمة، وهو أمر سيء صحيًا، والأسوأ إذا كان مصحوبًا بقلة الحيلة.
إن تتبع السلوك عن كثب ليس أمرًا جديدًا، فنموذج عمل شركات التكنولوجيا كفيسبوك وغوغل، يعتمد في نهاية الأمر على تتبع المستخدمين داخل وخارج الموقع. بات تسليع المعطيات في عقده الثالث، إلا أن الرقابة والإدارة الآلية في العمل أمر آخر. فالعمال لا يستطيعون الامتناع عن العمل دون أن يخسروا وظائفهم: لا يمكن أن تغلق الكاميرا في الشاحنة إذا كان هذا ضد سياسات الشركة؛ ولا يمكنك نزع جهاز التسجيل عن بطاقة الهوية. كما تأتي رقابة العمال مع تهديد قوي ضمني: فإذا لاحظت الشركة الكثير من الإجهاد، سيتم التغاضي عن الترقية الوظيفية. وإذا ما وصل إلى مسامعها أمر لا يعجبها يمكن أن يتم طردك حينها.
تعتبر التداعيات السياسية لرقابة العمالة واسعة الانتشار هائلة. فرغم أن المدراء لطالما تنصتوا على محادثات العمال، إلا أنه لم يكن بمقدورهم الاستماع إلا نادرًا، وما هو أكثر من ذلك كان مستحيلًا لوجستيًا. لم يعد الأمر كذلك. يتوجب على الموظفين أن يفترضوا أن كل ما يقولونه يمكن أن يسجل. فما معنى أن يعاد الاستماع إلى كافة كلماتهم، ونبرة صوت هذه الكلمات؟ لقد فقد الهمس قوته.
في الكثير من الحالات، يتم تركيب أجهزة الرقابة على العمال لأسباب أمنية ظاهرية، مثل الكاميرات الحرارية التي تركب لحماية العاملين والزبائن من عامل مصاب بالحمى. إلا أنه تبين أنها ليست جيدة لصحتنا. ذلك أن الرقابة الإلكترونية تضع جسد الشخص المتعقَب في حالة من اليقظة المفرطة الدائمة، وهو أمر سيء صحيًا، والأسوأ إذا كان مصحوبًا بقلة الحيلة. إذ يمكن أن يصبح العمال الذين يعرفون أنهم مراقبون قلقين ومرهقين ومتوترين وغاضبين إلى أبعد الحدود. حيث تتسبب الرقابة بإطلاق مواد كيميائية مرتبطة بالتوتر في الجسم، وتبقيها متدفقة، الأمر الذي يمكن أن يفاقم المشاكل القلبية، وقد يؤدي إلى الاضطرابات المزاجية وفرط التنفس والاكتئاب. أدار أساتذة من جامعتي كورنيل وماك ماستر مؤخرًا مسحًا للرقابة الإلكترونية في مراكز الاتصال، بيّن أن التوتر الذي تتسبب به الرقابة يعادل بجسامته التوتر الناجم عن التعامل مع العملاء المسيئين. شعر العمال بأن الرقابة تستخدم للانضباط وليس للتحسين، وأن التوقعات كانت غير منطقية، وأن استخدام الرقابة غير عادل. وقد فضلوا مديرًا بشريًا على جاسوس آلي دائم التواجد، لديه سلطة تؤثر على الأجور.
فهل من المستغرب أن تضرر الصحة النفسية لسائقي الشاحنات؟ أو أن ينهار العاملون في مراكز الاتصال؟ يتحدث سائقو الشاحنات والعاملون في مراكز الاتصال عن نوع من الضباب الذهني المزعزع للاستقرار، أشبه بحالة متواصلة من انعدام اليقين وجنون الارتياب: أي حركة باليد، وأي استراحة في الحمام، وأي محادثة تلك التي تسببت في خسارتي لتلك العلاوة؟ «أنا أعلم أننا في مكان عمل، ولكنني أخاف أن أحك أنفي»، هذا ما قالته سائقة في أمازون لمجلة إنسايدر في تقرير عن سائقي الشركة الذين يواجهون الكاميرات. لكنها لم تعطي اسمها خوفًا من الانتقام.
عام 2011 ، دعا ترافيس كالانيك، مؤسس أوبر، مجموعة من سكان مدينة شيكاغو لحفل في فندق إليجيان الفاخر. وعرض على شاشة كبيرة ما سماه مبدئيًا «منظور الله»، الذي أعيدت تسميته لاحقًا بـ«منظور السماء»، وهي خارطة يمكن للشركة أن تتبع عبرها سائقين مجهولي الاسم. شاهد الحاضرون في الحفل بدهشة مئات السيارات وهي تنطلق في أنحاء المدينة في ساعتها، مذهولين بتربعهم على قمة الدنيا.
تصور قصة «قمة الحماس: المعركة من أجل أوبر» من كتاب مايك أيزاك، كالانيك على أنه منتشٍ ومتلذذ بالهيمنة. نشاهده هو والشركة في كثير من الأحيان وهو يظهر جنون الارتياب المعتاد، متجسسًا لحماية القلعة. يفتتح الكتاب بكالانيك وهو يرد على الدفع نحو تنظيم قطاعه بتوظيف موظفين سابقين من «وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي» لبناء «قوة ائتلاف تجسس عالي الكفاءة»، «يتجسس على موظفين حكوميين، ويتقصى حياتهم الشخصية، ويتبعهم أحيانًا إلى منازلهم». ومتى حدد جواسيس الشركة الموظفين الحكوميين الذين يحاولون بناء قضية حول خرق أوبر للقوانين المحلية، تقوم أوبر بوضع شيفرة للتأكد من أن الموظف لن يتمكنوا أبدًا من طلب سائقي أوبر، ولن يتمكنوا بالتالي من تحري الخروقات في قوانين التوظيف المحلية. بل توفر لهم أوبر بدلًا من ذلك نموذج تطبيق وهمي بسيارات مزيفة. سيبدو وكأن الموظف طلب سائقًا، ولكن السائق لن يأتي أبدًا. وقد سمّت أوبر هذا البرنامج «غرايبول» (الكرة الرمادية).
تتسبب الرقابة بإطلاق مواد كيميائية مرتبطة بالتوتر في الجسم، وتبقيها متدفقة، الأمر الذي يمكن أن يفاقم المشاكل القلبية، وقد يؤدي إلى الاضطرابات المزاجية وفرط التنفس والاكتئاب.
يعمل آيزاك كمراسل تقني لدى النيويورك تايمز ويكتب بين حين وآخر عن وادي السيليكون. نشر آيزاك روايته حول غرايبول في التايمز عام 2017، وذلك قبل نشر كتابه بعامين. يلاحق عمله الأخاذ عن أوبر الشركة من أيامها الأولى وحتى الطرد النهائي لكالانيك، ويعود باستمرار إلى طرق استخدام أوبر للرقابة في بناء سلطتها. تعقبت الشركة العملاء بعد مغادرتهم سيارة الأجرة، واستخرجت معطيات بطاقة الائتمان للاستعلام عن المنافسين، وتجسست على السائقين العاملين لدى الشركات المنافسة. كما بنت مجموعة الخدمات الاستراتيجية التي استخدمت «شبكات الإنترنت الافتراضية الخاصة، والحواسيب المحمولة الرخيصة، ونقاط اتصال لاسلكية مدفوعة نقدًا». انتحلت أوبر أيضًا شخصيات سائقين في الدردشات الجماعية الخاصة لحيازة معلومات حول المنافسين، والتقطت صورًا للمسؤولين، وتتبعت الناس، وسجلت المحادثات الخاصة للمنافسين.
أظهر آيزاك كيف صرف كالانيك 10 ملايين دولار على التجسس والنشاطات المشابهة. وقد سرب مارك ماكجان، كبير جماعات الضغط السابق في أوبر والمسؤول عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في تموز، لصحيفة الغارديان أكثر من 124 ألف وثيقة تبرز مدى استخفاف أوبر بالقانون، ما بين 2013 و2017، وكيف قام المدراء التنفيذيون بالتودد لرؤساء دول من أجل بناء إمبراطوريتهم.
بعد سلسلة من التحرشات الجنسية وفضائح التحيز في مكان العمل، استبدل كالانيك كمدير تنفيذي عام 2017، ليحل محله دارا خوسروشاهي، الرئيس السابق لإكسبيديا. وقد غير خسروشاهي الشركة من بعض الجوانب منذ توليه المنصب، لكن لا يبدو أن الرقابة التي يواجهها السائقون قد تقلصت.
بحسب ما ورد، استولت أوبر في الفترة التي غطاها كتاب آيزاك على 20% إلى 25% من تكلفة الرحلة، فضلًا عن الخدمات الإضافية. في هذا العام، أطلق خوسروشاهي نظامًا جديدًا لمحاسبة السائقين وتسعير التوصيلات في بعض المدن. اعتمدت التعرفة على «عدد من العوامل»، بما فيها «الأسعار الأساسية، وطول ومدة الرحلة المقدر، ومطالبة الزمن الفعلي في مكان الوصول، والتسعير الديناميكي أو المفاجئ»، بحسب موقع الأخبار الاستقصائية على الإنترنت، مارك أب، في حين أن محاسبة السائقين غير شفافة ومتفاوتة. شارك أحد السائقين بعض إثباتات مدفوعاته مع موقع مارك أب، بينت إحداها أن السائق حصل على 14 دولارًا بينما حصلت أوبر على 13 دولارًا عن التوصيلة، بينما بينت أخرى أن السائق حصل على ستة دولارات في حين أخذت أوبر تسعة دولارات. ولا أحد يعلم لماذا تتذبذب دفوعات السائقين. ولكن ما نعلمه حقًا هو أن أوبر تتعقب مقاييس تصل إلى السرعة التي يفرمل السائق عندها، وأين يذهب السائق، وتقييماته، والتوصيلات التي يقبلها ويلغيها، وكم يلزمه من الوقت ليصل إلى مكان ما، وبهذا، يبدو من المرجح أن الدفع يرتبط بكافة هذه المعطيات.
تفعل شركات أخرى، مثل شركات توصيل الطعام دورداش وإنستاكارت، شيئًا مشابه أيضًا، مستخدمة أنظمة غير شفافة في توزيع الدفوعات الشخصية. كانت إنستاكارت تدفع مبلغًا أساسيًا لعمال التوصيل، ولكن قرارات الدفع باتت الآن صندوقًا أسودًا. ويخشى العمال أن الشركة تستخدم كل ما تعرفه من أجل أن تدفع لهم أقل ما يمكن، إلا أنه ليس بمقدورهم إثبات شيء.
إن كل هذا محبط وبائس، ولكن كيف يرتبط بالديمقراطية؟ يقدم كتاب إليزابيث أندرسون المقنع والشيق «الحكومة الخاصة»، الصادر عام 2017، إجابة جزئية. تهز إليزابيث أندرسون، وهي فيلسوفة سياسية من جامعة مشيغان، القارئ من كتفيه لتخرجه من الجمود الغريب الذي يتخلل النقاشات العامة حول الحكومة. فالتوظيف هو شكل من أشكال الحكومة كما تجادل؛ شكل أكثر صلة ومباشرة بالنسبة لغالبية الناس من شكل الحكومة المتمثل في واشنطن .
تضع شركة قوية مثل أمازون على سبيل المثال، شروط توظيفها الخاصة، وتؤثر في عملها هذا على سائقي البريد السريع وصناعة اللوجستيات الأوسع. يمتلك أصحاب العمل الخاص والتأثيرات الواسعة على مستوى الصناعة سلطة قسرية، أو ما تدعوه أندرسون بالسلطة الحاكمة. كانت الحكومة الخاصة، مجسدة بالنقابات الخاصة أو الاحتكارات الاقتصادية التي تقرها الدولة في مجال الصابون والملح والجلود، هي الهدف المركزي للنشطاء والمفكرين من أمثال جون لوك ونشطاء حركة المساواتيين [في بريطانيا القرن السابع عشر]. ترى أندرسون لدى لوك وآدم سميث وغيرهما قناعةً بأن السلطة التعسفية للإذلال والانضباط تشكل تهديدًا للمجتمع الحر، حيثما ظهرت، وأنه على الحكومة العامة المسؤولة أن تحمي الناس من الطغيان الخاص. فتجادل بأن العديد من «المفكرين والسياسيين» المعاصرين هم «مثل أولئك المرضى الذين لا يشعرون بنصف جسدهم»: من حيث إنهم «لا يستطيعون إدراك نصف الاقتصاد: ولا يدركون نصف ما يجري ما وراء السوق، بعدما يتم قبول عقد التوظيف». ونظرًا لذلك، تتم معاملة الشركات عمومًا على أنها خاصة تمامًا.
يعيش الكثير من عمال القطاع الخاص، بحسب أندرسون «في ظل الدكتاتورية في حياتهم العملية. وعادة ما تمتلك هذه الدكتاتوريات السلطة القانونية لتنظيم حياة العمال خارج ساعات العمل أيضًا، نشاطاتهم السياسية، وكلامهم، وأزواجهم، واستخدامهم للعقاقير المخدرة والكحول والتدخين والتمارين الرياضية». بالنسبة لها، فإن عمال الخدمات الذين يعملون على مدار الساعة، والتقنيين والسماسرة والطباخين الذين يبدون وأنهم يتمتعون بحرية حقيقية، هم في الواقع مثقلون بنظام قانوني يبيح للمؤسسات طرد العامل بناءً على نشاطه خارج ساعات العمل.
إن حرية التعبير للعمال غير موجودة عمليًا إلا إذا كانت تتعلق صراحة بالتنظيم العمالي، والتي كما تجادل أندرسون، هي فعليًا حبر على ورق في هذه الأيام، نظرًا لصعوبة التطبيق والخوف من تحدي تكتيكات المدراء.
كيف وصلت الأمور إلى هذا السوء؟ تعتقد أندرسون أن القضايا الجذرية التي مهدت لمكان العمل البائس الحالي تعود إلى أجيال سابقة. عندما نقلت الثورة الصناعية «موقع العمل المأجور الأساسي من الأسرة إلى المصنع»، استوردت التقليد العريق للقوة الاستبدادية الكاملة داخل الأسرة، والتي لم يمتلك الأطفال فيها الحرية في مواجهة آبائهم، والتي امتلكت فيها الزوجات حرية محدودة في مقابل أزواجهنّ. كان يمكن للثورة الصناعية أن تمنح مهربًا من «طغاة الحياة المنزلية»، ولكنها نسختهم بدلًا من ذلك.
في ذروة مجد شركة فورد للسيارات، بدأ القسم الاجتماعي بتفقد منازل العمال. تكتب أندرسون: «كان العمال مؤهلين لأجر الخمسة دولارات الشهير الذي كانت فورد تمنحه يوميًا فقط في حال أبقوا منازلهم نظيفة، وتناولوا الطعام الصحي، وامتنعوا عن شرب الكحول، واستخدموا حوض الاستحمام بالشكل المناسب، ولم يؤجروا ساكنين لديهم، وتلافوا صرف الكثير من المال على الأقارب الأجانب، واندمجوا في تقاليد الثقافة الأمريكية».
تشير أندرسون إلى أن آبل، وبينما لا تزور منازل الناس اليوم، إلا أنها تطالب عمال التجزئة بفتح حقائبهم للتفتيش قبل الدخول إلى العمل. نحن نأخذ هذه الأمور كمسلمات، كما تلاحظ، ولكن هل يجب علينا فعل ذلك؟ قرابة نصف الأمريكيين قد خضعوا لاختبار فحص المخدرات. ولا يملك العديد من العمال أي حماية من الطرد بسبب ما يقولونه في وسائل التواصل الاجتماعي. أما لأولئك الذين يدعون أن مكان العمل ليس حكومة لكونك تستطيع الاستقالة متى تشاء، ترد أندرسون بحزم، «كأنك تقول أن موسوليني لم يكن ديكتاتورًا، إذ كان بإمكان الإيطاليين الهجرة».
لا تركز أندرسون على الرقابة، لكن عملها يفترض أمرين، أولًا أن علينا من أجل مواجهة التجسس المستمر، والتركيز على السلطة وليس فقط التقنيات. حيث يجب أن تكون حقوق العمال وإنفاذ مكافحة الاحتكار ردودًا أولى على هيكليات السلطة القائمة التي تزداد سوءًا. وثانيًا، أن نتعامل مع مراقبة المدراء تمامًا كما نتعامل مع الرقابة الحكومية، أي بشك عميق. من البديهيات أن الرقابة الحكومية تجمد الكلام والنقاش وتفتت المجال العام؛ ولكن متى استوعبنا مكان العمل كموقع سلطة، فربما يمكننا بناء حركة سياسية من أجل حرية أكبر في الأماكن التي يقضي فيها العاملون معظم ساعات استيقاظهم.
من أجل أن نفهم الواقع الذي نعيشه، يلزمنا أن نتمكن من محادثة بعضنا بعضًا دون خوف من أن تستخدم المحادثة ضدنا. فالمحادثات الخاصة بين العمال والأصدقاء، والنقاشات والأسئلة، هي جزء من الالتحام والارتباط الذي لا يتيح تنظيم العمال فحسب، ولكن تنظيم الحياة العامة أيضًا. أما عندما يتم الاستماع إلى كل ما نتفوه به، خاصةً من جانب كادر من الموظفين أصحاب السلطة، يصبح من الأيسر عدم الكلام. لا يختلف هذا عن الشمولية السياسية التي حذرت منها حنة أرندت، حيث تهدف الدولة إلى تفكيك كل من الخاص والعام من خلال غمر الخاص في العام، ثم السيطرة على العام. فالاستنتاج المنطقي لرقابة مكان العمل هو أن المجال الخاص يتوقف عن الوجود في المنزل، نظرًا لكونه يتوقف عن الوجود في العمل، حيث الرقابة داخل حياة العامل مطلقة بلا حدود.
بوجود عمال مفتتين كليًا وممنوعين من التواصل مع بعضهم بعضًا، وفي المقابل مجبرين على تقديم صورة كاملة خاصة عن أنفسهم إلى مدرائهم، لا يمكن تصور ديمقراطية.
بينما كنت أعمل على بحثي قبل ثلاث سنوات لكتابي حول الاحتكارات وكيف تعمل كحكومات خاصة، تحدثت إلى مربي الدواجن الذين كانوا يتقاضون أسعارًا تختلف كل شهر من جانب موزعي الدواجن الكبار. بقي أحد المربين عالقًا في ذهني، وهو رجل محب وغاضب ومحبط، وصف كيف يكون الحال عندما يحصل على دفعة شهرية من موزع الدواجن دون أن يعرف ما إذا كان المبلغ الذي حصل عليه يعكس المنافسة الشريفة مع باقي المربين، أم ينطوي على انتقام منه للتحدث علنًا، أم يتضمن دليلًا على أنه كان جزءًا من تجربة. وقد تذكر أن زملاءه المربين اعترفوا بأنه انتابهم الغضب الشديد حتى إنهم رغبوا بقتل الموزعين.
يدعى نظام المدفوعات هذا بنظام المنافسة، حيث يتنافس المربون على الإنتاجية ويدفع لهم نظريًا على أساس إنتاجيتهم بالمقارنة مع المربين الآخرين. إلا أنه ليس هناك محاسبة أو آلية لتدقيق الحقائق: إذ يحتفظ الموزع بكافة المعطيات، وعندما يتم تمرير شيكات الدفع، فإن على المربين الذين يعتمدون كليًا على الموزعين تقبل كونهم صادقين إذا أرادوا البقاء بعيدين عن الإفلاس. إن بنية مشابهة لهذا النظام هي المخطط الأولي لكيفية ممارسة أمازون لسلطتها على نظرائها، سواء أكانوا حكومات أم بائعين أم عمال.
يغطي براد ستون في كتابه الثاني حول نمو شركة أمازون، «أمازون غير المقيدة»، توسع الشركة الهائل خلال العقد الماضي ونمو سلطتها السياسية. كان جيف بيزوس، بحسب تعبير ستون، منخرطًا بعمق في كافة نواحي إدارة الموارد البشرية، سواء في مكاتب الشركة أو في المستودعات. وقد تبنى نظام تعويض وترقية دعاه «الترتيب المكدس»، رتب فيه مدراء المستوى الأوسط موظفينهم وطردوا من كان في أدنى مستوى التصنيف. إذ عين للمدراء حصصًا بعدد الناس اللازم طردهم، وكان متوقعًا منهم تصنيفهم للوصول إلى هذه الغاية. ولكن هذه الممارسة توقفت بعد نشر قصة على الصفحة الأولى من التايمز حول ثقافة تحريض العمال ضد بعضهم البعض.
لكن الفلسفة التي تجبر الناس على القتال من أجل الفتات وطرد الأقل إنجازًا منهم، تعاود الظهور في أجزاء مختلفة من الشركة. عندما كانت أمازون تعتمد على المقاولين لتسليم الطرود، طورت تطبيقًا يدعى «الأرنب» لتتبع التوصيل. وقد راقب فريق الأرنب السائقين؛ «تخطوا وجبات الطعام، وأسرعوا عبر إشارات الوقوف، وألصقوا هواتفهم بأرجل سراويلهم حتى يتمكنوا من النظر أسفلًا إلى الشاشات، وكل ذلك من أجل تلبية تحدي مواعيد التسليم»، يقول ستون، ومن لم يتمكن من ذلك تم طرده. عندما قررت أمازون أنها تريد بناء مقر جديد، أعلنت مسابقة لتحديد الموقع، فما كان إلا أن حصلت على معطيات منافسة من 238 مدينة مختلفة مجانًا عبر هذه العملية.
بحسب ستون، الذي كان مراسلًا تقنيًا في وكالة أنباء بلومبيرغ، كان بيزوس شديد الحنق عندما حاول مدير العمليات في أمازون جعل الشركة تدمج المنهجية «المرنة» لشركة تويوتا، والتي طور العمال فيها الثقة والعلاقات مع مدرائهم بهدف التوظيف طويل الأمد. وعندما قدم مساعد مدير الموارد البشرية من ذات القسم ورقة تدعى «احترام الناس»، يقول ستون، «كرهها بيزوس. ولم يكتف بالاعتراض عليها في الاجتماع بل ودعى مساعد المدير في الصباح التالي لمتابعة إرهابه». فقد أراد بدلًا من قوة عمل متزنة مستقرة، إبقاء عمال المستودعات لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إلا إذا حصلوا على وظيفة جديدة داخلية. وقد قلص بشدة العلاوات الممنوحة بعد ثلاث سنوات.
تطالب الشركة عمال المستودعات بأمور خارجة عن المألوف: يمنع الكلام، ويتم تتبع كل شيء، ويطرد العمال الذين يفشلون بالالتزام بحصصهم، كما يتوقعون أن الظروف ستكون سيئة بما يكفي كي يستقيل العمال. وقد روت التايمز أنه ما قبل الجائحة كان «دوران العمل بين القوة العاملة لديها يقارب 150% سنويًا». «تقضي 10 ساعات واقفًا على قدميك، وليس هناك نوافذ في المكان، ولا يسمح لك بالكلام مع الناس، لا يسمح بالتفاعلات»، ذلك ما قاله أحد العمال لفوكس في رواية عن العدد المتزايد من اتصالات مستودعات أمازون على رقم الطوارئ 911. «تنامى لدي شعور أنه خلال وقت قصير سيدعون الناس تعمل حتى الموت، أو يصابون بالإجهاد إلى الحد الذي يتركون فيه العمل».
«إنه أحد الأسباب الكبرى لرغبة الناس بالاتحاد»، يقول كريس سمولز، وهو قائد اتحاد العمال في أمازون الذي نظم مستودع ستاتون أيلاند هذه السنة، لصحيفة الواشنطن بوست في كانون الأول الماضي. «من يرغب بأن يُراقَب طوال اليوم؟ إنه ليس سجنًا، إنه مكان عمل».
قد يكون من المغري اعتبار مراقبة أمازون مشكلة مستودع، وتغير الأجور المدفوع بالرقابة على أنه مجرد مشكلة مزعجة، لكن ما من حدود قانونية تمنع أصحاب العمل من تضمين أشكال جديدة من الأجور المتغيرة في التوظيف الرسمي، والإساءات التي يواجهها المتعاقدون المستقلون تندمج مع تلك التي يواجهها الموظفون الرسميون. إن هذه إحدى الحجج الأساسية لكتاب «مديرك هو خوارزمية» لأنطونيو ألويسي وفاليريو دي ستيفانو، وكلاهما من أساتذة القانون الأوروبيين. إن العمل المحدود زمنيًا، حيث يكون العامل هو الأضعف، هو موقع لتجارب تقنيات إدارية جديدة. تصبح هذه التجارب أرض الاختبار لاستراتيجيات تُستجلب لاحقًا في أشكال أخرى من التوظيف.
يجادل ألويسي ودي ستيفانو أن المستقبل يتجلى في دمج أدوات التعقب والمكافأة في العمل المؤقت، مع عقود العمل التي تسمح بتغيير الأجور. والأدوات المتاحة واسعة جدًا:
يفتش «آكتف تراك» البرامج المستخدمة وتعلم المدراء عن أي موظف فاقد للتركيز، يقضي وقته على منصات التواصل الاجتماعي. يسجل «أوكيوب آي» متى وكم من الوقت يتغيب فيه أحدهم عن مركز عمله. بينما يتتبع «تايم دكتور» و«تيرامايند» كل مهمة تدار على الإنترنت. وبالمثل، يجمع «إنترغارد» جدولًا زمنيًا دقيقة بدقيقة لمراقبة كافة المعطيات مثل تاريخ استخدام الشبكات وسعة الإنترنت المستخدمة، ويرسل إشعارات إلى المدراء إذا ما التقط العمال شيئًا مريبًا. فيما يلتقط «هابستاف» و«سنييك» صورًا روتينية للموظفين من خلال كاميرات الشبكة كل خمس دقائق تقريبًا لتوليد بطاقات حضور وتدويرها من أجل رفع المعنويات. يقوم «براغلي» بمزامنة رزنامات العمل وقوائم الموسيقى لخلق حس بالانتماء المجتمعي؛ كما يشمل خاصية تعرف على الوجوه يمكنها أن تعرض أحاسيس العامل الحقيقية على وجهه الكرتوني الافتراضي.
في الوقت الحالي، قد تتوفر الكثير من الأدلة على أن هذه الأدوات تستخدم لتغيير الدفعات والأجور في أماكن العمل التقليدية. سوى أن الكاتبين يجادلان بأنه ليس من الصعب مزج هذه الأدوات التقنية مع الابتكارات القانونية في عقود العمل. إذ يمكن للعقود التي تسمح بالأجور المعدلة أن تجلب بسهولة الكثير من شروط الوظائف المؤقتة إلى التوظيف التقليدي. وقريبًا ستهجر الشركات نموذج الأجور الثابتة الذي كان سمة توظيف ذوي الياقة الزرقاء لعقود.
ليس مصادفة أن رقابة العمل الروتيني مشت على خطى ثورة ريغان لمكافحة الاحتكار وانهيار اتحادات ونقابات القطاع الخاص. فلا شيء باستثناء العمل النقابي أو القوانين الجديدة توقف رب العمل من سحب كافة المعطيات التي يجمعها من أجهزة الاستشعار والتسجيل، واستخدامها للمزيد من الدقة في تعديل الأجور، إلى أن يحصل كل عامل على الأجر الأدنى الذي يقبل العمل به، ويعيش كافة العمال في رعب من الانتقام. ليس هذا خيالًا علميًا أكثر من فيسبوك وغوغل اللذين يقدمان المحتوى الفردي للمستخدمين والإعلانات المصممة لإبقائنا معتمدين على خدماتهم أطول فترة ممكنة، متيحين لهم بيع أكبر كم ممكن من الإعلانات.
كانت الملابس المفصلة التي ارتدتها مديرتي من بارك أفنيو علامة تميز؛ درجة أعلى فوق التصنيع الشامل بالجملة، أطقم خيطت لتلائم جسدها الخاص، وأحذية صنعت لتلائم الأخاديد والأقواس في قدمها. إن الوعد الحديث بشخصنة التقنيات، والبناء على مفهوم رومانسي بالأصالة والفردانية، يعني أن بمقدورنا أن نعيش جميعًا في عالم مفصل بشكل مشابه، حيث قوائم الأخبار معدلة بحسب تفضيلاتنا واهتماماتنا الاحترافية والترفيهية. قد تكون أحد المستمعين القليلين الذين يحبون كل من كيني روجرز وكيور، ولكن سبوتيفاي يعرفك، ويمكنه أن يأتي لك بأغان تحادث روحك أنت وحدك.
لكن توسيع روح التفصيل حسب الطلب أمر غير رومانسي على الإطلاق: فقد تمتلك تلك العينان حميمية وذكرى الحبيب، إلا أنها تفتقر إلى العاطفة. تعني تقنيات المراقبة الحديثة بأن الأجور المفصلة حسب الطلب ستحل في كافة أماكن العمل. لقد كانت أجور نهايات القرن العشرين البائسة والمنتجة على نطاق واسع تنذر بالخطر فعليًا، إلا أن أجور الذكاء الاصطناعي الجديدة والمصممة خصيصًا في القرن الـ21 تخلق مستوى جديد من السلطوية. ويتوجب علينا من أجل إيقافها، حظر أشكال معينة من التجسس، واستخدام قوانين العمال وقوانين مكافحة الاحتكار لإعادة هيكلة السلطة.
يجوز تسويق تقنيات التتبع كأدوات لحماية الناس، ولكن سيؤول الأمر إلى استخدامها في تحديد ضآلة المقدار الذي يقبل كل عامل أن يجنيه. وستستخدم لخفض الأجور وقتل الزمالة والصداقة التي تسبق العمل النقابي بتصعيب التواصل مع العمال الآخرين، وتسميم المجتمع الذي يمكّن النقاش الديمقراطي. وستستخدم لتعطيل التضامن من خلال فروقات الدفع بين العمال. كما أن هذا سيؤدي إلى تفشي التوتر والخوف في مكان العمل، حيث ستكون ضبابية أسباب حصولك على مكافأة أو تخفيض العلامة الفارقة في يوم العمل.
إن هذا الأمر في منتهى الأهمية لأن العمل ليس أمرًا ثانويًا للمجتمع الديمقراطي؛ فالعلاقات التي تبنى في العمل هي لبنة أساسية. بوجود عمال مفتتين كليًا وممنوعين من التواصل مع بعضهم بعضًا، وفي المقابل مجبرين على تقديم صورة كاملة خاصة عن أنفسهم إلى مدرائهم، لا يمكن تصور ديمقراطية.