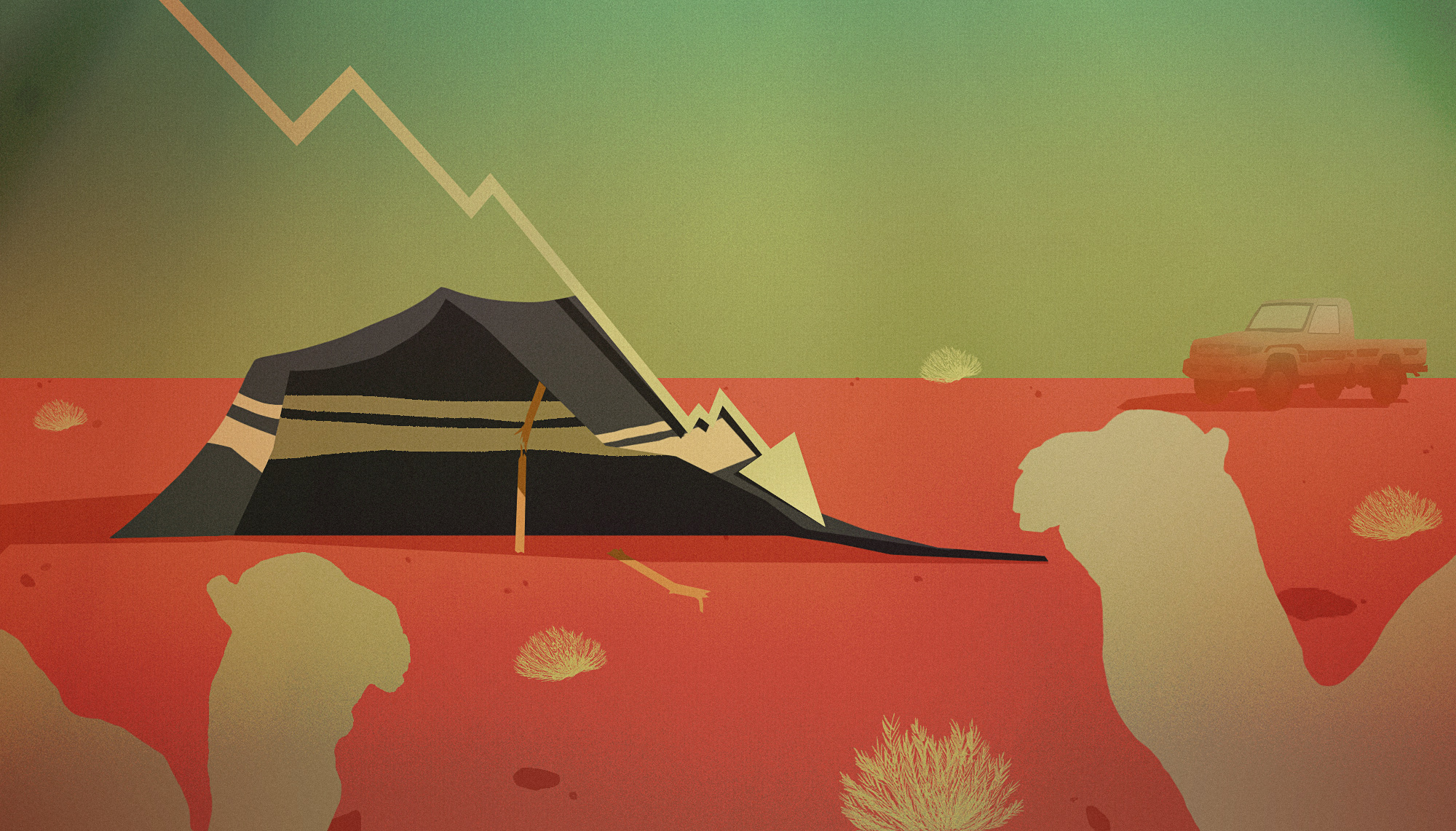قد تكون من المصادفات المفيدة، أنني وجدتُ نفسي محتفظًا بنصوص أول مقابلات بحثية أجريتها مع «سرّيحة الحاويات» في شباط عام 1998، أي قبل 23 عامًا بالضبط. سوف تتيح تلك المقابلات القديمة المكتوبة بخط اليد، مجالًا لرصد أشمل لسيرة مجمل ظاهرة «التنبيش» في الحاويات، وإجراء المقارنات اللازمة لتطور الظاهرة عبر الزمن.
في الواقع لقد تضخم حجم هذا النشاط كثيرًا، ولا غرابة في ذلك باعتباره نتاج فشل تنموي كليّ في المجتمع. ففي تلك المقابلات القديمة ما يشير إلى أن عدد «السّرّيحة» كان حينها بالعشرات فقط، لدرجة أنهم كانوا عمومًا يعرفون بعضهم بعضًا، وكانوا يقومون بعملهم ليلًا وفي مواقع محددة وبخطوط سير موزعة بينهم.
لقد كانت تسمية «سرّيحة»، وهي جمع لغوي شعبي لمفردة «سرّيح»، تُطلق على فريقين مختلفين إلى حد ما؛ الأول يضم مَن كانوا يسمون «سرّيحة نهاريين» أي جامعي الخردة والأدوات والمواد المستعملة الذين يتجولون علنًا في سيارات «بيك أب»، في العادة ينادون عبر مكبرات الصوت بحثًا عن تلك المواد التي يشترونها مقابل سعر يخضع في العادة لتفاوض قاسٍ. والثاني يضم «السّرّيحة الليليين»، أي نبّاشي الحاويات الباحثين عما يمكن إعادة تدويره بيعًا واستخدامًا من الأشياء التي تخلى عنها أصحابها وألقوا بها في حاويات النفايات. كان هؤلاء السريحة يقومون بعملهم ليلًا اتقاءً لنظرات الناس، لأن العمل لم يكن مقبولًا أو مستوعبًا اجتماعيًا.
أقرأ في تلك المقابلات القديمة أن السريح في العادة لم يكن يُبلغ جيرانه، وأحيانًا لم يكن يُبلغ أهله المقربين بطبيعة عمله، وأنه في العادة كان يخرج من بيته في ساعة متأخرة من الليل، يحمل كيسًا ويقوم بجولة تتكرر لعدة أيام في الأسبوع. وفي كل الحالات التي قابلتها كان السريحة من الذكور (شبابًا ورجالًا)، القاطنين في مناطق عمان الشرقية، يقومون بعملهم في أحياء غرب عمان الأكثر ثراءً، ويتعاون أغلبهم مع حراس البنايات في تلك المناطق، وتستمر الجولة لساعات وتمتد مكانيًا لعدة كيلومترات. وبعد أن يكتمل جمع حُمولة الكيس، يكون النهار قد بزغ، فيستخدم السريح واسطة نقل (سرفيس أو باص) ويدفع أجرته وأجرة نقل الكيس (10 قروش عني و15 عن الكيس كما ورد في مقابلة مع أحدهم حينها) نحو وسط عمان، وتحديدًا نحو آخر شارع سقف السيل، حيث يقوم بفرز وتصنيف ما جمعه لتجد كل قطعة طريقها، إما إلى زبون مباشر أو إلى تاجر جملة من المتواجدين في منطقة ما يعرف بـ«سوق الحرامية»، وهو اسم على «غير مسمى» بالطبع كما توصّل البحث الميداني حينها، وكما يعرف جميع باعة السوق وزبائنه الدائمون.
تضخم النشاط
لقد تغير الوضع كليًا وبتسارع منذ سنوات، لم تعد السّراحة على الحاويات ليلية فقط، بل امتدت على مدار الساعة ليلًا ونهارًا، حيث تخضع كل حاوية لعدة جولات نبش يومية، كما لم تعد العملية مقتصرة على أحياء عمان الغربية، وأصبحت تشمل حاويات مختلف الأحياء بما فيها الأحياء الفقيرة (أنا مثلًا، أقطن في منطقة الهاشمي الشمالي وأعمل فيها، وألاحظ أن جولات السريحة لا تتوقف طوال الوقت وتشمل كل الشوارع والطرقات الفرعية، وتتكرر الوجوه بما يعني انتظام العمل. ومن خلال أسئلة سريعة ظهر أن هناك ملتحقين جددًا بالعمل في هذه المنطقة على الأقل). ومن ناحية أخرى لم يعد العمل في السراحة يقتصر على الذكور، فهو الآن يشمل الكثير من الإناث كما يشمل الأطفال، بل يشترك الآباء مع أبنائهم ومع بناتهم أيضًا في عملية الجمع التي صارت تجري علنًا وبوضوح، ولم يعد مشهدها يثير الاستغراب.

جولة تفاوض صباحية بين مورّد بضاعة وباعة. تصوير أحمد أبو خليل.
لقد تنوعت وسائل وأدوات الجمع كثيرًا؛ تجد اليوم مشاةً على أقدامهم، بعضهم يحمل كيسًا وآخرين يجرون ما يجمعونه جرًا بواسطة حبل مناسب ومتين، بعضهم وخاصة من الفتيان يستخدم حمارًا لحمل الأشياء التي عثر عليها، وهناك من يستخدم عربات كبيرة تُدفع باليد، أو عربات التسوق من النوع المستخدم في المتاجر الكبيرة والمولات، فيما يستخدم المقتدرون منهم سيارات متواضعة يحشرون ما جمعوه فيها، وفي كل الأحوال تُستخدم هذه الوسائل بأقصى طاقتها، فهي مزودة بالحبال والأسلاك اللازمة، وتُعلق الأغراض على كل النتوءات المتوفرة في جوانب العربات والسيارات.
هذا التوسع، تطلب توسعًا في سوق التصريف، وبالتدريج، وابتداءً من عام 2009 و2010، وجد السريحة في منطقة فارغة حديثًا في منطقة المحطة، شرق وسط عمان، ساحة مناسبة للزحف نحوها. (أجرت أمانة عمان الكبرى قبيل ذلك استملاكات وإزالة مبان قديمة في تلك المنطقة بعد أن استحدثت لها اسمًا سياحيًا هو «صحن عمان»، كجزء من التحضير لمشروع كبير لإقامة ما سمته وسط عمان الجديد «سوليدير عمان»، نسبة إلى المشروع المماثل الشهير في وسط بيروت، ثم وبتأثير أزمة الاستثمارات العقارية العالمة وارتداداتها المحلية، توقف المشروع، وتشكلت ساحات مفرغة تتوسط المسافة بين مجمع المحطة للنقل العام وبين سوق «بالة المحطة» القديم القائم بجوار جسر المحطة).

طفلة تحضّر وجبة إندومي بجانب بسطتها. تصوير أحمد أبو خليل.
غير أن تطورًا جديدًا حصل في الأشهر الأخيرة، وخاصةً بعد الحملة الأمنية الكبيرة التي عرفت بحملة «فارضي الأتاوات والبلطجية»، والتي راح أصحاب البسطات عمومًا ضحيتها بلا ذنب مباشر، فإثر ذلك، اندفع عدد كبير من سريحة الحاويات إلى الموقع الجديد لتصريف بضائعهم. يشمل الموقع مئات وحدات البيع، على شكل بسطات متنوعة، ولكن أكثر من ثلثيها عبارة عن بسطات تعرض أغراضًا وسلعًا من تلك التي جمعها سريحة الحاويات.
السراحة في زمن كورونا
في السنة الأخيرة، سنة كورونا، أمكن، وبدلالة المشهد في هذا السوق وفي الشوارع حيث يمارس العمل، ورغم تقلص زمن السراحة بحكم تقلص زمن التجول، أمكن رصد زيادة في حجم العاملين في مجمل الأنشطة غير الرسمية، وفي ميدان نبش النفايات أيضًا. وكما في باقي الأسواق، تفرض إجراءات مكافحة كورونا نفسها هنا كذلك، فهناك دوريات للأمن تتجول في الموقع لمراقبة الالتزام. لقد قمت في الأيام الأخيرة بزيارتين خاصتين، واحدة للتعرف على السوق لحظة بدء العمل فيه في الصباح والثانية مساءً لملاحظة سلوك العاملين وقت الإغلاق.

السوق وهو مغلق. تصوير أحمد أبو خليل.
قد يكون هذا السوق من أكثر الأسواق أمنًا! هنا لا توجد وسيلة لإغلاق البسطة مساء سوى تغطيتها بالشوادر القماشية أو البلاستيكية، وتوزيع حجارة لمنع تطاير الأغطية، ثم المغادرة، وقد لاحظت أن العاملين ملتزمون جيدًا بوقت الإغلاق المخصص للمؤسسات، مع ملاحظة أن هذا يقتصر على بسطات السريحة، حيث أن أصحاب البسطات الأخرى يقومون بجمع بضائعهم ونقلها خارجًا في سيارات.
ولكن الزيارة الصباحية أظهرت عناصر أخرى أكثر تعقيدًا. فقد وصلتُ إلى الموقع قبل السادسة والنصف صباح الخميس الماضي، 11 آذار، كان عدد من أصحاب البسطات قد بدأ بالفعل برفع الأغطية عن الأغراض التي باتت من الليلة الماضية، فيما كان عدد من مُورّدي البضائع من حصيلة سراحتهم في اليوم السابق يحضرون إلى السوق.
توضح الحركة أن شبكة المتعاملين في هذه التجارة متشعبة؛ هناك سرّيحة يتوقف عملهم عند الجمع، ولا يقومون بأنفسهم بالبيع المباشر للزبائن، لكنهم يجلبون بضاعتهم في الصباح الباكر، حيث ينتظرهم باعة «وُسطاء» يشترون المواد بالجُملة من صاحبها، ثم يقومون ببيعها بأنفسهم خلال النهار، أو إجراء عمليات بيع فرعية أخرى. يتجمع الباعة حول مُورّدي البضائع ويجرون مفاوضات أشبه بالمزايدات على تلك البضائع. ثم يغادر السريح نحو جولته الجديدة، فيما يواصل الباعة بالمُفرّق عملهم في السوق. من الواضح أن منع التجول ليلًا ألقى بظلاله على أوقات السراحة وأوقات البيع، وخلق أو عزز في الواقع، أنماط توزيع العمل المعتمدة في هذا القطاع. إن السوق يبدل ساعات عمله وفق ساعات الحظر، فقبل القرار القاضي بالإغلاق المبكر في السادسة، كان باعة البسطات قد تمكنوا من توفير إنارة تسمح لهم بالعمل في ساعات المساء المسموحة.

الساحة التي انتزعت من السوق وتظهر سيارة الحراسة. تصوير أحمد أبو خليل.
كنتُ منذ بداية إجراءات مكافحة كورونا قد قمت بعدة زيارات للسوق، في الأشهر الأولى، كان مستوى النشاط محدودًا، وقد غاب كثيرون، إذ لم تعد هناك جدوى من الحضور. لكن هذه الأيام، يفيد المشهد أنّ النشاط أفضل نسبيًا، ولكن الباعة يؤكدون أنهم كغيرهم يعانون من الركود العام.
أحد محدّثينا، وهو رجل يبلغ عمره 47 عامًا، قال إنه يعمل في السراحة منذ عام 1990، وقد واظب على العمل في وسط البلد (منطقة سقف السيل)، فهناك كانت الحركة أفضل، لكنه منذ أشهر وبعد الحملة الأمنية اضطر للانتقال إلى هنا. ثم يضيف: إن وسط البلد «خط أحمر» بالنسبة للحكومة!
من الواضح أن عبارة «خط أحمر» قد تخلت هنا عن وقارها، فقد جرت العادة أن تُستخدم عند الحديث عن قضايا كبيرة، ولكن باعة البسطات أخضعوها لمقتضيات عملهم كما يبدو.

البسطات مغلقة قبل البدء صباحًا. تصوير أحمد أبو خليل.
كان محدثنا يتحسر على سوق زمان، من حيث حركته ومردوده. لكنه مع مواصلة الحوار طرح أمامي شكوى خاصة جديرة بالانتباه، فقد فاجأني بقوله: إنهم يلتقطون لنا الصور ويقولون عنا إننا نأكل من الحاويات! نحن لا نأكل من الحاويات، نحن نشتغل بجمع أشياء نبيعها ونستفيد منها.
إن شكواه محقة، ففي الواقع، لا تستطيع الصور الكثيرة التي تنشر لمواطنين وقد أحنوا أجسادهم داخل الحاويات أن تثبت أنهم يبحثون عن طعام. لكن سعي الصحافة (والتواصل الاجتماعي) لتقديم صورة «جذابة» يطغى على عرض الحقيقة، المتمثلة بكون هؤلاء جزء من قطاع هامشي، يعمل في نشاط إعادة تدوير النفايات، ويكمل نشاطه مواطنون، بل وأسر كاملة، وتجمعات سكانية تعمل وتقيم قرب مكبات النفايات، تقوم بالتنبيش الجماعي الكثيف في المكبات الكبيرة خارج المدن.
أسى وحيرة وقلة حيلة
أحدث المشاهد في هذا السوق، أن «العيون الفارغة» وصلت هنا، فقد أُبعِد أصحاب البسطات من مساحة تبلغ حوالي دونمين (2000 متر مربع)، وجرت تسويتها وتزفيتها وإحاطتها بالأسلاك، ووزعت المساحة إلى 411 قطعة مربعة، يبلغ طول ضلعها مترًا ونصف، على شكل صفوف بينها ممرات بعرض متر واحد. إنها تجربة سوق شعبي للبسطات، ولكن بعد مرور أشهر لا تزال الساحة مغلقة وغير مستغلة، وتوجد حراسة أمنية دائمة تمنع أحدًا من الاقتراب منها، وهناك «أقاويل» عن نية الأمانة تأجيرها، ولكن ما يعني مؤسسي هذا السوق من أصحاب البسطات الأصليين أن المساحة انتزعت منهم انتزاعًا.
بالطبع لا تتوقف حملات المداهمة ومصادرة البضائع، لكن كما هي العادة، وكما تشير مقابلاتي القديمة قبل ربع قرن، فإن أصحاب بسطات «السراحة» يكتفون بالابتعاد عن بسطاتهم أو بعثرتها مؤقتًا، فهي غير «جذابة» للمصادرة، وبعد أن تغادر دوريات المداهمة يعود صاحب البسطة لإعادة جمع أغراضه، ومواصلة العمل ولكن مع المزيد من الحزن والأسى.
في ظل أزمة بطالة خانقة، ومع الاعتراف بتزايد قسوة الفقر، لم تتمكن الجهات الرسمية من مغادرة زاوية نظرها التي لا تزال تقتصر على رؤية عنصر البيع العشوائي غير المرخص، ولا أحد يسأل إن كانت البطالة والفقر مرخصين.