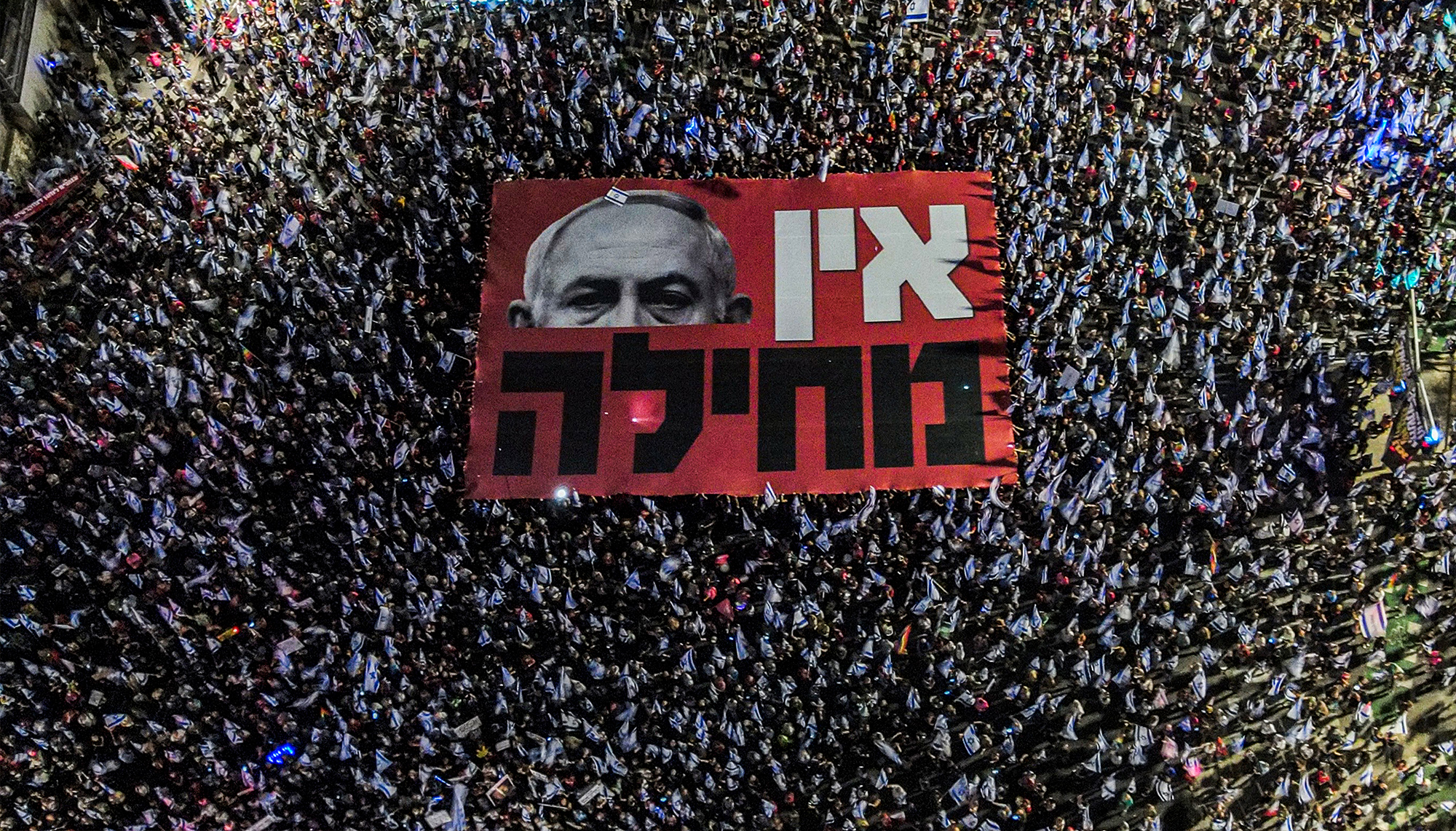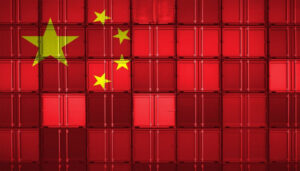نشر هذا المقال للمرة الأولى بالإنجليزية في مجلة «ذا بافلر» في الأول من تشرين الأول 2021.
على مدى معظم العصر الصناعي، كان العاملون في المكاتب حول العالم فئة خوّافة. حتى في عصر ما قبل الوباء الحالي، عانى الكثيرون منهم من مذلّات فظيعة؛ يجلسون في مكعباتهم المقسّمة، يعتنون بزجاجات مياههم ونباتاتهم العصاريّة، ويواجهون المراحيض القذرة وأوعية القهوة المُقزِزة من أجل نيل شرف الجلوس على كرسيٍ يراقبه مدير ما. ثم جاء المكتب المفتوح -كما لو أن تلك المهاجع لم تكن خانقةً بما فيه الكفاية- ومعه تحقق حلم المدير -المصاب بجنون العظمة- بالقدرة على المراقبة المستمرة، وتوجته العلاقات القسرية الناتجة عن التروما المشتركة، والتي تفرضها الأماكن الضيقة. أي ناجٍ من المكتب المفتوح سيخبرك أنه يمكنك حينها «التعرف» حقًا على زملائك في العمل. تشمل هذه «المعرفة» ما إذا كان قد فاتهم الاستحمام، أو تناولوا الكثير من البصل قبل مجيئهم للتحديق في الشاشة بجوارك، بالطريقة ذاتها التي تحدق أنت بها في شاشتك. وقد تشمل هذه المعرفة أيضًا أنّه رغم أنكم تؤدون الوظيفة ذاتها ظاهريًا، إلا أنّهم يتقاضون رواتب تفوق ما تتقاضاه بعشرة آلاف دولار.
مفاد كل هذا هو أنه حتى قبل الجائحة، كان الكثير من العاملين في المكاتب يعانون من جحيمٍ كافكويّ، يشم فيه الجميع رائحة ضراط بعضهم البعض، إلا أنّهم يتظاهرون طوال الوقت بأنهم لا يفعلون. ليس من المفاجئ إذًا بأنّ الأمريكيين الذين يعانون من متحور دلتا، والذين أنهكتهم الجائحة، ليسوا بالضبط متحمسين حيال احتمالية «العودة إلى المكاتب» على نطاقٍ واسع. لقد أفاد مركز بيو للأبحاث في شهر كانون الأول الماضي بأنّ «أكثر من نصف العاملين البالغين [54% منهم] الذين يقولون إن مهام عملهم يمكن تأديتها من المنزل (..) يقولون إنهم في حال كان لهم الخيار، يرغبون بالعمل من المنزل كل الوقت أو معظمه، بعد انتهاء تفشي كوفيد-19». وفي حال أضفنا ما نسبته 33% وهم الذين أجابوا بأنهم يودون العمل من المنزل «لبعض الوقت»، تصبح النسبة الإجمالية 87%. لقد أثار النطاق الهائل لإعادة التفكير المجتمعي بقيمة العمل وكرامة الفرد كعامل ظاهرةً غير مسبوقة، أُطلق عليها اسم «الاستقالة الكبرى». وكذلك هو حال النطاق الهائل للساخطين على مستوى العالم، فوفقًا لمسح أجرته مايكروسوفت شمل عدة دول في آذار الماضي، فإن 41% من القوى العاملة العالمية تفكر في ترك عملها الحالي في غضون العام.
رؤساء العمل مصدومون، حتى إنّ مايكروسوفت لاحظت بأنّ أصحاب الأعمال «منقطعون عن العمّال ويحتاجون إلى نداء يوقظهم». يبدو أنّ ذوي السلطة دائمًا ما يتخيلون أنّ تابعيهم في غاية الرضى، حتى حين يكلفونهم بأنّ يربضوا لساعات في غرفةٍ ما مع كائناتٍ أخرى. وقد رُوّج هذا الوهم أكثر خلال الفترة من القرن الماضي التي كان أرباب العمل فيها هم أصحاب القرار. في الواقع، في عالم ماضينا الضبابي ما قبل الجائحة، كان من المثير للسخرية أن نتخيل أن تنعكس القوى، ليصبح العمّال فجأة مسيطرين، أو على الأقل مسيطرين أكثر مما هم عليه في العصر الحديث. إنّ مما لا ريب فيه أنّ الجائحة قد قضت على ملايين الوظائف، وصحيح أيضًا أنّ أرباب العمل ما يزالون يشعرون بنقص في اليد العاملة، سبّبه -في قطاع الياقات البيض- الإدراك الجمعي بأنّ إمضاءك معظم حياتك مقيدًا إلى طاولةٍ في مجمع مكاتب ليس طريقة مناسبة للعيش، كما سبّبه ركود الأجور وظروف العمل السيئة في جزء كبير من قطاع الخدمات.
إنّ هذا الزمن الذي تتخلله جائحة عالمية ممتدة كئيب بما فيه الكفاية، من دون أن يكون المرء تحت رقابة مدير ما، يخبره بالساعات والأيام التي يجب أنّ يعمل فيها.
لقد دفعتنا الجائحة نحو إدراك أن معظم العمل المكتبي يمكن ببساطة القيام به في أي مكان. بدا كما لو أنّ التوقف الدراماتيكي لعجلة الهامستر التي ندور فيها ما بين العمل والأكل والنوم قد فضح مدى اعتباطية هذه العجلة، ومدى عدم ارتباطها بالعمل الفعلي كذلك. وفيما كان الناس يعدّون مكاتبهم المنزلية ويحتضنون قططهم وكلابهم، أدركوا بشكل جمعي كم هو مريح ألا يضطروا لتحمل عبء الصداقات القسرية في أماكن العمل، والمواصلات المميتة، والرؤساء اللامبالين (والمغفلين). كما لا يبدو أنّ الانتاجية تضررت، فقد وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على العاملين في أحد مراكز الاتصال في شانغهاي في عام 2015 بأنّ أداء أولئك الذين يعملون من المنزل قد تحسن بالفعل بنسبة 13%. كما أفادت بلومبيرج في دراسة أجرتها في نيسان الماضي بأنّه من المرجح أنّ يزيد العمل من المنزل الإنتاجية الأمريكية بنسبة 5%، ويرجع ذلك في الأغلب إلى تقليل الوقت المهدور في التنقل.
هناك سبب اجتماعي نفسي آخر، أقل حضورًا في النقاش، للنفور من الحياة المتمركزة حول العمل، ألا وهو ديناميات السلطة التي تفرضها أماكن العمل الحديثة على العاملين. إنّ معظم الترتيبات المكتبية قبل الجائحة ليست سوى مقارباتٍ فظّة لمفهوم البانوبتيكون الفوكويّ،[1] إذ تستخدم تهديدَ المراقبة المستمرة لضمان التزام العمّال بالقواعد التي وُضعت لهم. وإذا كنت مُذعنًا وحصلت على ترقية، فمن المرجح أنّ تكون مكافئتك هي التحرر من تلك المراقبة، فربما يكون لك مكتبك الخاص حيث لا تكون في مرأى الآخرين كل لحظة. وبهذا المعنى، فحتى في الوقت الذي دافعت فيه العديد من أماكن العمل عن التفكير «خارج الصندوق» أو الابتكار أو الأهداف والمُثل المشابهة، فإنّ النسق المكانيّ للعمل الجماعيّ قد أوقع الناس في شرك الخضوع لمديرٍ تتمثل وظيفته بأكملها في ضمان استمرارية هذا النسق.
حين تحررَ الناس من هذا الانضباط المكانيّ، أدركوا في منازلهم مدى تعسف الرقابة المكتبية، وباتوا يرفضونها ببساطة. بطبيعة الحال، فإن المدراء غير راضين عن ذلك ويشترطون التواجد المادي و«الحضور المقنّع»[2] تحت شعار «التعاون»، ويطالبون بإحياء دورهم كمراقبين بذريعة «العمل الجماعيّ». إنّ مخاوفهم من التغيير متوقعة، ففي المجتمعات الرأسمالية يصنَّف كل فرد وفقًا لقيمته المادية وقدرته الاستهلاكية. بعض الناجحين هم كذلك لأنهم وضعوا عملهم في المركز ورتبوا حياتهم وفقًا له، أو ببساطة وضعوا عملهم المركز لأن لا حياة لهم. لكن هذا سؤال أنطولوجي لا يستحق التفكير فيه. إنّ على بواكي ساعة المرح بعد العمل[3] والمدراء المتوسطين المصابين بجنون العظمة أن يعرفوا أن الحياة ببساطة لا تُعاش في مكان العمل، وأنّ أولئك الذين يتقاضون المال ليتسكعوا معك لا يفضلون ذلك حقًا.
لقد أشار مقال رأي نُشر مؤخرًا في النيويورك تايمز بدقة إلى أنّ هذا التغير في ديناميات سلطة العمل إنّما يلقي الضوءَ أيضًا على الإشكاليّة المتجاهلَة المتعلّقة بالكرامة الإنسانية. إنّ الحضور المقنع، أو اشتراط أن يحضر الشخص لساعات كل يوم، حتى وإنّ كان مريضًا، لمجرد أن «يراقَب»، هي فكرة تنزع عن المرء إنسانيته، وتعامله وكأنه قاصر، وتتجاهل أيضًا حقيقة أنّ الإحساس بالرفاه الحقيقي هو أمر ضروري وجوهريّ للشعور بالكرامة الإنسانية. ليس ضروريًا، ولا يجب، أن يكون العمل لدى الآخرين مشروطًا بالتنازل عن هذا المطلب، ليفوتنا أن ننزل الأطفال من باص المدرسة، أو نساند جارًا مريضًا، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإنّ هذا هو بالضبط ما مثّله العمل بالنسبة لملايين البشر الذين بدأوا يتمردون الآن، على نحوٍ غير مفاجئ.
كان فوكو سيفتخر بكل أولئك الذين استقالوا من وظائفهم أو يفكرون بذلك. إنّ الهروب من الوحشيّة المكانيّة لمكان العمل الخاضع للرقابة الدائمة يجب أن يكون حقًا من حقوق الإنسان.
في الولايات المتحدة، سيعتمد نجاح الطريقة الجديدة من العمل على الحكومة أيضًا. ففك الارتباط بين التوظيف والرعاية الصحيّة، على سبيل المثال، أمرٌ حاسم لتمكين العامل الحقيقيّ من التنقل والاختيار. فالاضطرار إلى البقاء في وظيفة أثرها مريع على صحّتك كشرط للحصول على رعاية صحية هو معادلة غير إنسانيّة، مثلها مثل الإفلاس بسبب طارئ صحيّ يضطرك إلى ترك الوظيفة. وفي هذه اللحظة التي تتصاعد فيها القوة العمّاليّة، لا بد أنّ يحصل المزيد من التنظيم الجماعيّ لضمان فك الارتباط هذا، ولتحرير الإمكانات الإبداعيّة للملايين العالقين في وظائف مروّعة من أجل اشتراكات التأمين الصحيّ الخاص بهم.
ختامًا، من الضروري الإشارة إلى أنّ العمل خارج حيّز المكتب يمكن أن يكون أشد إنصافًا من ذي قبل. في أحد النقاشات الأخيرة على فيسبوك، رأيت العديد من أصدقائي البيض يعبّرون عن درجةٍ ما من الأسى لافتقادهم المحادثات التي تدور حول مبرّد المياه. إنّ حقيقة كونهم جميعًا بيض تكشف شيئًا ما. فالموظفون غير البيض والمُهاجرون والنساء -وأي شخصٍ ليس من ضمن الأغلبية- لديه ولعٌ أقلّ تجاه ثقافة الصداقات المتولدة حول مبرّد المياه، والتي، كمعظم الأمور الأخرى في المجتمع، تنزع إلى تفضيل البيض. بهذا المعنى، فإنّ وجود تفاعلاتٍ قصديّة (بدلًا من تلك العرضيّة) يعني أنه يمكن قياس مقدار الوقت أو الاهتمام الذي يوجه لموظَفٍ واحد. هذه المقاييس يمكن أنّ توفّر أدواتٍ أفضل لأرباب العمل لمعالجة الانحيازات اللاواعية التي تؤثر في الكيفية التي يُقيَّم بها الموظفون المنتمون لأقليات عرقية أو جنسية.
إنّ هذا الزمن الذي تتخلله جائحة عالمية ممتدة كئيب بما فيه الكفاية، من دون أن يكون المرء تحت رقابة مدير ما، يخبره بالساعات والأيام التي يجب أنّ يعمل فيها. لا ينبغي أن تُترجَم تراتبيات العمل إلى تراتبيات للقيمة البشرية، يعامَل فيها الأدنى مرتبة كما لو أنّه عديم القيمة تقريبًا. كان فوكو سيفتخر بكل أولئك الذين استقالوا من وظائفهم أو يفكرون بذلك. إنّ الهروب من الوحشيّة المكانيّة لمكان العمل الخاضع للرقابة الدائمة يجب أن يكون حقًا من حقوق الإنسان، وربما يتحقق ذلك قريبًا بالفعل.
-
الهوامش
[1] بانوبتيكون (panopticon) تعبير يعني المراقبة المستمرة، جاء من تصميم قدمه الفيلسوف والمُنظر الاجتماعي جيرمي بنثام لسجن أسطواني الشكل يوفر مراقبة دائمة. ومن ثم استخدم مفكرون وفلاسفة مفهوم البانوبتيكون للتعبير عن الرقابة الدائمة خارج الأسوار الحقيقية للسجن.
[2] الحضور المقنع (presenteeism) هو حالة الحضور المادي للعمل في المكتب في حالات كالمرض وغيره ولكن دون تحقيق أي إنتاجية تذكر.
[3] الساعة المفرحة بعد العمل (after-work-happy-hour) هي مدة زمنية يذهب فيها العمّال للاستمتاع بوقتهم في المقاهي والمطاعم التي غالبًا ما تقدّم لهم تخفيضاتٍ على المأكولات والمشروبات.
* رافيا زكريا مؤلفة كتاب «ضد النسوية البيضاء» و«حجاب»، وكاتبة عمود في صحيفة Dawn في باكستان. كما تكتب لصحيفة «الغارديان» و«بوسطن ريفيو» و«ذا نيو ريبابلك» و«نيويورك تايمز ريفيو أوف بوكس».