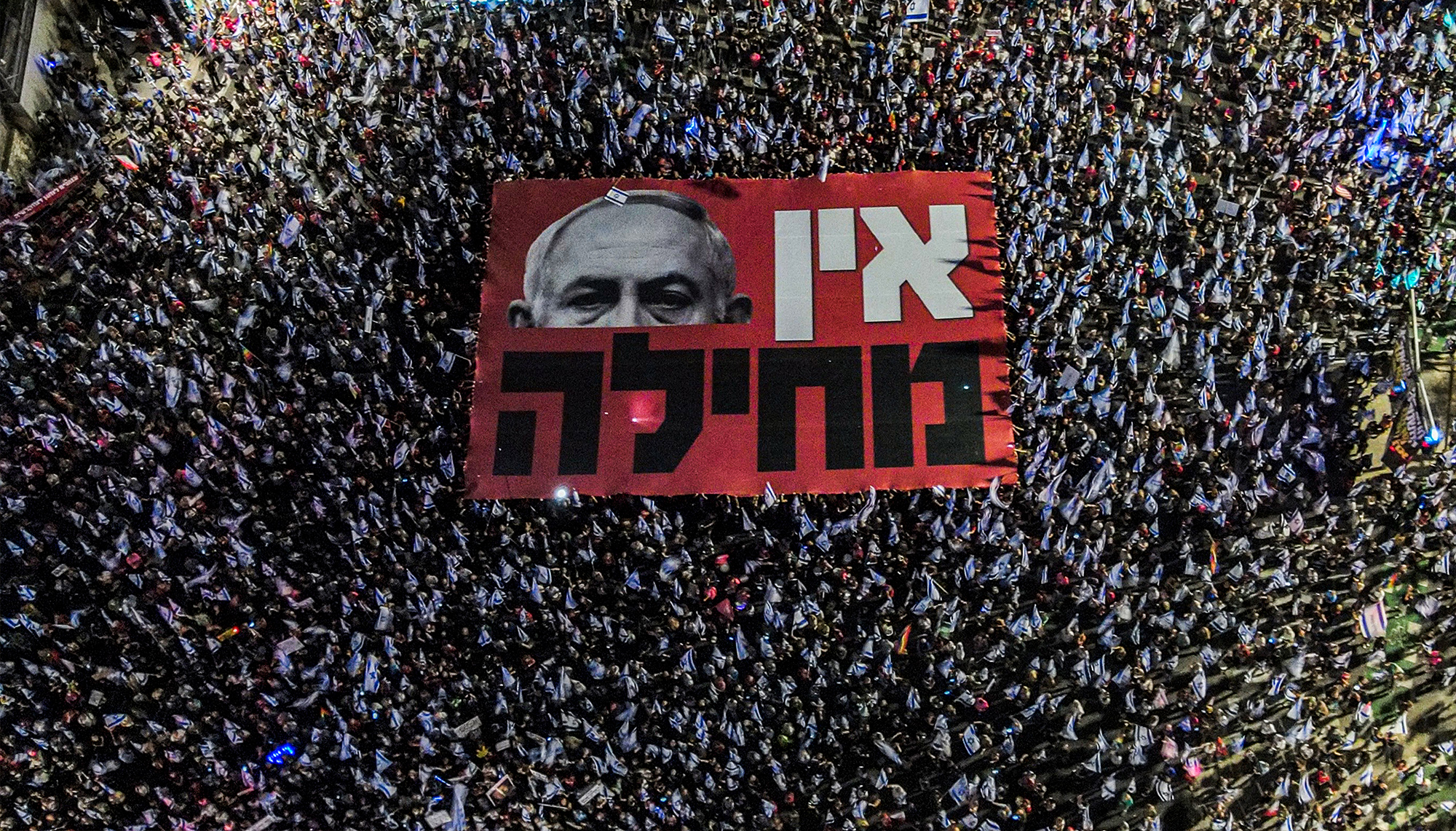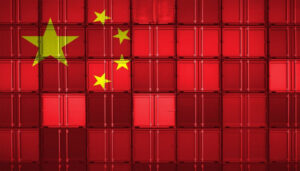نشر هذا المقال للمرة الأولى بالإنجليزية في مجلة بولاديوم، بتاريخ 4 حزيران 2022.
في عام 1931 أغلق طبيب أسنان أمريكيّ يُدعى ويستون برايس عيادته وشَرَعَ في رحلة طويلة حول العالم. كان في ستّينيّاته حينها، وقد حَظِيَ بالفعل بمسيرة مهنيّة طويلة ومميّزة إلى الدرجة الّتي يمكن معها اعتباره من بين أكثر ممارسي مهنة طبّ الأسنان تأثيرًا في الولايات المتّحدة. لكنّ رحلته هذه لن تكون تتويجًا لنهاية مسيرته المهنيّة؛ ذلك أنّه كان مصمّمًا على إيجاد إجابة لمسألة كانت تؤرّقه: وهي الشكّ المزعج في أنّ النظام الغذائيّ الحديث كان يسبِّبُ تدهورًا جدّيًّا للصحّة البشريّة.
مع نهاية القرن التاسع عشر، لاحظ برايس تسارعًا في تفاقم مشاكل الأسنان، وقد كان قادرًا قبل ذلك الوقت على توقّع مسار صحّة أسنان مرضاه ومبحوثيه، لكنّ تلك القدرة كانت في انحسار متسارع، والتجاويف السنّيّة الّتي كان يندُرُ حدوثها من قبل كانت تزداد سريعًا. كان التسوّس في كلّ مكان؛ وكان واضحًا أنّ شيئًا ما قد تغيّر، والمشتبه به الرئيسيّ في ذلك، الّذي كان قد بدأ لتوّه بالتشكّل، هو النظام الغذائيّ الحديث. كذلك كانت الكوادر الطبّيّة في العالم الغربيّ تلاحظ الأمر ذاته، جوستاف ويكسيل، طبيب الأسنان في بوسطن، لاحظ عام 1902 أنه «قبل شحن الدقيق الأمريكيّ المعالج إلى السويد، قبل جيلين من الآن، كان يمكن لطبيبيْ أسنان تغطية حاجات مدينة ستوكهولم بأكملها، أمّا الآن، فأطبّاء الأسنان كثرٌ مثلما هو الحال في أيّ مدينة أمريكيّة».
أراد برايس أن يعرف ما الذي كان يحدث بالضبط؛ إذ اعتقد أنّ التدهور الحاصل ليس عائدًا فقط إلى وجود موادّ حديثة سيّئة في الأنظمة الغذائيّة، لكن أيضًا، إلى عدم وجود بعض «العوامل الأساسيّة» غير المعروفة، والّتي اختفت مع ظهور الأنظمة الغذائيّة الجديدة الّتي تبنّاها المجتمع. لذلك كان مصمّمًا على الذهاب إلى الأماكن الّتي لم يصلها بعد النظام الغذائيّ الحديث، لدراسة صحّة المجموعات البشرية الّتي ما تزال تعيش وفق عاداتها الغذائيّة التقليديّة.
خلال السنوات اللاحقة، سافر برايس إلى كلّ ركنٍ من أركان العالم تقريبًا. في البداية سافر إلى جبال الألب لقضاء بعض الوقت رفقة قرويّين سويسريّين، ومن ثمّ إلى «هبرديس الخارجيّة» المعزولة قبالة الساحل الأسكتلنديّ، ولاحقًا إلى العيش مع مجتمعات الإنويت في ألاسكا، وهي مجتمعات أصليّة تعيش شمال كندا وفي بعض مناطق الولايات المتّحدة. ثمّ ارتحل إلى أرخبيل المحيط الجنوبيّ لمسح صحّة القبائل البولينيزيّة والميلينيزيّة؛ وإلى أفريقيا الوسطى والشرقيّة حيث قابل ثلاثين قبيلة مختلفة من الماساي إلى التوتسي؛ وإلى أستراليا ونيوزيلندا لمراقبة أنظمة شعوب الأستراليين الأصليين (الأبوريجينال) والماوريين الغذائيّة. وفي النهاية ذهب إلى أمريكا اللاتينيّة لدراسة أسنان قدماء الأنديز وأحفادهم البيروڤيين. وفي العام 1939، بعد ثمانية أعوام من الترحال المكثّف، نشر برايس كشوفاته في كتاب طويل عَنْوَنَهُ بـ«التغذية والضمور البدنيّ».
تحضر بعض الغرابة عند قراءة كتاب برايس؛ فثمّة أثَر ضئيل للتعالي والشوفينيّة اللّذان صَبَغَا عصره تجاه المجتمعات «البدائيّة»، أو لنظرة الباحث المعاصر المهنيّ اللامباليّة. يبدو برايس، تقريبًا، واقعًا في غرام كلّ مجموعة تقليديّة صادفها، مُرمْنِسًا إيّاهم حدّ الإفراط في بعض الأحيان، لكن، رغم ذلك، معاملًا إيّاهم باحترام عميق يقارب حدّ الرهبة.
بيد أن متعة الكتاب الأكبر ليست فيما احتواه من ترحال، بل في السرد المتعلّق بتجارب برايس الطبّيّة المضنية؛ فالبيانات الناتجة عن تلك التجارب كانت قد وُثِّقَتْ بدرجة مرهقة، مصحوبة بصور مدهشة لتجاربه. كلّ أولئك الّذين لم يتبنّوا النظام الغذائيّ الحديث، في كلّ مكان ذهب إليه تقريبًا، وكانوا ما يزالون يأكلون طعام أجدادهم، سواء اعتمَدَ على السمك، أو اللحم، أو الألبان أو الفواكه، أظهروا صحّةً سنيةً أفضل بكثير من أولئك الّذين يأكلون وفقًا للأنظمة الغذائيّة الحديثة. الناس الّذين لم يسبق لهم أن قابلوا طبيب أسنانٍ أو اختصاصيّ تقويم ولم يكونوا في حاجة إليهما. ولم يجد برايس، لدى بعض المجموعات المعزولة، أيّ حالة تسوّس أسنان على الإطلاق. مثلًا، وجد برايس لدى قبيلة دينكا النيل [وهي مجموعة عرقيّة تسكن جنوب السودان] أنّ 0.2% فقط من أسنانهم قد تعرّضت للتسوّس أو التجاويف؛ وكانت النسبة 0.3% لدى مجموعة من الإنويت الساكنين أحد روافد نهر كوسكوكويم في ألاسكا؛ و0.4% بالمئة لدى الماساي في جنوب كينيا.
الدول كانت دائمًا مسؤولة عن الغذاء؛ والنظام الغذائيّ الحديث هو نِتاجُ خيارات حكوميّة واعية، وليس نتاجًا طبيعيًّا لـ«قوى السوق» المستقلّة.
عندما بدأت هذه المجموعات نفسها بتناول ما وصفه بـ«الغذاء التجاريّ» مثل الدقيق الأبيض، السكّر، والمربّى، ومربّى قشور الحمضيات، والأطعمة المعلّبّة، سرعان ما بدأت أسنانهم بالتدهور وأصبحت التجاويف السنّيّة متفشّيّة بينهم. كان مرتاعًا ممّا فعله الاستعمار بصحّة شعوب أستراليا الأصليّة [الأبوريجينال]: «لم تكن شعوب الأبوريجينال في حياتهم الأصلانيّة بحاجة إلى أطباء أسنان، حيثُ كان بإمكانهم تناول طعام يحافظ على صحّتهم وعلى أسنانهم، أمّا الآن فهم بحاجة إلى أطبّاء أسنان لا يملكونهم».
لم تكن المسألة مسألة أسنان متعفّنة فحسب؛ فأينما ولّى وجهه، سواء في أوساط صنّاع الخبز السويسريّين أو مجموعات الصيد والجمع ( hunter-gatherers) في النيل؛ وجد أنّ الأنظمة الغذائيّة التقليديّة كانت أكثر تحفيزًا على النموّ البدنيّ من تلك الحديثة. ففي المجتمعات التقليديّة، كان الناس يتمتّعون بمستويات مذهلة من القوّة والقدرة البدنيّة؛ كان يمكن لأطفال القرى السويسريّة قطع الأنهار الجليديّة حفاةً دون التعرّض للإصابة بمرض السلّ، وقد زُعِمَ أنّ الماوري يستطيعون رؤية أقمار كوكب المشتري «الّتي لا يمكن للرجل الأبيض رؤيتها إلّا بمساعدة التلسكوبات»، وكانت قدرة الأسكتلنديّين على السباحة لمسافات بعيدة «تفوق التصوّر تقريبًا».
جذب كتاب برايس عددًا قليلًا من المتابعين المخلصين في السنوات الّتي تلت نشره، لكنّ حججه لم تكتسب شهرتها حتّى العقود الأخيرة، وهي أنّ الطعام التقليديّ يعكس حكمة صمَدَت أمام اختبار الزمن، وأنّ جودة التربة والعشب أثّرت في جودة الغذاء ومن ثمّ في الصحّة البشريّة، وأنّ الغذاء الحديث يتعارض بعمقٍ مع العيش الصحّيّ. وقد استشهد به كتّاب متخصّصون في الغذّاء مثل مايكل بولان وجاري تاوبيس بصفته مؤثّرًا في أعمالهم.
لكن، رغم أنّ الكتاب ليس كتابًا علميًّا وفقًا للمعايير الحديثة، فبرايس أقرب لعالم طبيعيّ من القرن التاسع عشر، وهو في جزء منه إثنوغرافيّ وفي آخر باحث طبّيّ، لكنّه مع ذلك، يظلّ كتابًا مذهلًا. كذلك ثمّة الكثير من الغرابة حول برايس؛ مثل هوسه الأحاديّ بسوء التغذية بوصفها سببًا للحرب أو للجرائم؛ لكنّ كتابه رغم ذلك يظلّ مقنعًا بشكل ملحوظ في حجّته القائلة إنّ ثمة خطأ يتعلّق بالنظام الغذائيّ الحديث.
تغذية السّخَط
بعد عقود على نشر «التغذية والضمور البدنيّ»، ظهرت خلال العقدين الأوّل والثاني من الألفيّة الثالثة طفرة في الجهود الرامية لمعالجة «الأمراض المرتبطة بنمط الحياة»، الّتي كانت بحلول ذلك الوقت قد صارت وباءً في الأمم الغربيّة. ومع وصول كوفيد-19 إلى الغرب وتسجيل الشعوب الأكثر سمنة لأعلى معدّلات وفيّات، أصبحت الصحّة السكّانيّة عاملًا فارقًا.
أدّى التحوّل الّذي حدث خلال القرن العشرين، والمتمثّل في توقّف الأمراض المعدية عن أن تكون السبب الأساسيّ وراء الوفيّات، وحلول الأمراض غير السارية محلها، أو ما يسمّيه علماء الديموغرافيا بـ«التحوّل الوبائيّ» (المرتبط بـ«التحوّل الغذائيّ» الّذي أعاد تشكيل النُظم الغذائيّة العالميّة)، أدّى -بشكل كبير- إلى استئصال العديد من الأمراض، ومن بينها شلل الأطفال والحمّى الصفراء، لكنّه لم يُفلِحْ في إرساء قواعد الصحّة العامّة.
في المقابل، خلق التحول الغذائي سكّانًا بأمراض مزمنة وبحاجة إلى رعاية طبّيّة دوريّة، وعليه انتقلت أنظمة الرعاية الصحّيّة من معالجة الأمراض الشديدة إلى إدارة سكّان في حالة دائمة من المرض لكن «قابلة للإدارة»، مع توفر الكثير من الأدوية، بخلاف ما كان سائدًا، ولكن بصحّة أسوأ من السابق.
من السهل قراءة ما سبق كتكلفة لتقدّم لا يمكن إنكاره؛ فالناس أكثر غنًى وأفضل تغذية وسيصبح عدد متزايد منهم بدناء. كذلك فإن الناس يعيشون لوقتٍ أطول، ويموتون بالسرطان أو الأمراض القلبيّة بدلًا من الموت بالتفوئيد أو الكوليرا أو برمح في الخاصرة. ثمّة آثار سطحيّة سلبيّة، لكنّ ما يهمّ هو أنّ كلّ شيء في صعود.
لكنّ رواية المنتصرين هذه ليست إلّا تفسيرًا جزئيًّا لما تغيّر خلال القرنين الماضيين. من الصحيح أنّ «الشخص العاديّ» يعيش وقتًا أطول ممّا كان يفعل في القرون الخالية، رغم أنّ المعدّلات الديموغرافيّة الأوّليّة عادة ما تقدّم الماضي في صورة وحشيّة أكثر ممّا هي دقيقة؛ فالناس الّذين نجوا في طفولتهم يمكنهم، بانتظام، توقّع أن يعيشوا السنين ذاتها الّتي يعيشها الغربيّون اليوم. في دراسته لشعوب Kung Bushmen في صحراء الكالاهاري، يكتب الأنثروبولوجيّ ريتشارد بورشاي لي، أنّ نسبة الأفراد الّذين تزيد أعمارهم عن ستّين عامًا «تكافئ نسبة المسنّين في الأمم الصناعيّة». الأمر نفسه ينطبق على شعوب الـتسماني في بوليفيا الّذين يتمتّعون بعمر نموذجيّ هو 70 عامًا، وذلك ليس سيّئًا بالنسبة لمجموعة تمارس نمط حياة كفافيّ يتألّف من الصيد والجمع والزراعة.
تحسنت الصحّة في المجتمعات الحديثة في بعض جوانبها؛ فنحن اليوم نعيش أعمارًا أطول، وأقلّ عرضة للجوع أو المُمْرِضاتُ المعدية؛ لكن، عند النظر إلى جوانب أخرى نجد أنّ الصحّة قد أصبحت أسوأ بكثير ممّا كانت عليه.
لا تغفل إحصائيّات العمر المتوقّع مجموعات الصيد والجمع فحسب؛ فلنفكّر بمجموعة سكّانيّة أخرى مشوّهة؛ وهي الطبقات العاملة في بريطانيا أواسط العصر الفيكتويّ (تقريبًا بين عامي 1850 و1870). مع حساب معدّل وفيّات الرضّع، كان متوسّط العمر المتوقّع للبريطانيّين في عمر الخامسة في أواسط العصر الفيكتوريّ يبلغ 75 عامًا للرجال و73 عامًا للنساء، ما لا يختلف كثيرًا عن المعدّل في المملكة المتّحدة اليوم. حتّى إن الأرقام تبدو أفضل بالنسبة للعمر المتوقع الحاليّ لرجال الطبقة العاملة البريطانيّة (بشكل تركيبيّ أكثر بالمقارنة مع سكّان أواسط العصر الفيكتوريّ)، حيثُ يبلغ متوسّط العمر 72 عامًا للرجال، في حين زاد متوسّط العمر المتوقّع لنساء الطبقة العاملة بشكل طفيف ليصل إلى 76 عامًا.
من المؤكّد أنّ الصحّة في المجتمعات الحديثة قد تحسّنت في بعض جوانبها؛ فنحن بالفعل نعيش لوقت أطول ممّا كنّا نفعل في الماضي، وأقلّ عرضة للتأثّر بالجوع أو المُمْرِضاتُ المعدية؛ لكن، عند النظر إلى جوانب أخرى نجد أنّ الصحّة قد أصبحت أسوأ بكثير ممّا كانت عليه.
العديد من عناصر تلك الفرضيّة صحيحة؛ فالتسيماني، والهادزا في تنزانيا، والكيتافيّون في جزر بابوا غينيا الجديدة، جميعهم يتمتّعون بصحّة جيّدة مدهشة. ثمّة العديد من الدراسات الّتي وُجِدَتْ على أساس الغياب التامّ لـ«أمراض الحضارة» الّتي تضنينا اليوم؛ فحبّ الشباب، الشائع حدّ العاديّة في الغرب، ببساطة غير موجود في أوساط الكيتافيّين أو الآتشي في البارغواي. في حين يتطوّر الضمور الدماغيّ المرتبط بالتقدّم في السنّ بشكل أبطأ بكثير في أوساط التسيماني، كما يتمتّعون بأدنى مستويات مرض الشريان التاجيّ الّتي جرى تسجيلها على الإطلاق.
لكنّ التركيز على مجموعات الصيد والجمع يُغفِلُ مدى حداثة كمّ كبير من هذا التدهور؛ فقد أدّى ظهور الزراعة إلى إحداث تدهور تاريخيّ في الصحّة، حيث أصبح السكّان أقصر وأكثر عرضة للعديد من الأمراض. في حين أنّ ظهور النظام الغذائيّ الحديث لم يَحْدُثْ إلّا في القرنين التاسع عشر والعشرين، وذلك التغيّر أحدث تدهورًا صادمًا في الصحّة، بالضخامة نفسها، ما يزال أثره حاضرًا حتّى الآن.
لنلق نظرةً، مثلًا، على مجموعة من الدراسات المميّزة الّتي نُشِرَت في العقد الأوّل من الألفيّة في مجلة «Journal of the Royal Society of Medicine»، والتي تناولت النظام الغذائيّ والصحّة عند بريطانيّي أواسط العصر الفيكتوريّ. وجدت هذه الدراسات أنّ الفكرة التقليديّة عن أنماط الأكل الفيكتوريّة -المتمثّلة بأيتام هزيلين يتوسّلون العصيدة- أبعد ما تكون عن الحقيقة؛ فالبريطانيّون الفقراء والفلّاحون الّذين عاشوا في خمسينيّات وستّينيّات القرن التاسع عشر، تمتّعوا، بحسب إحدى الدراسات، بنظام غذائيّ «أفضل بكثير من النظام الغذائيّ العامّ المستهلك اليوم، نظام يتقدّم بشكل ملحوظ على توصيات الصحّة العامّة المعاصرة».
وجدت الدراسة أنّ النظام الغذائيّ الّذي كان سائدًا في أواسط العصر الفيكتوريّ، كان غنيًّا بالخضراوات، والفواكه، خاصّةً الكرز والتفّاح، ما بين ثماني إلى عشر حصص يوميّة، وأحماض أوميغا 3 الدهنيّة، والمكسّرات، والحبوب الكاملة واللحوم. وتلك اللحوم -بدورها- لم تأتِ من القِطَع الأوّليّة باهظة الثمن؛ بل بشكل أساسيّ من لحوم الأعضاء الغنيّة بالمغذّيات الدقيقة، والمقطّرات الدهنيّة والعظام. ورغم أنّ فقراء أواسط العصر الفيكتوريّ اختبروا الجوع أكثر بمرار ممّا اختبرناه نحن، فالطعام لم يكن متوفّرًا بشكل فوريّ على هيئة وجبات خفيفة (Snacks) مثلما هو اليوم، لكنّهم، بشكل شبه مؤكّد، على مستوى تجريديّ، قد أكلوا أكثر منّا: «نظرًا إلى مستويّات النشاط البدنيّ الذي مارسته الطبقات العاملة بشكل روتيني في أواسط العصر الفيكتوريّ، تراوحت متطلّبات السعرات الحراريّة لديها بين 150% إلى 200% من المتطلبات الغذائيّة اليوم (على انخفاضها اليوم بالمقارنة بأي حقبة تاريخية)». إلا أن النظام الغذائي في العصر الفكتوري لم يكن مثاليًّا، فجودة الطعام، خاصّة اللحوم، كانت منفّرة، لكنّه لم يكن بأيّ حالٍ من الأحوال مجاعة، كما نفكّر فيه عادة.
أدّى الوصول إلى نظام غذائيّ أفضل إلى حيوات أكثر نشاطًا؛ فتقريبًا معظم العمّال البريطانيّين كانوا سيُصنَّفون نشيطين للغاية وفقًا لمعايير الخمول اليوم. كان بنّاؤو سكك الحديد يتربّعون على قمّة الأعمال البدنيّة الشاقّة، إذ كانوا قادرين «على استخراج عشرين طنًّا من الأرض يوميًّا من تحت أقدامهم إلى ما فوق رؤوسهم بشكل روتينيّ»، وهذا عمل يتطلّب قدرًا هائلًا من القوّة يمكن لعدد قليل من الناس اليوم مضاهاتها. كما أنّ الأنشطة الترفيهيّة، من الاعتناء بالحدائق وحتّى لعب كرة القدم، كانت أنشطة ملأى بالحيويّة أيضًا.
كذلك كانت حالات السرطان منخفضة بشكل صادم أيضًا؛ ففي عام 1869، كتب طبيب في مستشفى «تشيرنغ كروس» في لندن، واصفًا سرطان الرئة بأنّه «أحد أندر الأشكال من مرض نادر أصلًا؛ فلربّما تنقضي حياتك الدراسيّة دون أن تصادف حالة أخرى منه». حتّى عند حدوثها، كانت أمراض السرطان أقلّ تسارعًا في تطوّرها ممّا هي عليه اليوم؛ فقد اعتقد الطبيب جيمس باجيت أنّ النساء في المرحلة الثالثة أو الرابعة من سرطان الثدي قد يعشن لأربع سنواتٍ بعد تشخيصهن، وحتّى ثماني سنوات مع الجراحة، وتلك فترة أطول بكثير ممّا هو شائع اليوم.
لكن، ورغم كلّ الفوائد الصحّيّة المدهشة للنظام الغذائيّ الّذي ساد أواسط العصر الفيكتوريّ، إلّا أنّه لا يضاهَى بالتحوّل الرئيسيّ الذي حدث في سبعينيّات وثمانينيّات القرن التاسع عشر والمتمثّل في الانخفاض الكبير في أسعار الطعام. إذ أتاحت التطوّرات التكنولوجيّة -من قبيل التبريد، والبواخر، والسكك الحديديّة، وتقنيات الطحن المتطوّرة- إضافة إلى سياسات التجارة الحرّة، ظهور أوّل نظام عالميّ حقيقيّ لإنتاج الأغذية وانتشارها.
عَنَى ذلك، خارج بريطانيا، دمار الأنظمة القديمة الّتي كانت قائمة لعدّة قرون؛ فاقْتُلِعَتْ بشكل متسارع مساحات أحيائيّة كاملة، مثل البراري العشبيّة مترامية الأطراف في الولايات المتّحدة، الممتدّة من جبال الروكي حتّى نهر المسيسيبي؛ وفي الغرب الأمريكيّ، استُبْدِلَ رعي ثور البيسون التقليديّ بمزارع الماشية الواسعة، ومع رحيل هؤلاء الفاعلين المحلّيّين، كان من السهل انهيار الاقتصادات البيئيّة الّتي حافظت على المشهد الطبيعيّ لعدّة أجيال حتّى ذلك الحين. فيما شوّهت اقتصادات تربية المواشي الّتي حلّت محلّها، والّتي تميّزت بالأسلاك الشائكة المحيطة بها وبأنظمة الريّ الاصطناعيّة، بشكل عميق بيئة المنطقة لغاية خلق فوائض هائلة من اللحم للتصدير الخارجيّ.
عليه، وبعد عام 1870، أُغْرِقَت بريطانيا باللحم والقمح من الولايات المتّحدة، وكذلك الأرجنتين، وأستراليا، ونيوزيلندا. في حين دخلت الزراعة البريطانيّة المحلّيّة، غير القادرة على المنافسة، في مرحلة كساد طويلة. في الأثناء، كان الطعام قد أصبح رخيصًا ووافرًا وفي متناول معظم البريطانيّين؛ فبين عامي 1877 و1889، انخفضت قيمة السلة الغذائيّة الأسبوعيّة الوطنيّة تقريبًا بنسبة 30%.
أدّت تداعيات هذه الحقبة إلى تغيير النظام الغذائيّ البريطانيّ؛ فالأطعمة الّتي كانت نادرًا ما تؤكل في الماضي، أصبح من السهل الحصول عليها في أيّ مكان؛ كذلك ارتفع منسوب استهلاك اللحم والقمح بوتيرة متسارعة، إلى جانب بعض «الرفاهيّات» الأخرى مثل الجبن، والزبدة، والحليب. وشَهِدَ استهلاك السكّر انفجارًا استثنائيًّا بشكل خاصّ، في حين كانت مزارع السكّر في جنوب شرق آسيا وجزر الكاريبيان تعمل على إشباع هذه الرغبة الجديدة. منذ عام 1820 وحتّى عام 1846، كان نصيب استهلاك الفرد من السكّر يقارب 18 رطلًا، لكن، بحلول عام 1901، كان قد نما خمسة أضعاف ليصل إلى 91 رطلًا، مع ظهور المربّى، والحليب المكثّف، والشاي المُحلّى، كنواقل أوّليّة للسكّر.
كانت تلك ولادة النظام الغذائيّ الجمعيّ الحديث؛ الذي تميز بنسبة عالية من الكربوهيدرات، والسكّر، والدهون عالية المعالجة، مع نقص في الكيميائيّات النباتيّة (الفيتوكيميكالز) والمغذّيات الدقيقة الّتي ميّزت النظم الغذائيّة التقليديّة. بالنسبة للبريطانيّين العاديّين، كان ذلك تحوّلًا دراماتيكيًّا في أنماط حياتهم، بدا من الخارج وكأنّه تحريريّ.
لكن، حتّى مع ترحيب عوامّ البريطانيّين بهذا التحوّل، أدّى رُخْص الغذاء إلى تدهور كبير في الصحّة البدنيّة. مع نهاية سبعينيّات القرن التاسع عشر، كان النظام البريطانيّ الغذائيّ قد دخل في حالة ركود حادّة، حالة يمكن القول إنّه لم يتعاف منها حتّى اليوم. وقد فاقم تردّي الأطعمة، مثل مخلّفات الذبائح من الأعضاء وغيرها، من تفشّي نقص التغذية؛ فاستهلاك السكّر المتزايد وحده أحدث أضرارًا هائلة بأسنان الناس إلى درجة أنّهم أصبحوا غير قادرين على مضغ الأطعمة الصلبة. كان تسوّس الأسنان نادرًا في بريطانيا حتّى منتصف القرن التاسع عشر؛ لكنّه الآن أصبح في كلّ مكان. وباتت مشكلة شديدة الوضوح لدرجة أنّ زائرًا إلى مدينة شيفيلد في عام 1909 وجد أشخاصًا بـ«أفواه مترهّلة ولثّة بيضاء وبضع أسنان هنا وهناك». ومع بداية القرن العشرين، كان ثمّة تزايد حادّ في الأمراض التنكّسيّة المزمنة الّتي كانت في السابق نادرة الوجود، مثل السرطان والسكّريّ.
اقرأ/ي أيضا:
في العام 1901، أُجْبِرَتْ قوّات المشاة البريطانيّة على تخفيضِ حدّها الأدنى لطول المجنّدين من 5.4 إنشات إلى خمسة إنشات فقط، وقد استجابت الحكومة البريطانيّة بأن أنشأت «لجنة الانتكاس الجسمانيّ»، لمعالجة مشكلة لم تكن موجودة قبل بضعة عقود. لكنّ ذلك لم يغيّر الكثير؛ فأزمة تجنيد أخرى كانت قد ظهرت خلال الحرب العالميّة الأولى، وقد اشتكى رئيس الوزراء البريطانيّ الأسبق، ديفيد لويد جورج، متسائلًا عن «عدد الرجال الّذين كان بإمكاننا تجنيدهم للقتال لو أنّنا كنّا اعتنينا بصحّة الأمّة بشكل أفضل»، منتهيًا إلى القول: «إنّنا تعاملنا بغباءٍ، وبإسرافٍ، وبقسوةٍ مع ثروتنا البشريّة في هذه الدولة».
من السهل رؤية الأسباب الّتي دفعت بالعديد من المراقبين في مطلع القرن العشرين، إلى الاعتقاد بأنّ الصحّة الجسمانيّة لا تسيرُ في طور «تقدّميّ»، بل على العكس، في طور انتكاسيّ.
أجزاء كبيرة من خطاب الانحطاط هذا كانت مشوبة بدرجة من الهستيريا الّتي أدّت إلى توجّهات علاجيّة سريعة الزوال كان أثرها ضئيلًا في مكافحة أعراض الانحطاط الجسمانيّ. لكنّ المشكلة الّتي وصفتها تلك الشخصيّات كانت حقيقيّة جدًّا؛ فقد كان ظهور النظام الغذائيّ الحديث كارثة على الصحّة، كارثة شعرت بعض النخب، لفترة وجيزة، أنّ بإمكانهم معالجتها. لكن، حتّى في وسَطِ هذه الأجواء الساخنة، كان الدليل على الانحطاط الجسمانيّ غير قابل للطعن في صحّته.
لكنّ الحماس لحياةٍ صحّيّة ونمط حياةٍ أكثر طبيعيّة بدأ تدريجيًّا في الانحسار؛ فالنظام الغذائيّ الحديث، وبالتوازي مع تصاعد شيوع نمط الحياة الحضريّ الّذي مكّنهُ النظام الغذائيّ واعتمدَ على استمراريّته، كان قد أصبح متجذّرًا بشكل يتعذّر على المعالجة. وبحلول عشرينيّات وثلاثينيّات القرن العشرين، انتقل امتياز الاستجابة للمشاكل الّتي خَلَقها النظام الغذائيّ من الحقل الثقافيّ إلى ميادين الطبّ والصحّة العامّة.
في العقود الأخيرة من القرن العشرين، دَخَلَ النظام الغذائيّ الحديث مرحلة ثانية من الانحطاط المتسارع؛ وقد ترافق ذلك مع ظهور سلاسل مطاعم الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المسبّبة للإدمان والّتي تحتوى على شراب الذرة عالي الفركتوز، الّذي زاد استهلاكه عشرة أضعاف منذ عام 1970 حتّى عام 1990، في ظلّ اختفاء مصادر الأطعمة غير المعالجة. وفي غضون وقتٍ قصير، كان يمكن إيجاد «الأوريو» ورقائق البطاطس والكوكا كولا في كلّ أنحاء العالم، والفضل في ذلك يعود إلى تخفيف القيود على التجارة واستراتيجيّات التسويق العبقريّة للشركات، وكذلك السمات الإدمانيّة الجوهريّة في المُنتَجَات المُباعة. لم يكن معتادًا استهلاك الكوكا كولا في المكسيك في خمسينيّات القرن الماضي؛ لكن، بحلول عام 2019، كان سكّان ولاية شياباس، أفقر الولايات المسكيكيّة، يشربون ما معدّله 2.2 لتر من الكوكا كولا يوميًّا.
في الوقت نفسه، شَهِدَ نظام الزراعة العالميّ تحوّلًا آخر خلال العقود الّتي تلت الحرب العالميّة الثانية، مُعَوْلِمًا النظام الغذائيّ الحديث بشكل كامل. في مناطق مثل الكاريبي ومعظم أفريقيا، عَمِلَت لَبْرَلَة التجارة وبرامج التنمية على ربطِ اقتصادات تلك المناطق الزراعيّة بصادرات المحاصيل الزراعيّة النقديّة بعيدًا عن تركيزها على الاستقلال الغذائيّ. بذلك، أصبح السكّان المحلّيّون، الّذين دُفِعُوا بشكل متزايد إلى الانتقال من مجتمعاتهم الفلّاحيّة إلى الأحياء الفقيرة المدنيّة، معتمدين على الأطعمة المعالجة المستوردة من الخارج. في مناطق أخرى -في الهند تحديدًا- نزعت الثورة الخضراء وسلالاتها الجديدة من القمح وموادّ غذائيّة أساسيّة أخرى، فتيل «القنبلة السكّانيّة» المالتوسيّة، والّتي بدَت وشيكة الانفجار في منتصف القرن العشرين. لكنّ ذلك عَنى أيضًا ولادة أنظمة زراعيّة وطنيّة تركّز بشكل متزايد على محاصيل الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، ما دَفَعَ في اتّجاه تقارب عالميّ يتركّز على الأنظمة الغذائيّة الصناعيّة؛ فقد فَقَدَت الهند لوحدها ما يزيد عن 100 ألف سلالة من سلالات الأرزّ منذ العام 1970، وقد تراجعت بشكل كبير نسبة الأراضي الزراعيّة المخصّصة لأسلاف الحبوب الخشنة، مثل الذرة الرفيعة وحبّة الدخن، الّتي تتكيّف بشكل كبير مع الظروف الهنديّة، والّتي تمتلك عناصر مغذّية أكثر بكثير من بدائلها.
اقرأ/ي أيضا:
مع اكتساب الأرزّ المتجانس والقمح والذرة، هيمنة عالميّة مدفوعة بالزيادة الهائلة في الإنتاجيّة، تراجعت قيمة هذه الحبوب الغذائيّة؛ فمنذ منتصف ستّينيّات القرن الماضي انخفضت الكثافة المعدنيّة للقمح، أي ما يحتويه من كمّيّات من الزنك والحديد والنحاس والمغنيسيوم، بشكل كبير، حدث ذلك بالتزامن مع صعود هيمنة محاصيل الثورة الخضراء الضخمة من سلاسلات القمح شبه المتقزّمة. وقد عُثِرَ على توجّهات مماثلة في الأرز، الّذي يشكّل إلى جانب القمح والذرة، 51% من السعرات الحراريّة العالميّة المستهلكة؛ فمن بين ما يقارب 30 ألف نوع من النباتات الصالحة للأكل في العالم، تَزْرَعُ النُظم الزراعيّة الحديثة حوالي 150 نوعًا فقط، منها 30 نوعًا تشكّل مصدرًا لـ95% من السعرارات الحراريّة المستهلكة. في كلّ مكان في العالم، أَفْسَحَتْ مصادر الغذاء التقليديّة الطريق للنظام الغذائيّ المركزيّ المألوف.
مُسِخَتْ التغذيّة وفُكِّكَتْ بُناها المحلّيّة لتتكيَّفَ مع نظام يضَعُ المحصول فوق كلّ شيء آخر. جلبت هذه التحوّلات إلى العالم «النامي» أنماطًا غذائيّة كانت بالفعل قد تسبّبت بانحطاط جسمانيّ في الدول الحديثة. التحوّل نفسه الّذي حدث في بريطانيا الفيكتوريّة كان آخذًا في التوسّع نحو الأطراف جميعها. أمّا برايس، الّذي كان مذهولًا من صحّة سكّان الدول الحديثة السيّئة، تمكّن فقط من رؤية بداية ما كان سيحلّ على الأماكن الّتي درسها. في كاليدونيا الجديدة، الّتي أكنَّ لسكّانها مديحًا لـ «النظام شديد الدقّة» لنموّهم البدنيّ، أصبح الآن 60% من نسائها و64% من رجالها يعانون إمّا من زيادة الوزن أو السمنة. في حين تضاعف معدّل السمنة العالميّة ثلاث مرّات بين عامي 1975 و2016. لقد كان التحوّل الّذي حصل بالفعل من الأنظمة الغذائيّة التقليديّة إلى النظام الفيكتوريّ، بما احتواه من الشايّ المحلّى والمربّى، ضارًّا بما فيه الكفاية؛ إلّا أنّ هذا النظام الغذائيّ يبدو مزحة إن قُورِنَ بنظام نهايات القرن العشرين الغذائيّ الطافح بالطعام والشراب المترع بالسكّر.
يمكن رؤية آثار هذا التحوّل في عَوْلَمَةِ «أمراض الوفرة» في الدول الفقيرة؛ فمثلًا، الدولة الّتي تعاني من أعلى معدّلات مرض السكّريّ ليست الولايات المتّحدة أو بريطانيا، بل باكستان؛ والبلدان الّتي تعاني من أعلى معدّلات السمنة هي الدويلات الفقيرة جنوب المحيط الهادئ، مثل ناورو وتونغا، اللتان تفضّلان الأطعمة المعالجة المستوردة من أستراليا وفييتنام وتايلاند على تلك المحلّيّة الغنيّة بالعناصر المغذّية مثل جوز الهند أو فاكهة الخبز، وحتّى المايّين الياكوتيّين جنوب المسكيك قد بدأوا يعانون كثيرًا من أمراض أنماط الحياة الغربيّة.
View this post on Instagram
تمثّل هاواي بشكل خاصّ قصّة مأساويّة عن الانحدار الغذائيّ؛ فقبل الاتّصال الأوروبيّ كان سكّان هاواي الأصليّون مكتفين ذاتيًّا كلّيًّا في غذائهم؛ إذ كانوا يزرعون القلقاس على نطاق واسع ويبجّلون النبات بوصفه أخًا أكبر للهاواويّين ويأكلون منه ما يصل إلى 15 رطلًا يوميًّا. لقد استمتعوا في ظلّ هذا النظام الغذائيّ بالصحّة الجيّدة وغياب الأمراض بحيثُ، بحسب المؤرّخ الهاواويّ صاموئيل كاماكاو، اختفى «فنّ العلاج» ببساطة لأنّه «لم يكن ثمّة الكثير من الأمراض داخل المجموعة العرقيّة». لكنّ إعادة بناء الزراعة الهاواويّة بحيثُ تركّز على التصدير (تصدير السكّر والأناناس، ولاحقًا القهوة، والأفوكادو، وجوز المكاديميا)، في القرنين التاسع عشر والعشرين، أدّى إلى تدمير إنتاج القلقاس، ما نَتَجَ عنهُ الزوال السريع للمعرفة التقليديّة بزراعته وحصاده. يعتمد غذاء الهاواويّين اليوم في 80% منه على الواردات، في حين يُزرَعُ القلقاس في بضعة مئات الهكتارات فقط، وهو تحوّل يتوازى مع ظهور أمراض أنماط الحياة الحديثة الّتي تؤثّر بشكل خاصّ في الهاواويّين الأصليّين.
داخل هذا السياق التاريخيّ، يبدو «التحوّل الغذائيّ» الحاصل خلال القرنين الماضيين، أقرب لأن يكون كارثة غذائيّة؛ إذ يمثّل استئصالًا لأنماط الغذاء التقليديّة المحلّيّة في كلّ أنحاء العالم لصالح نظام غذائيّ مُمْرِض فقير التغذية يعتمد على الأطعمة المعالجة، وبعواقب وخيمة على الصحّة البشريّة.
الأعراض المرضيّة
كلّ هذا كان يمكن أن يكون سيّئًا كفاية إن كان يعني فقط زيادةً في الأمراض التنكّسيّة المزمنة، أو تدهور الأسنان، أو فقدانًا للثروة الغذائيّة وتنوّعها؛ لكنّه يذهب أعمق من ذلك. فنحنُ ما زلنا لم نفهمُ بَعْد بشكل كلي ما سيفعلهُ النظام الغذائيّ ونمط الحياة الحديثيْن في أجسامنا؛ فالتغييرات الحادثة غريبة، وخاطفة وعميقة؛ وتذهب إلى أبعد من مجرّد الانحطاط الّذي لاحظه برايس في ثلاثينيّات القرن الماضي.
لنفكّر، مثلًا، في مرحلة البلوغ؛ فهي تبدو وكأنّها تبدأ مبكّرًا وتستمرّ لفترة أطول ممّا كانت عليه في الماضي لدى الفتيان والفتيات، وذلك تغيّر لم يحظَ بالكثير من الانتباه على نحو لافت. في عام 1935، كان متوسّط الحدوث الأوّل للحيض لدى البنات في سنّ 16 عامًا، لكن، بحلول عام 1970، أصبح في سنّ 12 عامًا. وثّق العلماء عددًّا من العوامل المسبّبة لذلك، بدءًا بالموادّ الكيميائيّة المسبّبة لاضطرابات الغدد الصمّاء، وصولًا إلى التغييرات الشاملة في النظام الغذائيّ بوصفها تفسيراتٍ لتلك الظاهرة، لكن دون تثبيت علاقة سببيّة واضحة. في حين تبدو العواقب المترتّبة على سوء النموّ هذا جسيمة؛ فقد ارتبط البلوغ المبكّر بمعدّلات مرتفعة في سرطان الثدي لدى النساء، وكذلك بظهور الاضطرابات المزاجيّة.
كذلك ساهم تدمير النظام الزراعيّ القديم في فصل البشر الحديثين عن الأغذية والبيئات الّتي نكتسب فيها خلال طفولتنا ميكروبيوم الأمعاء الطبيعيّ، وتلك عمليّة حاسمة لامتلاكنا نظامًا مناعيًّا فعّالًا. نحن الآن، ولتوّنا، بدأنا نتعلّم عن المايكروبيوم ونضوبه، لكنّ التداعيات واضحة أمامنا؛ بخسارتنا للمايكروبيومات، نحن نخسر عضوًا كاملًا؛ فبالإضافة إلى عدم قدرتنا على هضم عدد معيّن من الأطعمة، أدّت خسارة المايكروبيومات إلى آثار معقّدة تابعة، مثل سوء تكيّف الجهاز المناعيّ. ومن المحتمل أنّ ذلك يفسّر الانفجار في انتشار العديد من الأمراض المزمنة غير السارية، من داء كرون إلى السكّريّ، الّذي ظَهَرَ منذ بداية القرن العشرين وهو آخذ في التسارع خلال الخمسين عامًا الماضية. من المحتمل أن يزداد عدد الظواهر الصحّيّة الغريبة والخبيثة، الّتي ظهرت خلال العقود القليلة الماضية، ومن المحتمل أن تزداد سوءًا، وذلك ينطبق على الدول المتقدّمة و«النامية» على حدّ السواء.
يعني ذلك أنّ كلا الجنسين الآن أكثر عرضة لتطوير إصابة بأمراض المناعة الذاتيّة، مثل التهاب القولون التقرّحيّ والتصلّب المتعدّد وكذلك الصدفيّة والتهاب المفاصل الروماتويدي، الّتي تتميّز بمهاجمة الجهاز المناعيّ للخلايا السليمة بالخطأ. إنّ من الممكن إدارة هذه الأمراض بشكل دائم، لكنّ علاجها بشكل كامل لا يمكن تحقّقه ما لم تُستَعَدْ صحّة الميكروبيومات على المستوى المجتمعيّ؛ فاستعادة الميكروبيومات لا تصلح على مستوى فرديّ، ذلك أنّنا لا نعرف كيف نعيد خلق النظام البيئيّ الطبيعيّ المعقّد الّذي يبني الأنظمة المناعيّة آليًّا.
كذلك، من المحتمل ارتباط نضوب الميكروبيوم بتكاثر الاضطرابات العقليّة خلال العقود القليلة المنصرمة؛ فقد ركّز الباحثون بشكل متزايد على «محور الدماغ-الأمعاء» وعلاقته بالصحّة النفسيّة؛ إذ ثمّة دلائل قويّة على أنّ الزيادة الملحوظة في الاكتئاب والقلب خلال العقود الماضية قد لا تكون مجرّد نتاج فقدان الروابط الشخصيّة، لكنّها أيضًا انعكاس لهذه المشاكل الجسمانيّة واسعة الانتشار؛ فالتناقص الشائع في المعادن مثل المغنيسيوم، مثلًا، قد رُبِطَ بحالات الاكتئاب والقلق لدى النساء؛ فقد وجدت بعض الدراسات علاقة بين انخفاض استهلاك أحماض أوميغا-3 الدهنيّة وبين الاكتئاب والاضطراب ثنائيّ القطب على مستوى الأفراد والسكّان. حتّى إنّ الفئران أظهرت صلة جزئيّة بين انعدام التلذّذ والأنظمة الغذائيّة غير الصحّيّة. اقرأ/ي أيضا:
لكن، قد يكون العارض الأكثر إثارةً للقلق ذاك المرتبط بالخصوبة؛ فلطالما ربطت الدراسات النظام الغذائيّ بتفاقم مشاكل الخصوبة لدى الرجال؛ إضافة إلى مسبّبات اضطرابات الغدد الصمّاء، مثل مادّة الفثالات (Phthalates)، الشائعة في الأطعمة المعلّبّة المباعة في المتاجر، الّتي يبدو أنّها تؤدّي دورًا في مفاقمة مشاكل الخصوبة إلى جانب السمنة ونقص العناصر الغذائيّة مثل الحديد وحمض الفوليك.
لا تزال العديد من هذه التغيّرات محاطة بالغموض؛ فالأسباب الدقيقة لهذه الأمراض ما تزال مبهمة أو في انتظار تفسيرها بشكل كامل؛ فنحن لا نعرف بالضبط ما الّذي يحصل لأجسامنا، أو ما الّذي تعنيه هذه التغييرات الجارية؛ لكن، وبما أنّ هذه الحالة المرضيّة المتوطّنة لا تزال غير مدروسة، فإنّ الحقيقة القاتمة هي كالتالي: من المحتمل أن يزداد عدد الظواهر الصحّيّة الغريبة والخبيثة، الّتي ظهرت خلال العقود القليلة الماضية، ومن المحتمل أن تزداد سوءًا، وذلك ينطبق على الدول المتقدّمة و«النامية» على حدّ السواء.
مقاربات ومخارج
يتطلّب الهروب من المأزق الصحّيّ انتقالًا من الإدارة للصحّة المتدهورة إلى منع تدهورها: أي، إصلاحًا جذريًّا لكيفيّة استهلاك المجتمعات للغذاء وكيفيّة زراعته، متبوعًا بإصلاح لكيفيّة هيكلة المجتمعات وتنظيم السوك البشريّ. ذلك، على مستوى تقنيّ فقط، دون التطرّق إلى المستويات السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة. وهو في حدّ ذاته يشكّل تحدّيًّا هائلًا؛ فالأمر لا يتطلّب فقط فَطْمَ السكّان عن الأنظمة الغذائيّة المسبّبة للإدمان بدرجات عالية، بل أيضًا محاولة إعادة تحسين الاقتصادات الزراعيّة الأكثر صحّيّة الّتي أهلكتها مَرْكَزةُ القرن العشرين. لكنّ ذلك ليس مستحيلًا؛ فأمريكا، القارّة، تمتلك الموارد الطبيعيّة لإحداث تغيير في نظامها الغذائيّ وجعله القاعدة الغذائيّة لسكّان يتمتّعون بصحّة جيّدة. حتّى الدويلات الأصغر، مثل هاواي غير المحدّثة، يمكنها أن تحافظ على وجود مجموعات سكّانيّة تتمتّع بصحّة جيّدة وتعتمد على أغذية بعينها، لا شيء مادّيّ يمنع ذلك من الحدوث مرّة أخرى.
هذه قضيّة حضارة؛ فالمسائل العامّة كالزراعة والغذاء دائمًا ما تكون قضايا حضاريّة، مثلما اعتقد برايس. لكنّ الواقع هو أنّه ليس ثمّة مؤسّسات معاصرة تملك القدرة أو الحافز على فعل الكثير فيما يتعلّق بقضيّة النظام الغذائيّ: فصناعة الغذاء تحوز قدرًا هائلًا من القوّة، ومعظم المؤسّسات الطبّيّة تركّز على التدخّل اللاحق وبيع الأدوية أكثر من تركيزها على صحّة السكّان العامّة. لكي تعالج هذه المشكلة، لا بدّ من دولة مستعدّة لتغيير شكل النظام الغذائيّ الحديث.
سيكون ذلك خروجًا صارخًا عن إطار العمل الحاليّ، والّذي يَنُصُّ على أنّ الأنظمة الغذائيّة، الّتي تندرج في إطار قضايا «نمط الحياة»، تَتْرَكُ لشركات الأطعمة السريعة والتسويق لتتعامل معها. لكنّه سيكون أيضًا، إن حَدَثَ، عودة إلى الأعراف التاريخيّة؛ فالدول كانت دائمًا مسؤولة عن الغذاء؛ والنظام الغذائيّ الحديث هو نِتاجُ خيارات حكوميّة واعية، وليس نتاجًا طبيعيًّا لـ«قوى السوق» المستقلّة.
على مستوى عمليّ، ستتطلّب استعادة صحّة السكّان استعادة واسعة للمعرفة الزراعيّة المفقودة، وظهور كوادر جديدة من المهندسين الزراعيّين وعلماء النباتات، لتصميم ما قد تبدو عليه أنماط زراعة مستدامة داخل مناطق إحيائيّة خاصّة، وكيف يمكن توسيع نطاقها باستخدام تقنيّات جديدة. أمّا على المستوى النظريّ، سيتطلّب نموذجًا جديدًا لماهيّة الدولة، تكون فيه مسألة إعادة خلق سكّان أصحّاء -وليس مجرّد إدارة أمراضهم لغايات الربح أو المحافظة على الاستقرار- مسألةً تتعلّق بالأمن البيولوجيّ على مستوى الأنواع، وتكون قادرة على التعامل مع هذه المسألة بوصفها أولويّة مثلما هي في الواقع.