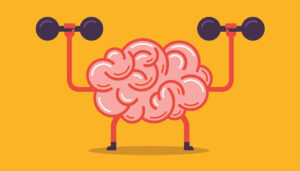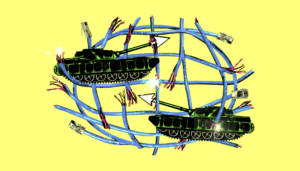الحفيف، والصرير، والنحيب، والزئير، والهزيز، هذه بعض الأصوات التي ألفناها وحفظناها في دروس اللغة العربية. ولكن ماذا عن الأصوات الأخفض، مثل صوت أصابعنا وهي تتأرجح أمام كاميرا الهاتف؟ أو صوت أظافرنا وهي تحتّك بالكيبورد؟ أو تصدّع الشمع بعد تيبّسه؟ أو تمرير المشط في شعر أملس؟ إنها أصوات عشوائية يصعب إيجاد المشترك بينها، لكنها تثير تفاعلات شعورية ناتجة عن ممارسة أنشطة اعتيادية، تصطحب معها تجاذبًا حسيًّا بين متضادات مثل الصمت والصوت، أو اللزوجة والخشونة، أو الفراغ والامتلاء.
قبل عام 2007 لم يكن لهذا الشعور الحسيّ اسمٌ، لكن في العام نفسه بدأ بعض الأشخاص بالإشارة إليه ومناقشته عبر المدوّنات والمنصات الرقمية، واستحدثَ أحد المدونين غرفة نقاش عنوانها «إحساس غريب مريح»، ليتحدث عن هذا الإحساس الجيّد الذي يشعر به كلّما قرأ عليه أحد نصًّا أو لمَسَ كفّيه.
بعد ذلك بعامين نَشرتْ فتاةٌ على قناة يوتيوب اسمها «Whispering Life ASMR» فيديو لنفسها وهي تهمس، وتقول فيه إن ما تفعله قد يبدو للبعض أمرًا غريبًا ولكنها تُحب أن تسمع أشخاصًا يهمسون في أذنها، وهو ما دفعها لنشر هذا الفيديو الذي يعدّ الأول من نوعه في محاولة نقل الشعور الحسيّ عبر وسيط رقمي. ورغم أن الفيديو ليس إلا شاشة سوداء مع صوت همسٍ يبدو خجولًا، إلا أنه حصد أكثر من 420 ألف مشاهدة حتى اليوم.
نُشرَت بعد ذلك الكثير من فيديوهات الهمس التي أصبحت منذ 2010 تُعرَف بمحتوى الاستجابة الزوالية الحسيّة الذاتية أو «ASMR» (اختصارًا لـ Autonomous sensory meridian response)، وباتت الهواتف وحسابات إنستغرام ويوتيوب تحتوي ملايين الفيديوهات التي تعرض -مثلًا- أيادٍ تقطّع ألواحًا من الصابون أو طفلة تصنع السلايم، أو شابّا يأكل دجاجًا مقليّا أمام الكاميرا بصوت مرتفع.
تعدّ فيديوهات الـASMR محتوى رقميًا يعتمد بشكل أساسي على الصوت والصورة في توثيق نشاطات يومية نادرًا ما نعيرها أهميّة، من أجل تحفيز ذلك الشعور الحسيّ عبر مشاهد مريحة للمشاهدين أو المستمعين، وتشمل هذه النشاطات أفعالًا كثيرة، منها الأكل، أو التحدث، أو ما هو أقل اعتيادية من ذلك، مثل فتح كتابٍ وإغلاقه، أو طباعة إيميل، أو تسريح شعر. وهكذا فإن هذا المحتوى يضمّ تصنيفات عديدة يصعب حصرها، لذا سيستثني هذا المقال بعضًا منها، مثل فيديوهات الأكل (Mukbang)، ويركّز على الفيديوهات التي يعتمد صانعوها على أشخاصٍ ومواد في استحداث أصوات وأشكال مريحة.
الفراغ في مواجهة القلق
«لمدة خمس أيام ما كنتش قادرة أنام من الخوف، من القلق. بتذكّر إنه كنت خايفة أشيل الجزمة عشان عندي إحساس إني لازم أركض بشكل متواصل»، هكذا تصف لميا (35 عامًا)، وهي فتاة مصرية، شعورها إبّان الثورة في مصر. ورغم أنها كانت تُعاني من الأرق إلى جانب الإكتئاب والقلق منذ سن مبكرة، إلا أن الأمر تفاقم مع التوترات السياسية حينها.
وفي أوج قلقها آنذاك، عرضت عليها قريبتها فيديو كان وحده قادرًا على تهدئتها: «حسيت بأمان غريب»، تستذكر لميا ضاحكة. لم يكن في الفيديو إلا يد فتاة تُدعى ماريا فيكتوروفنا وهي تهمس وتمرّر أصابعها على كراتٍ قطنية. تعدّ ماريا إحدى أشهر صانعات الـASMR، ويتجاوز عدد متابعيها على يوتيوب المليوني متابع. «مكنتش عارفة إيه هو الـASMR، مكنتش أعرف إن دا شيء [موجود] أصلًا (..) كان كل شيء آخر مش بهدّيني»، تقول لميا.
منذ ذلك الحين، تواظب لميا على مشاهدة فيديوهات الـASMR يوميًا، وبعد سنوات من استهلاك المحتوى قرّرت أن تصنع محتوى عربيًا مشابهًا، لتطلق قناتها على يوتيوب بعنوان «همسات عربية»، التي يزيد عدد متابعيها اليوم على 14 ألف متابع.
وعلى غرار تجربة لميا، أصبحت فيديوهات الـASMR مصدر راحة نفسية لكثيرين، وتساعدهم على مواجهة نوبات الهلع والتخفيف من حدة القلق. يشرح ريتشارد كريغ، عالم الصيدلة البيولوجية ومؤسس موقع «ASMR University»، في كتابه «Brain Tingles» ارتباط الظاهرة بالدماغ البشري، قائلًا إن الأصوات والحركات الخافتة والرتيبة لديها القدرة على إفراز هرمون الأوكسايتوسين المُلقّب بـ«هرمون الحب»، وهو الهرمون المسؤول عن تعزيز الترابط الحميمي بين البشر، حيث ترتفع مستويات الهرمون عند احتضان أحبائنا أو عند إرضاع الأم لطفلها.
ومن المثير للاهتمام أن ارتفاع مستوى الهرمون يكون عند كلّ من المتلقي والمرسل، أي لو كانت أمّ -مثلًا- تلعب بشعر ابنتها فسيرتفع الهرمون عند الأم باعتبارها مرسِلة، وكذلك عند ابنتها كمتلقيّة. ولا يقتصر الأمر على التلامس الجسدي، بل يمكن أن ترتفع مستويات الهرمون عند الأم عند رؤية ابنها يرسم أو يلوّن. وهذا ما يفسّر تأثر لميا وأمثالها بمشاهد تراها عن بُعد دون تواصل مباشر مع الحدث.
لكن، من جهة أخرى، فإن الأصوات والحركات تلقى ردود فعل متباينة جدًا من شخص إلى آخر، وقد يتغيّر شعور الشخص نفسه على مرّ الزمن عند تكرار سماع الصوت ذاته، لهذا لا يطيق كثيرون محتوى الـASMR، ويسمّي البعض هذا الانزعاج بالميسوفونيا وهي حالة الغضب أو التوتر التي قد تصيب بعض الأشخاص عند سماعهم أصواتًا معينة.
قبل اكتشافها فيديوهات الـASMR حاولت لميا لمدة طويلة أن تعالج أعراضها النفسية عبر التأمل وتمارين التنفّس وغير ذلك، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. لجأت لميا إلى هذه الأساليب لأنها كانت منهَكة جسديّا ونفسيّا، لكنها وجدت أن الأساليب ذاتها التي من المفترض أن تبعث فيها طاقة إيجابية تستنزفُ ما تبقى لديها من تركيز أو فاعلية: «كان لازم إني أشارك، أو أعمل حاجة. لازم تشربي أعشاب، لازم تواظبي على روتين معين، لازم تمارسي الرياضة قبل النوم».
لا يحتاج محتوى الـASMR من المتلقيّ إلا أن ينظر ويسمع، إذ يمنحه وقتًا مستقطعًا، وقتًا فارغًا غير محمّل بهدف أسمى سوى الخدر اللحظي.
تطلّب التأمل من لميا أن تسترخي وتُفرغ رأسها من الأفكار، فيما كانت هي عاجزةً عن تهدئة نفسها، ما زاد من توتّرها خصوصًا أن «عدم التفكير» يصبح حينها هوسًا يصاحب تفكيرها المنهَك أساسًا، وتقول إن التأمل صار أقرب إلى التنمية البشرية حيث «يحقّق» الشخص طموحه، أو «يصل» إلى السلام الداخلي، أو «يسأل» نفسه عن مبتغاه، أو «يغيّر» منظوره نحو الواقع، وهذه كلها ممارسات هادفة تتطلب لإتمامها عزيمة نفسية وجسدية. «دا تمرين مش استرخاء (..) أما الـASMR فإنتِ بتسيبي نفسك خالص (..) مش محتاجة أعمل حاجة غير إني أحط السماعات. حل سحري».
يتّسم خطاب الصحة النفسية المهجّن بالتنمية البشرية، والذي أصبح سائدًا إلى حد بعيد، بتأمّله المفرط في النفس، معتبرًا أن الذات هي المحرّك للتغيير، أي أن المشاكل لا تنبع من الظروف البنيوية والسياق التاريخي أو السياسي، بل من نظرة الفرد التشاؤمية تجاه الواقع، وهو ما يتطلب من الفرد تغيير وجهة نظره كي تتغير نفسيته وظروفه. وهذا، بحسب الكاتب سام بنكلي، خطاب نيوليبرالي بامتياز، يعزل الفرد عن واقعه المعاش ليصبح كائنًا خارقًا يتحمل وحده مسؤولية نجاحاته وانكساراته، بغض النظر عن البيئة المحيطة وبهدف إنتاج نسخة محسنة منها.[1]
بالمقابل، لا يحتاج محتوى الـASMR من المتلقيّ إلا أن ينظر ويسمع، وحيث أنه ليس محملًا بأي نوع من الرسائل، نظرًا لأنه محتوى فارغ، فهو لا يحاول أن يعكس معادلة الصحة النفسية التبسيطية عبر اتهام الأنظمة البنيوية، بالتالي لا يمكن اعتباره بديلًا ثوريّا عن خطاب الصحة النفسية، لكنه على الأقل لا يفترض أن الحل يكمن في الذات. باختصار، يمنح الـASMR الشخص وقتًا مستقطعًا، وقتًا فارغًا غير محمّل بهدف أسمى سوى الخدر اللحظي.
ترى العالمة الاجتماعية نيومي سميث أن للتأمل والصحة النفسية فوائد عديدة، ولكنها تقول -في مقابلة أجريناها معها- إن هذه الأساليب أصبحت منتجًا استهلاكيًا يستخدمه الرأسماليون وأصحاب النفوذ، وحتى الحكومات، من أجل تطويع الأفراد وتمييع القضايا. ومع أن شركات كثيرة حاولت الاستحواذ على محتوى الـASMR، كما فعلت «آيكيا» و«ليندت» وغيرهما، إلا أن هذه المحاولات لن تحقق انتشارًا واسعًا، «لا أعتقد أن الـASMR يوّفر استراتيجية تسويقية جيّدة على المستوى الجماهيري لأن مُحبّيه يُشكلّون شريحة متخصصة أضيق من أن تستهدفها الشركات»، تقول سميث.
تذكر سميث ردود الأفعال المختلفة تجاه إعلان نشرته شركة تبيع جعة اسمها «ألترا» خلال مباراة السوبر بول (نهائي دوري كرة القدم الأمريكية) سنة 2019، تظهر في الإعلان ممثلةٌ أمريكية تهمس وتنتج أصواتًا خافتة من زجاجة الجعة، تقول سميث: «استهجن البعض الإعلان، ما هذا الهراء؟ ما الذي يحصل؟ بينما أبدى آخرون إعجابهم»، مضيفة أن استهداف محبي الـASMR أمر صعب جدًا بكل الأحوال، لأنهم يحبون أنواعًا ومحفزات مختلفة؛ على سبيل المثال يحب بعضهم صوت الطرق على الخشب، ويحب آخرون الهمس، فيما يفضّل غيرهم أصوات المضغ، هذه الفروقات كبيرة جدّا وبالتالي يصعب حصرها أو التحدث عنها ضمن خطاب واحد.
حميمية غير جنسية
خَلق تحفيز الـASMR لمناطق الدماغ المسؤولة عن الحميمية جدلًا واسعًا حول ارتباط هذا المحتوى بالإيحاءات والفيتيشية الجنسية، خصوصًا أن أغلب صُناعه من النساء. في صيف 2018 حجَب المكتب الوطني الصيني لمجابهة الإباحية فيديوهات الـASMR معتبرًا أنها «بذيئة وإباحية» وغطاء لمحتوى جنسي. بالمقابل، ترفض الكثير من صانعات الـASMR فرض هذا التنميط عليهن معتبراتٍ أن ما يفعلنه فنّا ليس له علاقة بالجنس.
وتجنبًا لهذا اللغط، بالإضافة إلى أسباب أخرى، فضّلت لميا عدم الكشف عن وجهها في فيديوهاتها، حالها حال العديد من صانعات الـASMR.، فبدأت بتصوير يديها فقط وهي تطلي أظافرها أو تعتني بنبتة، ولكن بعد أن صار لها متابعون تربطها فيهم علاقة وطيدة كشفت عن نصف وجهها: «لمّا بكلمهم أصبحت أنا موجودة أكتر، مش مجرّد صوت مرتبط بإيدين (..) نظرات العين مهمة قوي، لكن لسّة للأسف مش قادرة أكسر حاجز العيون».
من جهة أخرى، أظهرت آرين، وهي طفلة أردنية تشاهد فيديوهات الـASMR يوميًا، حساسية عالية للأصوات منذ كانت في الثالثة من عمرها حيث كانت تطلب من والدتها أن تمشي بالكعب العالي على أرضيات مختلفة. في البداية لم تُبدِ والدتها آردا اهتمامًا جديًا برغبة ابنتها المتواصلة بتسريح الشعر أو اللعب بالسلايم، إلى أن لاحظت متابعة ابنتها لفيديوهات غريبة على يوتيوب: «ما كنت بفهم شو يعني ASMR (..) كنت بقولها شو هالسخافة؟ طب احضري فيلم».
تبلغ آرين اليوم 10 أعوام، وتأخذ معها أينما ذهبت ألعابًا حسيّة تصدر أصواتًا مريحة مخصصة لمحبي الـASMR. وأثناء إجراء المقابلة معها عبر زووم، لم تترك لوحًا دائريًا صغيرًا معروفًا باسم «pop it» فيه فقاعات مطاطية تقوم بالضغط عليها لتصدر أصواتًا مريحة.
على عكس لميا، لا تعاني آرين من أي اضطرابات نفسية أو قلق مزمن، وكل ما في الأمر أنها تجد هذه الفيديوهات مريحة، وهي تفضّل مشاهدة الفيديوهات على أن تقوم نفسها بإصدار الأصوات عبر اللعب بالسلايم مثلًا، وذلك لأن الفيديوهات تمكّنها من سماع أصوات دقيقة ومفصّلة لا يمكن للأذن المجردة أن تلتقطها، ولأن صانعيها يمتلكون تقنياتٍ متقدمة واحترافية غير متوفرة لها.
المُرادف الصوتي للمِجهر
لا يمكن التحدث عن الـASMR دون التطرق إلى التكنولوجيا والتفكير بتأثيرها وتأثّرها بحواسنا. تُستخدم الأدوات التكنولوجية عمومًا كوسيط يحمل الرسائل من نقطةٍ إلى أخرى. ولكن عندما يتعلق الأمر بالـASMR فإن التكنولوجيا تصبح فاعلًا رئيسيًا في إنتاج المحتوى، أي أن استبعاد الميكروفون أو الكاميرا من العمليّة يعني إسقاط الظاهرة بأكملها، وليس التخلي عن الوسيط فحسب. يرجع ذلك ببساطة إلى أن آذاننا غير قادرة على التقاط أصوات دقيقة وتكبيرها؛ سنسمع كرمشة الورق كأنها صوت هامشي بعيد تعلوه أصوات أخرى. وهنا تكمن المفارقة، لكي نستطيع الاقتراب من الحدث علينا أن نبتعد عنه مكانيًا وزمانيًا ونستعين بأدوات تكنولوجية تشكّل تفاعلنا معه.
قد تثير فينا أغنية نسمعها عبر سماعات الأذنين القشعريرة ذاتها التي تصيبنا عند مشاهدة فيديو ASMR، لكن الفرق أن الأغنية مصممة لإثارة تلك النشوة الحسيّة من خلال تناغم الإيقاع واللحن، على عكس الـASMR الذي يعتمد بشكل أساسي على مواد خام لا تهدف بحدّ ذاتها إلى إثارة الحواس؛ كنقر الخشب أو كرمشة الورق.
«يتلخّص الـASMR بخلق القُرب دون الحاجة إلى التواجد الفيزيائي مع الآخر» تقول سميث، مضيفةً أن الصوت عبر الـASMR يصبح قريبًا وبعيدًا في الوقت نفسه؛ بعيدًا لأن المتلقي والمرسل بعيدان عن بعضهما مكانيًا وزمانيًا، وقريبًا لأن الأصوات الخافتة كالهمس وتسريح الشعر تعبّر بطبعها عن نشاطات تتطلب مسافة شبه معدومة بين المرسل والمتلقي، كما أنها أصوات مركّزة يمكن التحكم بمستواها والاقتراب منها أكثر عبر ارتداء السماعات، وهكذا يصبح الـASMR مثالًا عن «كيفية تورط الحميمية المتناقَلة عبر الفضاءات الرقمية بتعقيدات المسافة».
تعتَبر سميث البُعد بين المُرسل والمُتلقي في هذه الحالة ميزة لا عيبًا، لأن التواجد الفيزيائي مع الشخص الآخر كثيرًا ما يضيف عبئًا نفسيًا على المتلقي، فقد يشعر بتأنيب الضمير أو الحاجة إلى التحدث أو الردّ. وقد يشعر المرسل كذلك بالضغط أو المقاومة في حال تسريح شعر شخص حقيقي أو الهمس في أذن حقيقية بدل الميكروفون. ومن الملفت أنه رغم ارتكاز الظاهرة على هذا الابتعاد، إلا أنها لا تخلو من التلاعب بالمسافة بين المرسل والمتلقي، فنجد مثلًا ميكروفون على شكل أذن بشرية للتشبّه بأذن المتلقي من أجل إنتاج صوتٍ مجسّم (ثلاثي الأبعاد).
إذن، في أسوأ الأحوال، قد يؤثر الـASMR سلبًا على التواصل البشري، نظرًا لأن البعض، ومنهم سميث نفسها، يفضلون الحميمية الرقمية المجهولة على التواصل الفيزيائي. وفي أحسن الأحوال سيخلق الـASMR للغرباء مساحةً لاختبار تواجدهم معًا بطريقة حميمية ومجانية وغير جنسية، دون أن تكون هذه المساحة موجودة فعليًا على أرض الواقع.
إضافة إلى مفارقة الاقتراب والابتعاد، ثمة مفارقة أخرى في الـASMR هي أن التكنولوجيا ورغم أنها أحد أسباب الإيقاع السريع المرهق للحياة المعاصرة أصبح فيها ملاذًا للاسترخاء. تستذكر لميا كيف كان الاسترخاء مختلفًا بالنسبة لها قبل اهتمامها بالـASMR: «كان الحل إنك تقفلي موبايلك، وتقطعي عنّك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي»، لكن هذه الطرق برأيها صارت غير ممكنة نظرًا لاعتمادنا الواسع على التكنولوجيا، «دلوقتي بقدر أسترخي عن طريق تلفوني، مش مضطرة أتخلّى عنه عشان أسترخي»، تقول لميا.
وعليه، فقد يشير الـASMR إلى تقلّص الفواصل القائمة بين الحياة البشرية والتكنولوجيا، بغض النظر عما إذا كان هذا أمرًا سلبيًا أو إيجابيًا. لم تعد التكنولوجيا في هذه الحالة مجرد وسيلة نوظّفها لمصلحتنا، بل صارت جزءًا متغلغلًا في أدق تفاصيل حياتنا.
عام 2017، وجدَ الصحافي العراقي محمد المؤمن فيديو لصوت الضوضاء داخل طائرة، ثم تتالت الفيديوهات حتى وصل إلى الـASMR. شارك المؤمن فيديو الطائرة على صفحته في الفيسبوك لشدة انبهاره به وبعدد المشاهدات التي حصدها. علّق أحد أصدقائه على المنشور: «إذا يريدون ضوضاء، نصدر لهم، عدنا ضوضاء بصري، ضوضاء سمعي»، ليردّ عليه المؤمن ساخرًا: «همه يريدون ضوضاء بيضاء، مو مثل السوداء التي عدنه». وهذا ما يفعله الـASMR بالضبط، إنه يعيد تعريف الضوضاء لتصبح خفيفة على الأذن، لكن هذه الخفة لا تحدث إلا لأننا نتحكم بالأصوات ونغربلها كما نشاء، ونغلق الشاشة إذا شعرنا بالملل أو التعب، وهو ما يستحيل فعله في حال كنا نعيش بجانب شارع عام أو بالقرب من محطة قطارات.
وعلى غرار لميا، يرى المؤمن أن الفيديوهات «الفارغة»، كما يصفها، توازن المحتوى الثقيل الذي يتلقّاه ويتعامل معه بحكم عمله في صحافة البيانات الاقتصادية. ورغم أن الـASMR تشعره بالراحة خصوصًا أنها تساعده على التركيز أثناء العمل، لكن يصاب بالإحباط من التفاعل مع المحتوى الاقتصادي الذي ينتجه مقارنة بتلك الفيديوهات: «أنا بحاول أبالغ بضخ معلومات (..) وأي معرفة أحاول أسندها بأكثر من مصدر (..) وأكو شخص نشر شيء فارغ وحصل على مشاهدات أحسن مني بآلاف المرات (..) آني شفت فيديوهات على يوتيوب بيها عشرات الملايين من المشاهدات وهي عبارة عن لا شيء، حرفيًا لا شيء».
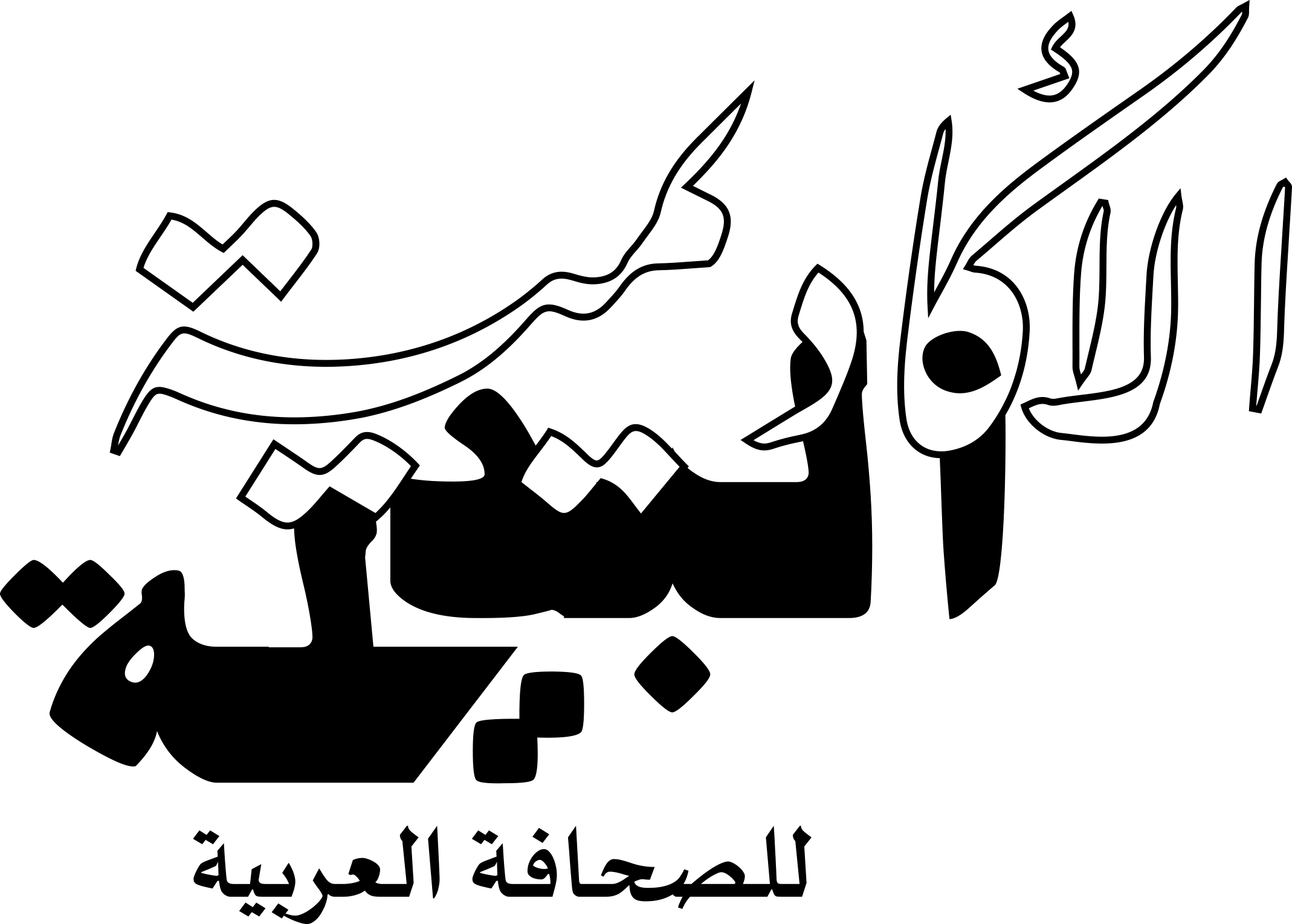
أنتجت هذه المادة ضمن فترة الدراسة في «الأكاديمية البديلة للصحافة العربية».
-
الهوامش