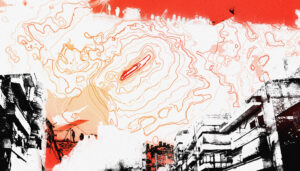فلنعترف بأن النصف الثاني من السنة الماضية شهد الكثير من المعارك على ساحات التواصل الاجتماعي، التي أخرجت نزعات عنصرية وتمييزية دينية صدمت الكثير منا. لكن، فلنعترف أيضًا أنه لولا وسائل التواصل الاجتماعي هذه لما كنا كمواطنين سنعرف تفاصيل أحداث حرجة حصلت في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر.
تتخبط الحكومة كلما واجهت تطورًا تكنولوجيًا خرج عن سيطرتها، وكما عودتنا دائمًا، تضرب بعرض الحائط الفرص الاقتصادية والاجتماعية لهذه التكنولوجيا في سبيل إعادة سيطرتها على تلك المساحة. رأينا ذلك في منع الطائرات من دون طيار، ومنع الطابعات الثلاثية الأبعاد، وفرض ترخيص المواقع، والآن محاولة السيطرة على «السوشال ميديا»، الفضاء الإلكتروني الذي كشف قصورها. ففي تصريح لصحيفة الغد، بشّرنا المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، بأن حكومته وجدت الحل لتنظيم المساحة التي تسمّى وسائل التواصل الاجتماعي بإصدار تشريع لقانون جديد خاص بها. يقول المومني بأن هذا القانون سيمكن الحكومة من وقف من يستخدم وسائل التواصل لبث «خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمعي».
الحق على فيسبوك
لوم وسائل التواصل عند كل مأزق هو منطق الدولة في التعامل مع هذه المساحة. فكلما كشفت وسائل التواصل الاجتماعي إخفاق الدولة في إدارة الشأن العام، ترفع الدولة سبابتها لتهدد مستخدمي تويتر وفيسبوك وتتهمهم بنشر الشائعات والفتن.
آخر النقاشات التي احتدت على وسائل التواصل الاجتماعي دارت حول ما إذا شهدت أحداث الكرك تقصيرًا من وزارة الداخلية، وهو ما قاد مجلس النواب لدراسة مقترح لطرح الثقة عن وزير الداخلية سلامة حمّاد. لكن بعد ١٤ ساعة من شح المعلومات الصادرة عن الحكومة، يصرح المومني في مؤتمر صحفي لا يسمن ولا يغني من جوع بأن وسائل التواصل هي سبب الشائعات التي أعاقت عمل الأجهزة الأمنية، متجاهلًا حقيقة أن الشائعات تخرج في ظل غياب المعلومة الرسمية، وبأن وسائل إعلام مرخصة كانت هي المصدر الأول للمعلومات غير الدقيقة حول هوية الإرهابيين.
لا يمكن إنكار أن وسائل التواصل الاجتماعي، كغيرها من المساحات، فيها الجيد والمسيء من التعليقات. وكما يحاسب القاتل على جرمه سواء استخدم سلاحًا ناريًا أم سكينًا لفعل جريمته، يجب أن يحاسب كل من سبب خطابه ضررًا واضحًا لأفراد أو مجموعات سواء وقف في ساحة وصرخ في مكبر الصوت أو ظهر في برنامج تلفزيوني. لكن هل رأينا قانونًا متخصصًا بجرائم القتل التي ترتكب بالسكين؟ أو قانونًا متخصصًا بجرائم القدح والذم والتشهير والابتزاز الجنسي وخطاب الكراهية التي ترتكب فقط من خلال مكبر صوت؟ إن كانت الإجابة لا، فلماذا تقرر الحكومة أن تخصص قانونًا يجرّم الوسيلة، وهي مواقع التواصل الاجتماعي، بدلًا من تجريم الفعل نفسه؟ أن تقوم الحكومة بإعطاء صلاحية قانونية لمراقبة وملاحقة الخطاب «المسيء» دون وجود شكوى من المتضررين ما هو إلا تنصيب لنفسها وصيةً على الخطاب الذي يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ المساحة التي كشفت تقصيرها وإخفاقها.
يصرح المومني في الخبر نفسه، إن مشروع القانون «سيضع مسؤولية على شركات الاتصالات في معرفة أصحاب الحسابات المسيئة وإيقافها». يعكس هذا التصريح مشاكل حقيقية، فهو أولًا يزجّ شركات الاتصالات في انتهاك للحق المنصوص عليه في المادة ١٨ من الدستور التي تحفظ للمواطنين سرية اتصالاتهم وألا يتم تتبعها إلا بأمر محكمة. ثانيًا، شركات الاتصالات توفر الإنترنت مقابل ما يدفعه عملائها، وتحميلها المسؤولية القانونية لما يقومون به على الشبكة هو مماثل لأن تطلب من شركة مقاولات أن تتحمل المسؤولية القانونية عن حوادث السير التي تقع على الشوارع التي عبّدتها. ثالثًا، يوضح التصريح عدم استيعاب الحكومة لتعقيد التقنية التي تحكم المساحة التي تستميت من أجل تنظيمها. من خلال تشفير (https) الذي يعتمد عليه اقتصاد الإنترنت وخصوصية مستخدميه، لا يمكن لشركات الاتصالات معرفة أصحاب الحسابات المسيئة والمواقع التي صدرت عنها التغريدات، دون توظيف أنظمة تجسس باهظة الثمن. ودون ذلك، لن تستطيع شركات الاتصالات إلا أن تطلب تلك المعلومات من الشركات المالكة لمواقع التواصل ذاتها، لتصطدم عندها بسياسة تويتر وفيسبوك التي تستوجب وجود قرار محكمة من أجل الإفصاح عن تفاصيل حساب معين.
بتطويرها لمثل هذا المشروع، تربط الحكومة خطاب الكراهية والعنصرية بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، وكأن الخطاب ليس وليد تشوهات اجتماعية وسياسية نتجت عن تقصير الدولة. لماذا لا تترك الحكومة للمواطنين ممارسة حقهم بالتقاضي ضد الإساءات بدلًا من أن تنصّب نفسها وصية على هذا الخطاب؟ وإن كانت الحكومة جدية فعلًا في مواجهة هذا التمييز والكراهية، لماذا لم توقف كتاب مقالات في صحيفة الدولة الرسمية، طالب أحدهم بتحديد هوية قاتل أمه وإن كان أردنيًا حقًا أم «ابن أردنية»، ووصف آخر الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بالنشمي لأن «احتقار النساء» من بين مزاياه؟
هل التشريعات الحالية مفعّلة أصلًا؟
وسائل التواصل الاجتماعي مساحات يصعب إخضاعها للتنظيم وفقًا لمعايير الحكومة في تحديد المسؤولية ومفهومها للإساءة. لذا، فإن الآلية الأفضل في تنظيم هذه المساحات، إذا كان الهدف هو حماية المجتمع، هي التنظيم الذاتي من قبل المستخدمين، أي أن يشعر المستخدميون أنفسهم بأهمية التقاضي ويقدّرون الإساءة ويعرفوا الأدوات القانونية التي يملكونها لمحاسبة المسيء. يكون ذلك عبر تعزيز التشريعات الحالية وتمكين المواطنين منها، دون أن ننسى أن إشراك الناس وتمكينهم في عملية الشكوى والتقاضي، سينعكس أيضًا على الحديث خارج التواصل الاجتماعي، من حيث رفض الكراهية والعنصرية والتمييز.
يقول المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، المحامي محمود قطيشات، في تصريح لوكالة الأنباء بترا، «إن النصوص التي تجّرم خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي كافية، إلا أن هناك صعوبة في إثبات الجرم من قبل المحكمة أو نسب الفعل للفاعل، ما يجعله يفلت من العقاب»، داعيًا إلى إعطاء دورات تدريبية مكثفة للقضاة حول التعامل مع الإعلام الإلكتروني. أي أن أي تشريع مرتقب في هذا الشأن لن يأتي بجديد لا يتوفر في قوانين حالية. وقد يكون ذلك سببًا آخر للاعتقاد بأن منطق «الفزعة» هو الذي يحكم العملية. فقد سبق لرئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة الإعلان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عن تشريع جديد قارب على الانتهاء لمحاربة خطاب الكراهية، وذلك بعد يوم واحد من مقتل ناهض حتر، ثم اختفى ذلك التشريع.
الأمر يشبه ما فعله مدعي عام الجنايات الكبرى يوم الخميس، عندما عمّم بمنع التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي «لا بالاستحسان ولا بالاستهجان» على قرار الادعاء العام بتوقيف متهم في قضية ما، قبل أن يعاد الإفراج عنه. جاء ذلك التعميم في وقت لم يكن المعلقون يستهجنون ويستحسنون فيه الإجراء لنيتهم التأثير في سير القضية أو مجرى العدالة، بل لأنهم افتقروا للمعلومة. ربما كان من الأولى توضيح الإجراء القانوني للناس، وتوضيح أن تعليقاتهم التي تطال التحقيقات السرية مخالفة لقانون انتهاك حرمة المحاكم، وأنهم يعرضون أنفسهم بذلك للمساءلة القانونية، بدلًا من فوضى المعلومات التي نقرأها مع كل جريمة تحصل بالأردن، وبدلًا من أن يكون الملجأ الأول هو حظر الكلام. وقد يفسر ذلك لاحقًا، السلوك المجتمعي بالتقاعس عن تقديم الشكوى حول مقالات الرأي في صحف رسمية تضمنت خطابات تحض على العنف والتمييز والكراهية، لأنهم أصلًا لا يشعرون بأنهم جزءٌ من منظومة العدالة التي لا يكلف أحد نفسه شرح قوانينها.
الريادة في قطاع يختنق
في حديثه صباح الخميس عبر التلفزيون الأردني، وعد الوزير المومني بأن يكون الأردن رائدًا على مستوى العالم «بهذا المجال»، دون أن نعلم ماذا كان يقصد بهذا المجال. هل كان يقصد تفوقنا على ذاتنا بعدد التشريعات التي نسنها للشأن نفسه؟ أم في مجال حريات التعبير الذي لا تظهر المؤشرات العالمية أي تقدم للأردن فيها؟ أو على مستوى تكنولوجيا المعلومات الذي لا نحتل كدولة أي مكانة عالمية عليه، باستثناء إبداعات فردية لم تلقَ الدعم من حكومتها؟ الحكومة لم تستطع منع الغش في التوجيهي إلا بحجب خدمة الواتس آب عن كل المناطق المحيطة بمدارس الامتحانات. ولم تستطع منع شركات الاتصال من حجب المكالمات عبر الواتس أب عبر شبكات 4G. لكنها تريد أن تصل للمستوى العالمي في تنظيم مواقع التواصل.
لا تتوقف الحكومة عن اللعب بورقة الأمن والأمان. لا شك أن هذا المتطلب أساسي لكل الناس، وقد تكون الثورة التقنية المهولة قد جعلت المخاطر أكبر، لكن ألا يجب أن يدفعنا ذلك لضخ دماء جديدة تستطيع مجاراة كل هذه التحديات، وخلق حلول تنظيمية معاصرة تخرج من قلب هذه البيئة التكنولوجية، بدلًا من تكريس العقلية المحافظة التي لا أداة في يدها سوى الحجب والرقابة؟
يقول المهندس أكرم الحمود في مقال له على حبر حول الطابعات الثلاثية «أعتقد أن أغلبنا ما زال يذكر الحظر الذي تم فرضه على طابعات الليزر الملونة، وأجهزة الـGPS، ومناظير التلسكوب والقائمة تطول. الآن أغلب الأجهزة الذكية تحتوى خدمة الـGPS، وطابعات الليزر الملونة تباع بشكل اعتيادي. بكل بساطة، لا أحد يستطيع وقف قطار التقنية مهما حاول. كل ما يفعلونه الآن هو تعطيلنا وتضييع سنوات ثمينة من عمرنا انتظارًا… الأردن بشبابه هو الخاسر الوحيد أمام أي عرقلة لطريق السائرين في ركب التقنية».