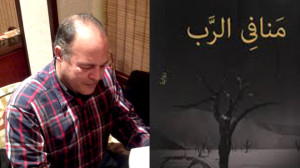الكاتبة إنعام كجه جي من مواليد العراق عام 1952 درست الصحافة ثم عملت بها وبالراديو في العراق قبل أن تنتقل إلى باريس لتكمل رسالة الدكتوراة في جامعة السوربون ومازلت تقيم هناك وتعمل كمراسلة لبعض الصحف بجانب عملها الأدبي. وصلت روايتها “الحفيدة الأمريكية” إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية – البوكر في عام 2009 والآن تصل روايتها “طشاري” إلى القائمة الطويلة لنفس الجائزة لعام 2014. حوار مع الكاتبة أجرته دينا الهواري كاتبة ومدونة من مصر.
حكيت لنا في “طشاري” عن العراق قديما حتى وصلت إلى العراق الحالي من خلال قصة الدكتورة وردية وعائلتها ومجتمعها، كيف رسمت هذه الشخصيات بهذه الدقة وهل هم نتاج خيال محض أم عرفتهم في الحقيقة؟
مثل كل العاملين في الصحافة، مهنتك تضعك في مواقع التماس مع شخصيات فريدة كثيرة. وقد صادفت في عملي الطويل شخصيات تتمرد على قالب التقرير الصحفي الموجز وتطالب بحقها في التمدد على صفحات رواية متأنية. لكن الواقع، مهما كان هائلاً، لا يكفي وحده لرسم الصورة. والراوي ليس مخرج أفلام تسجيلية. لذلك لابد من شحن ملكة الخيال لكي تأخذ بيد الأحداث الحقيقية وتمضي بها إلى مراتب العمل الأدبي.
أنا أعشق اللغة ومتعتي الكبرى مطالعة صفحات من “لسان العرب” كلما تيسر لي الوقت. ويحلو لي اختطاف تعبير تراثي جزل واستخدامه في مواقف مسكونة بروح عصرنا الحالي
غلاف الرواية حقاً استثنائي بصورة المرأة التي سيصدق القارئ انها فعلاً صورة وردية داخل غرفة التوليد التي انشأتها في الديوانية خاصة بعد قراءة تعليق “الصورة من أرشيف الكاتبة”، ما هي قصة الغلاف ومصدر هذه الصورة؟
لنقل إنها صورتها، بالفعل، في الديوانية عام 1956، أو صورة شبيهتها، أو قرينتها، أو ابنة عمها، أو لقطة بالأسود والأبيض تلبي المطلوب.
كم من الوقت استغرق كتابة الرواية والتحضير لها؟
التحضير استمر عدة سنوات. أي مطالعة الكثير من وثائق فترة الخمسينات الماضية في العراق، وفي مدينة الديوانية بالتحديد، ثم طبخ الشخصيات في بالي على مهل حتى تستوي. إن الفرنسيين الذين أعيش في ديارهم يحبون قطعة اللحم المطبوخة على النصف. أي بدمّها. وهو ما نسميه بلهجتنا “نص ستاو”. لكنني أفضلها “هبيطاً”. وعندما أشعر أن الأحداث أخذت قوامها المطلوب، أجلس للكتابة، متكاسلة في عملي الصحفي اليومي ومخصصة ساعات ليلية للرواية.
اسم الرواية يلخص مضمونها في كلمة واحدة كما نفهم خلال قراءتها. ألم تعتبري اختيار كلمة عراقية – قد تكون غير مفهومة لغير العراقين – كعنوان للرواية فيه شئ من المغامرة؟ وكيف تعاملت عموماً مع تحدي ادراج مفردات من العامية العراقية داخل الرواية؟
اختيار مفردة “طشّاري” كان مجازفة محسوبة. وهو العنوان الذي لم أجد ما هو أفضل منه للتعبير عما أريد. لكني لم ألعب مع القارئ لعبة الكلمات المتقاطعة بل شرحت له المعنى في السياق. وهو ما فعلته، أيضاً، مع بعض المفردات المحلية التي وردت على ألسنة شخصيات الرواية. أنا أعشق اللغة ومتعتي الكبرى مطالعة صفحات من “لسان العرب” كلما تيسر لي الوقت. ويحلو لي اختطاف تعبير تراثي جزل واستخدامه في مواقف مسكونة بروح عصرنا الحالي. لهذا، فإن اختيار مفردات من لهجتنا لا يعني أن الفصحى قاصرة عن احتواء الموقف. بل هي محاولة مقصودة لمنح النص نكهته العراقية. ثم أن الفضائيات التي دخلت البيوت أزاحت الكثير من حواجز اللهجات.
الرواية كما تحكي لنا عن تاريخ العراق، تحكي لنا عن ثلاث أجيال مختلفة، جيل الدكتورة وردية وجيل الأبناء وجيل الأحفاد متمثل في شخص “اسكندر”، هل سهّلت لك إقامتك في فرنسا الاختلاط بكثير من المهاجرين بحيث استطعت التعبير عن هذه الأجيال المختلفة في اشكالياتها ومفرادتها وأزمات هوياتها؟
ثلاثة أرباع الرواية تدور في العراق. ونحن شعب لم يعرف آباؤنا وأجدادنا الهجرة ولا فكروا بها. لماذا يهاجرون وهم يملكون في أرضهم خيرات الدنيا؟ إن الصراعات الحزبية، ومن بعدها الحروب والنزاعات المحلية، هي وحدها التي طردت العراقيين بعيداً وشتتهم في أرض الله الواسعة. وقد عشت، خارج وطني سنوات تفوق تلك التي عشتها فيه، وهو ما جعلني أتأكد أنه لن يغادرني وأنني سأبقى محكومة بنفض الغبار عن ذكرياته وتلميع صورته واتخاذها إيقونة لكتاباتي. وهنا، في بلد الهجرة، رأيت ما يكفي لكي أفهم هواجس المنفيين أوالهاربين أوالباحثين عن الرزق، عن الأمان ونسمة الحرية.
العراق القديم الخالٍ من الطائفية، هو أيضاً عراق جامع لجنسيات عربية مختلفة، هذا الأمر الذي لم يعد متاحاً بعد أن أصبحت الدول العربية تغلق حدودها أمام أبناء العرب لاعتبارات مختلفة. هل قصدت ابداء المفارقة نفسها في الصداقة بين اسكندر العراقي الأصل وكلثوم التونسية الذين تجمعوا ولكن في بلد غربي؟
لا حدود يمكن أن تغلق تماماً في هذا الزمان. وأظن أن الحروب فتحت البوابات لاستقبال المهاجرين والمهجّرين بين هذا البلد العربي وذاك. وكنت أتمنى لو تخالط العرب للسياحة، مثلاً، ولتبادل المعرفة، وليس للهرب من الجحيم المشتعل هنا وهناك. أما حكاية اسكندر وكلثوم فإنها ليست فريدة في مدينة مثل باريس حيث يجد آلاف المهاجرين العرب سلواهم في كنف بنات جلدتهم. واللغة هي التي تربط العلاقات، و”الدم يحنّ” كما نقول.
وليس أقسى من أن يتخيل المهاجر جسده راقداً في واحدة من تلك المقابر الأجنبية التي تصطف فيها القبور بعناية هندسية مثل قطع الدومينو
في أرض الواقع، هل ترين أنه من الممكن أن تكون المقبرة الافتراضية التي ينشأها اسكندر في الرواية والتي يتحمس لها المهاجرين ليدفنوا ولو افتراضياً في موطنهم وبجانب أحبابهم، قد تكون فعلأً ترضية نفسية للمهاجرين قصراً من بلادهم؟
المقبرة الألكترونية لعبة روائية، لا أكثر. وبعد صدور الرواية فوجئت بشركة فرنسية تنشئ مقبرة مماثلة وتدعو الزبائن للاشتراك فيها مقابل رسوم معينة. كما قيل لي إن هناك تجربة مماثلة في أميركا. أظن أن افتقاد الأرض، أي الطين والشجر ومياه النهر الأول، شاق على الروح مثل فراق الأحبة. وليس أقسى من أن يتخيل المهاجر جسده راقداً في واحدة من تلك المقابر الأجنبية التي تصطف فيها القبور بعناية هندسية مثل قطع الدومينو، مكشوفاً للريح الثلجية، بعيداً عن عظام الأهل ونخيل الديار.
من السهل طوال عرض أحداث الرواية مقارنة تطور الأحوال في العراق بما يحدث– أو على شفا الحدوث- في بعض الدول العربية من انشقاقات وخلافات، هل قصدت هذا التناول أم أنه تاريخ يعيد نفسه بطبيعة حال شعوبنا وتركيباتها؟
لا أدري سوى أن الكتابة عن ذلك الزمن الحضاري الرائق والهادئ، نسبياً، والثري فكرياً وثقافياً، هو وسيلتي لتذكير أبناء اليوم وبناته بما كانت عليه صورة الوطن قبل مجيئهم إلى دنياه المكفهرة. ويطيب لي أن أتوهّم أن هذا النوع من الكتابات يمكن أن يساعدهم في بناء مستقبل أصيل ومتسامح وغير هجين.
“أم يشبعون من الدم”؟ ، هكذا تنهين روايتك نهاية مفتوحة وسؤال بلا إجابة، هل تفضلين النهايات من هذا النوع أو هو اختيار فرضه موضوع الرواية.
أنهيتها هكذا لأن نهايات ما يجري في بلدي ما زالت مفتوحة، والجرح ينزف والجوع للدم ما زال في أوجه.
للمرة الثانية تصل رواية لك إلى القائمة الجائزة العالمية للرواية العربية – البوكر حيث وصلت روايتك “الحفيدة الأمريكية” إلى القائمة القصيرة في عام 2009 والآن تصل طشاري إلى القائمة الطويلة– كيف تقيّمين تجربة الترشّح في المرة الأولى وهل تختلف مشاعرك وتوقعاتك هذه المرة؟
أسعدتني تجربة اختيار “الحفيدة الأميركية” في القائمة القصيرة لأنها أتاحت لي السفر إلى أبو ظبي والتعرف، شخصياً، على زملائي المرشحين الآخرين وعقد صداقات معهم. كما سمحت لي بالمشاركة في الإشراف على ندوتين من الندوات التي دأبت إدارة الجائزة على تنظيمها في الإمارات، سنوياً، كنوع من ورش الكتابة لروائيين وروائيات من الجيل الشاب. إنها تجارب غنية لا تنسى، سواء بأماكنها أو بشخصياتها.
تبدو تيمة الهجرة والرحيل من العراق وأزمة الهويات في الموطن الجديد الخلطة المحببة لرواياتك كما نرى في “طشاري”، “الحفيدة الأمريكية”، “سواقي القلوب” … هل هناك خطة أخرى للأعمال القادمة أم مازال لديك جديد تقدمية تحت هذه التيمة؟
كتبت عما أعرف وما رأيت وعايشت. وأحلم برواية حب جارف، مثلاً.
لمن تقرأ الأستاذة إنعام؟ وبمن تأثرت من رواد الأدب؟
أقرأ كثيراً من المذكرات وكتب السيرة، وأحرص على الحصول على كل ما يهمني من روايات عربية، وقد تأثرت، في مراهقتي، بالأديب اللبناني ميخائيل نعيمة، قبل أن أغطس في لجة نجيب محفوظ.
ما هو أخر كتاب قرأته الأستاذة إنعام وترشّحه لنا للقراءة؟
قرأت متأخرة، للأسف، رواية “القوس والفراشة” للكاتب المغربي محمد الأشعري. وأنا أرشّحها لمن أحبهم، ضامنة لهم ساعات من المتعة الراقية.
مراجعة أدبية لرواية “طشاري” بقلم دينا الهواري.