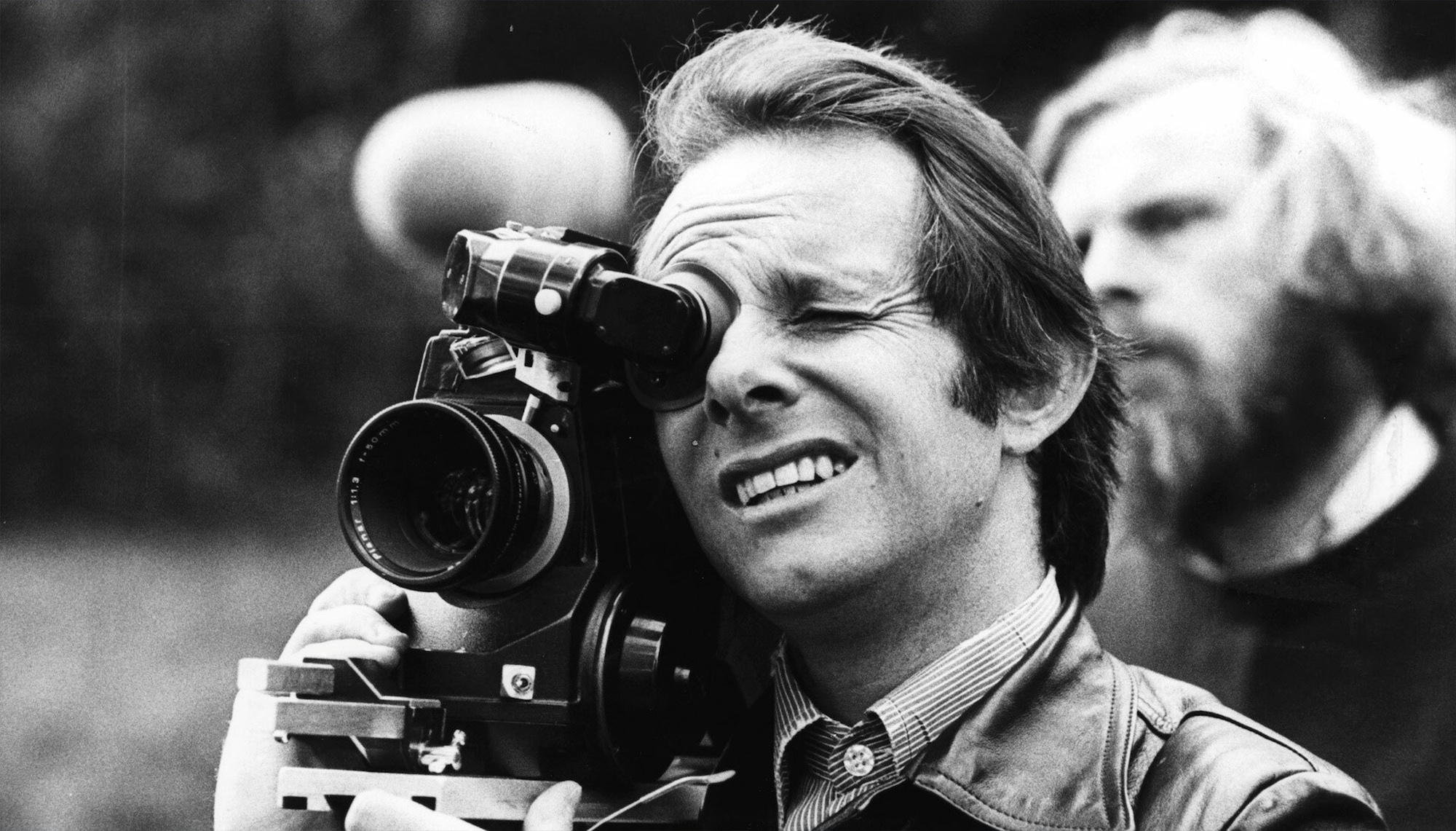فيما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف الأحياء السكنية، مخلفةً وراءها أكوامًا من الضحايا، أغلبهم من الأطفال، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية منهمكة في توزيع رسالة أبرق بها 86 من الفائزين بجائزة نوبل، على نحو عاجل، للأمين العام للأمم المتحدة، خوفًا على حياة الأطفال الرهائن لدى المقاومة. يبدو الدافع وجيهًا، فحياة الأطفال، ومهما كان انتمائهم، ثمينة، ويجب أن تكون خارج حسابات الحرب والصراع.
لكن اللافت في صحوة ضمير أصحاب نوبل، هو نصف العين التي يرون بها صراعًا مديدًا، يباد فيه الأطفال على الجانب الفلسطيني كل يوم منذ عقود. أرواح مهدورة دون أن يلتفت إليها أحد. عدا الأعداد الكبيرة من الأسرى في سجون الاحتلال، والتي بلغت العام الماضي، وفقًا للمراكز الحقوقية 865 حالة اعتقال بحق قاصرين، بعضهم جرحى بحالات خطرة، وبعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات. واللافت أكثر أن الرسالة المؤرخة في 16 تشرين الأول، والتي حملت عنوان «المطالبة بالحرية للأطفال المختطفين»، لم ترفدها رسالة مماثلة لأصحاب نوبل، حول الأطفال الذين قتلوا جماعيًا في مجزرة المستشفى المعمداني، يومًا واحد بعد إرسال الرسالة. ومن خلال بحث بسيط على الإنترنت، نجد أن المصدر الوحيد للرسالة هو حساب الخارجية الإسرائيلية على شبكة X، ما يوحي بأن أصحابها قد خصوا «إسرائيل» بنسخة قبل أن يبعثوا بها للأمم المتحدة. ظاهريًا لا يمكن أن ندين جائزة نوبل، لأسباب تتعلق بأشخاص حازوا عليها، ولكن هذا السلوك يكشف عن مواصفات خاصة يشترك فيها الحائزون على الجائزة، مع استثناءات قليلة.
تثير جوائز نوبل الجدل بلا توقف. لاسيما في فرعي السلام والأدب. ورغم ما يشاع عن الجائزة من أنها جزء من السلطة الثقافية الغربية المهيمنة، وذات انحيازات سياسية واضحة، إلا أنها تبقى الجائزة الأكثر تأثيرًا في العالم، والتي تصنع شرعية معنوية ذات أفق عالمي لمن يحصل عليها. ورغم المحاولات المضادة التي اجترحها السوفييت خلال الحرب الباردة من خلال جائزة لينين العالمية، ثم الصينيون بدايةً من عام 2010 عبر جائزة كونفوشيوس، ما زالت نوبل تحتفظ بسلطتها، التي تستمدها من نموذج الهيمنة الغربية القائم. لذلك كانت هذه السلطة السحرية محل سباق بين الدول والكيانات السياسية والعلمية والثقافية، لجهة المكاسب التي تحققها الجائزة لمن يحوزها.
شكلت جائزة نوبل محط اهتمام الكيان الإسرائيلي منذ نشأته نهاية أربعينيات القرن الماضي، وكانت كواليسها مسرحًا للنشاط الصهيوني. ذلك أن الحصول عليها كان سيشكل شاهد قوة على نجاح المشروع الصهيوني.
ولذلك أيضًا شكلت الجائزة محط اهتمام الكيان الإسرائيلي منذ نشأته نهاية أربعينيات القرن الماضي، وكانت كواليسها مسرحًا للنشاط الصهيوني. ذلك أن الحصول عليها كان سيشكل شاهد قوة على نجاح المشروع الصهيوني. منذ بداية الخمسينيات بدأت «إسرائيل» في تلقي طلبات من لجنة جائزة نوبل للسلام في البرلمان النرويجي لمعرفة ما إذا كانت توصي بأي شخص لجائزة نوبل للسلام. وفي عام 1952، طالب الدبلوماسي الإسرائيلي جدعون رافائيل، الذي خدم في بعثة «إسرائيل» لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن توصي «إسرائيل» اللجنة بمنح الجائزة لرافائيل ليمكين -وهو فقيه قانوني يهودي أمريكي ولد في بولندا وأحد الناجين من المحرقة- وهو من صاغ مصطلح الإبادة الجماعية، لكن الجائزة ذهبت إلى الطبيب والفيلسوف الألماني ألبرت شفايتزر.
في العام التالي حاول الإسرائيليون منح الجائزة للكاتب الأمريكية هيلين كيلر، التي كانت متحمسةً للكيان الوليد. في تشرين الأول 1953، كتب إريك بولتر، الأمين العام للمجلس العالمي للمكفوفين، إلى رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون وطلب منه أن يوصي اللجنة النرويجية بمنح الجائزة لكيلر، وهي كاتبة فاقدة للبصر وصماء في الوقت نفسه، تمكنت من مواجهة الصعوبات الجسدية وعملت من أجل المعاقين في العالم. إلى جانب أنها زارت «إسرائيل» عام 1952 والتقت بن غوريون. وفي كانون الثاني، خاطب القائم بأعمال رئيس الوزراء موشيه شاريت اللجنة وأوصى بمنح الجائزة لهيلين كيلر. وفي اليوم التالي، قدم حنان سيدور، مدير دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، تقريرًا إلى بولتر مصحوبًا برسالة شاريت. ومع ذلك، في عام 1954، مُنحت جائزة نوبل للسلام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
دون يأس، واصل الإسرائيليون العمل على خطف الجائزة. في عام 1954، شرعت منظمة «عاليات هانوعار» الصهيونية في العمل من أجل الحصول على نوبل للسلام، حيث توجهت إلى العالم اليهودي الأمريكي ألبرت أينشتاين وطلبت دعمه. استجاب أينشتاين وأرسل نسخة من خطاب التوصية الذي كتبه إلى لجنة الجائزة باللغة الألمانية. في الوقت نفسه أوصى آري أروخ، مدير قسم العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية، بعدم ترقية أي مرشح للجائزة، كي يفسح المجال للمنظمة الشبابية، ومع ذلك لم يكن هناك فائز بالجائزة عام 1955. لكن ذلك لم يمنع الإسرائيليين من مواصلة المحاولة، سواءً لفائدتهم أو لغيرهم من حلفائهم، أو من يرون في فوزه داعمًا لهم في مواجهة خصومهم العرب.
محاولة بورقيبة الفاشلة
ربيع العام 1965 كان الرئيس التونسي، الحبيب بورقيبة، الشخص الأكثر شتمًا في الصحف والإذاعات العربية، بعد أن طالب في خطاب ألقاه بمدينة أريحا الفلسطينية بفتح قنوات التفاوض مع «إسرائيل» والاعتراف بوجودها. في المقابل كان الرجل نجمًا في وسائل الإعلام الغربية. يكشف الأرشيف الإسرائيلي الذي رفعت عنه السرية مؤخرًا عن اهتمام إسرائيلي كبير بخطاب الرئيس التونسي، حيث وزعت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية منشورًا داخليًا وجهت فيه البعثات الإسرائيلية نحو الإشارة إلى النقاط الإيجابية في خطاب بورقيبة. ورغم أن الرجل عاد واستدرك في نيسان -خلال خطاب ألقاه في تونس- موضحًا دعوته للاعتراف بأنها قائمة على العودة إلى حدود تقسيم 29 تشرين الثاني 1947؛ أي إخلاء معظم الجليل والمثلث وممر القدس وجزء من النقب ويافا. بالإضافة إلى عودة اللاجئين، إلا أن «إسرائيل» أحجمت عن مهاجمته مكتفيةً بإعلان رئيس الوزراء ليفي أشكول في الكنيست في 17 أيار 1965 أن «إسرائيل» مهتمة بالسلام على أساس حدود هدنة عام 1949 مع تعديلات صغيرة متبادلة، دون القبول بعودة اللاجئين.
ويكشف الأرشيف الإسرائيلي، أن حكومة الكيان قد بلغها في صيف 1965 بأن الحكومة التونسية كانت تحاول حصول بورقيبة على جائزة نوبل للسلام. ورغم أن الخارجية الإسرائيلية قدرت بأنه لا توجد فرصة لذلك، فقد تقرر دعم هذا الاقتراح، بشرط أن يكون بورقيبة على علم بأن «إسرائيل» تدعمه. وهو التوجيه الذي أبرق به شاؤول بار حاييم من قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية عن ذلك إلى السفير الإسرائيلي في ستوكهولم يعقوب شيموني. وفي 12 أيلول أبلغت وزيرة الخارجية غولدا مائير الحكومة عن أنشطة بورقيبة، وأبدت موقفا غامضا تجاهه:
«إنه يريد المضي خطوة بخطوة، خطة 1947، عودة اللاجئين. لكن من ناحية أخرى، لا ينبغي مهاجمة بورقيبة لأن لدي سبب للاعتقاد بأنه لا يفكر في القضاء على دولة «إسرائيل» على مراحل. ولهذا أرسلنا إليه رسولين مباشرة. اتضح أن بورقيبة يعتقد أنه كان ينبغي أن يحصل على جائزة نوبل بوصفها الهدية التي قدمها لدولة «إسرائيل». بدأنا نفكر: ما الذي يهمنا، ربما يكون ذلك ممكنًا، ولكن ليس هناك أمل في ذلك».
ورغبة في تجنيبه الإحراج، تقرر أن يتعامل طرف ثالث مع الأمر. وهكذا، قرر الأستاذ في الجامعة العبرية، ناثان روتنستريتش، بالاشتراك مع سفير «إسرائيل» في واشنطن، أن يكون هذا الطرف رئيس جامعة البرازيل لترشيح بورقيبة للجنة الجائزة. كان واضحًا منذ البداية أن بورقيبة لن يحصل على الجائزة، ولكن كما لاحظ أحد مسؤولي وزارة الخارجية: «من المهم أن نتمكن من لفت انتباه بورقيبة إلى أننا وراء المبادرة». وكما كان متوقعًا في «إسرائيل»، لم يحصل بورقيبة على الجائزة.
أخيرًا شموئيل عجنون
أثمرت مساعي «إسرائيل» للفوز بنوبل أخيرًا في 20 تشرين الأول 1966، عندما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن فوز الكاتب الإسرائيلي من أصول أوكرانية، شموئيل يوسف عجنون بجائزة نوبل للآداب. حاول الكيان التعامل مع هذا الحدث كأداة للدعاية، لاسيما وأن الجائزة التي مُنحت لكاتب في ذلك الوقت كانت تمثلًا انتصارًا للمشروع الصهيوني القائم على اللغة العبرية. في 27 كانون الأول عادا عجنون إلى «إسرائيل» وحظي باستقبال لافت في مطار اللد. وقال في حديث مع الصحفيين إنه تلقى التهاني من كافة شرائح المجتمع باستثناء العرب و«شباب أغودات إسرائيل»، الذراع السياسي لليهودية الأرثوذكسية.[1] يكشف الأرشيف الإسرائيلي أن عجنون كان منزعجًا من أنه رغم التزامه بالوصايا الدينية، فإن الأرثوذكس المتطرفين هم الذين عارضوه. لكن عضو الكنيست إسحاق ليفين، رئيس كتلة «أغودات إسرائيل» في الكنيست، عاد معتذرًا لعجنون، وادعى أن أغودات «إسرائيل» لا تعارضه وطلب الاطلاع على الرسائل التي أرسلها إليه أولئك الذين دخلوا بشكل غير قانوني، يقدمون أنفسهم كأعضاء في أغودات «إسرائيل»، حين رأت الحركة المتطرفة في فوز الكاتب فرصة لها كي تعزز موقعها السياسي والاجتماعي.
ومع أن أدب عجنون، لم يمثل يومًا رمزًا للعالمية التي كانت تطلبها معايير نوبل، حيث كان منغلقًا على الحياة اليومية لليهود الأرثوذكس، ويحتاج قارئه إلى خلفية دينية توراتية متينة كي يفهمه، إلا أن لجنة الجائزة رأت فيه، بفضل الشبكات الضغط اليهودية والدعم الغربي، عالميةً ما. خاصة وأنه تغلب في دورة عام 1966 على كتاب مشهورين مثل غراهام غرين، وصامويل بيكيت، وهنري ميلر وأندريه مالرو وألبرتو مورافيا. ورغم ذلك بقي شموئيل عجنون غير معروف قياسًا لهؤلاء. فهو أحد الفائزين الذين لم تترجم الجائزة بالنسبة لهم إلى شهرة عالمية. حيث ظل إلى حد كبير ملكًا لجمهوره العبري المتدين والأشد تطرفًا حتى قياسًا لبقية سكان الكيان من ذوي الهوية الحداثية.
ويحلل آدم كيرش في دراسة حول أدب عجنون نشرت قبل سنوات في النيويوركر، هذه المفارقة بالقول:
«عندما ذهب إلى ستوكهولم لتسلم جائزة نوبل، أكد حقيقة أن هويته الكتابية كانت، قبل كل شيء، هوية يهودية. ووصف نفسه بأنه من نسل اللاويين، القبيلة الإسرائيلية التي كانت في خدمة الهيكل القديم: في حلم، في رؤيا الليل، رأيت نفسي واقفًا مع أخي اللاوي في الهيكل المقدس، وأغني معهم. أغاني داود ملك «إسرائيل» نغمات لم تسمعها أذن منذ يوم خراب مدينتنا وسبي شعبها». ونتيجة لذلك يتم تقليص أعمال عجنون والكلاسيكيات العبرية الأخرى كل عام من المناهج الدراسية ورفوف الكتب في سلسلة المتاجر. وبعبارة أخرى، لم يعد العديد من الإسرائيليين يتمتعون بالخلفية الدينية اللازمة لفهم كل معاني ما يقوله. ومع ذلك حاولت «إسرائيل» أن تصنع منه دائمًا أيقونة أدبية، شأنه شأن سارتر أو ماركيز، في سبيل صياغة هوية صهيونية. حتى إنه عندما اشتكى إلى البلدية من أن ضجيج حركة المرور بالقرب من منزله يزعج عمله، أغلقت المدينة الشارع أمام السيارات ووضعت لافتة كتب عليها: «ممنوع دخول جميع المركبات، كاتب في العمل».
في عام 2017 نشرت صحيفة هآرتس تقريرًا تحت عنوان «حرب الكلمات: المؤامرات وراء فوز «إسرائيل» بأول جائزة نوبل»، كشفت فيه استنادًا إلى أرشيف جائزة نوبل الذي تمكنت من الاطلاع عليه عن أسرار فوز عجنون بالجائزة. حيث كان عضو اللجنة الذي اقترح عجنون هو إيفيند جونسون، الذي فاز بالجائزة في عام 1974. ومن بين الوثائق التي تضمنها تقرير الجائزة، كانت هناك رسالة توصية من الكاتب السويدي الشهير أرتور لوندكفيست، مخصصة لعجنون. كان لوندكفيست، الذي انضم إلى الأكاديمية السويدية في عام 1968، معروفًا بين الكتاب السويديين باعتباره معجبًا بعجنون: فقد نشر مقالتين في صحيفة ستوكهولم تيدنينجن السويدية استعرض فيهما كتبه التي ظهرت في ترجمات سويدية (في عامي 1963 و1965). بل والتقى بعجنون في منزله بالقدس أثناء زيارته لـ«إسرائيل». بعد هذه الرحلة، نشر لوندكفيست كتابًا بعنوان «الحلم في يدك: رحلة إلى «إسرائيل»»، خصص فيه فصلًا كاملًا عن انطباعاته بعد اللقاء مع عجنون.
تقاسم عجنون الجائزة مع الكاتبة اليهودية السويدية نيلي زاكس. يعلق رئيس اللجنة أندريس أوسترلينغ قائلًا: «إن الاقتراح هو تقسيم الجائزة بين كاتبين من خلفيات لغوية مختلفة مدمجة في أخوة روحية تحمل معها رسالة «إسرائيل» في الأدب الحديث». وأشار، بشكل غير متوقع، إلى أنه «إذا كان منح الجائزة لهما يعتبر بادرة تجاه الصهيونية وإيقاظ تعليقات ذات طابع سياسي، فإن الأكاديمية تستطيع الدفاع عن قرارها والإشارة إلى القيمة الإنسانية فيه».
بيريز، حمامة السلام!
بعد مسارٍ سري ومتشعب، ظهر رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، مصافحًا رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، في حديقة البيت الأبيض في 13 أيلول 1993، فيما ظنه الجميع نهاية صراع طويل بين العرب واليهود. كان واضحًا أن نوبل للسلام عام 1994 ستذهب مناصفة بين الرجلين. لكن غير المُفسر هو لماذا شاركهما وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيريز فيها.
في اليوم نفسه لإعلان اللجنة عن الفائزين الثلاثة، انتهت محاولة القوات المسلحة الإسرائيلية لإنقاذ جندي مخطوف من أيدي خاطفيه الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمقتل الأسير وثلاثة من خاطفيه وأسرتهم. وبعد ساعاتٍ من الإعلان ظهر أحد أعضاء لجنة جائزة نوبل، وهو كاري كريستيانسن، شاهرًا استقالته من اللجنة، قائلًا إن زملاءه اختاروا الرجل الخطأ مشيرًا إلى عرفات الذي وصفه بأنه «ملوث بالعنف والإرهاب والتعذيب». كريستيانسن (1920-2005) أحد قادة حزب الشعب المسيحي النرويجي، والوزير السابق، كان يعتبر أحد أكبر أصدقاء «إسرائيل» في بلاده. لذلك لم يكلّ يومًا حتى وفاته، عام 2005، من مناشدة لجنة الجائزة بسحبها من عرفات أو إعلان اعتذارها عما فعلته عام 1994. في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى خريف عام 2000، أعاد طرح طلبه بضرورة سحب الجائزة من أبو عمار، لكنه أدرك أن ذلك مستحيل بما أن مؤسسها ألفريد نوبل جعل هذا الأمر ممنوعًا في ميثاقها، فإن كل ما تبقى له هو مطالبة اللجنة بالتعبير عن أسفها.
تثير جوائز نوبل الجدل بلا توقف، لا سيما في فرعي السلام والأدب. ورغم ما يشاع عن الجائزة من أنها جزء من السلطة الثقافية الغربية المهيمنة، وذات انحيازات سياسية واضحة، إلا أنها تبقى الجائزة الأكثر تأثيرًا في العالم.
حقد كريستيانسن المحموم على عرفات سيثمر لاحقًا من حيث لا يدري عن فضيحة ستهزّ مصداقية الجائزة العالمية. في عام 2002، زار ممثل الأمم المتحدة تيري رود لارسن ما تبقى من مخيم جنين، في أعقاب المجزرة الإسرائيلية، منتقدًا سلوك «إسرائيل» الهمجي. وعندما انتشرت صور لارسن وهو يقف وسط أنقاض مخيم اللاجئين في جميع أنحاء العالم، شرعت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطة لضرب شرعيته ومصداقيته. من الباب الخلفي وصلت وكالة أنباء الموارد الإسرائيلية، لمالكها الكاتب ديفيد بيدين، سجلات لمركز بيريز للسلام تفيد بأن المركز قدم لتيري رود لارسن وزوجته منى جول (سفيرة النرويج في «إسرائيل») مكافأة قدرها 100 ألف دولار، قبل أن يتم تعيين لارسن كمنسق خاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بدايةً من عام 1999.
طار بيدين إلى أوسلو وسلمّ كريستيانسن الوثائق، التي طاف بها وسائل الإعلام النرويجية، كاشفًا عن أن بيريز وعد بدفع أجر لارسن من أجل ضمان تقاسم جائزة نوبل للسلام مع رئيس الوزراء رابين. حيث كان لارسن ضمن الفريق النرويجي الذي يرعى المفاوضات السرية بين منظمة التحرير وحكومة الكيان قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو، بوصفه أحد كبار الدبلوماسيين النرويجيين وله تأثير على منح الجائزة. ذلك أن النرويج لها الحق الحصري في منح جائزة فرع السلام، فيما تقرر السويد مصير بقية الفروع.
وتفاقمت المشكلة عندما تم الكشف عن أنه بعد وقت قصير من منح الجائزة، قامت وزارة الخارجية النرويجية بدفع مبلغ كبير لمؤسسة بيريز للسلام. ولم يتوقف تضارب المصالح عند هذا الحد، بل عيّن وزير الخارجية السابق، ثوربيورن ياغلاند، زوجة لارسن، منى جول، سفيرةً في تل أبيب، وأصبح هو الآخر بعد خروجه من الوزارة عضوًا في مجلس إدارة مركز بيريز.
لكن بيريز ورغم لعبه الخفي في كواليس الجائزة بالمال والأصدقاء والمصالح، لم يكذبّ خبرًا، حيث نزع عنه ثوب قناع السلام بعد بضعة شهور من فوزه بالجائزة مسددًا قذائف جيشه نحو مركز قيادة قوات الأمم المتحدة في قرية قانا جنوب لبنان، حيث تحصن أكثر من 100 طفل وامرأة من القصف، لكن رايات قوات السلام الزرقاء لم تعصم دمائهم من الموت.
-
الهوامش[1] معاريف، 28 كانون الأول 1966.