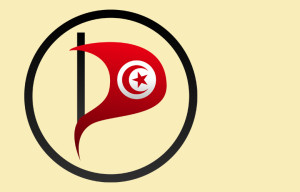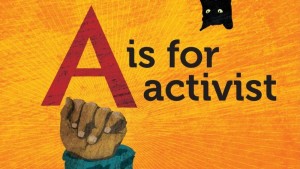هذا المقال هو جزء من كتاب: “لعنة الألفيّة: لماذا يفشل النشاط التغييري”. يمكن قراءة السلسلة الكاملة على هذا الرابط: لعنة الألفية
بقلم طوني صغبيني (مدونة نينار)
انتفاضات العام 2011 وما بعده تم تمجيدها من قبل العديدين بسبب طبيعتها اللابنيوية المتمثلة بغياب التنظيم، غياب القادة، وغياب البرامج والرؤى. تم اعتبار اللابنيوية على أنها الظاهرة الأكثر تعبيراً عن كون الانتفاضات “من الشعب” – وبالتالي تم الافتراض بأن نتيجتها ستكون بالتأكيد “من أجل الشعب”. لكن القليلين انتبهوا إلى أن اللابنيوية كانت في الواقع إحدى نقاط الخلل الكبرى التي أدت إلى فشل معظم الانتفاضات. اللابنيوية عرقلت معظم الثورات في العالم العربي خلال العامين الماضيين من تحقيق أهدافها، عجّلت نهاية حركات شعبية أخرى مثل احتلوا وول ستريت في الولايات المتحدة، وسمحت للسلطات وبقية الأحزاب السياسية المنظّمة بالاستيلاء على الثورات وأخذها في الاتجاه المعاكس لهدفها.
في العالم العربي، جميع الانتفاضات اللابنيوية تقريباً انتهت بتعبيد الطريق للإسلاميين المنظّمين للإستيلاء على الحكم منذ أولى لحظات انهيار الأنظمة القديمة. لسخرية القدر، الرابحون الوحيدون من الانتفاضات اللابنوية كانوا القوى السياسية البنيوية والمنظّمة.
رغم ذلك، قامت العديد من حركات الألفية وناشطيها – وخصوصاً في صفوف التيار اللاسلطوي – باستنتاج درس معاكس من انتفاضات عام 2011 الفاشلة. الهبات الشعبية “العفوية” يتم تمجيدها على أنها الشكل النموذجي الجديد لثورات القرن الواحد والعشرين فيما تعامل أمور كالبنية والتنظيم على أنها مرادفة للقمع، السلطوية، البيروقراطية، انعدام المساواة وكل الكلمات السيئة الأخرى.
اللابنيوية على الجهة الأخرى يتم تقديمها على أنها مرادف للحرية، الفردانية، الفعاليّة، وكل الأمور الجيّدة. التيارات الأنركية والنسوية الحالية هي معادية بشكل خاص للبنيوية والتنظيم وتدعو عادة إلى لابنيوية تامّة وغياب كامل للقادة.
لكن الواقع يقول أن اللابنيوية تحقّق دوماً عكس الهدف الذي تبغاه. كما لاحظت المؤلفة والناشطة النسوية جو فريمان في السبعينات:
“لا يوجد شيء اسمه مجموعة من دون بنية. أي مجموعة من الناس من أية طبيعة كانت تأتي سوية لفترة من الوقت لتحقيق هدف ما ستقوم في النهاية المطاف بتنظيم نفسها بطريقة ما”[1].
فريمان تصف شوائب اللابنيوية بكلمات دقيقة:
“فكرة اللابنيوية تصبح ستاراً للأقوياء أو المحظوظين لإحكام السيطرة المطلقة على الآخرين. وهذه الهيمنة يمكن تحقيقها بسهولة لأن فكرة اللابنيوية لا تمنع قيام البُنى غير الرسمية، بل تمنع فقط قيام البُنى الرسمية. وبالتالي تصبح اللابنيوية أسلوب لتمويه وجود السلطة، وداخل حركة النساء، اللابنيوية مدعومة عادة بقوّة من اللواتي يمتلكن أكبر قدر من السلطة”.
هذا يحصل لأن المجموعات التي تقبض على السلطة في الحركات اللابنيوية لا يمكن إقصائها ولا محاسبتها على القرارات التي تأخذها باسم المجموعة الأوسع.
إلى ذلك، اللابنيوية لا تنجح لأنها تقوّي بُنى الامتياز والسلطة غير الرسمية ولأنها تجعل أيضاً من التخطيط الاستراتيجي والتطبيق المنظم للاستراتيجية عمليّة مستحيلة. لقد تم لفت النظر من قبل العديد من الناشطين في العالم العربي إلى أن اللابنيوية جعلت العناصر العلمانية، اليسارية والليبرالية التي أطلقت الثورات، في موقع ضعيف مقابل الحركات الإسلامية المنظّمة والرؤيوية التي استطاعت استلام السلطات ما أن هدأ غبار الثورات. الأمر نفسه لوحظ من قبل بعض المؤلفين والناشطين الغربيين على أنه السبب الذي أدى إلى تضاؤل واختفاء حركة احتلوا وول ستريت من دون تحقيق أي نتيجة.
مدير التحرير في المجلة اليسارية الأميركية “ديسينت”، مايكل كازين، أشار إلى أن “المجال المفتوح لهذه الحركة التي يغيب عنها القادة هو بحد ذاته ما جعل من الصعب المحافظة عليها. من دون بنية، من شبه المستحيل الخروج باستراتيجية للحركة، والقرارات التكتيكية يمكن بسهولة أن يتم تطبيقها بشكل خاطىء”[2].
فريمان أيضاً تحدثت عن عدم قدرة اللابنيوية على الخروج باستراتيجيات فعّالة:
“كلما كانت حركة ما لابنيوية، كلما كان لديها تحكّم أقل بالاتجاه الذي تأخذه وبالتحرّكات السياسية التي تشارك فيها… إن كان هنالك اهتمام من الإعلام والظروف الاجتماعية المناسبة، سيتم انتشار أفكار الحركة بشكل واسع. لكن انتشار الأفكار لا يعني تطبيقها؛ إنه يعني فقط أن هذه الأفكار موجودة في النقاشات. إن كانت الأفكار يمكن تطبيقها على الصعيد الفردي، يكون بالإمكان تطبيقها؛ لكن حين يتعلّق الأمر بالحاجة لجهود سياسية منظّمة لتطبيقها على مستوى واسع، لن يتم تطبيقها”[3].
اللابنيوية لم تنجوا حتى من انتقادات بعض الناشطين والمدوّنين الأنركيين اللاسلطويين الذين انتقدوا الطبيعة المفتوحة للحركة واعتبروها نقطة ضعفها الرئيسية. في تقييم لما حدث لحركة احتلوا وول ستريت بعد عام واحد عليها، المدوّن الأنركي “كولين أو” استنتج أنه “لا يبدو أن أي من المجموعات المختلفة لحركة احتلوا أنشأت منظمات مستدامة قادرة على الاستمرار بمقاومة البنى التي تسبب التفاوت الاجتماعي التي برزت حركة احتلوا لمحاربتها في الأساس. لذلك وفيما قد نكون ألهمنا أنفسنا، وهذا أمر مهم، لا يبدو أننا انتشرنا أكثرنا بتنظيمنا أو اكتسبنا المزيد من القوّة الجماعيّة”[4].
هذا التحليل يتناغم مع عودة الاهتمام بإعادة النظر في أساليب التنظيم اللاسلطوية بعد عداء أنركي مزمن تجاه التنظيم الواسع. العديد من المجموعات الأنركية في المتوسّط على سبيل المثال كانت تحاول في وقت كتابة النصّ خلق شبكات أوسع أكثر تنظيماً. وفي الوقت الذي كُتب فيه هذا الفصل، كانت العديد من المجموعات الأنركية الأميركية تعيد النظر بموقفها من التنظيم وبعضها يعمل على إنشاء منظّمة أميركيّة موحّدة تمتلك مراكز تنسيق مركزيّة.
في مقال بعنوان “تنظيم وطني للأنركيين الثوريين في الولايات المتحدة؟”، تعدّد مجموعة روشستر الأنركية أسباب إقامة منظّمة أنركية موحدة وهي أن هكذا منظمة تمتلك قدرات أكبر في مجال البروباغاندا الجماهيرية، تستطيع تحقيق تضامن سياسي أوسع وأقوى، وتسهّل بناء وتوسيع الفروع المحلّية، وتفتح المجال أمام مستويات مختلفة من الانخراط في العمل العام أمام الناس، وتردم الانقسام المديني – الريفي في أوساط الناشطين، ويكون لديها القدرة على القيام بتعبئة شعبية أوسع ويكون بمتناولها موارد أكثر، وكنتيجة يكون لديها تأثير أكبر على السياسات العامة على المستوى الوطني[5].
رغم هذه الملاحظات، يبدو أن الانبهار باللابنيوية هو ظاهرة قوية جداً في صفوف النشاط التغييري الألفي، وذلك يغذّي مجموعة من الافتراضات التي تؤثر بشكل عميق على أسلوب تنظيم أنفسنا اليوم. لنلقِ نظرة على ثلاث منها:
الافتراض الخاطىء الأول: الشبكة الواسعة هي أفضل من الحركة المنظّمة
الشبكات هي مكوّنة عادة من عدد كبير من الأفراد الذي يمتلكون فيما بينهم صلات ضعيفة، من دون قيادة مركزية تستطيع حسم القرارات أو وضع الاستراتيجيات. هذا يجعل الشبكة أكثر انفتاحاً تجاه انخراط الجميع في نشاطها، وتستطيع الوصول إلى عدد كبير من الناس بسهولة، ما يجعلها فعّالة في الظروف التي لا تتطلّب نشاطات ذات مخاطر عالية كنشاطات بناء الوعي، توقيع العرائض، والقيام بتظاهرة أو اعتصام.
لكن الصفات نفسها التي تعطي أسلوب الشبكة قوته تجعلها غير فعّالة في وضع وتطبيق استراتيجيات بعيدة الأمد أو الاضطلاع بنشاطات دقيقة فيها مخاطر عالية. المؤلف مالكوم غلادويل يشير إلى أن:
“الشبكات لا تستطيع التفكير استراتيجياً؛ هي معرّضة بشكل دائم للنزاعات والخطأ. كيف يمكنك اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلّق بالاتجاه الفكري أو الاستراتيجي حين يكون الجميع لديهم صوت متساوٍ؟”[6].
غلادويل يعدّد في ذات المقالة كيف أن مقاطعة باصات مونتغمري والحركة المدنية الأميركية في الستينات في الولايات المتحدة نجحت في إعطاء السود حقوقهم لأنها ارتكزت على أشكال مركزية من التنظيم “كانت تشدّد على الانضباط والاستراتيجيّة”.
الافتراض الخاطىء الثاني: لا يمكن الثقة بالقادة ويجب رفض أي نوع من القيادة
بقدر ما هو التنافس على البروز الفردي قوي في أوساط الناشطين العصريين، بقدر ما يوجد هنالك عداء حاد تجاه القيادة وتجاه القادة المحتملين في أوساطهم. مجتمع الناشطين في كل مكان ممتلىء بشكل مستمر بخوف صريح أو ضمني من أن يكون هنالك قادة، رغم أنه هنالك عدد غير مسبوق من الناس يتنافسون على أدوار القيادة.
مسابقة البروز يمكن أن تكون إحدى العوامل التي تغذّي العداء تجاه القبول بأي نوع من القيادة من أي شخص آخر. الثقافة الفردانيّة الشديدة التي يتميّز بها أبناء جيلنا الشاب بالإضافة إلى الأمثلة التي لا تحصى عن سوء استخدام القادة لمنصابهم وسلطتهم، هي أيضاً عوامل أخرى تغذّي الظاهرة.
غياب الثقة في فكرة القيادة تجد تعبيراً لها في العداء الشديد تجاه المنظّمات التي تمتلك قادة واضحين وتجاه الأشخاص الذين يقدّمون أنفسهم كقادة أو يكتسبون سلطة القادة خلال حدث ما. أي منظّمة تمتلك قيادة واضحة يتم اتهامها في أوساط الناشطين الألفيين أنها “طائفة عبادة شخص”، رغم أن الواقع يقول أنها وحدها المنظمات التي امتلكت قيادة جيدة حقّقت نتائج في التاريخ.
هذا العداء تجاه القيادة يعرقل قدرة الأوساط الناشطة على تغذية وإنشاء قادة حقيقيّين، وهي تحرم حركات المقاومة من إحدى الأدوات الرئيسية الضرورية لنجاحها. المنظومة العالمية المهيمنة تواجهنا بقادة متشدّدين مدربّين ومتلزمين بقضيتهم، كالوزراء وموظفي الدولة ومدراء الشركات ورجال الدين، الذين يمتلك كل منهم دعم مؤسسات منظّمة ومنضبطة، فيما نحن نخوض حروباً داخلية طاحنة لإلغاء ظهور أي قياديين حقيقيين في صفوف حركاتنا.
إن كنّا نريد أن نصل إلى المستوى التالي في معركتنا مع السيستيم، علينا أن نتغلّب على خوفنا من أن يكون هنالك قادة: نحن نحتاج لمنظّمين ورؤيويين ومحرّضين وأشخاص ماهرون في خلق وإدارة الطاقة والموارد التي نحتاجها لتحقيق أهدافنا.
الافتراض الخاطىء الثالث: أفضل طريقة لاتخاذ القرارات في الحركة هي عبر الإجماع
تبجيل شكل اتخاذ القرارات عبر الإجماع على أنه الشكل الأفضل لصناعة القرار في حركات التغيير هو الوجه الآخر لرفض القادة وتفضيل الشبكات غير المنظّمة.
معظم المجموعات الأنركية والنسوية تستخدمه، ولقد تم استخدامه بكثافة في الانتفاضات الشعبية في العام 2011. واستُخدم حتى في منظّمات أكثر جذرية مثل Earth First! (الأرض أولاً) وجبهة تحرير الأرض ELF.
العالم الأنتروبولوجي والناشط الأنركي الأميركي المعروف ديفيد غرايبر يشرح صناعة القرار بالإجماع التي تتبعها المجموعات اللاسلطوية كما يلي:
“الفكرة الأساسية للإجماع هي أنه بدل التصويت، عليك أن تخرج باقتراحات مقبولة من الجميع – أو على الأقل اقتراحات لا يعترض عليها أحد بشدّة. تقوم أولاً بإعلان الاقتراح ثم تسأل عن الهواجس وتحاول أن تجيب عليهم. غالباً، في هذه النقطة، سيستجيب الناس عبر إضافة تعديلات طفيفة وإيجابية على الاقتراح الأساسي، أو تعديله، للاستجابة للهواجس التي يطرحها المعترضون. وفي النهاية، حين تطلب الإجماع، تسأل إن كان هنالك أحد يريد إيقاف الاقتراح أو التنحّي. التنحّي يعني أنك تقول أنني لا أوافق شخصياً على المشاركة في هذا النشاط، لكني لن أوقف الآخرين من ذلك. أما إيقاف الاقتراح فهو طريقة القول بأنني اعتقد أن هذا الاقتراح يخرق المبادىء الأساسية التي تقوم عليها المجوعة أو هدفها، وهو يعمل كفيتو: يمكن لشخص واحد أن يوقف أي اقتراح بشكل كامل”[7].
شوائب هكذا شكل لصناعة القرار هي واضحة: الإجماع يمكن أن يعمل في مجموعات صغيرة تمتلك أهداف واسعة وعلاقات شخصية جيدة في وسطها، لكنه مرهق وغير فعّال حين يكون الهدف هو وضع خطط طويلة الأمد واستراتيجيات لمنظمّات كبيرة. القرارات والاستراتيجيات التي تُصنع بالاجماع تكون عادة الاقتراح ذات السقف الأدنى الذي يناسب جميع الحاضرين، وعادة ما يعني ذلك أن الاستراتيجية أو النشاط النهائي الذي يتم إقراره هو عملياً لاشيء.
إلى ذلك، من الصعب جداً تحقيق الإجماع ضمن مجموعات كبيرة من الناس كما أن هذه الطريقة بصناعة القرار لا تضمن بأن جميع الناس يشاركون في صناعته حقاً. ففي معظم الحالات، هنالك أقلية من الأفراد الأكثر تحدثاً أو الأعلى صوتاً أو الأكثر حضوراً في الاجتماعات هي التي تحدّد فعلياً القرارات للمجموعة. من شبه المستحيل أيضاً دراسة وإقرار الاستراتيجيات الدقيقة للقيام بتحرّكات ذات مخاطر عالية لمنظمات كبيرة عبر أسلوب الإجماع.
محاسبة القادة هي أيضاً مسألة صعبة جداً في ظلّ الإجماع؛ فإن كانت المجموعة ككل هي المسؤولة عن كل القرارات، من ستتم محاسبته إذاً وأمام من إن حصل خطأ ما؟ وماذا يبقى من مبدأ المحاسبة حتى في هكذا حالة؟
*
(الحلقة القادمة في السلسلة: معضلات انتظار القيامة الجماهيرية والرهان على الحلول الفردية)