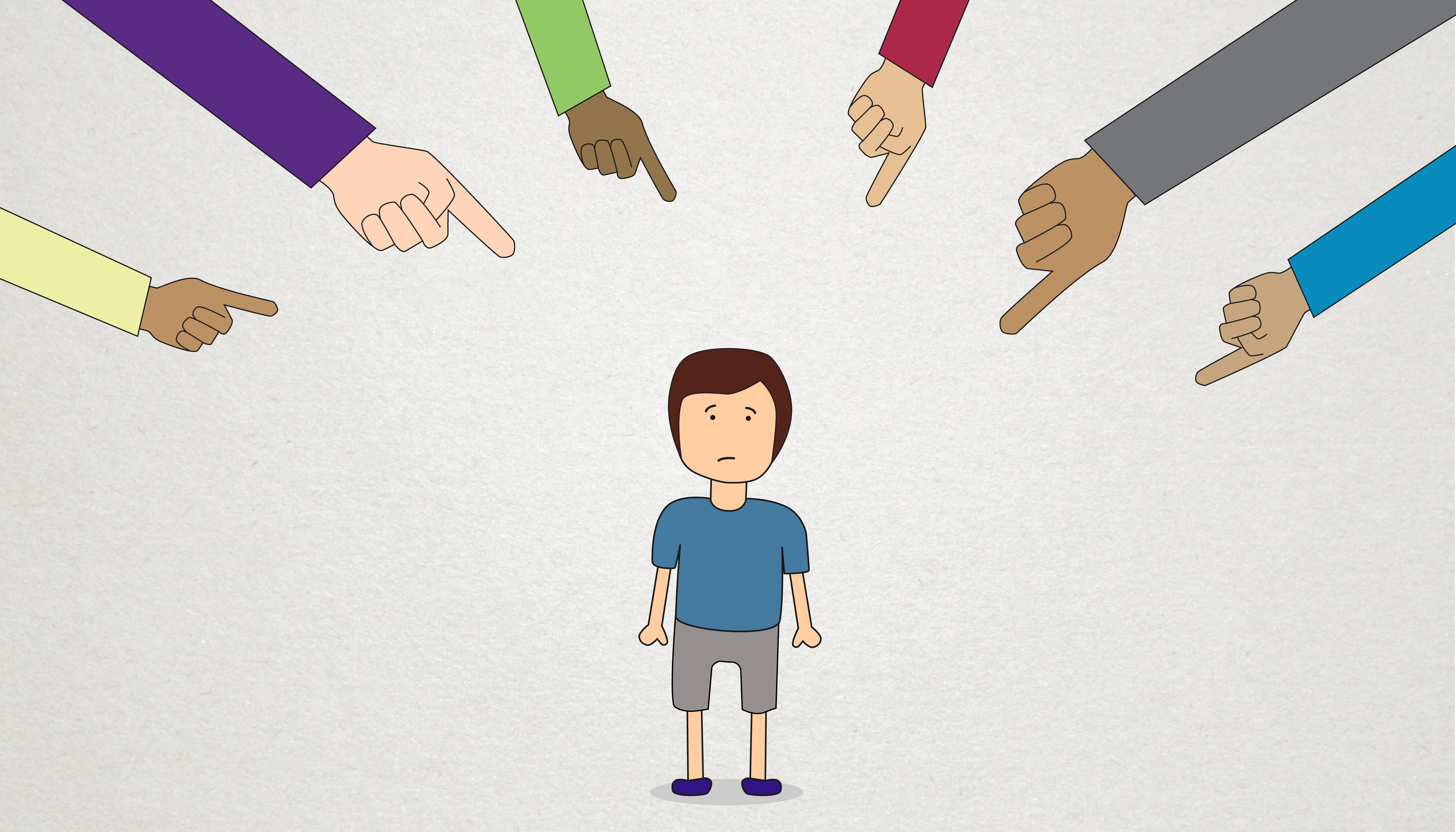قد يكون وزنه زائدًا، لديه إعاقة، أو يرتدي نظارة سميكة. هذه بعض الأسباب التي تجعل من طفل ما هدفًا للتنمر في مدرسته. وفي جميعها، سيحظى الطفل بدعم وتعاطف الأهل والمعلمين معه. لكن هناك حالة محددة، لا يجد فيها الطفل، في أحيان كثيرة، هذا التعاطف من عالم الكبار: إنه الولد الذي يُبدي اهتمامات، ويسلكُ بطريقةٍ، تصنف وفق المعايير الاجتماعية السائدة «أنثوية».
في مجتمع صارم في تحديده ملامح الهوية الجندرية، وفي توقعاته أن ينسجم الذكور والإناث، كلٌّ مع معايير هويته المحددة، يجد الفرد الذي يميل إلى السلوك خارج هذا التقسيم نفسه موضع إدانة، حتى لو كان هذا الفرد ولدٌ في التاسعة من عمره، صُنّف في المدرسة والحارة، والبيت، بأنه «بنوتة»، واختَبر، بسبب ذلك، أقسى ما يمكن لطفل في عمره أن يختبره: الدعس على الرأس، الأمر الذي حدث لمروان*.
عمْر مروان الآن 25 سنة. لكنه ما يزال يستحضر بمرارة كبيرة، المرتين اللتين أُلقي فيهما أرضًا، ووضع ولدٌ قدمه على رأسه. وهذا واحد فقط من ذكرياته عن تنمر الأطفال الآخرين عليه في المدرسة والحارة، وتشبيههم المستمر له بالبنات، لأنه كان يميل دائمًا للعب معهن وبألعابهن، ويكوّن معظم صداقاته معهن. في وقت كان ينفر فيه بشدة من الألعاب الخشنة، خصوصًا كرة القدم.
يتذكر مروان أن التنمر عليه بدأ في الصف الرابع. ورغم أن انسجامه مع عالم البنات بدأ منذ بداية وعيه على العالم، وكان يتعرض لتعليقات بسبب ذلك، لكنها كانت تعليقات عابرة، فقبل هذه السن كان من المألوف، كما يقول، أن يلعب الأولاد مع البنات. لكن: «بس نكبر بصير فصل. والبنات خلص بروحوا».
بعد هذه المرحلة، بدأت التعليقات العابرة تتحول إلى عنف لفظي واضح ومستمر، واعتداءات جسدية. ومن الأوصاف التي بدأ يسمعها، «ناعم»، و«بنوتة»، و«طنط مركّب جنط»، و«إزلم».
«وبحسسني (التعليق العدائي) بشعور كره للمجتمع. مع إني عارف إنه الحق مش على حدا. الحق على البنية كلها»
هذا السلوك ضده ليس استثنائيًّا، فالمجتمع قرر، كما تقول الباحثة والعاملة في مجال الطفولة، ليلى عبد المجيد، ملامح محددة للهوية الجندرية، لكل من الذكور والإناث منذ طفولتهم المبكرة، وحدد لكل منهما اهتمامات، وطريقة سلوك، ومظهر. حدد للبنات الدمى وألعاب المطبخ والألوان الزاهية، وللأولاد الركض، وكرة القدم. وفي اللحظة التي يقرر فيها أحد اجتياز الحدود، باتجاه الفريق الآخر، فإنه مباشرة يوصم، ويبدأ التنمر عليه. يحدث هذا للذكور، أكثر بكثير من الإناث كما تقول عبد المجيد،: «إذا ولد بحب يلعب بألعاب البنات، ويمشط شعرهم، أكيد بكون عليه تعليقات أكثر بكثير من بنت بتلعب كرة قدم». وتفسير ذلك، بحسبها، هو الربط الاجتماعي التقليدي للأنوثة بالضعف، والذكورة بالصلابة. أي أن سلوك الولد بطريقة تصنف تقليديا بأنها أنثوية يعني أنه ضعيف. وهذا ما يعرّضه للسخرية والإيذاء أكثر.
حوّل التنمر حياة مروان في المدرسة إلى عذاب يومي، يبدأ من لحظة ذهابه إلى النوم: «لمّا كنت بدّي أنام، بصير أفكر إيش رح يصير باليوم التاني، إيش المصيبة اللي جاييتني؟ كيف بدّي أقضي الفرصة بهذا اليوم؟». وعندما يستيقظ صباحًا: «يا إمّا بتذكر اللي صار باليوم اللي قبليه، أو لازم أتوقع السيناريو اللي بدّي أعمله، أي موقع لازم أروحه».
أصعب أجزاء يومه الدراسي، كانت الأوقات التي من المفترض أنها الأسعد لأي تلميذ: الأوقات الحُرة في باص المدرسة، وحصص الرياضة، والاستراحات، فهي الأوقات التي يكون فيها تنمر الأولاد على أشدّه. لم يكن يستطيع تفاديهم، في باص المدرسة، حيث كانوا يسخرون منه، وينادونه «سمكة»، ولا في حصص الرياضة، عندما لم يكن يستطيع مجاراتهم في الألعاب، ما يعرضه إلى تعنيف معلم الرياضة، والذي يثير سخريتهم من جديد. لكنه كان يستطيع التواري عن الأنظار في الفرصة، فكان يبقى في الصف. وعندما تكتشفه المعلمات، ويخرجنه عنوة لأنه ممنوع على التلاميذ البقاء في الصفوف في الاستراحات، كان يذهب إلى أماكن منزوية ليجلس فيها إلى حين انتهاء الاستراحة.
يبدأ الأطفال ما بين السنتين والثلاث بإدراك هوياتهم الجنسية، كما تقول أخصائية الطفولة والإرشاد الوالديّ، سيرسا قورشة، فيعرف الطفل في هذه السن أن هناك ذكورًا وإناثًا. ويعرف إلى أي جنس ينتمي. أما الوعي بالهوية الجندرية، وهي المرتبطة بتوقعات المجتمع من كل جنس في ما يتعلق بدوره وسلوكه، فإنه يتأخر إلى ما بين الخامسة والسادسة. وفي هذه السن، وما بعدها بقليل، يبدأ الأطفال باستيعاب ما هو متوقع منهم بحسب جنسهم، والتصرف على أساسه. ويبدؤون، أيضًا، بتمييز الطفل المختلف عنهم، أي الطفل الذي لا يسلك بحسب التقسيم التقليدي لأدوار الذكور والإناث، ويوصف عادة بأنه «دلّوع». وفي هذه المرحلة يبدأ التنمر على هؤلاء الأولاد.
المشكلة، وفق قورشة، هي أن التنمر، لا يكون فقط في المدرسة والحارة، بل في البيت أيضّا. فرغم أن هناك أهال يتعاملون بتفهّم مع أبنائهم، إلا أن الاتجاه الغالب في المجتمع، بحسبها، هو أن هؤلاء الأولاد يتعرضون لعدم التقبل من عائلاتهم نفسها. الأمر الذي يجعلهم يتجنبون الشكوى لأهاليهم، خوفًا من المزيد من اللوم.
وهذا ما حدث مع مروان الذي لم يخبر عائلته. وإلى الآن، لا يعرف والداه عن ذلك، رغم أن أخته الأصغر منه بأربع سنوات، كانت طالبة معه في المدرسة نفسها، ذلك أن محاولاته التواري عن الأنظار في المدرسة، كانت تشمل أيضًا، تفادي أخته: «كنت أتفادى وين هي تكون عشان ما تشوف ناس عم يتخوتوا عليّ (…) ما كنت عارف شو رح تنظر إلي بأي نظرة، شو الفكرة اللي رح تاخدها عني. ولإني كنت كمان خايف يوصل لأهلي».
أحمد* (11 سنة) أخفى أيضًا تنمر الأولاد عليه عن أهله، وعندما اكتشفوا ذلك، بدأ يحكي لهم قصصًا عن دفاعه عن نفسه، وضربه الأولاد الذين يتنمرون عليه. وهي قصص اتضح في ما بعد أنها مختلقة، كما تقول أمه.
يتسم أحمد، كما تقول والدته، بشخصية شديدة المسالمة والهدوء. لم يمل قط إلى الأنشطة الرياضية، ولا إلى أي نشاط حركي فيه خشونة، بل مال دائمًا إلى القراءة، والفنون اليدوية والزراعة. وهو بشكل دائم محلّ مقارنة، من قبل المحيطين، مع أخيه الأصغر، الـ«الشقي كثير. وما بوقّف نطّ، وما بوقّف شقلبة». وهي مقارنة، ليست في صالح أحمد، فالـ«الصغير الشقي كتير، بنظر المجتمع، هو صبي، ما شاء الله صبي، رح يطلع شبّ. والهادئ ورايق، اللي بحبّ يحلّ الأمور بعقلانية، بالنسبة للمجتمع: ليش هيك إنت هادئ، كإنك البنت المستحية؟».
بدأ التنمر على أحمد قبل ثلاث سنوات تقريبًا، عندما بدأ ينعزل في غرفته، ويبكي طوال الوقت. ثم أعلن مرة أنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة. وكانت ردّة فعل والده هي لوم أمه لإصرارها على إرساله إلى مدرسة «إنترناشونال». فهذا برأيه ما جعله «مدلل ومدلّع». أبوه كان يريد إرساله إلى مدرسة حكومية: «لأنه هناك الشباب بِشدّوا عليه، وبصير رجّال، بصير خشن».
تقول أم أحمد إن هذا الخطاب هو الذي دفع أحمد لإخفاء الأمر عنهم، فإضافة إلى تهديد الأولاد له في حال أخبر أحدًا باعتدائهم عليه، وهو تهديد نفذوه فعلًا، عندما تجرأ مرة واشتكى للمعلمة، فكان عقابه أن تجمعوا عليه في الحمام، وطرحوه أرضًا، إضافة إلى ذلك، كان هناك الخوف من ردّة فعل والده: «طول الوقت أبوه بشحنه شحن: بدّي ياك تكون قوي. إوعى تخلي حدا يقرّب عليك. إنت قوي إوعى تعيط (…) تخيل إنه إذا إجى وقاللنا إنه هو انضرب، إنه هذا رح يخلي أبوه يستعرّ فيه». وهذا ما جعله عندما عاد إلى الصف، بملابس مبللة بمياه أرض الحمام، لا يخبرُ المعلمة عمّا حدث «لإنه خاف تكون ردة فعل المدرّسة زي ردة فعل أبوه بالبيت».
تقول أم أحمد إنها ووالده قررا أن يجعلاه يتصرف بنفسه، ويشكو لإدارة المدرسة، التي وجهت إنذارات إلى هؤلاء الأولاد، ونقلت بعضهم من صفه، ومع ذلك، لم ينته التنمر تمامًا، فابنها ما زال يتعرّض لمضايقات. لكنه الآن يعود ويقول لوالده: «أنا ضربتهم لمّا ضربوني. لمّا بطحوني بأرض الحمام، أنا دبحتهم». الأمر، الذي تقول أم أحمد إنه مختلق بالكامل. وباعتقادها هو يفعل ذلك كي لا يخيّب أمل والده فيه.
التقسيم التقليدي لما هو ذكوري وما هو أنثوي في ما يتعلّق بالسلوك والاهتمامات، ليس صحيحًا.
تلفت قورشة، التي تعمل في مجال إرشاد الأهل، إلى القلق البالغ الذي يعيشه أهلٌ لديهم ابن يسلك بطريقة يصنّفها المجتمع أنثوية. وتروي عن ردة الفعل العنيفة التي تواجهها من قبل الأهل، الآباء بالتحديد، في كل مرة تقترح فيها، مثلا، لعلاج غيرة طفل من مولود جديد، أن يجلب الأهل للولد دمية يعتني بها، كما تعتني والدته بالطفل الجديد. تحذّر قورشة من ترك الولد يواجه التنمر وحيدًا. فهذه التجربة هي صدمة له، تعرضه للكثير من المشاكل النفسية والسلوكية. ودور الأهل هو حمايته بمساندته، والحديث معه، والسماع منه. والأهم عدم لومه، بل إفهامه أن دعمهم له غير مشروط.
لكن ما يحدث، في كثير من الأحيان، هو أن الولد يُترك وحيدًا؛ ذلك أن الجهات التي يمكن أن يلجأ إليها، ترسل إليه رسالة بعدم التقبل. يحدث هذا في البيت وفي المدرسة. وجزء من هذا الرفض، كما تقول الباحثة ليلى عبد المجيد، سببه هو أن هؤلاء الأطفال مختلفون عن السائد في ثقافة لا تتقبل كثيرًا مبدأ الاختلاف. تلفت عبد المجيد إلى أن التقسيم التقليدي لما هو ذكوري وما هو أنثوي في ما يتعلّق بالسلوك والاهتمامات، وافتراض أن هناك ما هو حصرًا للذكور، وما هو حصرًا للإناث، ليس صحيحًا. ورغبة طفل في أن يفعل أشياء ما يزال يراها المجتمع خاصةً بجنس معين، يجب أن يقُبل بوصفه جزءًا من التنوع الذي يغني الحياة.
بسبب الاعتبار الكبير الذي يقيمه المجتمع لمطابقة الهوية الجندرية مع الجنس، والضغط الكبير الذي يضعه الأهل على الطفل، تبعًا لذلك، فإن هذا يجعله يُختزل في جانب واحد من شخصيته، هو هويته الجندرية، وتُهمّش أبعادها الأخرى: «هويته، تركيبة شخصيته، كثير أكبر من إنه هو دلوع ولّا نعوم ولّا بنوتة، ولّا أكثر ذكوري».
يقول مروان إنه احتاج إلى سنوات كي يفهم اختلافه ويتقبله. وكي ينتقل من لوم النفس، والرغبة الشديدة في التغير ليرضي الآخرين، إلى تقبل ذلك الجانب في شخصيته، الذي رفضه المعظم بسببه: «أنا بصنّف حالي كشخص فيه أنوثة. وهذا مش إشي بستحي منه». لكنه يعترف أنه لم يشف تمامًا من تجربة التنمر التي سلبته سنوات طفولته ومراهقته. والآن، رغم أنه بنى ثقة بنفسه، فإن تعرّضه أحيانا لتعليقات عدائية تخصّ هذا الموضوع، يعيد إليه، كما يقول، الذكريات الماضية، ويخلخل، وإن لوهلة، ثقته بنفسه: «وبحسسني بشعور كره للمجتمع. مع إني عارف إنه الحق مش على حدا. الحق على البنية كلها».
* تم تغيير أسماء الأشخاص حفاظًا على خصوصيتهم.