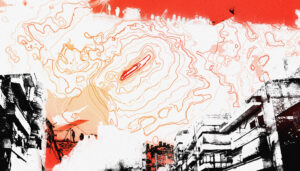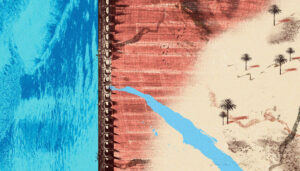بقلم ياسين الحاج صالح*
لا أزال أجد صعوبة في التصالح مع كلمة منفى. كنت أنظر إليها بعين السجين، ثم بعين المقيم في البلد، فتبدو لي تمثيلًا لتجربة بعيدة عن أن تكون الأقسى بين تجارب السوريين، أو مفردة من معجم مثقفين من الطبقة الوسطى ابتعدوا عن الصراع الاجتماعي والسياسي في بلدهم، واخترعوا شيئًا للشكوى منه. هذا الشيء هو المنفى. الصعوبة مستمرة إلى اليوم لأني، وسوريين كثيرين سأذكر أمثلة عنهم لاحقًا، ممزقون بين حالة المنفى وبين البلد المحطم، نعيش في «الخارج»، لكن لنا في «الداخل» أحباء يعانون أوضاعًا أقسى من وضعنا: الخطف والاعتقال، وانقطاع الأثر.
في وقت سابق، لم يكن المنفى أقل سوءًا من السجن وحده، كان غالبًا أقل قسوة من الحياة في البلد. كان السوريون «منفيين» في وطنهم، بلا حقوق سياسية ولا حمايات قانونية ولا حياة ثقافية مستقلة، وبالكاد تتجاوز الحياة الاجتماعية ذاتها دوائر القرابة. كانوا معرضين فوق ذلك لـ«سلبطة» يومية من قبل طغمة حاكمة تجمع بين الخسة والجشع والانحطاط والقسوة. صانوا إنسانيتهم بما استطاعوا، صانوا أيضًا هوامش ومساحات ودودة يعيشون فيها، لكنهم استبطنوا منطق أوضاع سياسية بالغة الجور، حالت بينهم وبين قول الحق في كل شأن مهم تقريبًا. ليس أن معظمنا لم يعِش حياة سياسية فقط، لم نعِش حياة أخلاقية أيضًا. ليس أننا مُنعنا من القيام بما نؤمن به، بل فرض على كثيرين بيننا أن يقوموا بعكس ما يؤمنون به.
كان السوريون «منفيين» في وطنهم، بلا حقوق سياسية ولا حمايات قانونية ولا حياة ثقافية مستقلة.
وإنما لذلك كانت كلمة «منفى» تبدو لي، حتى بداية الثورة، بل حتى خروجي من سوريا، أشبه بسخرية من الباقين في البلد. وربما لهذا السبب عينه، أعني كون «الوطن» سجنًا أو ما يقاربه، لا يبدو أن أحدًا من السوريين قد استخدم مفهوم المنفى أو تأمل فيه، وهذا رغم أن كثيرين عاشوا التجربة عقودًا أو طوال أعمارهم. لا يبدو أن المفهوم يمثل تجربة تَعرَّفَ أي سوري على نفسه فيها.
اليوم، هناك فوق 4 ملايين سوري وسورية مهجرين خارج سوريا. هل هم منفيون؟ بل هم لاجئون تمكنوا من النجاة بأرواحهم. لا تزال هويتهم تتكون من عبور الحدود وخرق الدول، من الاقتلاع والترحل، من الاندفاع بعيدًا، أكثر من العيش بعيدًا والنظر إلى الوراء. هناك من لم يتمكنوا من الترحل أو تقطعت بهم السبل، لكن في الداخل هذه المرة. كان صديقي إسماعيل الحامض يُعِدُّ العُدّة متمهلًا للخروج بأسرته من الرقة، لم يكن يقدر بحال أنه معرض لخطر غير القصف العشوائي من قبل طائرات النظام، هذا قبل أن تختطفه داعش في يوم 2/11/2013. هذا حال كثيرين. منهم سميرة الخليل، زوجتي، التي كنا نخطط معًا كي تنضم إلي في الرقة أولًا، ثم في «منفى» ما، وقت أن ظهر أن الرقة ليست «وطنًا» ممكنًا لنا.
المنفى ليس شرط من حطمت حياتهم، ويعيشون في مخيمات اللجوء، وكان يمكن أن يموتوا جوعًا لولا ذلك. المنفى ليس شرط زبيدة، زوجة إسماعيل الحامض، وأولادها (في فرنسا اليوم، بعد تركيا)، وليس شرط غدير، زوجة أخي فراس، وابنها إبراهيم (في تركيا). يعيشون مضطرين خارج بلدهم، لكن قلوبهم عند المخطوف في الداخل لا يعلمون عن مصيره شيئًا.
ولا أتعرف في مفهوم المنفي على نفسي أيضًا حين تكون سميرة مخطوفة ومغيبة في الداخل. لا أعرف كيف أسمي هذا الشرط، لكنه أشد قسوة من المنفى، ومن السجن، ومن أي شيء خبرته من قبل.
لا يزال الاقتلاع تجربة سورية مستمرة، وفي الداخل الحرب والقتل والتعذيب، وهي تجارب تحول دون استقلال المنفى، دون أن نفكر في أنفسنا كمجرد منفيين. لكن المنفى منذ الآن شرط سوريات وسوريين كثيرين، لم تتحطم حياتهم بالقدر نفسه، ويعيشون متناثرين في بلدان العالم. تجربتهم الشخصية تتمركز أكثر وأكثر حول حول الإقامة بعيدًا والنظر إلى الوراء والداخل، أي حول «المنفى»، وليس حول الاقتلاع والترحل والعبور.
ما أجده شاقًا في هذه التجربة الجديدة هو تفلّتها وعسر التحكم بها، الافتقار إلى نقطة ارتكاز مرجعية تساعد في استيعابها وتنظيمها من جهة، وإلى دليل صالح عن كيفية عيش حياة كهذه من جهة أخرى. لعل هذا هو الجانب الأقسى في التجربة، ذلك الشعور بالانخلاع، بأنك بلا موقع وبلا إحداثيات للتوجه في العالم، الشعور بالانجراف وانفلات المصير. قد لا يكون الاقتلاع من البلد والترحل بين البلدان أسوأ ما في تجربة المنفى، الأسوأ أن يقترن ذلك بصعوبة بناء مكان شخصي، يكون مركزًا للانطلاق منه والابتعاد عنه والعودة إليه. هذا ما يجعل الاقتلاع نهائيًا ومطلقًا. لعل الوطن هو هذا المكان الشخصي، المعروف في كل مكان باسم «البيت»، نُطوِّر مفهومه عبر تجربة الخروج منه والعودة إليه.
يبدو لي، مع ذلك، ممكنًا تطوير ترياق مركب ضد سم التجربة هذه.
لعل الوطن هو هذا المكان الشخصي، المعروف في كل مكان باسم «البيت»، نُطوِّر مفهومه عبر تجربة الخروج منه والعودة إليه.
أول عناصره هو الصداقة. كان مصدر عون خاص لي أن التقيت منذ البداية بأصدقاء من تركيا سبق أن عرفتهم في دمشق. الأصدقاء ينزعون غربة المكان، ويوفرون نقاط علّام للتحرك فيه، يخففون هويته كمنفى ويساعدوننا على بناء هوياتنا وأدوارنا، وحياتنا ككل، في أوضاع جديدة صعبة.
الترياق الفعال الآخر لتمزق حياتنا هو العمل. لا أستطيع التوقف عن العمل، يساعدني على الإمساك بحياتي في شروط مقلقلة، ويشكل في الوقت نفسه جسرًا يربطني بالبلد. العمل الكتابي والعمل مع شركاء في أطر للعمل العام هي أفعال اتصال بسوريين آخرين، وبحياتنا قبل القطيعة التي يمثلها اللجوء. وهي بهذا محاولة بناء وطن حيث نكون. الكتابة بالذات كانت هويتي في سوريا، لم تكن مجرد عمل أعيش منه، ولكن منهجا لشرح العالم والتوجه فيه، بل وللوجود في العالم. وطنًا مختارًا. وبفضل الكتابة والعيش منها لم أعان مشكلات عموم المنفيين. حملت الكتابة معي، عملًا ووطنًا.
الترياق الثالث هو تعلم لغة بلد «المنفى». ليس فقط لأن «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم»، على ما يفيد قول عربي قديم متوجس، ولكن لأن لتعلم اللغة مفعول الصداقة من حيث أنه يساعد في فك شفرات العالم الجديد ونزع «عُجمته»، وتسهيل توطّنه. أي أيضا نزع صفته كمنفى. وأقر أني على هذا المستوى مقصر جدًا. لم أتعلم على نحوٍ منهجي شيئًا من التركية، كأني أقاوم اعتبار منفاي المختار، وهو مختار فعلًا، وطنًا مؤقتًا بديلًا. الإنكليزية تحل جانبا من المشكلة. فهي اليوم اللغة العامة للغرباء.
الترياق الرابع هو المنزل. قبل أسابيع قليلة قالت لي صديقة كاتبة شابة خرجت من البلد قبل نحو عامين ونصف بعد تجربة اعتقال قاسية إنها قضت عامًا صعبًا في بيروت، ممزقة النفس ولا تقر على حال. لكنها أقامت مستقلة في مسكن خاص بعد ذلك وصارت حياتها مثمرة أكثر، وصارت هي أكثر تقبلًا لحياتها الجديدة. أقمت في مسكن مستقل بعد وقت قصير من قدومي إلى إسطنبول، أعمل فيه، ويوفر لي خصوصية لا غنى عنها. وهذا الفضاء الشخصي مفيد لحوار المرء مع نفسه ويساعد على استيعاب التجارب الجديدة بهدوء. هل هذه المساكن بيوت؟ في حياة الترحل ليس لنا غير مساكن نجتهد لتكون بيوتًا. يمكن لدفء البيوت أن يكون خانقًا، لكن الأسوأ أن نكون بلا بيوت، أو أن نُهجّر من بيوتنا.
وأعتقد أن أقسى ما في تجربة التهجير القسري هو فقدان المرء لبيته، حيزه الخاص الذي يتمثل فيه حياته ويهضم تجاربه. هذا حال قدر كبير من السوريين، حيث يقترن فقدان البيت لا بفقدان نقطة المرجع فقط، ولا بتقطع الروابط مع بيئة حياة اجتماعية وطبيعية، ولكن كذلك مع شرخ عميق في الذاكرة. حين جرى الاستيلاء على بيتنا في الرقة من قبل داعش، بدا ذلك لأختي رفعة سرقة لذكرياتنا. البيت موئل الذاكرة، مثلما نخرج منه ونعود إليه، تنبض ذاكراتنا برحلات ذهاب وغياب بين زواياه وخباياه وحياتنا فيه وبين الحاضر. الحنين مرتبط بالبيوت بوصفها مواطن الحميمية والخصوصية، ما يشدنا، أهل البيت، إلى بعضنا وما يميزنا عن غيرنا. لا أستطيع أن أشكو كثيرًا على هذا المستوى. لم نكن، سميرة وأنا، نملك بيتًا خاصًا في سوريا، لكن كان لنا مسكنٌ عشنا فيها سبع سنوات متواصلة، وقبله مسكنان أقمنا فيهما وقتًا أقصر. لكن منذ اختطافها قبل عام وأربعة شهور صارت سميرة هي مرجع ذاكرتي، بيتي المفقود، وقضيتي.
وقت كنت في البلد اعتدت أن أقول إنه ليس لدي أسباب خاصة للشكوى ولا أسباب عامة للرضا. ما تغير بعد الثورة، وما تعرضنا له من تحطيم، ليس شيئا يتعلق بالشكوى والرضا وحدهما، وإنما بأنه لم يعد لدي ما هو شخصي. صار الشخصي سياسيًا، والسياسي شخصيًا. الأمر كذلك في كل حال ودومًا، لكنه مضاعف هنا وضاغط جدًا. بعد خطف سميرة، وقبلها فراس أخي، وبينهما ومعهما أصدقاء أعزاء، لم تكد تبقى مساحة شخصية. هذا المحو التقريبي لما هو شخصي يصلح تعريفًا للمهجرين قسريًا، سواء اضطلعوا هم بهذه الصفة السياسية لحياتهم أم لا.
من جهتي أقبلها تمامًا. أريد أن يتشكل السياسي بصورة تبقيه حساسًا لأوضاع الأشخاص وخياراتهم وفواجع حياتهم. أن يكون إنسانيًا.
* كاتب سوري.
قرأ الكاتب النص في تولوز في 9 نيسان، في أمسية نظمتها جميعة التضامن مع سورية في المدينة. نشر النص على صفحة الكاتب الشخصية على فيسبوك.