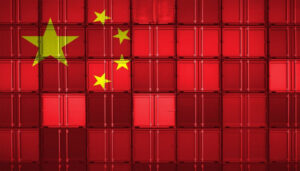«اللحظة المناسبة هي الآن وإلا فلا، إذا كنا نريد حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية». هذا هو التحذير الذي أطلقه جيم سكيا، الأستاذ في كلية لندن الملكية والرئيس المُشارك في فريق العمل المسؤول عن أحدث استعراض شامل لعلوم المناخ، نفّذته الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ. يحذر التقرير من أن العالم على شفا الوصول إلى احترار بواقع 1.5 درجة مئوية خلال العقدين المقبلين، ويذكر أن الاقتطاعات الهائلة من الانبعاثات الكربونية –بدءًا من اليوم– هي وحدها القادرة على تجنّب كارثة بيئية ومناخية. بما أن هذه الاستعراضات والتقارير لا تُعد إلا كل ست إلى سبع سنوات، فربما يكون هذا هو التحذير الأخير من هيئة المناخ قبل أن يمضي العالم إلى مسار لا رجعة عنه من الانهيار المناخي، ستكون عواقبه وخيمة.
بدأت أعراض الانهيار المناخي تظهر في المنطقة العربية،[1] في صورة تقويض الأسس البيئية والاجتماعية-الاقتصادية للحياة. تعاني دول مثل الجزائر وتونس والمغرب ومصر من موجات حر متكررة وحادة، وفترات جفاف مطوّلة، وهي الظواهر التي لها آثار كارثية على الزراعة وصغار المزارعين. في صيف 2021، واجهت الجزائر حرائق غابات غير مسبوقة ومدمرة، وتعرضت تونس لموجة حر خانقة، حيث اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة مئوية، وعانى جنوب المغرب من جفاف مروع للموسم الثالث على التوالي، وفي جنوب مصر، فقد 1100 شخص بيوتهم في فيضانات وأصيب المئات بسبب لدغات العقارب التي خرجت من الأرض بسبب الظروف المناخية المتطرفة. وفي السنوات المقبلة، تُقدّر هيئة المناخ أن منطقة حوض المتوسط ستتعرض لاشتداد للأحداث المناخية المتطرفة، مثل حرائق الغابات والفيضانات، مع زيادة في معدلات القُحولة والجفاف.[2]
تقع آثار هذه التغيرات بقدر غير متناسب على المهمشين في المجتمع، لا سيما صغار المزارعين والمشتغلين بالرعي والعمال الزراعيين والصيادين. بدأ الناس بالفعل يشعرون بالاضطرار إلى ترك أراضيهم بسبب موجات الجفاف والعواصف الشتوية الأقوى والأكثر تواترًا، وتوغّل الأراضي الصحراوية وارتفاع مستوى سطح البحر.[3] تعاني المحاصيل من الفشل في مواسم الحصاد، وتقلّ مصادر المياه تدريجيًا، فيشتدّ تأثيرها على الإنتاج الغذائي في منطقة تعتمد بشكل مزمن على الواردات الغذائية.[4] سوف تطرأ ضغوط هائلة على إمدادات المياه القليلة بالفعل بسبب التغيرات في أنساق تساقط الأمطار وتوغل مياه البحر في خزانات المياه الجوفية، فضلًا عن الإفراط القائم في استخدام تلك المياه. بحسب مقال نُشر في دورية «لانسيت»، فسوف يعرّض هذا أغلب الدول العربية لمستوى فقر مائي مُطلق بواقع 500 متر مكعب للفرد سنويًا بحلول عام 2050.[5]
يتنبأ علماء المناخ بأن المناخ في قطاعات واسعة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد يتغير بشكل يهدّد قدرة بقاء السكان على قيد الحياة.[6] في شمال إفريقيا على سبيل المثال، ستشمل الفئات التي ستتغير حياتها بأكبر قدر صغار المزارعين في دلتا النيل والمناطق الريفية في كل من المغرب وتونس، والصيادين في جربا وقرقنة في تونس، وسكان عين صالح في الجزائر، واللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف في الجزائر، والملايين ممن يعيشون في عشوائيات القاهرة والخرطوم وتونس العاصمة والدار البيضاء.
في كل عام، يجتمع قادة العالم السياسيين مع المستشارين والإعلام ولوبيات الشركات في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب» (COP). لكن رغم التهديد الذي يواجه الكوكب، تستمر الحكومات في السماح بتصاعد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الأزمة. وأصبح من الواضح أن المحادثات المناخية مفلسة وفاشلة، اختطفتها الشركات والمصالح الخاصة التي تروج لحلول كاذبة هدفها جني الأرباح، مثل أفكار تجارة الكربون وما يُسمى بـ«الصفر الصافي» و«الحلول المستندة إلى الطبيعة»، بدلًا من إجبار الأمم الصناعية والشركات متعددة الجنسيات على تقليل الانبعاثات الكربونية.[7]
جذب مؤتمر كوب 26، الذي انعقد في غلاسكو في عام 2021، اهتمامًا إعلاميًا هائلًا لكنّه لم يحقق أيّ عوائد كبرى. ويُرجح أنّ محادثات 2022 و2023 التي ستنعقد في المنطقة العربية (كوب 27 في مصر وكوب 28 في الإمارات) لن تؤدي إلى إنجاز يُذكر، لا سيما في ضوء اشتداد التنافس الجيوسياسي العالمي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو سياق لا يسمح بالتعاون بين القوى الكبرى، ويمثل ذريعة إضافية لاستمرار الإدمان العالمي على الوقود الأحفوري. سيكون هذا هو المسمار الأخير في نعش محادثات التغير المناخي.
إن بقاء الجنس البشري يعتمد على ترك الوقود الأحفوري في باطن الأرض، وعلى التكيف مع المناخ المتغير مع الانتقال إلى طاقات متجددة ومعدلات مستدامة من استخدام الطاقة وتحولات اجتماعية أخرى. سوف تُنفق المليارات على محاولة التكيف، من البحث عن مصادر مائية جديدة وإعادة هيكلة الزراعة وتغيير المحاصيل وبناء حواجز بحرية (مصدات أمواج) لإبقاء الماء المالح بعيدًا عن اليابسة، وتغيير شكل وطبيعة المدن، ومحاولة الانتقال إلى مصادر خضراء للطاقة من خلال بناء البنية التحتية المنشودة والاستثمار في الوظائف والتكنولوجيا الخضراء. لكن مصالح مَن ستخدم هذه التحولات والانتقال الطاقي؟ ومن هم المتوقع أن يدفعوا أغلى أثمان الأزمة المناخية والتعاملات معها؟
من يقود الاستجابة لتغير المناخ؟
حاليًا، تصوغ نفس القوى وبنى السلطة الشرهة التي أسهمت في حدوث تغير المناخ الردَّ عليه، وهدفها الأساسي هو حماية المصالح الخاصة وجني أرباح أكبر. في حين أن المؤسسات المالية العالمية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تعكف على وضع تصورات عن الحاجة إلى الانتقال المناخي، فإن تصوراتها هي تصورات لانتقال رأسمالي بقيادة الشركات في أغلب الأحيان، وليست تصورات تقودها المجتمعات المحليّة وفي خدمة مصالحها. لا تجد أصوات منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية عادةً آذانًا صاغية عندما يتعلق الأمر بعواقب هذا الانتقال والحاجة إلى بدائل عادلة وديمقراطية. على النقيض من ذلك، فإن المؤسسات المالية العالمية ومعها مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي تتحدث بوضوح وبصوت مسموع، وتنظم الفعاليات وتنشر التقارير في دول المنطقة العربية. لكن تحليلاتها للتغير المناخي والانتقال المنشود ضيّقة ومحدودة وهي في واقع الأمر خطرة، إذ تهدد بإعادة إنتاج نفس أنماط الاستلاب ونهب الموارد التي وسمت حقبة الوقود الأحفوري الحالية.
تدفع أطرافٌ مثل البنك الدولي ووكالة التنمية الألمانية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالة التنمية الفرنسية والكثير من هيئات الاتحاد الأوروبي رؤيةً للمستقبل يكون الاقتصاد فيها خاضعًا لمنطق الربح الخاص، بما يشمل الدفع بالمزيد من الخصخصة للمياه والأرض والموارد والطاقة، بل وحتى الغلاف الجوي. وتشمل المرحلة الأخيرة في هذا التّوجه الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي يتم تنفيذها في كل قطاع في المنطقة، وتشمل كذلك قطاع الطاقات المتجددة.
الدفع نحو خصخصة الطاقة وهيمنة الشركات في مجال الانتقال الطاقي ظاهرة عالمية لا تقتصر على المنطقة العربية، لكن آليات هذه العملية في المنطقة العربية أكثر تقدمًا، ولم تصادف إلى الآن مقاومة كبيرة. المغرب ماضٍ بقوة في هذا المسار، وكذلك تونس. وهناك دفع قوي بالخصخصة وتوسيعها في قطاع الطاقة المتجددة في تونس، مع تقديم محفزات هائلة للمستثمرين الأجانب لإنتاج الطاقة الخضراء في البلاد، بما يشمل إنتاجها لأغراض التصدير. وتسمح القوانين التونسية باستخدام الأراضي الزراعية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في بلد يعاني بالفعل من تبعية غذائية حادة[8] (كما تبين أثناء انتشار جائحة كوفيد ثم مع حرب أوكرانيا).
تستعرض المؤسسات المالية الدولية والشركات والحكومات «الاقتصاد الأخضر» أو ما تسمّيه بـ«التنمية المستدامة» بصفتها منظورًا جديدًا. لكنها في واقع الأمر امتداد لنفس منطق التراكم الرأسمالي والتسليع والتعامل بمنطق مالي بحت، بما يشمل تطبيق كل هذا على الطبيعة ذاتها.
إن الواقع التاريخي والسياسي والجيوفيزيائي للمنطقة العربية، ولشمال إفريقيا الذي نخصه هنا بالتفحص، يعني أن كلًّا من الآثار والحلول الخاصة بالأزمة المناخية ستكون مختلفة في المنطقة عن وضعها في أية سياقات أخرى. تنخرط شمال إفريقيا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي من موقع تابِعٍ؛ فقد أثّرت القوى الاستعمارية على دول شمال إفريقيا أو أجبرتها على القبول ببناء اقتصاداتها بالأساس حول استخراج وتصدير الموارد –التي عادةً ما تُقدم رخيصة في صورة خام– مقابل استيراد السلع الصناعية عالية القيمة. النتيجة هي نقل واسع النطاق للثروة إلى المراكز الإمبريالية على حساب التنمية المحلية.[9] يؤكد استمرار هذه العلاقات غير المتكافئة أو المتعادلة حتى اليوم على دور دول شمال إفريقيا بصفتها جهات مُصدِّرة للموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز، والسلع الأساسية المعتمدة بشكل مكثف على المياه والأرض، مثل المحاصيل الزراعية النقدية. يفاقم هذا التجذّر للنمط الاقتصادي الاستخراجي التصديري من التبعية الغذائية والأزمة البيئية مع تكريس علاقات هيمنة إمبريالية وتراتبيّات استعمارية جديدة.[10]
من ثم، هناك أسئلة مهمة يجب طرحُها عند الحديث عن التصدي لتغير المناخ والتحول نحو الطاقات المتجددة في المنطقة: كيف سيكون التعامل العادل مع التغير المناخي هنا؟ هل يعني حرية الانتقال إلى أوروبا وفتح الحدود معها؟ هل يعني تسديد الدين المناخي والإنصاف والتعويض من قبل الحكومات الغربية والشركات متعددة الجنسيات والنخب المحلية الثرية؟ هل يعني الانتقال بعيدًا عن النظام الرأسمالي؟ ما الذي يجب أن يحدث لموارد الوقود الأحفوري في المنطقة والجاري استخراجها حاليًا من قبل شركات غربية؟ من الذي يجب أن يسيطر على الطاقة المتجددة في المنطقة؟ ما معنى التكيّف مع المناخ المتغير ومن سيشكل هذه الآليات ومن سيستفيد منها؟ ومن هي الأطراف التي ستكافح من أجل تغيير حقيقي وتحوّلات جذريّة؟
بينما بدأت بعض الحكومات عبر العالم التعامل مع تغير المناخ بجدية، فهي كثيرًا ما تفعل هذا انطلاقًا من منظور «الأمن المناخي»،[11] من تدعيم للدفاعات ضد ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى مواجهة الحوادث المناخية المتطرفة، ولكنها كثيرًا ما تُفعّل إجراءاتها أيضًا ضد «تهديد» اللاجئين المناخيين، وضد إعادة التفاوض على توزيع السلطة عالميًا. لكن تشكيل المستقبل حول منظور «الأمن» سيُخضع نضالاتنا لأطر مفاهيمية وتخيّلية تعيد في نهاية المطاف تمكين قوى الدولة القمعية، مع فرض المنطق الأمني والعسكري على الاستجابة لتغير المناخ. فهذه الإجراءات لن تحل الأزمة المناخية، بل ستسمح للأغنياء بالبقاء في أوضاع مريحة مع دفع باقي العالم ثمن الجمود في التعامل مع التغير المناخي.
الاستشراق البيئي
كما قوّض الإخضاع الاقتصادي والهيمنة الإمبريالية من الاستقلالية السياسية والاقتصادية للمنطقة العربية، فإن إنتاج المعرفة عن الشعوب العربية وتمثيلهم هم وبيئتهم يُستخدم بالمثل من قبل القوى الاستعمارية لشرعنة مشاريعها وأهدافها. تستمر استراتيجيات الهيمنة تلك حاليًا في دول المنطقة ويجري إعادة تشكيل التصورات عنها (مرة أخرى) بصفتها أشياء يجدُر تنميتها، بما يدعم مرة أخرى أفكار «رسالة التحضر الأوروبية» من العهود الاستعمارية.
تحاجج ديانا كيه ديفيز بأن التصوّرات البيئية الأنغلو-أوروبية في القرن التاسع عشر مثّلت البيئة بالعالم العربي بصفتها «غريبة ومختلفة وفانتازية وغير طبيعية، ومتدهورة كثيرًا بشكل من الأشكال». واستخدمت بدقة ومهارة مفهوم «الاستشراق» الذي صكه إدوارد سعيد،[12] كإطار مفاهيمي لتفسير التمثيلات الغربية المبكرة للبيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشكل من أشكال «الاستشراق البيئي». تُسرد قصة هذه البيئة على ألسنة من أصبحوا أصحاب سلطة إمبريالية -بالأساس من بريطانيا وفرنسا- بصفتها «غريبة وناقصة»، مقارنة بالبيئة الأوروبية «الطبيعية والمثمرة»، كتبرير للتدخلات التي هدفت إلى «تحسين وترميم وتطبيع وإصلاح» هذه البيئة.[13]
إن مقاومة وتفكيك الاستشراق والسردية البيئية الاستعمارية الجديدة ستتطلب بناء رؤى نحو حراك جماعي ضد التغير المناخي، ومن أجل العدالة البيئية والتحول الاجتماعي-البيئي.
استخدمت السلطات الاستعمارية هذا التصوير المخادع للتدهور البيئي والكارثة البيئية المفترضين في تبرير جميع أشكال الاستلاب التي أقدمت عليها، فضلًا عن السياسات التي صممتها للسيطرة على السكان في المنطقة وعلى بيئتهم الطبيعية. في شمال إفريقيا، شيد الاستعمار الفرنسي سردية بيئية انطوت على مقولات التحلل والتفسخ والتدهور من أجل تنفيذ «تغييرات دراماتيكية، اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية».[14] انطلاقًا من هذا المنظور، فإن السكان المحليين وبيئاتهم احتاجوا معًا إلى مباركة «رسالة التحضر الأوروبية» وعناية الرجل الأبيض.
ثمة مثال معاصر واضح، هو التمثيل الحالي لصحراء شمال إفريقيا، التي عادة ما توصف بأنها أرض فسيحة وخالية وميتة فيها قلة من السكان، وكأنها الجنة الموعودة للطاقة المتجددة. بناءً على هذا التصور، فهي تمثّل فرصة ذهبية لتقديم الطاقة الرخيصة لأوروبا حتى تستمر في نمط حياتها الاستهلاكي الباذخ وفي استهلاك الطاقة المفرط. تتجاهل هذه السردية الكاذبة أسئلة الملكية والسيادة وتخفي وراءها علاقات الهيمنة والسيطرة العالمية التي تيسّر نهب الموارد وخصخصة المشاع وسلب المجتمعات، من ثم تدعم سبل الإدارة غير الديمقراطية والإقصائية للانتقال الطاقي. كما هو الحال في مناطق عديدة حيث حياة الناس وسبل معاشهم خفية أو «مخفية» في عين الدول المستعمرة، «لا توجد أراضٍ خالية» في شمال إفريقيا.[15] حتى عندما تكون الأراضي قليلة السكان، فلا تزال البيئات التقليدية والأراضي مغروسة في قلب الثقافات والمجتمعات القائمة، ولا بد من احترام حقوق الناس وسيادتهم في سياق أي تحول اجتماعي-بيئي.
من الضروري تحليل الآليات التي يتم بموجبها نزع إنسانية الآخر، وكيف تُستخدم سلطة التمثيل وبناء التخيلات حوله (وحول بيئته) في تعميق بنى السلطة والهيمنة والاستلاب. في هذا الصدد، فإن ما وصفه إدوارد سعيد في «الاستشراق» بأنه «احتقار واختزال ونزع الطابع الإنساني» عن الثقافات أو الشعوب أو المناطق الجغرافية الأخرى، مستمر حاليًا في تبرير العنف الموجه ضد الآخر وضد طبيعته. يتخذ هذا العنف قالب تهجير السكان والسيطرة على أراضيهم ومواردهم، وجعلهم يدفعون الثمن الاجتماعي والبيئي للمشروعات الاستخراجية ومشروعات الطاقة المتجددة، مع قصف وتقتيل الشعوب المظلومة وترك المهاجرين يغرقون في المتوسط، وتدمير الأرض تحت لواء التقدم.
بالتالي، فإن مقاومة وتفكيك الاستشراق والسردية البيئية الاستعمارية الجديدة ستتطلب بناء رؤى نحو حراك جماعي ضد التغير المناخي، ومن أجل العدالة البيئية والتحول الاجتماعي-البيئي، تضرب جذورها في تجارب وتحليلات وأفكار تحرّرية من مناطق إفريقيا والعالم العربي وغيرها من المناطق.
ما هو «الانتقال العادل»؟
تهيمن المؤسسات النيوليبرالية الدولية على أغلب الكتابات عن التغير المناخي والأزمة البيئية والانتقال الطاقي في المنطقة العربية. وتحليلات هذه المؤسسات متحيزة ولا تتعاطى مع أسئلة الطبقة والعرق والجندر والعدل والسلطة والتاريخ الاستعماري. وحلولها المقترحة ووصفاتها للمشاكل تستند إلى السوق، وتأتي من أعلى لأسفل، ولا تتصدى للأسباب الجذرية لأزمات المناخ والبيئة والغذاء والطاقة. تؤدي المعرفة التي تنتجها هذه المؤسسات -بشكل عميق- إلى عدم التمكين، وتتجاهل أسئلة القمع والمقاومة، وتركز بقوة على نصائح «الخبراء»، مع إقصاء الأصوات «القادمة من أسفل».
على هذه الخلفية من المقترحات، التي في أفضل الأحوال تتجاهل إلى حد بعيد أسئلة السلطة والعدالة، ظهر مفهوم «الانتقال العادل» بصفته إطار عمل يضع العدالة في قلب النقاش. يقرّ هذا النهج -على حد قول إدواردو غاليانو- بأنّ: «حقوق البشر وحقوق الطبيعة هما مسميان لنفس الكرامة».[16] من أين جاءت فكرة الانتقال العادل؟ وما الذي يمكن أن تقدمه لمشروع إعداد رؤى تعمل من أسفل لأعلى وتقاوم الإمبريالية من أجل الخلاص البشري والتحرك على ملف المناخ في سياق المنطقة العربية؟
يمكن تتبع جذور مفهوم الانتقال العادل إلى الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن العشرين، عندما ظهرت تحالفات جديدة غير مسبوقة بين النقابات العمالية والحركات البيئية والشعوب الأصلية، للنضال من أجل العدالة البيئية في سياق مواجهة الصناعات الملوِّثة للبيئة. في مواجهة القوانين البيئية التي كانت تُنفّذ حينئذ للمرة الأولى أو شُدِّدت نصوصها خلال ذلك العقد، ادّعت الشركات أن السياسات الحامية للبيئة تطالبها بفصل الكثير من العمال. التفتت النقابات والجماعات المحليّة ضد محاولة «فرق تسد» تلك، وقالت إن بين العمال والجماعات المهمشة –لا سيما السود وغير البيض الآخرين ومجتمعات الشعوب الأصلية الذين عانوا أكثر من غيرهم من الصناعات الملوّثة للبيئة– مصلحة مشتركة في توفير بيئة مناسبة للحياة وعمل لائق وآمن بأجور معقولة.
على مدار العقود التالية، تبنّت مجموعات مختلفة مفهوم الانتقال العادل واستكشفته وشرحته وفسّرته. في البداية، تركزت المجموعات هذه في الولايات المتحدة وكندا، ثم انتقل النقاش إلى مجموعات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا. تعاونت الحركات العمالية وحركات العدالة البيئية –مع الشعوب الأصلية والحركات النسوية والشباب والطلاب ومجموعات أخرى– على بناء تحالفات ورؤى مشتركة لتقديم حلول قادرة على إحداث تحولات جذرية في ملف الأزمة المناخية، بما يشمل التصدي للأسباب الجذرية، مع وضع حقوق الإنسان وسيادة الشعوب ومواجهة التدهور البيئي في الصدارة.
من الواضح أن الانتقال العادل سيتطلب الإقرار بالمسؤولية التاريخية للغرب المتقدم صناعيًا، فيما يخصّ التسبّب في الاحترار العالمي.
ومع اكتساب إطار العمل هذا الشعبية والانتشار، زادت الشركات والحكومات من محاولاتها لتقديم رؤاها الخاصة للانتقال العادل، وجاءت تلك المحاولات مفتقرة للتحليل الطبقي، مع إنكار الحاجة إلى تحولات جذرية. مع ذكر مفهوم «الانتقال العادل» في ديباجة اتفاق باريس –وهو انتصار اكتُسِب بشق الأنفس من طرف الحركات العمالية وحركات العدالة المناخية العالمية– اشتدت وتيرة هذا «الالتفاف» على المفهوم وتخفيف مغزاه السياسي القوي. اليوم، لم يعد «الانتقال العادل» مفهومًا واحدًا، حيث أصبح واقعًا في حقل من الخلاف حوله، في مساحة تشهد نضالات حول الحلول المطلوبة والممكنة للأزمة المناخية. لا يعني المصطلح بالضرورة سياسات تقدمية مُخلصة للبشر، إذ تستخدمه الكثير من الأطراف لوصف مقترحات لا تعدو كونها استمرار الحال على ما هو عليه والدفاع عنه، أو استمرار الحال على مسار تكثيف النمط الاستخراجي «الأخضر». لكن بخلاف الحديث عن «التنمية المستدامة» أو «الاقتصاد الأخضر»، يقدّم مفهوم الانتقال العادل مساحة يمكن للحركات استغلالها للإصرار على سموّ العدالة في جميع الحلول المناخية المقترحة. فرغم محاولات «الالتفاف» على المفهوم ونزع حدته السياسية، تُعدّ مركزية «العدالة» في المصطلح في حد ذاتها نقطة قوة تحافظ على سلامة المفهوم.
مقترحات الانتقال العادل التي تقدمها الحركات الاجتماعية التقدمية مدفوعة بقناعة أنّ الناس الذين يتحملون أعلى كلفة للنظام الحالي، يجب ألا يصبحوا هم من سيدفع ثمن الانتقال إلى مجتمع مستدام، بل يجب أن يكونوا في صدارة الأطراف التي ستشكل مسار هذا الانتقال. استكشفت ديناميّات عديدة جوانب مختلفة من هذه المسألة، سعيًا لتحسين فهم تكاليف النظام القائم وإمكانات الانتقال، والنفقات المحتملة للبدائل المقترحة. من المنظورات النسوية وتلك الخاصة بالشعوب الأصلية، إلى البرامج الإقليمية والقُطرية، فإن الحركات المختلفة تدفع بتعريفاتها الخاصة بها لكل من «العدالة» و«الانتقال» في سياقاتها المتعددة.[17]
يعتمد المفهوم الذي نتبناه على رؤى صادرة عن اجتماع لحركات العدالة البيئية والحقوق العمالية من ثلاث قارات، وقد انعقد في أمستردام في 2019. توصل المشاركون في الاجتماع إلى ستة مبادئ أولية للانتقال العادل: الانتقال العادل مختلف في مختلف الأماكن؛ الانتقال العادل مسألة طبقية؛ الانتقال العادل مسألة جندرية؛ الانتقال العادل إطار عمل معادٍ للعنصرية؛ الانتقال العادل لا يخصّ فقط مسألة المناخ بل يتعدّاها؛ الانتقال العادل مرتبط بالديمقراطية.[18]
مع عدم الادعاء بأنه تعريف جامع مانع أو مجموعة نهائية ومستقرة من المبادئ الدائمة، فإن هذا التحليل يوضح الأسس العامة لموقف يقرّ بأنه على المناقشات حول الانتقال العادل أن تستجيب لواقع التنمية غير المتكافئة الذي تسببت فيه الإمبريالية والاستعمار، وأن على الانتقال العادل أن يشمل تحولات جذرية تزيد من سلطة «الناس العاملين»[19] على تنوّعهم، وتقلل من سلطة النخب الرأسمالية والسياسية، مع الاعتراف بأنه لا يمكن التصدي للمشكلات البيئية دون التصدي للبنى العنصرية والمتعصبة جندريًا، وغيرها من البنى القمعية للاقتصاد الرأسمالي. هذا الموقف يُقرّ كذلك أن الأزمة البيئية أكبر من كونها أزمة مناخية، إذ تشمل فقدان المواطن البيئية والتنوع الحيوي، والانهيار الشّديد للعلاقات البشرية مع «العالم الطبيعي»، ويعترف أنّ الانتقال العادل لا يمكن أن يتحقق دون تحولات في السلطة السياسية والاقتصادية نحو مزيدٍ من الديمقراطية.
الوجه الثاني لمتانة مفهوم الانتقال العادل هو تاريخه كأداة أو إطار موحّد للحركات المختلفة عبر خطوط الانقسام الكثيرة القائمة والمحتملة. كما أوضحنا أعلاه، فقد خرج المفهوم في الأصل للتعامل مع تكتيكات «فرّق تسد» التي تسلّحت بها الشركات المقاومة لتشديد القوانين البيئية. هذه الأساليب حية وتُمارس إلى الآن، حيث تدفع الشركات بسياسات تحمي أرباحها بغض النظر عن التكاليف التي تتحمّلها المجتمعات والعمال والكوكب، مع تحريضها مختلف المناطق وفئات البشر العاملين ضد بعضهم البعض. تقرّ الحركات الدولية المعنية بالعدالة المناخية، والائتلافات القُطرية والإقليمية والتحالفات المحلية في شتى أنحاء العالم، بأننا جميعًا تقريبًا مستفيدون من وجود بيئة مزدهرة وحية، وأننا نعاني عندما تتركز الثروة والسلطة في يد نخب ضئيلة تستفيد من حماية نفسها فقط من أسوأ آثار الأزمة المناخية. لكن بناء حملات ورؤى ومقترحات مشتركة والكفاح من أجلها، هي عمليات بطيئة ومليئة بالتحديات سياسيًا ولكنها تبقى ضرورية. ويمكن أن يساعد مفهوم الانتقال العادل، وما يتصل به من تجارب متنامية من العمل والحملات حول العالم، في توفير بعض الإرشاد والتوجيه على هذا الطريق الصعب.
لقد تشكّل مفهوم الانتقال العادل جزئيًا على يد الحركات العمالية، لذا تبقى مسألة العمل اللائق في قلب عدّة مقترحات مقدَّمة في إطار هذا المفهوم. في هذا السياق، ما الذي نقصده حين نتكلم عن العمل اللائق؟ وكيف يمكن أن نفهم مختلف فئات العمال/ العاملين؟
بإلهام من المؤرخ والناشط السياسي الغوياني والتر رودني واستعماله السياسي لمفهوم «الناس العاملين»، حاجج الباحث التنزاني عيسى شيفجي بأنه «في ظل النيوليبرالية، يتخذ التراكم البدائي أشكالًا جديدة ويصبح أكثر عمومية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يشمل ما يُسمى بالاقتصاد غير الرسمي. يستغل المنتِج نفسه/ نفسها حتى يبقى على قيد الحياة، مع دعمه في الوقت نفسه لرأس المال». ثم يقول شيفجي بأننا بحاجة إلى فهم جديد للعمال، يقرّ بالاستغلال الشائع الذي يواجه العمال الصناعيين المنظَّمين وكذلك العَمالة الهشّة وغير الرّسمية، والمؤقتة والمهاجرة، بالإضافة لغير مدفوعي الأجر وذوي الأجور المتدنّية (عادة النساء) الذين يقومون بأعمال منزلية وأعمال رعاية وأعمال إعادة إنتاج للمجتمع، والموظفين ذاتيًا أو صغار المزارعين، والرعاة والصيادين الذين يعملون بشكل مباشر للبقاء على قيد الحياة.[20]
ليست صدفة أن هذه الأغلبية المُستَغَلة والمعرَّضة للعمل غير المستقر هي أيضًا المجموعة الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، والفئة الأقل قدرة على حماية نفسها من آثاره. إذن، بالاقتران مع مفهوم الانتقال العادل، يمكن أن نستخدم هذا التعريف لـ«البشر العاملين» أثناء إعداد رؤيتنا عمّن يجب أن تكون لهم الكلمة فيما يخص الانتقال الطاقي، والتعامل مع الأزمة المناخية بشكل عام. إذ يمثّل المفهومان معًا المهاد والمبدأ لما يمكن أن تكونه العدالة في العمل المناخي.
تختلف الديناميات القائمة من دولة لأخرى وهي معقّدة، لكن هناك أيضًا تحديات وأسئلة مشتركة كثيرة. فمن الواضح –وبشكل متزايد– أن الانتقال العادل سيتطلب الإقرار بالمسؤولية التاريخية للغرب المتقدم صناعيًا، فيما يخصّ التسبّب في الاحترار العالمي. ثمّة حاجة إلى الإقرار بدور السلطة/ القوة في صياغة مسار تشكل التغير المناخي ومسبّباته، ومن يتحملون عبء آثاره و«الحلول» المقدمة للأزمة. في هذا الإطار، فإن العدالة المناخية والانتقال العادل مفاهيم يمكن أن تحدث قطيعة مع «استمرار الوضع الرّاهن» الذي يحمي النخب السياسية العالمية والشركات متعددة الجنسيات والنظم غير الديمقراطية.
هذا المقال هو نسخة مختصرة من مقدمة كتاب «آبار قديمة واستعمار جديد: تحديات المناخ والانتقال العادل نحو طاقة مستدامة»، الذي حرره حمزة حموشان وكايتي ساندويل، ويضم أوراقًا لتسعة باحثين تتناول قضايا تتعلق بالانتقال الطاقي في عدد من بلدان شمال إفريقيا، والصادر حديثًا عن دار صفصافة في القاهرة بالشراكة مع المعهد الدولي (TNI). وتنشر حبر هذا المقال بالتعاون مع المعهد الدولي.
-
الهوامش
[1] مع الإقرار بعدم دقة المصطلحات، فإننا نستخدم «شمال إفريقيا» و«المنطقة العربية» والشرق الأوسط وشمال إفريقيا» بالتبادل.
[2] هيئة المناخ. 2021. «تقرير التقييم السادس»: IPCC (2021) Sixth Assessment Report – Working group 1: The physical science basis..
[3] حمزة حموشان وميكا مينيو-بالويللو. 2015. «الثورة القادمة في شمال إفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية».
[4] Amouzai, A. and Kay, S. 2021. «Towards a just recovery from the Covid-19 crisis: the urgent struggle for food sovereignty in North Africa». Transnational Institute and North African Food Sovereignty Network.
[5] El-Zein, A. et al. 2014. «Health and ecological sustainability in the Arab world: a matter of survival», The Lancet 383(9915): 458–476.
[6] Lelieveld, J. et al. (2016) «Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st century», Climatic Change 23.
[7] Friends of the Earth International (2021) «Chasing carbon unicorns: the deception of carbon markets and «net zero»; Corporate Accountability (2020) «Not zero: how «net zero» targets disguise climate inaction»
[8] شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية – تونس. 2019. «فلاحتنا، غذاؤنا، سيادتنا: تحليل للسياسات الفلاحية التونسية على ضوء مفهوم السيادة الغذائية».
[9] Amin, S. 1990. Delinking: Towards a polycentric world. Zed Books; Amin, S. 2013. The Implosion of Capitalism. Pluto Press; Rodney, W. 2012. How Europe Underdeveloped Africa. London: Pambazuka Press; and Galeano, E. (1973) Open Veins of Latin America. New York: Monthly Review Press.
[10] حمزة حموشان (2019) «النمط الاستخراجي ومقاومته في شمال إفريقيا»، ترانس-ناشونال. و ليلى رياحي وحمزة حموشان (2020) «التبعية الشاملة والمعمقة في شمال إفريقيا»، ترانس-ناشونال.
[11] Buxton, N. 2021. «A primer on climate security: the dangers of militarising the climate crisis». Transnational Institute.
[12] إدوارد سعيد. 1977. «الاستشراق»، لندن: بنغوين.
[13] Davis, D.K. 2011. ‘Imperialism, orientalism, and the environment in the Middle East: history, policy, power and practice’, in D.K. Davis and E. Burke III (eds) Environmental Imaginaries of the Middle East and North Africa. Athens, Ohio: Ohio University Press.
[14] المصدر السابق.
[15] Springate-Baginski, O. 2019. «There is no vacant land»: a primer on defending Myanmar’s customary tenure systems». Transnational Institute.
[16] Movement Generation Justice and Ecology Project. no date. From Banks and Tanks to Cooperation and Caring: A strategic framework for a just transition.
[17] Friends of the Earth International. 2021. «If it’s not feminist, it’s not just». Indigenous Environmental Network. 2017. «Indigenous principles of just transition». Trade Union Confederation of the Americas. 2014. PLADA – Development Platform of the Americas. Alternative Information and Development Centre. 2016. «One million climate jobs».
[18] Transnational Institute. 2020. «Just transition: how environmental justice organisations and trade unions are coming together for social and environmental transformation». Transnational Institute.
[19] يُستخدم مفهوم «الناس العاملين» أو «البشر العاملين» كمفهوم جامع دال على العمال بكافة فئاتهم، بما يتجاوز مُحدِدات «الطبقة العاملة». تحاول هذه الصياغة استيعاب فكرة تنوع صنوف العمل، من عمل بأجر وبغير أجر، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، دائم ومؤقت، وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها في الأغلب النساء، وكذلك أعمال ربما لا يُنظر إليها ضمن إطار «العمال» التقليدي، من قبيل الفلاحة والرعي والصيد، أو الأعمال بدوام جزئي أو موسمي، بما يشمل عمل مجموعات الشعوب الأصلية وفئات السكان الأخرى المشتغلة بأنشطة معيشية غير متعارف على كونها «عمل».
[20] Shiva, I.G. 2017. «The concept of «working people», Agrarian South Journal of Political Economy 6 (1): 1–13.